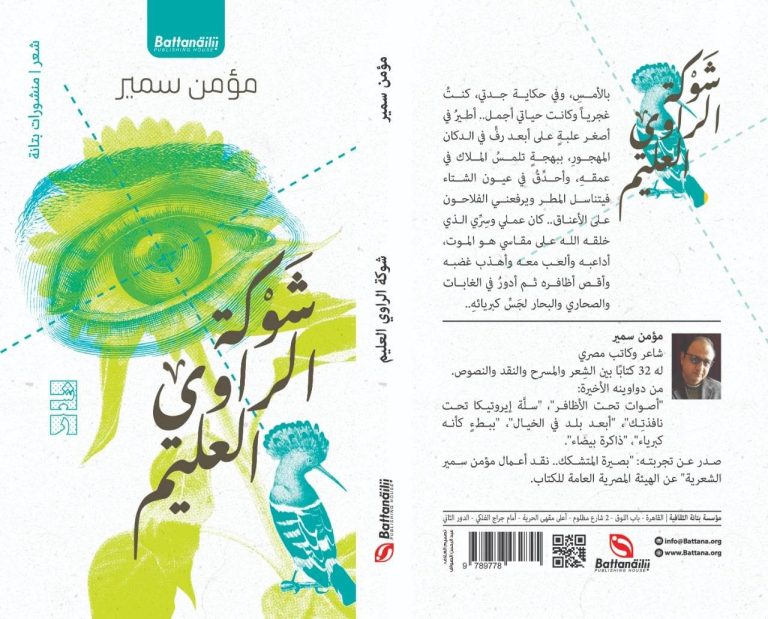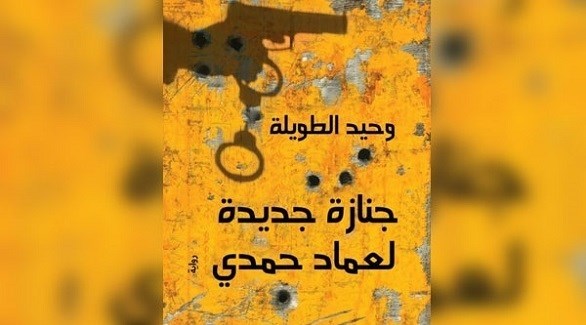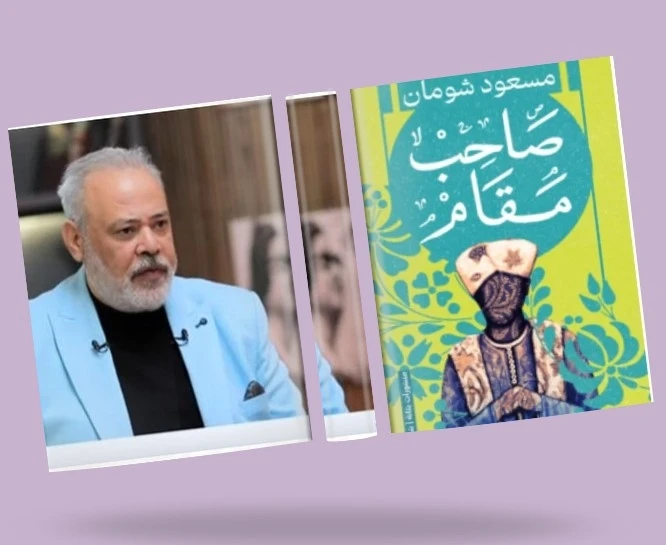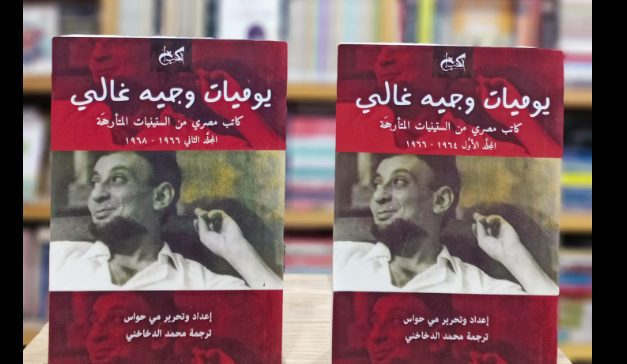عبير سليمان عبد المالك
أن تقرأ لأشرف الصباغ فلابد إذن أن تتخلى عن كل تحفظاتك، وتتمرد مثله على كل التابوهات خالعاً عنك مسوح الفضيلة والرهبنة الزائفة، فأنت على أعتاب تجربة أدبية جريئة وغير تقليدية فكن مقتحماً وشجاعاً كما يليق بها، ولا تنسى أن تحضر معك أدواتك، ذهناً حاضراً ويقظاً، كشكولاً وقلماً لرسم شجرة الشخصيات وبعض الملاحظات الهامة، فالكاتب خفيف الظل، يجيد التعبير عن الألم الإنساني وإحباطات الإنسان المهمش بروح السخرية والدعابة، فيخرج النص ممتلئاً بالحركة والحيوية، ولا مانع من توظيف الألفاظ المعتادة في الحواري والمقاهي الشعبية، وبعض المشاهد عن العلاقات الجنسية التي تفرضها قوانين التجاور حد التلاصق بين الغرف السكنية داخل البيوت.
لن أخجل من قول إنني شعرت لدى انتهائي من حكايات كائنات الليل والنهار، كأني عدت طفلة دخَلَت متاهة ولا تعرف سبيلاً للخروج منها، فبداية الرواية كانت مراوغة، بدأها الأديب من حي الزمالك الذي وصفه بأن له كوداً لا يُمنح إلا لشريحة خاصة من المجتمع، وهم من يملكون المؤهلات الاجتماعية والعلمية والثقافية ما يؤهلهم للحصول على هذا الكود، أو بطاقة الهوية التاريخية التي تشير إلى أن حاملها يليق به السكن في هذا الحي.
تبدأ أحداث الرواية من مكان عمل “عاشور” في حي الزمالك ويحكي لنا أولا على لسانه: “سكان الزمالك لا تستطيع الحديث معهم ، ومنهم من لا ينظرون إليك أصلاً وقطاعات أخرى لا تتصور أنك موجود وآخرون يمدون لك يد المساعدة لكن بحساب، أو يشفقون عليك إلى ذلك الحد الذي يجعلك لا تتمرد عليهم أو تتساوى رأسك برؤوسهم”، ثم يأتي صوت الراوي المثقف ليروي جزءاً مهماً عن تاريخ المكان: “في سبعينيات القرن الماضي، عندما طفا تجار الخردة والمخدرات على السطح، كانت هناك محاولات لتحويل هذه المنطقة إلى منطقة عادية مثل بقية المناطق، ولكن “الكود التاريخي “لسكانها وقف حائلاً دون ذلك”.
ويعود بنا بالفلاش باك إلى حيث ولد ونشأ عاشور، كأنه أراد أن يمهد لنا بعرض لوحة جميلة ومريحة للبصر قبل أن يصدمنا بالانتقال إلى منطقة أخرى على النقيض تماماً، لكنه بذكائه فضل ألا يبدأ بك من المشاهد الواقعية القاسية التي تحيط بكائناته، وهي مناظر تلال القمامة، والحواري الضيقة التي لا تتسع إلا للبشر والحيوانات، ومنها من يتسع أكثر قليلاً ليمر منه التوكتوك، ولا يخفى على أحد من أهل مصر أن من أهم متناقضات العاصمة هو تجاور الأحياء الأنيقة الراقية مع الأحياء العشوائية بكل ما بها من فوضى وسلوكيات همجية تصل حد الإجرام أحياناً، والجريمة هنا أبطالها السلاح الأبيض ، وغرز ساهرة حتى الفجر تأوي الحشاشين وأصحاب الكيف ، بعضهم يذهب عقب سهرة الكيف لصلاة الفجر في المسجد.
يعبر عن الصورة داخل هذه الاحياء وتحديدا وقت الصباح الباكر بقوله: “القاهري الأريب يستطيع أن يفرق جيداً بين هدوء الحشاشين وهم يقفون على عربات الفول والبليلة والكسكسي أو الجالسين على المقاهي، وبين حركة العمال والموظفين حول نفس عربات الفول والكسكسي وهم في طريقهم إلى أعمالهم”.
أثناء تجولنا معه في حي بولاق أبو العلا وجزيرة الوراق، يأخذنا معه الكاتب في عملية استكشاف يعرض لنا من خلالها أدق تفاصيل سكان هذه المناطق الذين سقطوا من قعر قفة الحكومات المتتابعة، ولم تتذكرهم إلا لتزيد همومهم، وتلغي وجودهم كي تقيم على أنقاضهم كيانات عمرانية أخرى لامعة وبراقة في هيئة فنادق أو أبراج سكنية ومكتبية.
نلمح من خلال العنوان “كائنات الليل والنهار” إشارة إلى مضمون يشمل الكائنات الحية ممثلة في البشر، والكائنات المصاحبة لهم في رحلة حياتهم اليومية، لقد وصف الأديب هنا شخصياته بالكائنات لأنهم في نظر الحكام والمسئولين مجرد كائنات تحيا على هامش الحياة، هي لا تراهم إلا وقت حاجتها إليهم وإلى بيوتهم وأراضيهم كي تقتلعهم منها دون رحمة، هذه الكائنات التي تشكل تروساً صغيرة ضمن مصنع الحياة الضخم ممثلاً في عاصمة تلتهم لحم الكادحين وتتغذى على دمائهم.
أشرف الصباغ هنا تغلغل إلى أعماق مجتمع العشوائيات، وخاض تجربته معها كطبيب جراح يغوص بمشرطه في أعماق بطن المريض، ليستخرج السموم والديدان الكامنة في أحشائه، ولا يبالي بأن تمتلئ يداه بالدماء حتى إن وصلت إلى الكوع، وهذا هو ما يميز هذه الرواية عن أعمال أخرى ناقشت عوالم المهمشين سواء في العاصمة أو خارجها.
نلاحظ أيضاً كيف وظف الصباغ عنصر الزمان وهو ما بعد ثورة يناير 2011، ليقول لنا بمرارة وغضب “إن الثورة التي قامت لتنصف الفقراء، استغلها أصحاب المصالح من رجال الأعمال ومن يساندهم من كبار موظفي الوزراء لانتزاعهم من أراضيهم، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية لن يجني ثمارها إلا هم ومساعدوهم في المؤسسات المختلفة “ممن يبقون أدراج مكاتبهم مفتوحة لاستقبال للرشاوى” ومن أعوانهم في وسائل الإعلام. ويعرض لنا بأسلوب يجمع بين الغضب المكتوم والتمرد الصاخب وروح المشاكسة وتجاوز القوالب المعتادة، مشاهد حية لطبيعة العلاقات بين السكان داخل البيت الواحد في هذه المناطق.
دون مبالغة كنت أسمع ضربات قلبي تتسارع كلما توغلت داخل تفاصيل حياة البطل “عاشور”، ويتجسد لنا تيار الوعي من خلال صوته وهو يحكي عن نفسه، واصفاً حاله وشعوره بالوحدة في هذه الحياة بسبب يتمه المبكر: “يفتح الإنسان عينيه على الحياة، وقبل أن يضع قدمه على أول الطريق، يجد نفسه معلقاً في الهواء، من دون أم وأب دفعة واحدة، فقدان غير مخطط له، وبوضع الإنسان ذاكرته في زجاجة مفرغة من الهواء يتحول إلى مجرد كبسولة تعزل ما بداخلها عن الحياة والواقع، بينما قشرتها الخارجية فقط هي الشيء الوحيد الذي يدل على وجودها واحتكاكها بالعالم الخارجي”.
كلما انتهيت من إحدى المحطات في حياته أجدني بحاجة لالتقاط أنفاسي، أجلس ساهمة يهاجمني شعور بالخوف، وفي عقلي تردد سؤال “لماذا اختار لبطله اسم عاشور”، ففي زمننا نادر أن تجد شاباً بهذا الاسم الذي لم أسمعه من قبل إلا في رواية الحرافيش وبطلها “عاشور الناجي”، قلت لنفسي: “ترى هل تعمد الكاتب اختيار الاسم ليضعنا في مقابلة بين عاشور نجيب محفوظ الذي نجا من الطوفان، وخلف من بعده ذريته يتناوبون على الحارة، وتشعبت من نسله الحكايات التسعة وشخوصها، وبين عاشور العصر الحديث الذي لا نعرف كيف سينجو من كل ما سيواجهه من اختبارات قاسية؟ ولن تملك إلا أن تشفق عليه فهو منذ البداية يعلن موقفه الرافض للثورة، والناقم عليها وعلى من قاموا بها، ويرى أن البلد لا تتحمل مثل هذه الأوضاع، ويفضل أن يؤثر السلامة ويبقى ملتصقاً بالحائط شأنه شأن غيره من الـ “الغلابة” فهو يعلم أن من مثله لا ينبغي أن ينشغل إلا بأكل العيش، وتفادي الصدام مع الحكومة.
أن تقرأ لأشرف الصباغ ليست بالمهمة السهلة، وأن تكتب عن رواية أو قصة له فهذه المهمة الأصعب على الإطلاق، فهو مترجم قدير، بارع في الكتابة بأسلوب تجريبي يكسر فيه قيود الأساليب التقليدية، لا أبالغ إن قلت إني لمست فيه شيئاً من روح بوكوفسكي المغامرة بكل شطحاتها، يحرص على كشف عورات مجتمع العاصمة التي يصفها بأنها مدينة غريبة، تعادي نفسها وتكره سكانها بقدر ما يكرهونها ويهينوننها ويتبولون يومياً في وجهها، ويتم منهجه في التجريب بتعرية عورات النفوس في مجتمع العشوائيات، فتتعجب من أحوالهم وتحتار في أمرهم هل تكرههم أم تتعاطف معهم؟
قرب وصولنا للنهاية نرى كيف كيف تقود الظروف المتتالية عاشور للخروج من زجاجته التي ظل حابساً مشاعره بداخلها، والبداية عندما يواجه صداما رغم أنفه مع الحكومة عندما يجد نفسه مطالباً بسداد فاتورة كهرباء باهظة لا يقدر على دفعها، تكون هي أول طوبة تسقط من قلب حجر الأساس الذي صممه كنواة لمشروعه الخاص.
قرب انتهائي من قراءتها تملكتني الحيرة والدهشة تجاه البطل “عاشور، بداية من اسمه الغريب، وهو بالمناسبة اسم غير دارج ذكرني ببطل ملحمة الحرافيش وأول حكايتها “عاشور الناجي”، وربما وجدت حلقة حفية تربط بين نهاية كليهما، النهاية الغامضة المريبة، فعاشور الذي صنعه الصباغ تتراكم المصائب فوق رأسه ولا يملك كبح جماح الضغوط التي تحاصره من كل الاتجاهات، فتصبح مع الوقت أقرب لسلاسل حديدية تحيطه حتى تخنقه، ترى ماذا يفعل إنسان يتمكن منه الشعور بالقهر لهذه الدرجة، كيف يحافظ على اتزانه النفسي والعقلي وهو يرى بعينيه أحلامه تنهار تباعاً وبسرعة جنونية، عاشور هنا لم يفلح في الهرب من الجنون الذي يطارده كلما حاول إيجاد مخرجاً مشروعاً.
ترى كيف تكون نهاية مواطن بسيط قضى معظم عمره مصففاً لشعر السيدات، المهنة التي تحتاج فناً وصبراً، عندما يدرك إنسان مسالم مثله أنه في نظر حكومته مجرد رقم، وأن أحلامه تنهار تحت أقدام خيول طائشة لا تعترف إلا بمصالحها وأطماعها، لا يرون فيه إلا كائناً لا يُرى بالعين المجردة، لذا فإن حياة عاشور بكل تفاصيلها وأحداثها من بدايتها حتى لحظة انهيار وتساقط أحلامه واحداً وراء الآخر، تُعتبر نموذجاً للمأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبوصول الأحداث لذروتها عند النهاية لا نملك إلا أن نغلق الصفحة وفي قلوبنا غصة وحزن، وسؤال يلح على أذهاننا: لماذا لا يترك هؤلاء المساكين لحالهم، ولماذا تستكثر عليهم أنظمة الحكم المستبدة تحقيق أحلامهم البسيطة المشروعة، والاستمتاع بحياتهم دون منغصات ودون ممارسات قمعية!