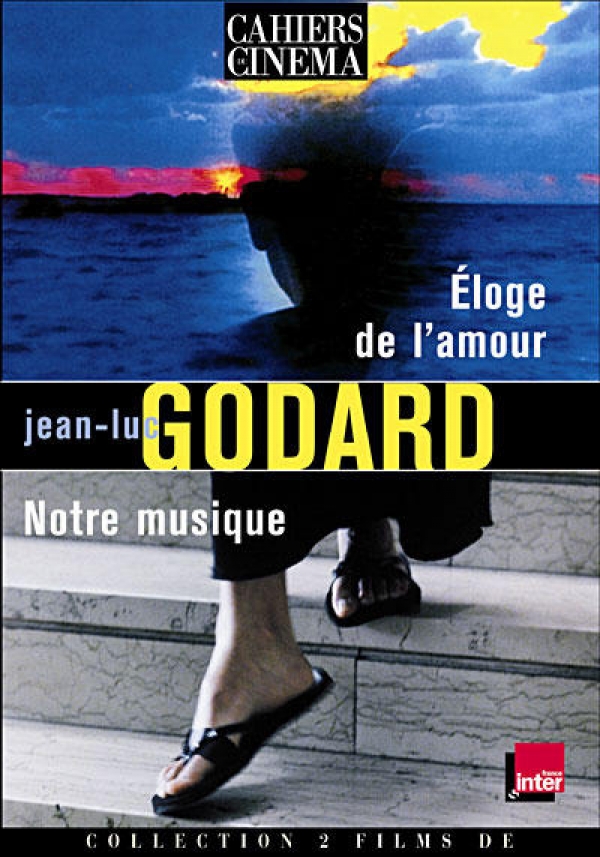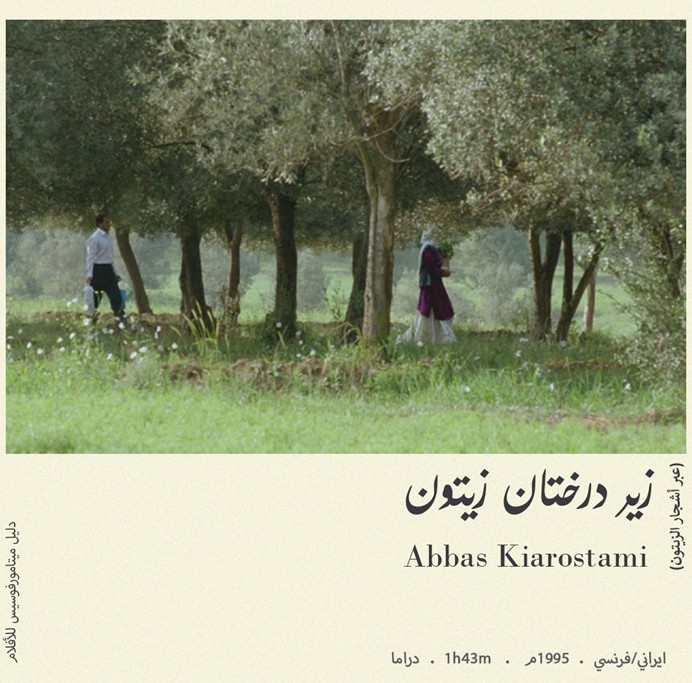أحمد عبد الرحيم
منذ أيام، كنت فى أحد شوارع حى الناصرية بالقاهرة، وبالمصادفة سمعت من سيارة متعطلة، يفحصها صاحبها، أغنية مهرجانات أشعارها غريبة بعض الشىء، وتتحدث عن شخص أُطلقت عليه النيران من قِبل خصومه! بعد عودتى للمنزل، بحثت على جوجل عن هذه الأغنية، لأكتشف أنها مهرجان “فارس جوه الحياة”، من غناء الفنان الشعبى الشاب “عصام صاصا”، فجلست لأسمعها كاملة..
بادئ ذى بدء، لست ناقدًا موسيقيًّا، لكنى سأعرض ما جال فى ذهنى من خواطر بخصوص هذه الأغنية، فقد لاحظت – كالمعتاد فى أغانى المهرجانات – غياب أساسيات مثل المذهب والكوبليهات، إلى جانب رتابة الموسيقى والإلقاء، وابتعاد الصوت عن التطريب أو الجودة، لكنى وجدت أن هذه الأغنية تدور حول معانٍ مثل الاعتزاز بالنفس، وأهمية مواجهة الأعداء، وتستعرض معاناة العيش فى قلق دائم من الموت، كما أن أشعارها احتوت على بوادر موهبة تستطيع أن تكون بليغة أو ساخرة مثل: “رجولتى دى ف دَمِّى”، “ح تدوقوا نار سمّى”، “الحُبّ بقى سلعة”، “أَنا لو من الكفار، دول كانوا رحمونى”، “مِنِّى ياله هتتهرس، هتمشى ع الحيطة”.
على الجانب الآخر، كانت هناك تعبيرات غريبة يتجاوز فيها الاعتزاز بالنفس حد الغرور الصاعق، مثل: “عايش و100 مليون بيهتفوا باسمى”، حيث المبالغة متطرفة لدرجة مثيرة للضحك! ثم يمدح المغنى نفسه، هو وموزِّع اللحن: “كروانك يا زمان هو عصام صاصا، وإللى وزّع الألحان هو خالد لولو المدرسة”!
بعدها، على المنوال الافتخارى ذاته يقول: “ابن الأصول وزعامة.. دَه مصطفي نابوليا”، “إصحى لحسين دبور.. وإضرب هنا تحية”. الحق أنى لا أعرف من هو “مصطفى نابوليا”، ويزداد اللغز غموضًا حينما تتغزل مقاطع أخرى فى عظمة أشخاص مثل “فهد نابوليا”، و”كرم نابوليا” و”حسّان نابوليا” (إما أنهم إخوته، وإما أولاده)، لكنى اكتشفت من قناة اليوتيوب التى سمعت الأغنية من خلالها أن “حسين دبور” هو منتج العمل!
تضرب الركاكة أشعار المهرجان، فحينما يحذِّر المغنى خصومه يقول: “كان فى معايا وخلص”، دون توضيح ما الذى كان يملكه وانتهى (هل الصبر؟ هل الرحمة؟)، لكنك حينما تسمع بعدها مباشرة: “منِّى يالا ح تتهرس”، تكتشف أن الجملة الأولى وُضعت لضبط الوزن ليس إلا. وحينما يسخر من الخصوم أنفسهم يقول: “حبة عيال معووجة، من الدنيا خدوا فاصل”، فما معنى فاصل الدنيا هذا؟! (أظنهم – مثلًا – أخذوا من “الشجاعة” فاصلًا حين مواجهته)، وغيرها من التعبيرات الفقيرة مثل “مصطفى نابوليا.. أساسه رجولية”، ثم “فهد نابوليا رجولة، مشهور برجولية”!
ثم صادفت تعبيرات أخرى لم أفهمها البتة مثل: “جاهز لعدة فى هوجة”، “كانوا عايزنى إتغايب”، “شادد وشوكوا بخوجة”، “الجاى ع الأيد واكل”؟! لعلها تعبيرات عامية جديدة، أو ألفاظ طائفة حرفيّة، لم أسمعها من قبل، وإن كنت أتمنى معرفة معانيها. الأغرب من ذلك عدم توضيح الأشعار لأزمة بطلها؛ فهو مُطارد من قِبل خصوم حاولوا قتله، والموت يحاصره فى كل لحظة مُعذِّبّا إياه، فمَن هو، ومَن الذين يطاردونه، ولماذا هو مُستهدَف؟!
لكن يظل أهم ما قابلته إطلاقًا هو تلك الكلمات التى أصابتنى بالخوف مثل: “تعبت مِن التفكير، هاخدلى تانى جُرْعَة”!، طبعًا مفهوم هنا ما هى الـ”جرعة” التى سيتعاطاها المغنى بعد تعبه من التفكير؛ وهو ما يروِّج إلى أن المخدرات هى علاج الإرهاق الذهنى، أو المشاكل المُحيِّرة. بعدها يُكمل: “دول ضربوا فَيّا عِيَار، عايزين يصفونى”، “ح تشوفوا وشى الشرس، ح أحبسكوا أنا فى أوضة”، “الطلق زى المطر، قدامه تتهدوا”، “ح أدبح ومش ح أسمِّى”؛ وهو ما يعبِّر عن واقع عنيف، وعالم متوحش، يحكمه الخطف والقتل، ويلقى بـ”فارس” الأغنية من “الفروسية” إلى “الافتراس”!
تأكّدت المعانى ذاتها عند استماعى إلى أغنية أخرى لصاصا، شاركه فيها مغنى مهرجانات آخر هو سامر المدنى، عنوانها “أشرب حشيش، لو يوم ماكلمنيش”!، وأغانى غيرها لصاصا منفردًا مثل: “ح أدى فى قلبك طلقة” التى يهدِّد فيها خصمه بالقتل دون مواربة، ويفخر بأنه – أى المغنى – يسهر مع منحرفات، ويشرب الخمر، ويشم البودرة!، و”ضربونى فى ضهرى بالجرينوف” والجرينوف هو نوع من المدافع الرشاشة، و”إفتح مطوة، وعوَّر خصمك” حيث شرب البيرة، وتعاطى الحشيش، وممارسة الجريمة نشاطات عادية فى الحياة اليومية لمغنيها!
حسنًا، لا تتعجب. واقعنا فى مصر تشوّه بالتراكمية طيلة السنوات الماضية، وغابت عنه ركائز أساسية كثيرة؛ مثل التعليم والدين والأخلاق، المسلسلات الدينية والتاريخية والتربوية، تطبيق القانون وحضور الشرطة، العدالة الاجتماعية وحرية الرأى. إنه واقع مدهوس بالفقر والقهر، الجهل والانحطاط، العشوائية والإجرام. لذا حينما يظهر نتاج فنى يعكس قيم هذا الواقع فالوضع طبيعى، وإذا أردت لوم صاصا ورفاقه مرّة، فعليك بلوم الواقع الذى أنتجهم، وسينتج غيرهم، مرّات ومرّات.
صحيح أن المستوى الفنى لـ”فارس جوة الحياة” متواضع، لكن الأخطر من ذلك هو تلك الرسائل التى يحملها، مثل بديهية اللجوء للمخدرات، وشهوة سفك الدماء، والاعتزاز بالنفس المتطرف إلى درجة الغرور الأعمى؛ وهو ما يشبه – إلى حد كبير –أسوأ نوع من أغانى الراب الأمريكية، وهو Gangsta rap أو راب العصابات، الذى نشأ من منتصف ثمانينيات القرن الماضى، ومازال مستمرًا، وتحمل أشعاره العلامات ذاتها: المخدرات، العنف، الغرور، ذكر أسماء شخصيات لا يعرفها سوى المغنى، سواء كانوا أصدقاء أو أعداء، ويقترب صنّاعه من عالم العصابات، بل ينتمى بعضهم إلى عصابات بالفعل، ومنهم من مات مقتولًا بأيدى عصابات معادية، وهذا جزء من حالة الانفلات الأخلاقى، واستفحال الجريمة فى الولايات المتحدة، التى حقّق شعبها مؤخرًا “أعلى نسبة جرائم قتل بأسلحة نارية فردية فى دولة متقدمة”، ونال لقب “الشعب الأكثر تسليحًا على مستوى العالم”، وتنتشر فيها العصابات المسلحة أكثر من محلات الفول والطعمية عندنا. لا أعلم إن كان صاصا، وبقية مبدعى الأغنية، سمعوا هذا الصنف من الأغانى، وأحبوه، وتأثروا به، وأبدعوا عملًا على غراره، أم أن الأمر مجرد إفراز طبيعى لظروف مشابهة. لكن – فى كل الحالات – الوضع مخيف؛ لأنه يعبِّر عن اختلال بشع، وينشر مبادئ فاسدة، ويصنع ثقافة أساسها المخدرات والعنف، ويشرعن الجريمة كرد فعل على أى ظلم أو اعتداء!

عرضتُ شيئًا من هذه الخواطر على الأصدقاء والأقارب، فحسدنى البعض، لماذا؟! لأنى لم أقابل أغانى مهرجانات أخرى تضج بكوارث إضافية؛ مثل ألفاظ قاتلة البذاءة، غزل صارخ الفجور، علاقات جنسية منحرفة، أوضاع جنسية شاذة، فضلًا عن أصوات مؤذية للأذن، وربما للروح أيضًا. ولا شك أن الخطورة تتفاقم حين أداء تلك المهرجانات بشكل حى فى أماكن عديدة متنوعة، من أول أفراح الأحياء الشعبية، وصولًا إلى حفلات الساحل الشمالى، على نحو لا ينقصه الحضور الكثيف، بل شيوعها عبر الشبكة العنكبوتية، وتحقيقها لجماهيرية عظمى وسط الشباب، والمراهقين، بل الأطفال!
يقينًا لست ضد نوع المهرجانات ذاته، الذى ظهر وازدهر خلال الخمسة عشر سنة الماضية، ويُوصف بأنه مزيج من نوعيتى الراب والتكنو؛ فالتطور الفنى أمر بديهى، بل إن عدمية وجوده دليل غير صحى، ناهيك عن أن غالبية الأغانى التقليدية، وأقصد بالطبع الرومانسية، كالبضاعة المألوفة فى المقابل، تكاد تكون وصلت إلى حالة من التكلس والتجمد، بإصرارها على أشعار شديدة التشابه، وموضوعات واحدة لا تتغيّر، وربما انفصالها عن الواقع المعيش، بمشاكله ولغته، لتستغرق فى التغزل برموش المحبوبة، وتكرار حكاوى حب بلهاء، وتناول 1 % فقط من الواقع؛ وهو نمو علاقة عاطفية بين شاب وشابة، فى صور ترهقك من فرط مراهقتها. لذلك جاءت المهرجانات كدرجة طبيعية فى سلم التطور، وانعكاسًا لجيل جديد مختلف، وتمردًا على تراث فنى شاخ وعجز. ومن ثم فإن موقفى الرافض ليس لذلك النوع الفنى، وإنما لإنتاجه المنحل؛ الذى ينهل من مستنقع الإباحية حتى الثمالة، ويساهم فى تخريب المجتمع بدلًا من إصلاحه.
قد تظن أن كارثة تلك الأغانى فى انحطاطها، خصوصًا على مستوى اللفظ والرسالة، لكن الكارثة الحقيقية فى تسلُّلها إلى نفوس جمهورها، وسريانها فى عروقهم، وتأثيرها فى وجدانهم، وتوجيهها لأفكارهم. قد تظهر أغنية ماجنة فى زمان ما، ومكان ما، لتُلعن، وتُنبذ، وتُحرم من الاندماج فى التيار الرئيسى، ونيل الجماهيرية الواسعة. إنما حينما تكون الظروف مهيئة للانحطاط، والملعب مُباح لكل مشبوه، وإمكانية الفرز بين الغث والسمين ضائعة؛ يشتهى المتلقى أى كاسر للتقليدى المحافظ، ويحتفى بموفِّر متعه الشهوانية والتخديرية، ويتأجج نشوة بهذا الذى يحتفل بأركان عالمه الساقط. حينذاك، تفرض تلك الأغانى وجودها على التيار الرئيسى، وتحرز الجماهيرية الواسعة دون مجهود.
انظر حولك، وستدرك كيف صارت هذه النوعية الرديئة الفاحشة مُكوِّنًا أساسيًّا فى مشاعر وأفكار أجيال تتغذى على فنها ومعانيها (ضمن التعليقات على واحدة من أغانى عصام صاصا بموقع يوتيوب، كتب أحد المعجبين أن أفضل ما استمع إليه فى حياته هو “القرآن الكريم، وأغانى عصام صاصا”!)، وكيف انحدرنا من سمات السمو والرقى التى ميِّزت أغانينا، حتى الشعبية منها إلى عهد قريب، إلى سمات الانحلال والهمجية. إنه انقلاب فنى يقلب مستمعه من إنسان تُرغَب له الأخلاقية والتمدن إلى كائن أكثر سوقية ووحشية، ومن شاب يُنشَد له الاتزان السلوكى إلى مشروع مجرم!
أكيد تتساءل الآن: ما الحل؟ كيف نواجه ذلك؟! انس الرقابة، لأنها توفيت إلى رحمة الله. أمام مستجدات الألفينيات؛ مثل شيوع الإنترنت، وعربدة مستعمليه، وسطوة القنوات الفضائية، وتحلُّلها من القيم—ضعفت الرقابة، وتهاوت، وأصبحت على الهامش، أو خارج الصفحة أساسًا. ولا تحدثنى عن المؤسسات المتعددة المنوط بيها حماية الشباب، بل القضاء على الجهل والفقر والفساد فى المجتمع. الدولة مدانة، لا شك. لكن هذا النوع من الفن وُلِد، وشاع، وصار تيارًا، وتأسست له قاعدة صناع وجماهير؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر، يخبرك موقع يوتيوب أن مشاهدات مهرجان “فارس…” فى قناة “دبور برودكشن” تعدت الخمسة مليون، ومشاهدات أغانى قناة “عصام صاصا” الرسمية تعدت المليار، وبالتالى لا أستبعد أن تظهر قريبًا مهرجانات لأغانى المهرجانات، لتكرِّم روادها وصانعيها (ويرعاها رجال أعمال مثل ساويرس!). لكن يبقى السؤال: ما هو الحل؟!
الحل فى قاعدة فيزيائية قديمة جدًّا. حين علّمنا مُعلِّم الفيزياء فى المدرسة كيف نضع بيضة مسلوقة فى زجاجة. لا تستغرب، فهذا ممكن. نُشعل ورقة أو قطعة قطن، ونضعها فى الزجاجة، وحين محاولة وضع البيضة فى الفوهة، سيبرد الهواء الساخن المتمدِّد داخل الزجاجة، ويقلّ ضغطها بالنسبة للضغط الجوى خارجها، وهو ما سيدفع البيضة إلى داخلها فى أريحية. وكان الدرس هو: “يتحقّق المستحيل بتغيُّر المناخ العام”. هذا هو الحل الوحيد المطروح أمامى الآن: تغيُّر المناخ العام. يمكنك رفض سماع هذه الأغانى، تحذير أولادك منها، تجاهلها كأنها لم تكن، لكنها ستبقى انعكاسًا للواقع المخيف، الذى طفا على السطح فى غياب من رقابة الدولة، وبالتأكيد ستتزايد سلبياتها مع تزايد عدد فنانيها، واتجاهها إلى إباحية أكبر بمرور الوقت، لكن ظروف انخفاضها كمًّا وكيفًا، أو حتى اختفائها يومًا ما، مرتبطة بالمناخ العام، الذى – بكل أسف – يغرق فى مصائبه، أكثر وأكثر، بمرور الوقت. كمثال، تذكر وصولنا إلى مرتبة أسوأ تعليم على مستوى العالم؛ فلو كان تعليمنا أفضل من ذلك، لأنتج مبدعين وجمهورًا أفضل من ذلك. وكمثال آخر، تذكر أننا نعيش عصرًا قضى على نوعيات أخرى مثل أغنية الطفل، والأغنية الدينية، والأغنية الوطنية، وترك الساحة لأغانى تخاطب أحط الغرائز، وتربى أخطر القيم..
لكن دعنى أَكُنْ متفائلًا، وأخبرك أنه حتى لو مال الذوق العام ناحية تلك المهرجانات، ووقع فى غرامها، وأدمن ترديدها، فإن رفضك لها، ومحاولة توعية غيرك بشأنها، إلى جانب إصرارك على سماع الأرقى والأفضل، وتمسكك بالقيم الأنقى، هو حائط صد عظيم، ومقاومة لها تأثيرها. نعم، فى إمكانك شق طريق مغاير، مهما كان طويلًا ووعرًا، فإن هدفه ساطع، وبلوغه مستطاع. فلا تنسَ أن المناخ العام يبدأ من الخاص. وهنا، لا يسعنى إلا تذكر كلمة للفنان التشكيلى الراحل هانى المصرى (1951 – 2015)، رد بها علىّ عبر صفحته بالفيسبوك فى 9 مايو 2015، حينما عبّرت عن يأسى من أن تنعدل الأمور، وتخبو الشرور: “لو مصر رجعت، مش ح يكون فى عمرى ولا حتى فى عمرك.. إنما لازم تفهم إن تصرفاتنا وأعمالنا فى حياتنا هى اللى ح تحدِّد إمتى وإزاى مصر ح ترجع.. إللى ح نسلّمه لأولادنا، سواء من تربية أو علم أو نظام أو انضباط، ح يبقى حب للبلد والناس، وأسس تعامل.. ممكن تبقى متشائم على المدى القريب، إنما متفائل على المدى البعيد.. وتحدِّد إنت عاوز مصر يبقى شكلها إيه فى يوم من الأيام، وتعمل لليوم ده.. زي الأجيال إللى اشتركت فى بناء معبد الكرنك إللى استغرق 600 سنة، واشتغل فيه 20 جيل.. كل جيل يسلِّم اللى بعده”.
إذن، فليفعل كلٌ ما يستطيعه، آملين فى المستقبل، فالأيام دُوَل، ولا يوجد عصر اضمحلال يدوم للأبد؛ لعل المستحيل اليوم يتحوّل إلى ممكن غدًا، لعل النار تصبح رمادًا، والأرض المحروقة تخضر، ولعل الأستاذ “عصام صاصا” يجد حلولًا لمشاكله غير تعاطى المخدرات، وتعذيب خصومه.