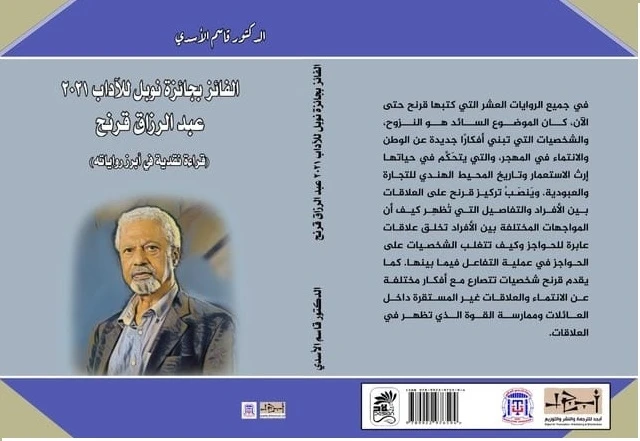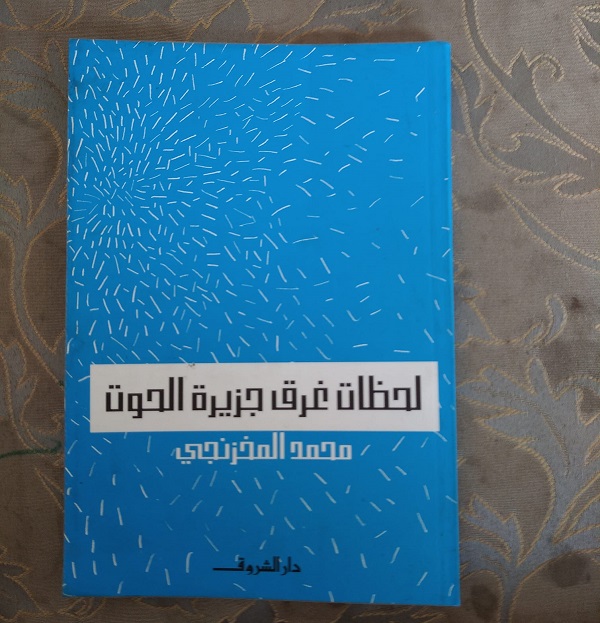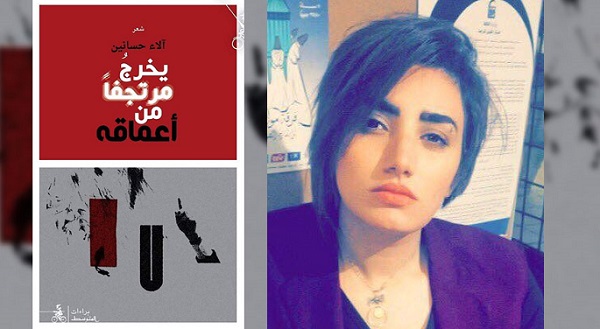د.خالد عاشور
كان أديب الألمانية الأكبر جوته يقول: “كاتب الأعاجيب ليس في سيرته عجيباً”.
وهي مقولة صادقة، وواجبة الاستدعاء حين يتسني للمرء أن يطلع على السيرة الشخصية للأدباء والمفكرين وقادة الفكر والرأي في كل زمان وفي أي ثقافة؛ حيث نصطدم غالباً بسيرة مذهلة وحياة مخيبة للصورة النمطية التي استودعتها كتاباته وأفكاره في مخيلتنا، ونتمني معها لو أننا لم نطلع علي هذه الحياة ولا علي تلك السيرة، ولو أن علاقتنا بهذا المفكر ظلت علي الورق وعبر كتاباته ومن خلال أفكاره فقط، لتظل مقولة “إن هناك أدباء وهناك أدبهم” مقولة صحيحة إلى حد كبير.
يذكر بول جونسون صاحب كتاب “المثقفون” نماذج من حياة الآباء المؤسسين للثقافة والأدب والفلسفة الغربية تترجم عما نقول في مظهرين كلاهما صادم : الأول هو الانحطاط الخلقي والسلوك المعيب الذي لا يصدر عادة إلا عن إنسان لم يرتق في مدارج السلوك والثقافة.
أما الثاني وهو الأشد إيلاماً فهو التناقض المفزع بين ما يدعو إليه ذلك المثقف والمفكر وبين واقع حياته العملية؛ بين أفكاره وحياته.
جان جاك روسو (1712 – 1778) الذي قال عنه تولستوي: روسو والإنجيل لهما أكبر أثر في حياتي والذي كان جزءاً من توقه المتزايد لكي يكون نبياً للحق والفضيلة، أن يرسم حدود العقل ويمهد لمكان الدين في قلوب الناس.
لاشك أنك ستصدم حين تعرف أنه كان مثالاً للمحتال المتمرس الذي يسلب الآخرين بعد أن يكسب ثقتهم، ولذلك لا تندهش عندما تعرف أنه كان في شبابه يكتب خطابات الاستجداء وقد بقي أحد تلك الخطابات؛ كان قد كتبه إلي حاكم “سافوي” يطلب منحه معاشاً علي أساس أنه يعاني من مرض خطير مشوِّه وأنه سوف يموت قريباً.
كان روسو أحد كبار المتذمرين دائمي الشكوي في تاريخ الأدب، وكان يصر علي أن حياته حافلة بالاضطهاد والبؤس.
كان أول مثقف يستغل آثام الأثرياء والموسرين علي نحو منتظم، فقد عاش معتمداً علي إنفاق سيدة تُدعي “مدام دي وارينز” حوالي أربعة عشر عاماً وكان عشيقها في فترات مختلفة أثناء تلك المدة. وكانت هذه السيدة هي التي أنقذته من الفقر والعوز ووقفت إلي جواره أكثر من مرة، ولكن عندما تحسنت أحواله فيما بعد وكانت هي قد أصبحت معوزة، لم يفعل من أجلها شيئاً يذكر. توسلاتها إليه لكي يساعدها ذهبت أدراج الرياح، وقضت العامين الأخيرين من حياتها طريحة الفراش، وربما يكون موتها سنة 1761 بسبب سوء التغذية.
ومن الضروري أن ننظر عن كثب في سلوكه الشخصي كمعبر عن الحق وممثل للفضيلة، فماذا نجد؟
في تورين عندما كان شاباً كان يتسكع في الشوارع الخلفية ويكشف عن نصفه الأسفل الخلفي للنساء: “لا أستطيع أن أصف تلك المتعة الحمقاء التي كنت أجدها في كشف ذلك أمامهن”.
ويحكي كيف كان يمارس العادة السرية وهو صبي، كما يدافع عنها لأنها تحمي الشباب من الأمراض الجنسية: “هذه الخطيئة التي تستحق الخجل، فيها أكثر من ميزة وجاذبية للخيال، إنها تُمكن الخيال من إخضاع كل النساء له، وتجعل الجمال في خدمة المتعة دون إذن منه”. واعترف أنه عاد لممارسة العادة السرية في عمر متقدمة وبأنها كانت وسيلة أكثر ملاءمة من ممارسة الحياة الجنسية العادية.
كان روسو أول مثقف يعلن عن نفسه مراراً وتكراراً أنه صديق للبشر جميعاً، ولكن مع هذا الحب العام للبشرية كان لديه ميل شديد للخصام والشجار مع الأفراد من البشر. وكان يحمل ضغائن كثيرة وكان مخادعاً باستمراره في حملها.
ورغم أن جزءاً كبيراً من شهرة روسو مرده إلي نظرياته في تربية الأطفال، فإننا لا نجد للاهتمام بالأطفال أثراً في الحياة الحقيقية، ولا يوجد أدني دليل علي أنه درسهم حتي يتأكد من صحة نظرياته. كان يدعي أن أحداً لا يمكنه أن يستمتع باللعب معهم مثله، ولكن النادرة الوحيدة في هذا المجال لا تؤكد شيئاً من ذلك؛ فقد شوهد في حدائق توليير وعندما ارتطمت كرة طفل برجل الفيلسوف استشاط غضباً وجري وراء الطفل بعصاه.
ومما نعرفه عن شخصيته يتضح أنه ما كان يمكن أن يكون أباً جيداً، ويصدمنا اكتشاف ما فعله بالنسبة لأطفاله:
الأول أنجبته له إحدي عشيقاته في شتاء 1746 ولا نعرف إن كان ذكراً أم أنثي حيث لم يُعط اسماً، وكما يقول إنه استطاع بصعوبة بالغة أن يقنع تيريزا بالتخلي عنه لإنقاذ سمعتها وشرفها، وأطاعت وهي تتنهد فقام بوضع بطاقة عليها أحرف في ملابس الطفل وطلب من القابلة أن ترمي الصرة في مستشفي للأطفال اللقطاء، كما لقي نفس المصير أربعة آخرون أنجبتهم تيريزا، ولكنه لم يحاول أن يضع أي بطاقات مع أي منهم كما فعل مع الأول. لم يسم أحداً، ويبدو أنهم قد ماتوا جميعاً في أعمار باكرة.
مازوكي، محب للمظاهر، نوراستيني، مصاب بوسواس مرضي، ممارس للعادة السرية، شاذ جنسياً(شذوذ كامن)، لحوح، عاجز عن الحب الأبوي، شديد الارتياب، في الآخرين، نرجسي، شديد الانطواء ، يملؤه الشعور بالذنب، جبان لدرجة مرضية، مريض بالسرقة، صبياني السلوك، بخيل . ذلكم هو ملخص حياة جان جاك روسو .
كارل ماركس: (1818 – 1883)
يؤسفني أن تعرف إن كنت من المعجبين بماركس والمؤمنين بأفكاره أن تلك الشخصية التي تأثرتَ بها كانت تتشكل من أربعة جوانب: ميل للعنف، شهوة للسلطة، فشل في الأمور المالية، نزوع إلي استغلال من حوله.
وإليك التفاصيل:
كان يلاحظ عليه الشجار الدائم داخل عائلته، أُلقي القبض عليه مرة وهو طالب في جامعة “بون” لحمله مسدساً، وكاد يفصل من الدراسة. سجلات الجامعة توضح أنه كان يشارك في الصراعات الطلابية وأنه دخل مبارزة وجرح جرحاً بليغاً في عينه اليسري.
شجاره الدائم داخل الأسرة ألقي بظلاله الكئيبة علي حياة والده في السنوات الأخيرة وفي النهاية أدي إلي قطيعة تامة مع أمه.
كان قذراً لدرجة لا تحتمل، هجين قط وقرد، وشعر أسود أشعث كالفحم وبشرة كالحة قذرة، كان من المستحيل أن تحدد إذا ماكانت ملابسه وبشرته بلون الطين أو أنها كانت قذرة، له عينان ضيقتان حادتان مملوءتان بالشر.
كان من عادته أن يقول: “سوف أمحوك من الوجود” وكان يكرس معظم وقته لجمع ملفات مفصلة عن أعدائه وخصومه السياسيين، ولم يكن يتردد في توصيلها للشرطة لخدمة مصلحته.
كانت النقود تسيطر علي كل مراسلاته العائلية، الخطاب الأخير من والده والذي كتبه وهو يموت يجأر فيه بالشكوي من أن ماركس لا يبالي بأسرته إلا من أجل الحصول علي مساعداتهم. وبعد ثلاثة شهور مات الرجل ولم يشغل ماركس نفسه بحضور جنازته، بل بدأت ضغوطه علي أمه.
رفضت أمه أن تسدد ديونه، كانت تعرف أنه سوف يقع فيها مرة أخري، وفي النهاية قطعت صلتها به تماماً. كانت تصدق أمنيتها المُرّة في أن كارل سوف يجمع رأس المال بدلاً من مجرد الكتابة عنه.
الأدهى من ذلك أنه لا يوجد أي دليل علي أن ماركس كان قد تكلم فعلاً مع الفلاحين ومُلاك الأراضي ونظر إلي الظروف مباشرة. ثم كتب في عام ١٨٤٤ مقالاً للمجلة الأسبوعية المالية “فوروارد” عن الأحوال السيئة لعمال نسيج الكتان في “سيليسيا” ولكنه لم يذهب أبداً إلي هناك أو تكلم مع أي من العمال من أي صنف. بل إنه رفض دعوة أنجلز ليرافقه في زيارة لمصنع نسيج أقطان.
إن قدمي ماركس لم تطئا مصنعاً أو منجماً أو أي مكان عمل آخر طوال حياته. أما الأمر الأكثر إثارة من ذلك فهو عداء ماركس للرفاق الثوار من أصحاب تلك التجارب أي العمال الذين أصبحوا علي وعي سياسي. وقد رفض كل من تقدموا للزواج من بناته من بين رفاق الوسط الثوري.
اتخذ من خادمة للأسرة تدعي لينشن عشيقة له، وحملت منه وأنجبت طفلاً رفض ماركس الاعتراف به وكان يرفض أن يقول أحد إنه ابنه. لكن أمه أعلنت ذلك، فكان يسمح لها وله بزيارة بيت أبيه دون استخدام الباب الرئيسي، ولا يري أمه إلا في المطبخ، كان يخشي أن يكتشف أمر هذا الطفل مما يسبب له ضرراً كقائد ثوري.
ورغم أن لينشن كانت هي الاتصال الحقيقي الوحيد له بالبروليتاريا، فإنها كانت هي الإنسان الوحيد من الطبقة العاملة التي لم يعرفها ماركس أبداً بشكل جيد.
ولعلك ستضحك معي ساخراً عندما تعرف أن مقولة “الدين أفيون الشعوب” لم تكن من اختراعه وإنما وجدها في مقالة لصحفي صغير كان يعمل معه، فأخذها ونسبها لنفسه !!!
أعتقد أن هذه الجرعة من “كاتب الأعاجيب” كافية ، فإن لم تكن، فإليك هذين المثالين الآخرين المختصرين:
الشاعر الإنجليزي شلي (1792 – 1822): كان شلي يسعي إلي ملء الفراغ الأخلاقي من خلال الشعر بعد فشل الكنيسة في ذلك وأحد قادة موجة الشعر الرومانسي الذي انتشر أثره في كل آداب العالم تقريباً.
وكان يقول: “أنا مقتنع تماماً بأنني من الممكن أن أظل صديقاً مخلصاً ومحباً صالحاً للبشرية ونصيراً قوياً للحق والفضيلة”.
لكنه مع ذلك كان يجهر بآرائه عن سخف وعبث العفة، وقال لصديق له مرة إنه لن يمانع أن ينام أي شاب يراه مناسباً لذلك مع زوجته.
كان يقترض من كل مكان ومن كل أنواع البشر ولم يسدد معظم تلك المبالغ، وأصبح “شلي”، رجل الحقيقة، غشاشاً ومحتالاً مدي الحياة؛ ففي مناسبتين هاجم أهالي المنطقة منزله في منطقة البحيرات وفي ويلز، وأجبروه علي ترك المكان كما فرَّ كثيراً أمام مطالبات دائنيه وأمام الشرطة.
وكانت هناك ضحايا كثيرة (معظمهن من النساء) علي مذابح أفكاره يغويهن ويبتزهن وبعد ذلك يلقي بهن.
براتند راسل (1872 – 1970 ): نظرياً كان راسل مع حركة القرن العشرين لتحرير المرأة، أما من الناحية العملية فكان مغروساً في القرن التاسع عشر. كان يميل لأن يري النساء يتبعن الرجال كذيول لهم. ولم يكن يؤمن حقيقة بالمساواة. كان يعتقد أن الرجل أذكي منها. وذات مرة قال: “إنه كان دائماً يجد ضرورة لأن يتحدث إلي المرأة باحتقار”. ويبدو أنه كان يشعر في قرارة نفسه أن وظيفة المرأة هي إنجاب الأطفال للأزواج.
على أن ما ذكره صاحب كتاب المثقفون عن هذه النماذج وغيرها وعن الوجه الآخر لسيرتها ، مما يصدم قرَّاءهم وشيعتهم والمعجبين بأفكارهم وفلسفاتهم، شكَل ظاهرة تجاوزت الغرب الأنجلو أمريكي إلى الحياة الثقافية في بيئات أخرى؛ فعندنا في الشرق مثلاً ستصدم عزيزي القارىء كما صدمتُ وأنا أقرأ عن عباس العقاد ( 1889 – 1964 ) مثلاً – وفق ما يذكر صاحب كتاب عصر ورجال – ما يضعه في قائمة كتاب الأعاجيب:
كان العقاد – كاتب الإسلاميات الشهير وأحد المدافعين عن الإسلام ضد خصومه – يكثر من توبلة كلامه بالكفريات، فقد كان يشير إلي الله تعالي بقوله: “صاحبنا اللي فوق” وفي يوم كنا نتكلم عن القرآن ثم طال بيننا الحديث حتي وصلنا إلي باب مكتبي فوقفنا علي عتبة الباب فقال تعليقاً علي سورة الناس: “لو نسبوا إليَّ هذه السورة لتبرأت منها” ثم راح يتلوها مكرراً كلمة الناس في ختام كل آية هازَّاً رأسه علامة الاستهجان.
وزار مرة صالون العقاد الأسبوعي أحد طلاب العلم المفتونين به وكان متديناً، وكان الصالون ينعقد كل جمعة وقت الصلاة، فاستأذن ذلك الطالب الأستاذَ العقاد في أن يتنحى جانباً ليصلي الظهر، وسأله عن اتجاه القبلة ، فكانت المفاجأة أن العقاد لا يعرف القبلة كيف يكون اتجاهها في بيته، الذي يقيم فيه منذ عشرات السنين.
أما مواقفه السياسية فلم يحوجنا العقاد إلي دليل، نستدل به علي أسلوبه في السياسة، فقد اعترف في شجاعة يحمد عليها، أن الإنجليز كانوا يحسنون الظن به وأنهم كانوا لا يجدون مانعاً من إسناد الأمور التي تهمهم وتخصهم إليه بل إنهم فكروا في الاستعانة به فعلاً أكثر من مرة خلال الحرب العالمية الأولي وقبلها في وقت كان الشبان المصريون الذين يقلون عنه شهرة ومكانة قد أبعدوا إلي النفي في الخارج أو إلي المعتقل في الداخل، ولم يقف تفكير الإنجليز في الاستعانة بالعقاد عند حد إسناد المناصب الإدارية إليه، بل تجاوزوا ذلك إلي ترشيحه للمهام السياسية أيضاً.
من هذه المهام ترشيحه لرئاسة تحرير صحيفة المؤيد بعد وفاة علي يوسف. ولسنا في حاجة إلي أن نقول إن الإنجليز لا يتجهون إلي ترشيح كاتب كالعقاد لشغل هذا المنصب السياسي الهام، إلا وقد علموا سلفاً باتجاهاته السياسية، وبشعوره نحوهم، فقد كانت الغاية من إسناد رياسة تحرير المؤيد إليه أن يكون المؤيد لساناً من ألسنتهم.
ثم لم يلبث العقاد حتي قبل أن يعين رقيباً علي الصحف المصرية، إبان الحرب العالمية الأولي. وكان مدير الرقابة بريطانياً يدعي “هورنبلور” وقد اختلف معه العقاد فيما يجب حذفه، وفيما يجب تركه، فترك العمل في الرقابة بعد أسبوع. والاختلاف بين البريطانيين أنفسهم يقع، فوقوعه بين العقاد وبين هورنبلور، لا يزكي العقاد كثيراً ولا ينفي عنه أن الإنجليز لم يكونوا يتوجسون منه، بل العكس كانوا يطمئنون إليه ويودون أن يصلوا أسبابهم بأسبابه.
ويحكي فتحي رضوان قصة أخرى عن ظروف كتابته في “روزاليوسف” :
انتوت السيدة روزا اليوسف إصدار جريدة يومية في بعد أن كانت قد أصدرت مجلة أسبوعية بدأت أدبية ثم تحولت إلي سياسية، تحمست للوفد وأيدته، وكانت من أقوي أدوات دعايته، وأحد أسلحة الهجوم علي خصومه.
وفكرت السيدة “روزا” في أن تسند رياسة تحرير جريدتها إلي فكري أباظة الذي اعتذر لأن ولاءه لدار الهلال ولصاحبي الدار ألزمه ألا يعمل في غير صحف هذه الدار وقد بقي وفياً لهذه الدار حتي اليوم.
وفكرت في أن تسند رياسة التحرير إلي محمود عزمي، وكان يكتب وقتذاك في جريدة الجهاد الوفدية التي كان يصدرها توفيق دياب، وقبل عزمي أن يترك الجهاد، وأن يعمل في الصحيفة اليومية الجديدة، وحرر العقد بين السيدة روزا اليوسف وبين محمود عزمي إبراهيم عبد الهادي المحامي، الذي أصبح من زعماء الهيئة السعدية ثم وصل بعد ذلك إلي رياستها، بعد مقتل ماهر والنقراشي.
ثم فكرت السيدة في ضم العقاد إلي هيئة تحرير الجريدة الجديدة، فقبل العقاد، بعد أن رفض أول الأمر، بحجة أنه لا يعمل في جريدة تحمل اسم “ست”، ولكن السيدة روزا عرفت كيف تعالج هذا الرفض، فقد رفعت مرتبه من ٧٠ جنيهاً كان يتقاضاها من جريدة الجهاد إلي ثمانين جنيهاً، ثم قبلت أن تعجل له مرتب أربعة شهور يقبضها دفعة واحدة، وكان لابد أن يضاف إلي هذين الشرطين الماديين شرط أدبي، كان من قبيل تحصيل الحاصل، هو أن تكون الجريدة وفدية.
أما أمير الشعراء أحمد شوقي (1868- 1932 ) الذي أبكتنا قصائده في المديح النبوي والدفاع عن الإسلام وتوضيح حقائقه ببلاغة منقطعة النظير، فقد كان الرجل عظيم الإيمان بدينه، وإن كان لا يصوم ولا يصلي، كما اعتذر عن السفر مع الخديو عباس لأداء فريضة الحج. .
وعن غرابة الأطوار في حياة شوقي فحدث ولا حرج:
يستوقف النظر ويثير الدهشة في حياة أمير الشعراء أن يفتح صالوناً للحلاقة في أسفل عمارة يملكها، وهو شيء ظريف يستوقف النظر. فأن يدير شاعر ثري صالون لحلاقة الشعر (بالكسر لا بالفتح) والذقن ويقوم الحلاق يومياً بتقديم الحساب لصاحب الصالون، ظاهرة تحتاج إلي تفسير محلل نفساني، وإن كان مما ييسر عليه المهمة أن يكون حساب ذلك الصالون بالخسارة دائماً، إذ إن بهذه الخسارة يخرج الباعث علي كسب المال من دائرة البحث.
وقد كان شوقي يرمي بأنه بخيل وأنه كلما تقدم به السن زاد حرصه علي ماله.
وكان شديد الخوف من العدوي إلي حد الوسوسة، فكان لا يسمح لأحد يزور مريضاً من أولاده أو أهل بيته إلا إذا غسل يديه ورأسه بالكولونيا خوفاً علي مرضاه من الزائرين.
كان يجزع من النقد جزعاً شديداً، ويخاف الصحف الصغيرة (الصفراء) فكان يغدق علي أصحابها الأموال الجليلة، ولا يلقاهم إلا بالتكرمة وخلع الألقاب الضخمة عليهم. وقد علم أولئك عنه ذلك، فإذا قبض يده عنهم غمزوا شعره، فهرول إليهم مسترضياً باذلاً ماله، وكان هذا سبيلهم إلي سلبه.
وقال الأستاذ أحمد محفوظ مؤرخ سيرته: إن شوقي غضب عليه غضباً شديداً لأنه أخبره بمقال نشر في إحدي هذه الصحف الصغيرة، ملأه كاتبه نقداً في شعره. فثار وصاح في وجهه: “يأخي هو لازم تبلغني شتيمتي. أنا ماأقراش الصحف الساقطة دي” وفي اليوم التالي اتصل شوقي بصاحب المقال، وأجزل له العطاء، وأسبغ عليه أكبر الألقاب.
وكان لا يطيق أن يمدح أمامه شاعر أو كاتب سواه، حتي لو كان من الموتي، أو مَن فرّق بيننا وبينهم الموت قروناً طويلة.
وكان لا يحب أن يسمع حديث الموت لفرط حرصه علي الحياة، بل كان لا يحب أن يهول زواره إذا مرض في الحديث عن مرضه حتي ولو كان ذلك من قبيل الجزع له والاهتمام به. دخل عليه وهو في فراش مرضه شاب من ذوي قرباه، وقال له: مسكين يا عمي .. سلامتك! فصرخ في وجهه: اخرج اخرج. لا أنا عمك ولا أعرفك .. اخرج برة يا حمار.
هل لديك عزيزي القارىء نماذج أخرى من “كاتب الأعاجيب” ؟