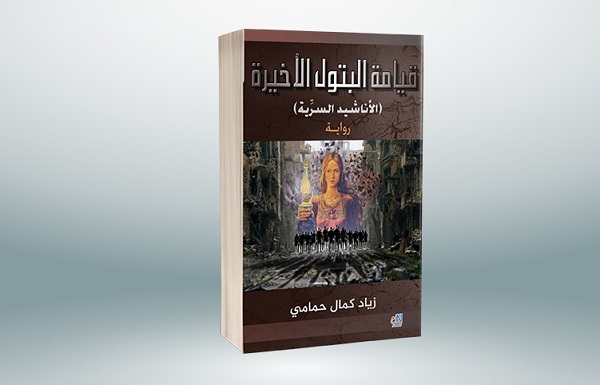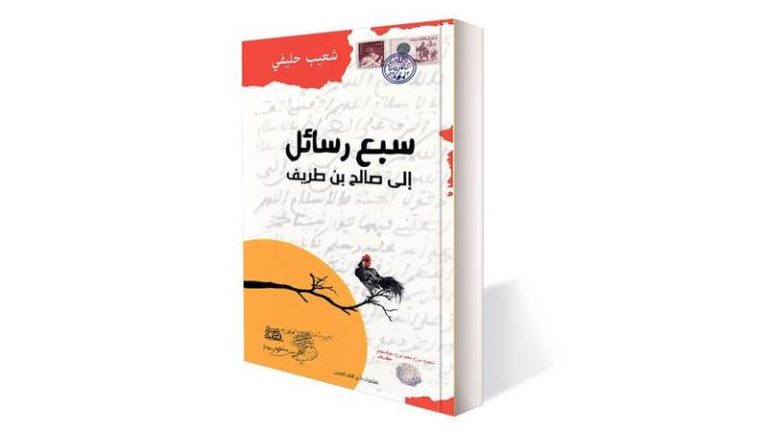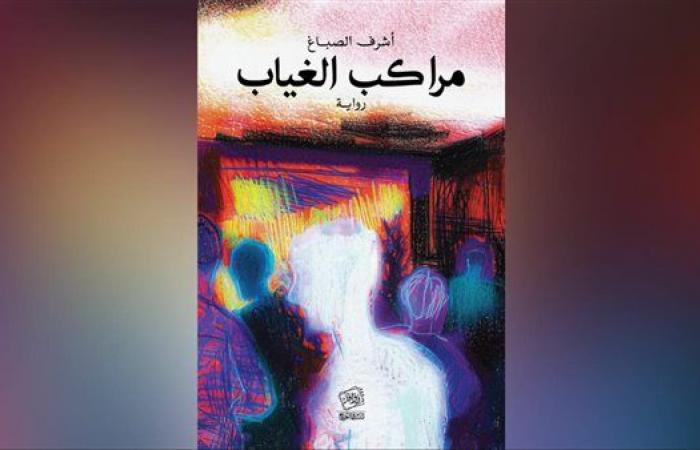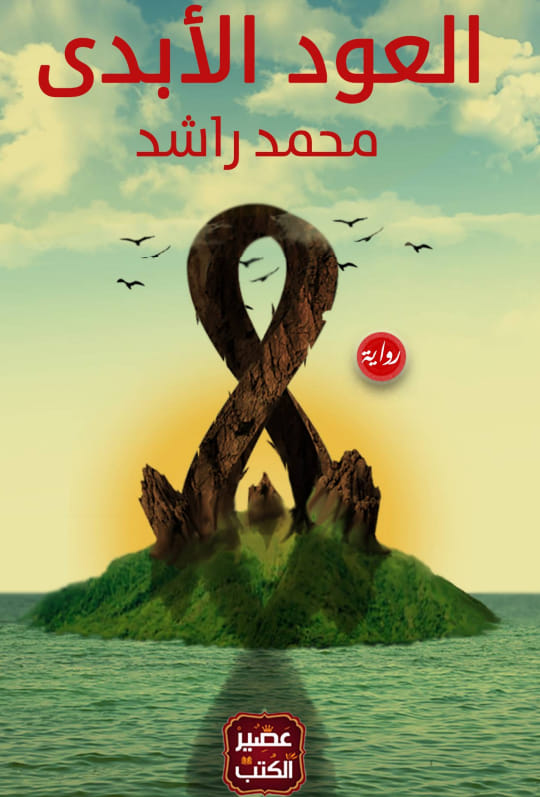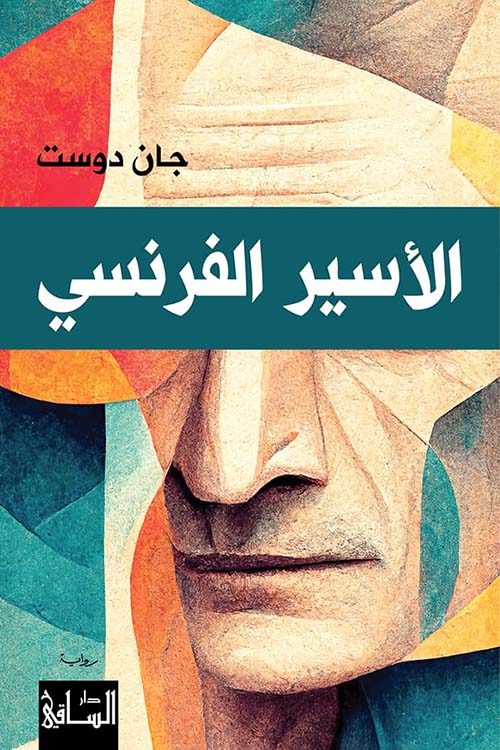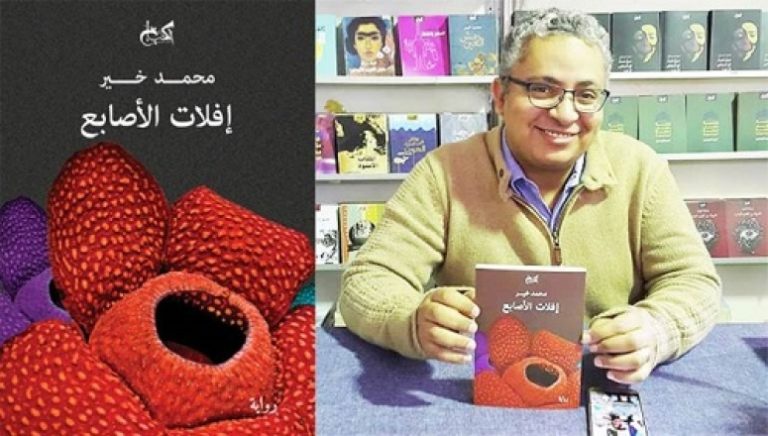د. مصطفى عطية جمعة
تطرح رواية ” قيامة البتول” للروائي السوري زياد كمال حمّامي ( والصادرة عن دار نون 4 للنشر والطباعة والتوزيع ، حلب – سوريا، 2018م) قضية امتهان الجسد في الحروب، انطلاقا من أنه إذا كان هناك حديث عن الحرب في أبشع صورها، فحتما سيكون الجنس حاضرا، في أشد صوره عنفا، ألا وهو الاغتصاب، فتوارى الجنس الحميمي المعبر عن الحب، وتلاشت العلاقات الرومانسية التي تُتَوَّج عادة بالزواج، وتنشأ في دوائر القربى أو الحي أو الحارة، أو الزمالة في الجامعة والعمل، بل إن صور الزواج التقليدي، اختفت تماما في أجواء الرواية وحلّ مكان كل هذا صور الاغتصاب في أشكال مختلفة، إما اغتصاب بوصفه حالة فردية، مثلما حدث مع البتول العذراء، ذات الجمال البريء والقلب الصافي، على أيدي عدد من المجرمين، أذيال كبار الفاسدين، اعتدوا على الأب، وتناوبوا على الابنة، أو اغتصاب جماعي للنساء على أيدي الجنود، أو اغتصاب جثث النساء..، وتلك هي الحرب، ولا تسأل عن الإنسانية، ولا القيم ولا الأخلاق، ولا الدين، فالمحارب الذي يتلذذ بفعل القتل، وتنعشه الدماء المتطايرة، سيتلذذ حتما بالاغتصاب، بل سيتلذذ بالجسد الأنثوي الضعيف الواهن وهو يستعطفه، ولكن المغتصب في قمة نشوته: لذة الجنس ولذة القوة ولذة الانتشاء.
اعتمد السارد تقنية التفكيك السردي والزمني في استعراضه لواقعة اغتصاب البتول، فلم يورد الحادثة بتفاصيلها، وإنما تعمد منهجية التفتيت، ففي مطلع الرواية نقرأ إشارة أولى، تحير المتلقي، ولكنها تشوقه لمعرفة المزيد عنها، يقول:” تتكور في زاوية الغرفة نفسها التي شهدت حالات اغتصابها اللعين، تتنفس بصعوبة، تبكي، تنتحب، تحاول أن تخفي عُريها المدنَّس، ودماءها المتخثّرة تحت ثرى ساقَيها، وثيابها الداخليّة البيضاء، وتلك الكدمات الموشومة على وجهها المصدوم، وآثار الشذوذ الجنسيّ الوحشيّ الذي تعرّضت له، بعد أن تمّ اغتصابها مرارا وتكرارا، بوحشيّة همجيّة”، (ص12). المشهد السابق يقطر قتامة: بكاء، عري، دماء، صدمات، شذوذ، وحشية، وجاء في الصفحة الأولى، وعبد السلام يشكّل تمثاله عن الحرية، فهل كان إزميله ينحت في الصخرة الصلدة انتقاما لشرف البتول، أم هو كفنان ينتقم من الحجر، لعله يشفي غليلة نفسه، ويداري عجزه وعجز أبناء الحارة عن حماية شرفها المثلوم؟
المشهد السابق هو نتيجة لفعل الاغتصاب، الذي سيفصله السارد بعدئذ، وقد بدأ به مطلع روايته، لأنه كان المشهد الأشد في نفسه، حيث ظل “يتماوج طيف البتول في مخيّلته المتوثّبة، ينثال أمام ناظريه، كموجة عالية، تتلوها موجة قريبة لجسدها المدمى، شبه العاري، وفي إحدى زوايا غرفة الدار الواسعة” (ص14)، لأنها الفتاة المثالية، التي كان يراها دائما عنوانا على الصفاء والطهر والنقاء، وكانت تمثل الحب النقي في أعماقه، وربما كان هذا الموقف سببا في انحرافه بعد ذلك، وسقوطه في حمأة الرذيلة، عندما اقترب من إبراهام وابنته ليزا. كما عشقها صديقه يحيي وكان متيما بها، وتغزو دوما أحلامه (ص57). لقد ترك المجرمون البتول بعد فعلتهم الدنيئة وهي عارية، حيّة، ولم يقتلوها مثلما اعتادوا أن يفعلوا، وربما هذا عائد إلى رغبتهم في إذلالها وإذلال أحل الحارة جميعهم وامتهانا لكرامة من أحبها.
وعندما وصل أهالي الحارة إلى منزل البتول، بعدما غادروه، وجدوا والدها الأستاذ “أبو النصر”، والذي كان نموذجا للموظف الشريف وتم فصله من أجل ذلك من عمله في بلدية حلب(ص21)؛ وجدوه مربوطا بحبل بلاستيكيّ مُحْكَم من يديه، وقدميه، وقد تمَّ وضع شرابٍ متّسخٍ في فمه، وفي غرفة أخرى، كانت البتول في تأوّهاتها، تضرب رأسها بالجدار، تلقي كلمات غير مفهومة، فمن الواضح تماما، وقد اغتصبت بعنف جماعيّ متكرّر، وتمَّ فضُّ عذريتها. (ص15، 16). لقد كان والدها مكبلا، وهو يسمع صراخ ابنته، غير قادر على نجدتها أو مبادلتها الصراخ، فيا للذل الذي لحقه ساعتها وبعدها! ويفصل السارد مشهد الاغتصاب أكثر (ص23)، عندما كمم أحدهم فم والدها، وراح ينتظر دوره كي ينال من شرف البتول، وكان الأب يموت في لحظاتها ألف مرة، وهو يرى ابنته الوحيدة ونور عينيه، الطالبة في كلية الزراعة، مثل الزهرة التي تنفرط أوراقها تحت أجساد من كان يجب أن يحمي الوطن، ثائرا كان أو جنديا وطنيا، وهي التي كانت تحلم أن تملأ الوطن بزهور من زرعها. ويتكرر المشهد ثانية بتفصيلات مختلفة (ص69)، فالبتول الممددة على الأرض، أشبه بالدجاجة التي لم يكتمل ذبحُها، ولكن عبد السلام يرى فيها الطهارة، وقد أصيب بالذهول أمام وجهها الفاتن، غير منتبه إلى الدماء المنثالة منها.
ولم يكن أمام البتول إلا الانتحار، فتوجّهت نحو سطح الدار العالي، ووقفت على حافّته، ورفعت رأسها إلى السماء عاليا، طالبة السماح من الرب، قبل أن تلقي بنفسها.(ص16)، وهو فعل متوقع من أية فتاة عفيفة، تتعرض لمثل هذا، في مجتمع عربي، ينظر بقداسة إلى العرض. وغالبا ما تكون في حالة نفسية، لا تدرك أبعاد فعلتها، ولا كونها ترتكب جرما آخر في حق نفسها. وكانت المفارقة في جسد البتول الذي اختفى تماما، ولم يُعثّر له على أثر، على الرغم من البحث الدائب عنه، فهناك ركام ضخم في المكان الذي سقطت فيه، ولم يفلح الكلب”ميمو”، وهو الذي يعرف رائحتها جيدا أن يستدل عليها(ص25)، وكان قد ساعد الأهالي كثيرا في الوصول إلى الجثث المختفية تحت ركام البيوت، أو نجدة الأحياء العالقين بين الجدران المهدمة.
وتحولت البتول طيلة صفحات الرواية إلى طيف، يطل كل حين في مخيلة عبد السلام، أو يبدو كالملاك أمام أهل الحارة. وكما يشير (ص70)، أنه ومنذ لحظة اغتصابها، والبتول لم تفارقه، تأتيه في الحُلُم، تستولي على أفكاره، تنهض مع ذكرياته، وفي أحلامه تأتي إليه البتول نفسها، بلحمها وعظمها، بجسدها وروحها، وهذا يؤكّ د أنّها لم تنتحر، ولم تمت، وستقوم قيامتها قريبا.(ص71)، وهو ما يفسر عنوان الرواية “قيامة البتول”، ويدفعنا لقراءة الرواية في منظور التأويل للفانتازي، حيث الحلم ممتزج مع الواقع، وطيف البتول لا يغادر القلوب.
ولكن السؤال ظل معلقا، ودائرا على الألسنة: “هل توفّيت انتحارا، وتطهّرا؟ أم إنّها، حقّا، غارت بجسدها تحت أنقاض المدينة التي كانت لا تنام؟!”(ص17). لتصبح البتول الشفافة لغزا، ويظل شبحها يطارد أهل الحارة زمنا طويلا.
ولنا عِبرة في موقف العرَّافة خاتون، التي ظهرت ذات يوم حزينة جدا، وعيناها تشعّان احمرارا، والبكاء المقدَّس، ولذلك بثّت لأهالي الحيّ ، في صباح اليوم التالي: إنّ البتول قد أعلنت قيامها، وانبعاثها من الرماد. وتؤكّد العرافة أنّ البتول قد زارت الحارة البارحة، وأنّها كانت غاضبة، متألّمة، مجروحة، وقد مزّقت ثيابها، وخلعت خِمارها، وأنّ عويلها كان تحذيرا.. وأشارت بكلمات واضحة: إنّ الحياة في هذا الحيّ البائس لم تعد تطاق، ولا سبيل غير الرحيل! (ص205، 206). وبذلك يتحول السرد إلى المنحى الفانتازي، فالبتول ملاك يحوم على أهل الحارة، يتأمل أوجاعها، ويتألم لألمها، والعرافة خاتون هي الوحيدة التي يمكن أن تتواصل مع البتول، وتنبئ أهل الحارة بما تريده منهم، ويسوق السارد الكثير من التفصيلات عن أفعال السحر التي تمارسها، ويهرع إليها الناس، يستطلعون الغيب، أو يتآمرون ضد الآخرين(ص66).
وبذلك لم يعد السرد مجرد وصف للواقع المعيش في حارة البندرة الحلبية، وإنما تحول ليكون واقعا مرتبطا بالحلم، من خلال إطلالات البتول المتكررة، وإلحاحها قلوب من أحبها، وأيضا من خلال الرسائل التي تنقلها خاتون، كي لا تتكر مأساة البتول.
على صعيد آخر، فإن الاغتصاب بكل ما فيه من دناءة؛ يصبح كاشفا عن مكبوتات النفس، وما اختزنته في طفولتها. وهذا هو يتسلّل “الجقجوق”، يتلذذ باغتصاب جثث النساء، حيث يسحب الجثة التي لم يبحث عنها أحد، ويتسلل بها إلى دار خربة، ثم يجرِّدها من ملابسها، وهو يخمن في نفسه أن صاحبة الجثة ربما كانت قبل موتها، تعبر الأزقّة الضيّقة عبورا طارئا، مختصرا، وذلك للوصول إلى “باب الفَرَج”، ولكنّها تعسَّرت هنا، وها هي ذي تجثو عارية، على طاولة خشبيّة متهرئة، ليمارس معها الجقجوق” مكبوتاته الجنسيّة، بشهوانيّة لا مثيل لها، فيبدأ في التفرّس فيها بشهوة الذئب، فيشمّها، ويبتسم، تظهر أسنانه المتكسّرة، ولبرهة، يتوقّف عن الحركة، يتذكّر تلك الحوادث التي جرت في طفولته، ولم ينسَها أبدا، حينما كان يشاهد أمه “زيزفونة”، المومس والرجال يفدون إليها كل يوم، يضاجعونها نظير أجر معلوم، ويسخرون منه ويسبونه. وعندما كبر لم يبتعد كثيرا عن مهنة الأم، فعمل في حمام، ليتلصص على الأجساد العارية، وصار أيضا لوطيا، يمنح جسده كيفما شاءوا. وهو في فعلته القميئة مع الجثة، يصورها بكاميرا هاتفه ويقص شعرها، قبل أن يدفنها بهدوء، في الدار الخربة، ثم يغادرها منتشيا بالسعادة والقوة (ص73،74).
إن الجقجوق ليس مدانا وحده، وإنما الوسط الذي نشأ فيه، وإحساسه المستمر بالمهانة، وهو يرى أمه ذليلة تحت أجساد الرجال، وهو أيضا ذليل عندما كبر، فهو شوق إلى لحظات من القوة، لا يستطيع أن يفعلها مع الأحياء، فليس أمامه إلا اغتصاب الموتى، في واحدة من أشد جرائم النفس الإنسانية شذوذا.
*****
إن أبرز ما يميز أسلوب زياد كمال حمامي هو ثراؤه اللغوي، وقدرته الكبيرة على الوصف المسهب، وإن كنّا نتحفظ على إطنابه وإسهابه أسلوبيا، حيث ينجرّ غالبا إلى ما نسميه “غواية القلم” ، فيكثر من حروف العطف، ويعدد من المترادفات، ويزيد من الأوصاف والأخيلة، ويراكم التعبيرات، مما ينأى بأسلوبه عن التكثيف، الذي هو ملمح أساس في السرد الروائي المعاصر، الذي يتكفي باللمحة والكلمة والإشارة، ويترك للمتلقي أن يفهم المخبوء من بين السطور، لا أن يفصل الواضح، ويسهب في المفهوم، ويطنب في المعلوم.
وتلك قضية مهمة، لأن التكثيف والاختزال في الأسلوب والبنية السردية؛ يتيح للمتلقي أن يعمل عقله، في الرسائل المبثوثة في المتن السردي، مما يؤدي في النهاية إلى تخمة في النص، قد تكون عبئا في قراءته، وعبئا أيضا في التفاعل معه، فالأسلوب الموجز المكثَّف يحرّك الفكر، ويثير الوجدان، ويحفز العقل على التأمل، خاصة في السرد الروائي، والذي استقرت دعائمه في الأدب العربي المعاصر، وصارت البراعة في قدرة المبدع على تقديم الحدث والشخصية بدقة وشفافية، وبتشويق وبلاغة، وتكون براعته في كيفية تحميل متنه السردي ما يريد من أفكار، وكيفية تشكيل بنية سردية ماتعة، في موضوعها وطرحها.
أخيرا، لاشك أن رواية “قيامة البتول” فيها الكثير مما يُدرَس نقديا، ففيها الكثير من الشخصيات متعددة الأصول والتوجهات والمواقف، كما أنها تزخر بمادة ثرية من الأحداث الواقعة على الأرض، وقد أحسن المؤلف عندما صاغها بتقنية السارد العليم، ممتلكا في يده مختلف خيوط السرد، وهو ما أتاح له التنقل بكل حرية مع الشخصيات والأحداث؛ يقطّعها زمنيا، ويفصّلها مكانيا، ويقاربها دلاليا وفكريا.