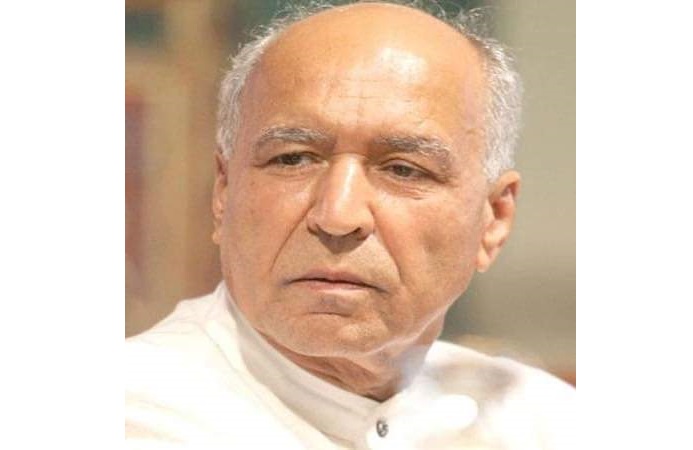وليد خيري
في زمن مضى، كان مصير مسرحية في برودواي أو فيلم في هوليوود أو رواية في القاهرة معلقا بسن قلم ناقد واحد يجلس في مكتبه الوثير بصحيفة نيويورك تايمز أو مجلة الكواكب. كانت تلك الحقبة هي عصر الكهنوت النقدي، حيث يمتلك الناقد مفاتيح الجنة والنار الفنية، يرفع نص من يشاء ويخسف عرض من يشاء. لكن، مع بزوغ فجر السوشيال ميديا، حدث زلزال عنيف؛ تهشمت فيه الأقلام النقدية للنخبة تحت وطأة ملايين الأصابع التي تنقر على شاشات الهواتف الذكية.
إذا كان الفيلسوف الفرنسي رولان بارت قد أعلن في الستينيات موت المؤلف ليحرر النص ويمنح القارئ حرية التأويل، فإن السوشيال ميديا في القرن الحادي والعشرين قد أعلنت موت الناقد.
هذا التحول هو انتصار للنسبية المطلقة. لم يعد هناك جميل أو قبيح استنادا لقواعد الدراما الأرسطية أو نظريات السينما؛ الجميل هو ما يحصد التريند، والقبيح هو ما يتجاهله التايم لاين.
نحن أمام ظاهرة تمكين الهامش. الإنسان العادي الذي كان صوته يضيع في المقاهي، وجد في فيسبوك وتيك توك وإكس منصة توازي في قوتها أعمدة الصحف الكبرى. هذا التمكين خلق ما يسمى بذكاء الحشد تارة، و طغيان الغوغاء تارة أخرى. السلطة النقدية هنا لم تعد سلطة معرفية، بل سلطة رقمية؛ قوتها لا تكمن في عمق التحليل، بل في حجم الضجيج الذي تحدثه.
لعل السينما هي الساحة الأكثر تضررا وتأثرا بهذا الانقلاب. ظهرت مواقع مثل (Rotten Tomatoes) و(IMDb) التي تضع تقييم الجمهور بجوار تقييم النقاد. وفي كثير من الأحيان، نرى فجوة هائلة: فيلم يمنحه النقاد تقييا عاليا لجمالياته الفنية، بينما يمنحه الجمهور تقييما منخفضا لأنه لم يفهم حبكته المعقدة، أو العكس؛ أفلام تجارية سطحية يكتسح فيها الجمهور شباك التذاكر بينما يلعنها النقاد.
أبرز مثال صارخ على خضوع الصناعة لسلطة العاديين هو ما حدث مع فيلم Sonic the Hedgehog. عندما طُرح الإعلان التشويقي الأول، سخرت السوشيال ميديا من تصميم الشخصية. تحت ضغط هذا التنمر الرقمي الهائل، رضخت الشركة المنتجة، وأعادت تصميم الشخصية بالكامل لتشبه ما يريده الجمهور، مما كلفهم ملايين الدولارات. هنا، لم يكن المخرج هو صاحب الرؤية النهائية، بل الجمهور.
حملة #ReleaseTheSnyderCut لفيلم Justice League. لسنوات، ضغط الجمهور عبر السوشيال ميديا على شركة وارنر براذرز لإصدار نسخة المخرج زاك سنايدر. وفي سابقة تاريخية، رضخت الشركة وأنفقت 70 مليون دولار إضافية لإصدار الفيلم. هذا يثبت أن المنتج الفني لم يعد مُنجزا نهائيا، بل مادة قابلة للتعديل بناءً على رغبة الزبون الرقمي.
فيلم ريش للمخرج عمر الزهيري. بينما احتفى النقاد العالميون والمحليون بالفيلم وحصد الجوائز، شنت السوشيال ميديا المصرية هجوما كاسحا عليه متهمة إياه بتشويه سمعة مصر وإظهار الفقر. هنا، تحول النقد من نقد فني لجماليات العبث، إلى محاكمة أخلاقية ووطنية يقودها مواطنون عاديون لم يشاهدوا الفيلم أصلا، بل شاهدوا مقتطفات وآراء غيرهم. سلطة العاديين هنا كادت أن تطمس القيمة الفنية للعمل تحت وطأة الصوابية السياسية والشعور الوطني الجارف.
في الأدب، تغيرت اللعبة تماما. منصة تيك توك وتحديدا مجتمع (BookTok) أصبح هو المحرك الأول لمبيعات الكتب في العالم، متجاوزا ملاحق الصحف الثقافية العريقة.
لم يعد النقاد هم من يرشحون الكتب الجيدة، بل المراهقون الذين يبكون أمام الكاميرا وهم يقرأون رواية عاطفية. ويقولون تلك العبارة المبتذلة: اسوأ ما في هذه الرواية “إنها بتخلص”
الأخطر من ذلك هو ظاهرة تغيير النهايات. بعض الكتاب، خاصة في منصات النشر الرقمي مثل واتباد، يقومون بتغيير مسار القصة بناء على تعليقات القراء في كل فصل. هنا، فقد الكاتب سلطته الأبوية على نصه، وتحول إلى منفذ لرغبات الجمهور. أصبح الأدب تفاعليا، لكنه فقد الكثير من خصوصيته ورؤيته الذاتية المستقلة.
المسرح، فن اللحظة الحية، بات يعيش رعبا حقيقيا من كاميرا الهاتف. قديما، كان الحكم على المسرحية ينتظر نشر المقال في صباح اليوم التالي. اليوم، الحكم يصدر في الاستراحة بين الفصلين عبر تغريدة.
النقد المسرحي من قبل العاديين غالبا ما يركز على الإفيه والقفشة والديكور البراق، متجاهلا البناء الدرامي والأداء التمثيلي العميق. المسرحيات التجارية الحديثة التي تعتمد بشكل كلي على التريند. نجد الممثلين يخرجون عن النص ليس لخدمة الدراما، بل لإلقاء نكتة تتعلق بحدث رائج على فيسبوك في نفس اليوم. أصبح إرضاء خوارزمية الضحك الآني أهم من البناء المسرحي. العاديون هنا لم ينقدوا المسرح فحسب، بل أجبروا المسرح على أن يشبه سكتشات تيك توك: سريع، مفكك، ويعتمد على الصدمة اللحظية.
تمنح ممارسة النقد على السوشيال ميديا شعورا زائفا بالتفوق الأخلاقي والفكري. عندما يهاجم مستخدم عادي فيلما معقدا ويصفه بالممل، فهو يحمي الأنا الخاصة به من الشعور بالقصور في الفهم.
كما تلعب عقلية القطيع دورا جوهريا. الخوارزميات مصممة لتضخيم الآراء المتطرفة (الحب الشديد أو الكراهية الشديدة). الإنسان العادي يميل لتبني رأي الأغلبية ليشعر بالانتماء. إذا قال التريند إن هذا الكاتب مبدع، فسيصفق له الجميع. وإذا قال إنه مدع، فسيُرجم بالحجارة الرقمية.
السؤال الجوهري الآن: هل يمكن للفن الحقيقي أن يصمد؟ وهل يمكن مقاومة رغبة الصناع في مداهنة ذائقة العاديين؟
الواقع يقول إن المقاومة صعبة ولكنها ليست مستحيلة، وهي تتطلب تحالفا جديدا: لا بد من وجود منصات ومهرجانات تحمي الأعمال التي لا تعجب الجمهور العام من سطوة الأرقام.
الناقد يجب أن يتنازل عن عرشه القديم وينزل إلى ساحة المعركة الرقمية. لا ليحارب الجمهور، بل ليعلمهم. يحتاج الناقد لاستخدام أدوات العصر (يوتيوب، بودكاست) لشرح لماذا هذا الفيلم جيد، بلغة يفهمها الجيل الجديد.
التاريخ يخبرنا أن حكم العاديين آني ولحظي. الروايات التي انتشرت كالنار في الهشيم في القرن التاسع عشر لأنها دغدغت مشاعر العوام، نسيها التاريخ. وبقيت أعمال ديستوفيسكي التي ربما لم تعجب الكثيرين وقتها. الزمن هو الغربال الحقيقي الذي يسقط منه التريند ويبقى منه الفن.
إن منح السوشيال ميديا سلطة النقد للعاديين هو سيف ذو حدين؛ فمن ناحية، كسر هذا التحول احتكار النخبة المتغطرسة وجعل الفن ديمقراطيا ومتاحا للنقاش العام. ومن ناحية أخرى، خلق ديكتاتورية التسطيح، حيث يُجبر المبدع على تفصيل أعماله على مقاس المتوسط الإحصائي للجمهور خوفا من المقصلة الرقمية.
نحن نعيش مرحلة انتقالية حرجة، يعاد فيها تعريف الفن: هل هو ما يرضي الناس؟ أم هو ما يصدمهم ويرتقي بهم؟
في ظل هذا الطوفان، تقع المسؤولية على عاتق المتلقي الواعي الذي يرفض أن يكون مجرد رقم في خوارزمية، ويمارس حقه في النقد بتجرد وفهم، لا بتقليد أعمى لصرخات الحشد. الفن سيبقى ما دامت الروح البشرية موجودة، لكن الخوف كل الخوف أن يتحول الفن من مرآة نرى فيها حقيقتنا، إلى فلتر يجمّلنا لنعجب الآخرين.