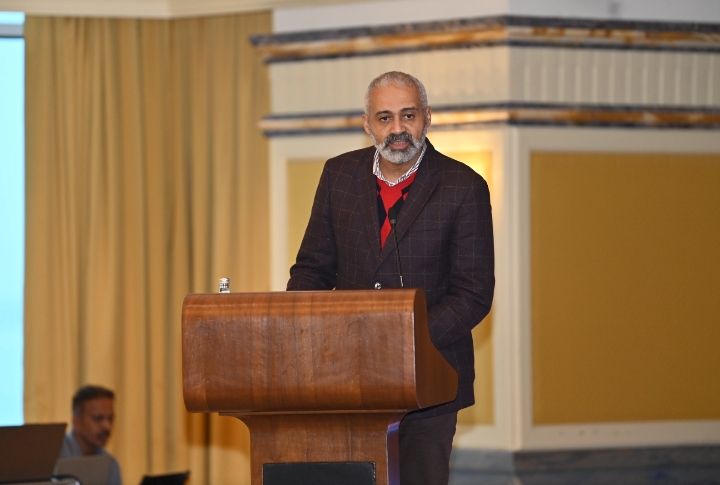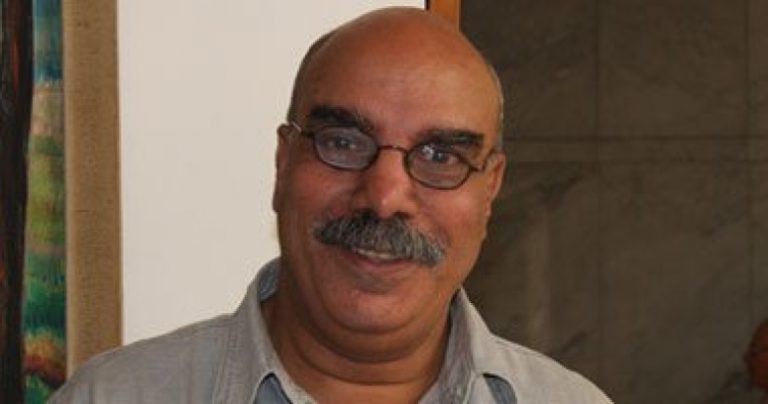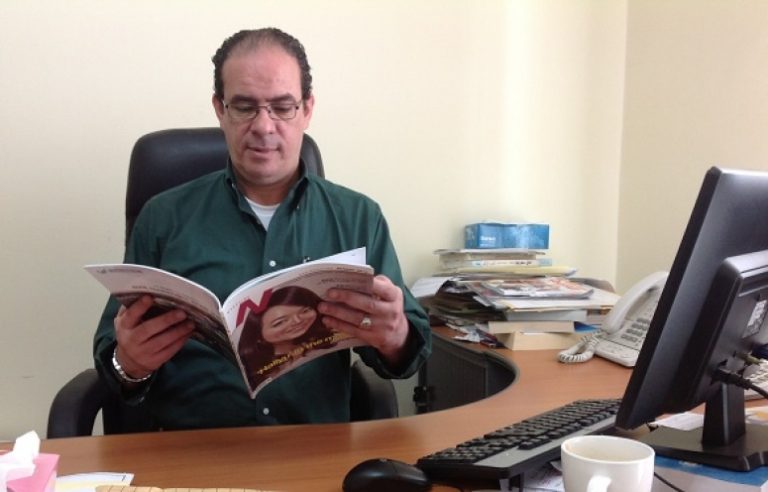محمود خيرالله
على الرغم من تقديري وامتناني للنوايا الحسنة التي أعدّت موضوعَ الندوة وأسئلتَها بغية إنصاف الشعر الجديد والانتصار للوعي النقدي به، إلا أن هذه الأسئلة لم تتخلص من بعض الأفكار النقدية الخاطئة، التي كانت ولاتزال شائعة ـ للأسف ـ حول الشعر الجديد، وتحديداً حول “قصيدة النثر”، كما لم تتخلص من اعتقادٍ نظريّ غيرِ دقيق، عن دور النقد الأدبي والمساحة المفترض أن يكونَ قد شغلها في متابعةِ منجز “قصيدة النثر” العربية، ما يهمني هو أن أعيد تفكيك هذه الأفكار وأن أصوَّبها في ثلاث نقاطٍ أساسية لأبنيَ على هذا التصويب جوابي على سؤاليْكم، بناء على تجربة عشتُها كشاعر مصري من شعراء قصيدة النثر العربية ينتمي ـ في الوقت نفسه ـ إلى “جيل التسعينيات”:
قصيدة النثر أولاً ليست ابنة “نظريات نقدية حديثة”، وهي لم تكن كذلك في أيِّ يومٍ من الأيام ولا في أيّ لغة من اللغات، لا عربياً ولا أوروبياً ولا أمريكياً، والعكس تماماً هو الصحيح، لأن قصيدة النثر ثانياً سبقَت التنظيرَ النقديّ لها وجوداً وانتشاراً بزمن طويل، في كل الآداب الأوربية كما في الأدب العربي الحديث، ونظرة سريعة على تاريخ قصيدة النثر العربية تدلنا على أن النصوص كُتبت بغزارة (أدونيس وأنسي الحاج وفؤاد رفقة ومحمد الماغوط وتوفيق صائغ وشوقي أبي شقرا ويوسف الخال وغيرهم..) متخذةً شكل قصيدة النثر، خلال النصف الثاني من عقد الخمسينيات من القرن العشرين(1)، ثم بعدها ظهرت محاولات قليلة وبدائية لقراءتها والتعريف النقدي بها، بينما كان اهتمام النقد العربي ذي التوجهات الحديثة وقتها موجّهاً إلى قصيدة “الشعر الحر” أو قصيدة “التفعيلة”، إن كنتم تتذكّرون.
الحقيقة التاريخية الثابتة ـ على الأرض ـ تقول إن شعراء النثر العرب سبقوا دائماً النقد بتجارب ومغامرات شعرية من كل الأجيال: السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، وأن النقد لم يسبق قصيدة النثر بل على العكس، لم يكن النقدُ أبداً قادراً على ملاحقة انجازات الشعراء وقدراتهم على التجريب، ولهذا السبب ربما أخذ بعض شعراء النثر على عاتقهم عبء تقديم رؤى نقدية لكتاباتهم، فزاول كثيرٌ منهم النقد والترجمة، لسد الفراغ النقدي والمعرفي حول النص الجديد، والحق أنه باستثناء كتابات نقدية لأمثال ادوار الخراط وصبري حافظ وفاطمة قنديل وعلي البطل وأيمن بكر.. وقليلين غيرهم، اتخذت كثيرٌ من المنطلقات النقدية للشعر العربي الحديث من قصيدة النثر أحد موقفين لا ثالث لهما: إما الاستبعاد التام والتجاهل المُطلق لها أو الحديث عنها من موقع العداء والاستعلاء وبنيَّةِ التشويه والاستهزاء، ربما لأن “قصيدة النثر” بطاقتها الفريدة على “الهدم والبناء” كانت تمثل بالنسبة للغالبية العظمى من النقاد والأكاديميين خطراً يدمر ما تعلموه وأتقنوه وأصبح “لقمة عيشهم”، من دراسات حول الشعر القديم والوقوف على أطلاله الدارسة، وهي الأطلالُ نفسُها التي دفعت الشعراء الجدد ـ أصلاً ـ إلى انكار وتحطيم “عمود الشعر” كله
إن الاهتمام النقدي الجاد بقصيدة النثر ظهر في العقد الأخير من القرن العشرين، ففي منتصف التسعينيات تقريباً كتب الدكتور علي البطل عن “بنية الاستلاب” في شعر رفعت سلام، وكتب إدوار الخراط عن شعراء السبعينيات ومن جاءوا بعدهم، كما كتب الدكتور محمد عبدالمطلب عن قصيدة النثر، لكن أكبر دليل على تأخر النقد العربي وتخلفه ـ بالمعنى الزمني ـ عن مواكبة قصيدة النثر هو موقف ناقد كبير منفتح على الثقافة الغربية مثل الدكتور جابر عصفور ( 1944 ـ 2021) من هذه القصيدة، فقد كتب عنها ـ لأول مرة ـ في أواخر رحلته، حين نشر العام 2011 دراسة مطولة عن الشاعر محمد الماغوط في كتابه “رؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر”، بعد خمسة أعوام من رحيل الماغوط عن دنيانا.
كما أن نظرةً سريعةً إلى تاريخ قصيدة النثر الفرنسية ـ مثلاً ـ تكشف أن ألويزيوس برتران رحل العام 1841، قبل أن يرى بعينيه نسخة من ديوانه الوحيد “جاسبار الليل”، أول كتاب قصيدة نثر فرنسي، وبعده كتب شارل بودلير (1821 ـ 1867) مجموعاته النثرية الشهيرة، وبعدهما وضع آثر رامبو (1854 ـ 1891) بصمته الشعريةَ التي غيّرت ـ لاحقاً ـ وجه الشعر الفرنسي، ثم بعد تراكم كل هذا التراث لقصيدة النثر، وبعد عقود من انتشارها على نطاق واسع في مجلات الأدب الفرنسي، تمكّن الشاعر ماكس جاكوب من أن يضع ـ لأول مرة ـ تعريفاً لقصيدة النثر العام 1916 (2)، أي بعد أكثر من عقدين على رحيل مؤسس قصيدة النثر الأميركية والت ويتمان (1819 ـ 1892).
كما أن قصيدة النثر ثالثاً مثل كل الآداب والفنون لا تنشأ إلا عن حاجة “نفس اجتماعية”، ولا تُنتَج إلا بناء على تغير اجتماعي وسياسي وثقافي ووفقاً لممارسة كتابية ومعاناة وتمرد، ومثل كل الآداب لا يمكن لقصيدة النثر أن تنشأ في الفراغ لأن ناقداً أطلق نفيرَ البوق ذات مرة فكتب الشعراء بـ “الأمر المباشر” استجابة لهذا النفير، خصوصاً أنه سرعان ما انهالت الاتهامات واللعنات على مبدعي قصيدة النثر العربية الأوائل (3)، حيث لم يفهمها أو يتعاطف معها أحد، ثم أين هي تلك الفنون التي تنشأ لأن هناك من يطالب بنشأتها؟.. ولماذا لم يقل لنا أحد من قبل إن أدب “القصة القصيرة” أو أدب “السيرة الذاتية” الحديثين نشآ لأن نقاداً عرباً طالبوا بذلك، ولماذا لم تزدهر فنون طالب البعض بها ـ بالفعل ـ مطلع القرن العشرين مثل “فن الخطابة” أو “فن الرسالة”، بينما ازدهرت قصيدة النثر وأثمرت وسط اللعنات؟.
في تقديري أنه آن الأوان أن نعترف بأن معارفنا المُتخمة بقواعد الشعر القديم وتقنياتهِ ونماذجِه جعلتنا نهدر ما في قصيدة النثر من طاقة فنية هائلة، لقد حُرمت أجيالٌ من متعٍ كثيرة يوفرها تلقي النص الجديد، الذي يعبر عن لحظة انتقال من قصيدة العصر والوجدان التقليدي إلى قصيدة العصر والوجدان الحديث، فالقصيدة التقليدية ـ ابنة الماضي الشفاهي والذاكرة الإيقاعية المحفوظة ـ كانت تعبر في أعمق حالاتها عن طموحات رجل يريد أن يخرج في رحلة للصحراء على ظهرِ جمل وأن يعينه الشعر على “وعثاء” السفر، بينما قصيدة النثر تخاطب وجداناً تشبع برحلات على متنِ طائرة إلى مدن حديثة، ويحتاج هذا الوجدانُ من الشعرِ أن يعينَه على أسئلةٍ أكثر تعقيداً(4).
لا شك أن تطور المجتمع الصناعي الناشئ عن ثورة اجتماعية وتطور الفنون البصرية وفنون الطباعة مطلع القرن العشرين ـ وبعد عقود من تأثير بودلير ورامبو ـ كان من أهم الأسباب وراء ظهور الحاجة إلى شعر النثر، كما أن تطور فنون الصورة الفوتوغرافية والتصوير السينمائي والفنون التشكيلية والتطور الهائل لتقنيات التصوير بالفيديو وانتشار ثقافة “الهواتف المحمولة” ـ الآن ـ بدَّل الذائقة البصرية تبديلاً، وأمد الخيالَ الإنساني والشعري بطاقات جديدة.
ظني أن الحديث عن نقدٍ سبق قصيدةَ النثر ونظَّر لها ثم قيدها بقيوده هو ـ ولا شك ـ حديث افتراضيّ لا يمت للواقع بأي صلة، وظني أنه يصح أن نصفَ به شعراء كانوا يكتبون شعر “التفعيلة” أو “الشعر العمودي”، من هؤلاء اللذين فُتحت أمامهم أبوابُ النشر وانشغل الأكاديميون بتجاربهم، وأُنفقت لأجلهم ”ملايين” الجوائز التي سهلت تقييدَهم داخل الأوزان والتفاعيل والتعبيرات الموروثة، بينما مات شاعر قصيدة النثر المُجدد رياض الصالح الحُسين (1954 ـ 1982) عارياً إلا من سروال داخلي في مستشفى “مواساة” في دمشق، ورغم ذلك لا يجيد بعضُ النقادِ ـ إلى اليوم ـ نطقَ اسمه صحيحاً.
يؤسفني القول إن واقع قصيدة النثر العربية لم يعرف ـ خلال سبعين عاماً ـ مثلَ هذا النقد أبداً، أقصد النقد الذي سبق ثم نظَّر ثم قيَّد، بدليل أن قصيدة النثر ـ وهي في متن الشعرية العربية الآن ـ تعاني لا تزال من قلة الدرس النقدي والأكاديمي الجاد المُتابع لها، “انظر في العدد الهزيل لرسائل الماجستير والدكتوراه التي تناولت قصيدة النثر في قسم اللغة العربية في كلية الآداب ـ جامعة القاهرة خلال السنوات العشر الأخيرة على سبيل المثال”. كما أنها عانت من ندرة المعرفة النقدية الجادة المترجمة إلى العربية حول قصيدة النثر، ويمكننا أن نعتبر تأخر ترجمة الكتاب العمدة للناقدة الفرنسية سوزان برنار “قصيدة النثر من بودلير حتى الوقت الراهن” إلى اللغة العربية دليلاً دامغاً على صحة كلامنا، فقد صدر الكتاب كاملاً ـ لأول مرة ـ في القاهرة العام 1998 ـ بعد أربعين عاماً كاملة من صدوره في فرنسا 1958 ـ بترجمة راوية صادق ومراجعة الشاعر رفعت سلام، وبمبادرة من ناشر خاص “دار شرقيات”، وهذا يعني ـ من ناحية أخرى مثيرة للضحك ـ أن كثيراً من شعراء قصيدة النثر العرب ـ ربما ـ لم يقرأوا هذا الكتاب العمدة أصلاً ولم يكتبوا ـ وبالتالي لم يلتزموا ـ أية قواعد سابقة، وربما كان المكوّن الأبرز لخيالهم وهم يكتبون قصيدة النثر العربية الأولى هو ما كانوا يقرأونه وقتها من قصائد مترجمة عن لغاتٍ أخرى.
الآن أجيبُ على سؤالكم الأول:
هل التوتر وعدم استقرار العلاقة بين الشعر العربي الحديث والنقد الأدبي ساهم بشكل فعال في تطور القصيدة أم عرقل نموها؟
أولاً: لا أستطيع أن أتصور أن نقداً عربياً بقواعد صارمة يمكن أن يكون أسهم في تطور أو عرقل ـ حتى ـ نمو “قصيدة النثر” عندنا، ليس فقط لأن هذا النقد لم يحدث في الواقع، بل أيضاً لأن هذا الكلام يتعارض مع القيمة النظرية الأساسية التي شجَّعت الشعراء على كتابة قصيدة النثر، وهي قيمة الإيمان المطلق بالحرية في كتابة النص والاعتقاد في ضرورة هدم كل قيد وتحطيم كل شرط وكسر جميع الثوابت البلاغية والجمالية، أن كل قصيدة نثر يجب ألا تُكتب على نسقٍ سابق وألا تخضع لمعايير قياسٍ من خارجِها، وبالتالي تؤمن القصيدة الجديدة ـ أكثر من أي شعر آخر ـ بتعدد الأشكال والمداخل والأساليب في الكتابة الشعرية بعدد الشعراء أنفسهم، الذين أصبحوا بدورهم يؤمنون بالتداخل “الأجناسي” وينهلون من “تقنيات السرد” الحديثة ويوظفونها في نصوصهم النثرية، مثلما أصبحوا يعتمدون على أدوات تنتمي إلى فنون معاصرة أخرى، مثل استخدام تقنيات ”المونتاج” السينمائي في الشعر وآليات البوح “السير ذاتي”، فأين يمكن أن نعثر على دور للنقد ـ سلبياً كان أو إيجابياً ـ في كل ذلك؟.. لا أعرف.
ثانياً: لفت كثيرٌ من النقاد والمتابعين الأنظارَ إلى أن النقد ـ فوق أنه جاء متأخراً عن كتابة قصيدة النثر زمناً، لم يكن مفيداً حين وصل قطاره إلى هذه القصيدة، بل كان على العكس معادياً لها، وربما أسهم في وأدها لدى الرأي العام، وبشهادة مثقف كويتي كبير منتصف الثمانينيات من القرن العشرين كان النقد عدائياً إلى حد ما تجاه الشعر الحديث، فقد اتهم الكاتب والمفكر الكويتي الدكتور محمد الرميحي بعضَ النقاد بالعداء للمعاصرة ـ قبل نحو أربعين عاماً ـ فكتب في افتتاحية “كتاب العربي” بعنوان “آراء حول قديمِ الشعر وجديدِه”، 15 أكتوبر 1986: “لقد ظَلم بعضُ النقاد والشعراء الشعرَ العربي عندما قرروا له بشكل قطعي إطاراً خاصاً في الشكل يجب ألا يخرج عنه، ولعل ذلك الموقف ناشيء إما عن قصور في فهم تاريخ الشعر العربي، أو مغالاة في الاحتفاظ بالشكل دون الجوهر، ويجب أن لا ننسى أن النقد الأدبي العربي في بعض كتاباته يعادي المعاصرة”.
وللأسف، تعدّى الأمر العداوةَ إلى الإيذاء، فكل احتفاء بشاعر “تقليدي” على حساب التجريب كان ضربةَ إحباط لبعض شعراء النثر الذين كانوا في وضع المستبعدين(5)، كما كان طعنة نجلاء في صدر الذائقة العامة للشعر، فبحسب الناقد الدكتور سيد عبدالله السيسي في كتابه المهم “ما بعد قصيدة النثر نحو خطاب نقدي جديد للشعرية العربية”(6) فإن الأذى المباشر الذي سببه غياب الجهد النقدي الموازي لقصيدة النثر المصرية والعربية، هو تراجع مستويات الأداء الشعري لدى بعض الشعراء الشباب، يقول السيسي، الذي يعمل استاذاً للأدب والدراسات العربية في جامعة “جورج ميسن” بالولايات المتحدة الأمريكية:
“فكثير من الدواوين الأولى لشعراء شباب كانت تحمل من الغنى والبشارة بالخصوبة الكثير إلا أن غياب الحركة النقدية وتغافلها عن أداء دورها الموازي لهذا الإنجاز الإبداعي جعل كثيراً من الدواوين اللاحقة لبعض الشعراء في تصورنا تتراجع عن المستوى الذي بدا في الدواوين الأولى”. (7)
ثالثاً: ليس النقد هو الذي ساهم في تطور قصيدة النثر، بل ترجمات الشعر العالمي إلى اللغةِ العربية، التي توفَّر لها في بعض الأحيان مترجمون بارعون من شعراء النثر أنفسهم: “أدونيس، سعدي يوسف، بسام حجار، رفعت سلام”، على سبيل المثال، وهو تأثير شهير في تاريخ الشعر بين اللغات، فكثيراً ما أدت ترجمة الشعر الموزون في لغة ما إلى خلخلة أو هدم الثوابت “الوزنية” في شعر اللغات المترجَم إليها، ولا ننسى أن بعض المترجمين العرب كانوا في البداية يترجمون نصوص الشعر الأجنبي على إيقاعات البحور الخليلية كأنه من شعر التفعيلة، وقد فعل ذلك مترجمون كبار مثل الدكتور عبدالغفار مكاوي، لكنه كان مضطراً في كثير من الأحيان إلى تقديم ترجمات نثرية خالصة لكثير من النصوص التي ترجمها.
ظني أن قصيدة النثر عاشت سبعين عاماً من الاستبعاد النقدي وأعتقد أنها ربما استفادت واستمتعت بطاقاتها التجريبية الهائلة في غيبة من التنظيرات النقدية وبعيداً عن أي سلطة معرفية، الأمر الذي يجعلنا نظن أن طموحات الشعراء وإحساسهم العميق بالحرية هو الذي قاد إلى كل الفتوحات التي قدمتها “قصيدة النثر”، حتى أصبحت تصنَّف كذروة التجريب في الشعر العربي الآن، لكن واقع الأمر هو أن النقاد والمؤسسات لم يلعبوا الأدوار المطلوبةَ منهم لترقيةِ أذواق الجمهور العام وتعريفِه الأسسَ الجمالية والمعرفية للنص الجديد، وهو أمر ينقلنا مباشرةً إلى سؤالكم الثاني:
هل يناقض شاعرُ القصيدة الحديثة نفسَه عندما يشتكي من قلة المقروئية، وينّظر في خصوصية القصيدة الحديثة ونخبويتها وأنها فن القلة؟
هذا سؤال لن أجيب عليه، ولدي في ذلك كثيرٌ من الأسباب:
1 ـ لأنه يحمِّل الشاعر العربي الجديد وحده مسئولية المقروئية، وهو أمر غير واقعي، لأن ضعف المقروئية ظاهرة تتحمل مسئوليتها في الحقيقة العديد من المؤسسات الثقافية والتعليمية المعنية بالشعر، والأجيال السابقة التي كتبت أو “ابتذلت” الشعر، كما تتحمل مسئوليتها الأوساط الأكاديمية، لأنها ـ دون غيرها ـ التي تقاعست عن أداء دورها في الارتقاء بأذواق الأجيال الجديدة، وتعامت متعمِّدة عن تقديم معارف جادة حول الشعر الجديد، بما فرضته على أنشطتها الإعلامية والثقافية والتعليمية من تسييد نمط الشعر التقليدي، وأعتقد أن هذه المؤسسات باتت اليوم مُلزمة بالاعتراف بقصيدة النثر والتعريف بها، تكفيراً عن عقود من التجاهل والعداء والإساءة إلى هذا الفن الشعري، الذي أصبح اليوم ـ ورغم كل هذا الحصار ـ ذروة التجريب في الشعر العربي.
2 ـ لأن هذا السؤال يتجاهل حقيقة أن الشعر سواء كان نثرياً أو منظوماً أصبح اليوم فنَ القلة أو قل هو فن النخبة، ليس في الوطن العربي فقط بل في كل بلاد العالم، في مواجهة “الرواية” الأكثر رواجاً، لكن السخرية والمعايرة لم توجّه إلا إلى شاعر النثر العربي، الذي ـ ياللغرابة ـ لم يُعترَف بشعرِه ولا بقصيدته أصلاً على مدار أكثر من نصف قرن (8)، وها نحن نمنعه من الحديث في بعض الموضوعات، مثل “نخبوية الشعر”، من دون أن نسأل أنفسنا وما العيب في أن ينظّر الشاعر حول الشعر وكونه فن القلة، أليس هذا ـ بالضبط ـ من صميم عمله، ألا يتحدث الشاعر هنا في موضوعٍ يخصه وهو الأجدرُ بالحديثِ فيه؟
3 ـ لأن سؤالكم يتجاهل حقيقتين حول قصيدة النثر العربية:
ـ أنها قبل أن تكون محاولة لهدم القيم الشعرية المستقرة والثابتة والموروثة ولتحطيم “الأناشيدية” في الشعر فهي محاولة لبناء موقفٍ من العالم ومن القيم الاجتماعية والفلسفية السائدة، ولذلك كثيراً ما تم الربط بينها وبين الثورات أو التغيرات الاجتماعية الكبرى، مثل الربط بين آرثر رامبو و”كوميونة باريس” 1871، والربط بين انتشار قصيدة النثر وقصيدة الشعر الحر منتصفَ القرن العشرين في توقيت ازدياد الغليان بعد هزيمة الجيوش العربية في فلسطين 1948، وتزايد حركات الاحتجاج للمطالبة باستقلال البلاد العربية عن سلطات الاحتلال الأجنبي.
ـ أنها أول فن شعري ذي أصلٍ كتابي في الثقافة العربية، أولُ قصيدة شعرٍ وُلدت وقُرأت ونُقدت كنصٍ مطبوع، لها إيقاعها الخاص بين الكلمات وقد قال أوسكار وايلد ذات مرة:“تغريدة البلبل قصيدةٌ موزونة لكن أغنية البجع هي قصيدة نثر”، وحاول بودلير تعريفها بقوله: “قطعة بلا رأس ولا ذيل” أو “ميدالية من اللحم” كما قال أحد الشعراء الأوربيين، أما الشاعر الأمريكي جيمس ريتشاردسون فوصفها بتعبير لطيف: “قصيدة النثر مثل الطماطم، قد تكون فاكهةً لدى التصنيف النباتي، مع أنها خضروات لو قمت بتحضير السلاطة”. (9)
يناير 2025
إشارات:
* شهادة مهرجان “القرين” الثقافي بالكويت ضمن محور “جدلية النقد والنص الإبداعي” فبرلير 2025
1ـ الإشارة هنا واجبة إلى عملٍ شعري مبكر للكاتب والمفكر المصري الراحل لويس عوض (1915 – 1990) هو ديوان “بلوتولاند” الصادر العام 1947، تضمن شعراً تفعيلياً وقصائد نثر وأثار كثيراً من الجدل، لأنه طالب في مقدمته صراحةً بتحطيم عمود الشعر العربي، بما يجعل البعض يعتبر عقد الأربعينيات من القرن العشرين زمن انطلاق قصيدة النثر لا عقد الخمسينيات، بل إن الدكتور شريف رزق لفت إلى انبثاقة أولى عرفتها قصيدة النثر ـ قبل عقد الأربعينيات ـ في فضاء الثورة الرومانسية التي ارتادها أمين الريحاني وجبران خليل جبران. انظر “آفاق الشعرية العربية الجديدة في قصيدة النثر”، شريف رزق، القاهرة ـ طبعة 2012 ـ دار الحضارة العربية.
2 ـ مقدمة “ديوان إلى الأبد قصيدة النثر / أنطولوجيا عالمية” عبدالقادر الجنابي، دار التنوير ـ لبنان ـ الطبعة الأولى 2015
3 ـ يُمكن الاطلاع على طائفة من هذه اللعنات ـ على سبيل المثال ـ في مقال للشاعرة نازك الملائكة، العدد الرابع سنة 1961 من مجلة “الآداب” البيروتية، تحت عنوان “من قضايا الشعر المعاصر قصيدة النثر”. (متاح ألكترونياً)
4 ـ يلخّص الأكاديمي والمترجم المرموق الراحل الدكتور عبدالغفار مكاوي التغير في التعبير الشعري خلال القرنين 19 والعشرين قائلاً: “نظرة الإنسان إلى الطبيعة والله قد تغيرت كما تغيرت نظرته إلى نفسه وإلى المجتمع البشري خلال القرنين الأخيرين تغيرات كبيرة بصحبة ثوراته الصناعية والاجتماعية والدينية والعقلية أو تأثرت بها ونتجت عنها وانعكست بالضرورة على وجدانه الفني، وظهرت في تعبيره الشعري فيما يمكن أن نسميه بثورة الشعر الحديث أو ثوراته المتعددة” انظر”ثورة الشعر الحديث” عبدالغفار مكاوي، الطبعة الأولى الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1972.
5 ـ تم استبعاد شعراء النثر في مصر من كل أنشطة وجوائز واحتفالات وزارة الثقافة المصرية حتى العام 2011، لدرجة أنهم أقاموا على نفقتهم مؤتمرات شعرية لافتة بعيداً عن مؤسسات الثقافة الرسمية، لكنهم لاحقاً أصبحوا الصوت الشعري الأبرز على الساحة.
6 ـ“ما بعد قصيدة النثر نحو خطاب نقدي جديد للشعرية العربية”، الدكتور سيد عبدالله السيسي ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ الطبعة الثانية ـ القاهرة 2022. الطبعة الأولى ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ لبنان 2016
7ـ الناقد المغربي رشيد يحياوي ـ مثلاً ـ كان يعتقد أن “نظريات النوع الأدبي” جعلت المتلقي مستهلكاً سلبياً توجّهه كما تشاء، لأنها لا تهدف إلى إرهاف حاسة التلقي لديه وتدريبها وتطويرها لتلقي أي تغيير جزئي أو كُلي يطرأ على النوع الأدبي، ويظل العقد المُبرم بين الكاتب والقاريء مقدساً لا يجوز الطعن عليه”، انظر “مقدمة في نظريات النوع الأدبي”، أفريقيا الشرق ـ الدار البيضاء ـ المغرب 1991
8 ـ أول ديوان قصيدة نثر يحصل على “جائزة الدولة التشجيعية” في مصر كان ديوان “الجحيم” للشاعر محمد أبوزيد وذلك في العام 2020.
9 ـ من مقدمة ديفيد ليمان لكتابه “قصيدة النثر الأمريكية” ترجمة: محمد عيد إبراهيم، “دار خطوط وظلال” ـ عمان، الأردن ـ الطبعة الأولى 2021.