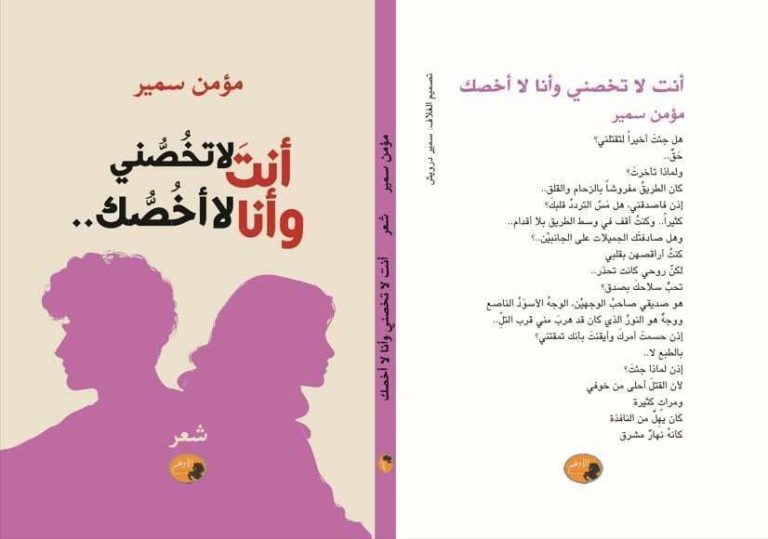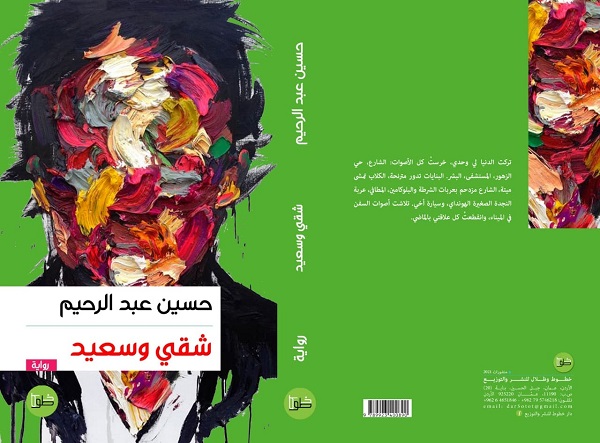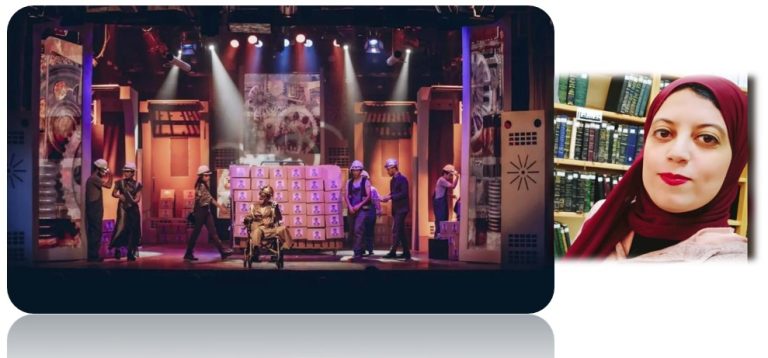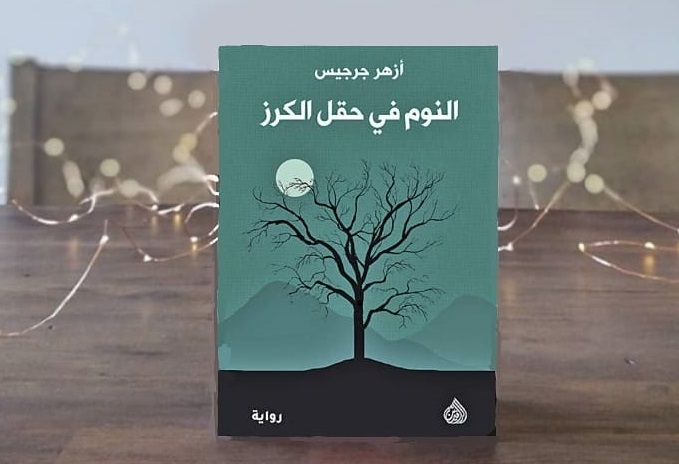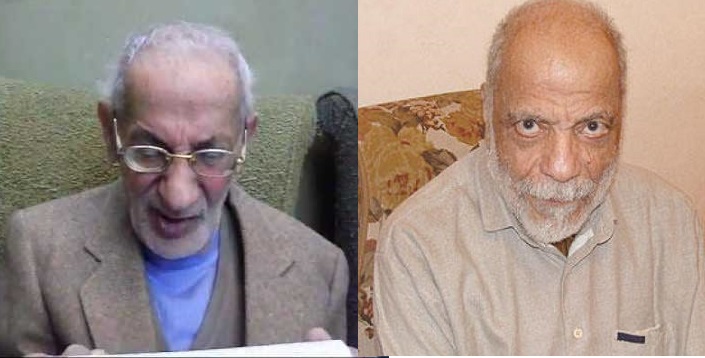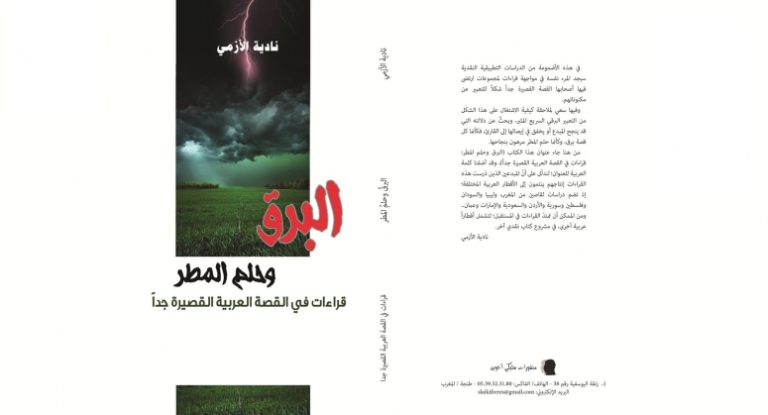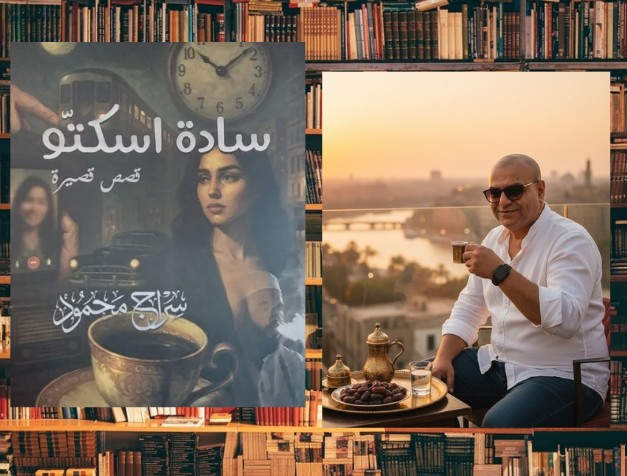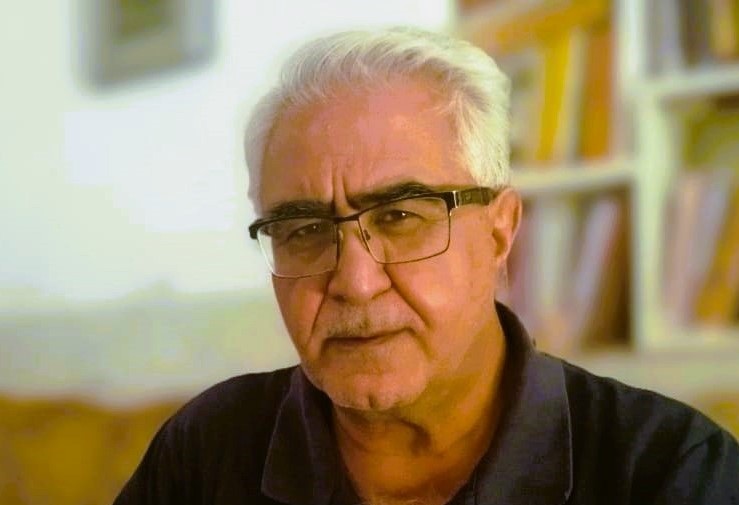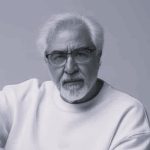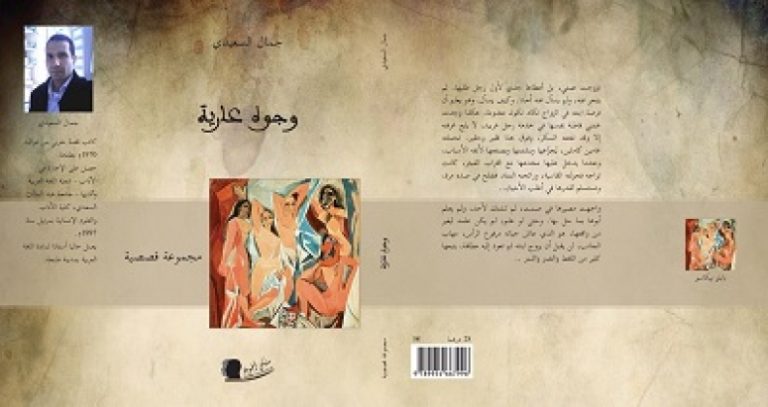د. زينب العسال
يحتل أشرف الصباغ موضعًا لا تخطئه العين بين المبدعين ممن نطلق عليهم تسمية جيل الثمانينيات، وهو جيل قد تشكلت معظم ملامحه، ولم يبق إلا الإضاءات النقدية التي لا تعدو للأسف- بالنسبة لحياتنا الإبداعية بعامة نقاط ضوء متناثرة، يصعب أن تشكل الصورة بكل ما تنطوي عليه من تكوينات وألوان وظلال.
لقد استطاع أشرف الصباغ في قصصه القصيرة- وهي قليلة نسبيا- أن يمثل صوتًا يحاول التعبير عن الذات القصصية، فقد توزع منذ صباه- بين العمل والدراسة حتى انتهى به إصراره إلى الحصول على درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة موسكو.
يرى أرسطو أن الأحلام مجرد بقايا أو مخلفات من الانطباعات الحسية العريضية وكأنها الدوامات التي نراها في الأنهار، والتي يكون لها نمط لا يتغير ومع ذلك فقد تغيرت إلى أشكال جديدة بفعل ما تواجهه من بعض العوائق!
“قصيدة سرمدية في حانة يزيد بن معاوية” المجموعة القصصية الأولى للأديب أشرف الصباغ تضم اثنتي عشرة قصة هي “قصيدة سرمدية في حانة يزيد بن معاوية، أنا وهي ويوسف، بهلول في بلد الجحوش، ملخص ما نشر عن سلمى، جاري البحث والتحري، تفاصيل قاهرية، موت البرتقال في سبع قصص قصيرة، اللعنة، طائر غريب”.
“قالوا: بالسر إن باحوا تُباحُ دماؤهم”. البوح في الحقيقة يقابله القتل والفناء، وثمة بوح آخر لا يسلمنا للموت، وإنما هو حياة أخرى، إنه بوح الحلم.
البوح ينازعه الصمت محاولاً انتزاع مكانه، عله يغير الواقع المأزوم ليعادل بذلك في غالبية القصص الحلم مستترا حينًا، أو معلنًا عن نفسه أحيانًا.
ولنتناول- على سبيل المثال- قصتين من قصص المجموعة تمثلان حالتين من حالات الحلم.
“في قصيدة سرمدية” تغيب الأسماء فلا يهم تحديد الشخصيات، فهناك العمة والجد والصغير، وهذا الغريب القادم للقرية، وهناك وعى تام من القاص أشرف الصباغ في إطلاق لفظ “عفريت” بما يتلاءم مع الملامح المنقوشة بإزميل خرافي”.
فالشخصية تنتمي إلى عالم آخر، عالم القدرة والمعرفة، عالم يتمتع بأشياء قد يعجز الإنسان عن الإتيان بها. لفظ “عفريت” يستدعي بالضرورة الميراث اللغوي، فالعفريت من العفر بالسكون والتحريك الظاهر التراب، الجمع بين السكون والحركة يتواءم تمامًا مع ما أعلنه القاص في تقديمه للمجموعة، والتحرك السريع يجعلنا نستحضر الآية الكريمة: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك”.
الحلم هنا ما هو إلا قشرة يزيلها القاص حينما يريد معبرًا عن سرد يتسم بالإطالة، خاصة الحديث عن طفولة الراوي.. فيكون أمامنا الكتاب والمئذنة، ليرنو إلى رؤية الحاضر نافياً عنها الإيجابية مستحضراً شخصية أبي ذر بكل ما تحمله من مواقف، والروح تتشظى رغم أنها صارت قصيدة على لسان الطير، ويصير الراوي هو المروي عنه شاهدا على أحداث وعصور ولت، معلنة عن وجود حقيقي للحلم. فعالم القرية هنا يتشكل في ذاكرة الراوي العالم كله “أرى معاوية يفر، والآخر يكشف عن عورته الخلفية بمحض إرادته، ويزيد يسكر حتى مطلع الفجر، فأتقلد سيفي وأضرب”.
النص يستحضر شخصيات تاريخية.. معاوية ويزيد والحجاج والحاكم أمام الحسين والمسيح وأبي ذر وأبي حيان والسهروردي ممن أدانهم التاريخ أمام من قدموا حياتهم فداء لخلاص البشرية. ومع تعدد الرموز تتعدد الدلالات، فهل كل هذا أحدثه الغريب؟ وهل التصق الراوي بجلد الغريب فصارا جسدا واحدا؟
هل هو إنسان حقيقي أم حاله كونية استشعرها الراوي؟ هل أراد تقديم ملامح “مخلص” من الشرور والآثام، يوازي- فيما فعل- الحسين والغفاري!
يقول الشاعر السويسري كارل شتبلر: الأحلام لا يمكن أن تحكى، ذلك أنها تتحلل عندما يحاول الذهن العقلاني أن يمسك بها في كلمات، لكن ثمة كسر لهذه المقولة في القصة، فالتفاصيل الدقيقة تأتى في سياق الواقع، وتشكل الحلم وتعلن عن ذاتها، فالولد يذهب للكتاب ويعاقب من معلمه، “سيدنا يدق سافودًا يوميا في أعماق روحي”.
الشخصيات تقدم من خلال السرد والوصف أو مزج الوصف بالسرد، لنصل إلى حالة تصاعدية مستمرة تنطلق من الأفراد إلى حركة القرية كمجتمع.
“لم نفكر يوما في تحطيم الأصنام في نفوسهم” (ص 17) أهل قريتنا يبصرون بالمال والقلوب الصدئة، الصمت يؤرقهم، إنه صمت ما قبل الفعل، لكنه أبدا لا يكون صمت موافقة وتلقي، أما حصافتهم فهي كالعهن المنفوش. كلامهم حماقات لا تنطلي على الصغار، يهزون رؤوسهم ولا يؤمنون “الصغار يبحثون عن الحرية، فيكسرون هالة الكذب التي صنعها الكبار”.
“أعجبتهم حكاياك فالتفوا حولك في الأمسيات المترعة بسحر صوتك”، هل انتصر الحكي على المعرفة المستبدة (ص 20). هذا سؤال تطرحه القصة- لكن يعقب ذلك فقرة مليئة بالتعبيرات الصوفية تهيمن على النص. “الوحدة تؤرقك وفطنة الطبيعة العفية لا تسعفك. ومهما تعدى العشق حدود الصمت وانكشف الستر عن الحرف، فالقيد إشارة في بحر الوصل، وعاجلا أو آجلا سيتساوى الحد الفاصل بين النطق وبين الصمت”. إن تجاوز هذا الخطاب الصوفي مع عبارة “طقوس أهل قريتنا عمياء مثلهم، وأخبث من ادعاءات الكواكب الإحدى عشر، وأمر من أنياب الذئب الذي التهم الثاني عشر وأنت الثالث عشر”.. يضعنا أمام إشكالية التركيب الأسلوبي الذي اتكأ على الموروثات والحوادث التاريخية. وقد استهوت أشرف الصباغ هذه الإجادة، فقدم هذه القصة معلنًا عن قدرته على هضم العديد من القراءات، لتخرج قصته بهذا الأسلوب، تطرح أسئلة لا تأتي مباشرة وثقيلة على النفس، بل تُغلَّف في ثوب من المقابلة والمفارقة والعبثية أحيانًا.، من خلال حركة السرد المستمر التي قد يقطعها حوار قصير.
وفي قصة الآخر والمهداة إلى روح إبراهيم فهمى، تبدأ القصة برصد علاقة حيادية يطلق عليها في القصة “علاقة تحاشي”: “كنت دائماً أحاول أن أبدو محايدًا وموضوعيًا عندما أتحدث عنه، بل كنت أنتقى الألفاظ والكلمات والجمل بحذر شديد”. المكان في القصة يعلن عن تأثيره في تحديد العلاقات بين شخصيات القصة. فهناك.. شبرا، المغربلين، الدرب الأحمر، المقطم، الزمالك، سليمان باشا.. يغيب وصف هذه الأماكن بالتحديد وإعطاء ملامح مكانية تميزها عن بعضها.. إلا أن الراوي وهو القاص ذاته- المغترب في موسكو- والذي كان يحيا حياة الأدباء ويتردد على أماكن تجمعهم، حيد المكان لصالح الوصف وحركة القص ليبرز من البداية مفارقة بين عالمين يعيش داخلهما الراوي، عالم أتى منه، وآخر يعبره ليصل إلى البار. أطلق على الأول الخراب الجميل أما الثاني فيمثله بشر يتحركون في نشاط وحيوية، بيع وشراء “يتمان في هدوء بدون مساومة أو وجع قلب”.. إنه أيضًا بيع لكنه– قطعًا الثاني- يختلف عن بيع الجسد…
هذا هو منطق القصة، صراع بين عالمين خفي ومعلن وبينهما يقع تجمع الأدباء، المقهى والبار وتسيطر شخصيات بعينها: الحاج مرقس والمعلم عطية وسيد، شخصيات تمارس قمعًا خفيفًا هو الآخر قمع المقهور. فهي شخصيات تطالب الأدباء بدفع ثمن ما يشربونه أو يأكلونه. القصة تقترب من كتابة الذات متوارية خلف حدث يفترض أننا جميعا نعرفه، مـــوت إبراهيم فهمي، موت إنسان بسيط عاني الفقر والضياع، لتصير الذات كلا جمعيا، وتتجه بالإدانة إلى المجتمع ككل، ومجتمع الأدباء خاصة، لتفتح ذواتنا أمام مرآة قام واحد منا بكسرها نيابة عنا، فلا فائدة من لملمة تشظي الذات لأننا لم نعـــد- كما تبين القصة- في الحلم والمراوغة.
…………………
.نشر هذا المقال في مجلة “أدب ونقد”، يونيو 1997. ثم نشر في كتاب للمؤلفة بعنوان “تقاسيم نقدية”