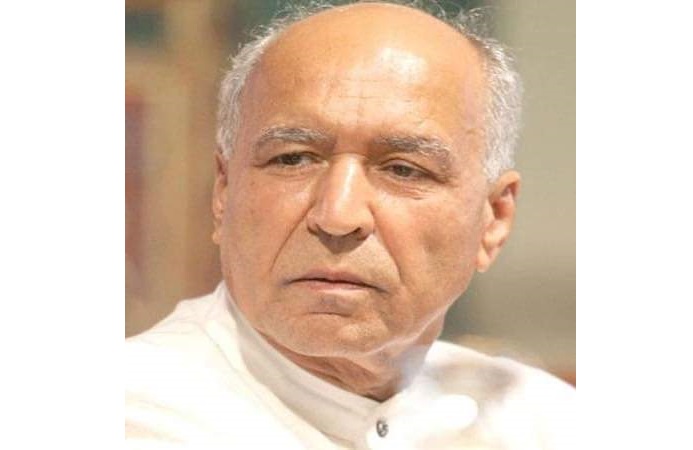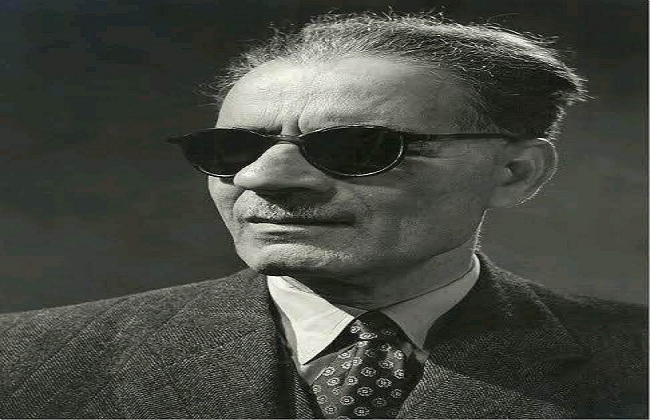إطلالات تربويّة من شبابيك الوطن – 11
قصص الرّعب في المدارس والبيوت!
د. إلياس زيدان
سندخل في هذه الإطلالة في دهاليز رعب الأطفال من القصص والزواجر الدّينيّة، كما هي حال الطّفلة البيروتيّة عنبرة سلام الخالدي (1897-1986) الّتي تؤكّد: “الامر الذي لا ازال اذكر وقعه في نفسي هي قساوة أسلوب الترهيب الذي كان استاذنا الشيخ يبالغ فيه […][1]، وقصص العفاريت والجان والشّياطين (وغيرها) التي رواها لهم الكبار، تلك القصص الّتي يؤكّد في خصوصها الطّفل القاهريّ إبراهيم المازني (1890-1949) أنّه: “يقف لها شعر الرأس ويتقبض الجلد […]”.[2] لفتَ انتباهي أنّ هذا الموضوع، بأحداثه ومشاهده المروّعة، هو من أكثر المواضيع شيوعًا في السّير والمذكّرات، وقد عانى منه أطفالنا، كتّاب السِّيَر والمذكّرات من الذّكور والإناث على مرّ أجيال، ومن أقطار مختلفة من الوطن الكبير، ومن مختلف الطّبقات الاجتماعيّة والدّيانات والملل. بعض هؤلاء استطرد في وصف المشاهد، كما فعلت الطّفلة القاهريّة رضوى عاشور (1946-2014) الّتي تؤكّد في سيرتها “أثقلُ من رضوى”: “ولن يضير هنا استطراد آخر لمشهد ظل طافيًا بين آلاف المشاهد التي انطمرت في حيِّز ما من الذاكرة غير الموعيّ بها”.[3] ستروي لنا رضوى المشهد بتفاصيله لاحقًا. لم ينجُ من هذا الرّعب حتّى الطّفل المرّاكشيّ عبد المجيد بن جلون (1919-1981)، فرغم أنّ أسرته قد انتقلت من الوطن الأمّ مرّاكش إلى إنجلترا ولمّا يبلغ السّنة من العمر، ورغم أنّ ذاكرة طفولته الأولى تعود به إلى مدينة مانشستر الإنجليزيّة الّتي عاش فيها مع أسرته ومربّيته، إلّا أنّ ألسنة النّار، نار الجحيم، لاحقته إلى هناك. على غرار الطّفلة رضوى، كان الطّفل عبد المجيد من المستطرِدين في وصف المشاهد. صبرًا، فسوف نعود إلى عبد المجيد لكي يصف لنا مشهد النّار بإسهاب.
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ الّذين أدخلوا هؤلاء الأطفال في أجواء الرّعب كانوا من المعلّمين والمعلّمات والأهالي – الجدّات والأمّهات والآباء والإخوة والأخوات الأكبر سنًّا والأقرباء – والجيران والمربّيات والخَدَم. تؤكّد عنبرة سلام الخالدي في هذا الخصوص: “والغريب ان الكثيرين ممن كانوا يعدّون على درجة من العلم أو التديُّن كانوا يروون احاديث، يثبتونها بالشواهد والبراهين، عن حضور الجن”.[4] وكيف يكون ذلك؟! لماذا يقوم الأهل بأفعال كهذه تُدخل هؤلاء الأطفال في كوابيس تحرمهم من النّوم ساعات طوالًا في الليالي، وحين يفلح الأطفال في الخلود إلى النّوم بعد جهد جهيد، يزورهم العفاريت والجانّ في أحلامهم/نّ، فتقضّ مضاجعهم/نّ من جديد؟! ولماذا يجعل الأهالي بعض هؤلاء الأطفال يخافون من تخطّي عتبة البيت، أو صعود درج الدّار أو نزوله في المساءات؟! لماذا؟! لماذا؟! ولماذا يقترف هؤلاء الكبار “الجُرم” تلو “الجُرم” في حقّ أعزّ النّاس إلى قلوبهم، فلذّات أكبادهم/نّ وأقاربهم/نّ وطلبتهم/نّ وجيرانهم/نّ؟! سنكتفي هنا بإجابتين على لسان طفلة وطفل من هؤلاء الأطفال، وبعض الإجابات الأخرى قد تأتينا في سياق حديث الأطفال عن تجاربهم/نّ ووصفهم/نّ لمشاهد الذّعر والكوابيس. تكتب المصريّة هدى شعراوي (1879-1947) في “مذكّرات هدى شعراوي”: “كان الأهل يخفون عن الأطفال كل الحوادث والأحداث المحيطة بهم، فإذا مات أحد أفراد الأسرة، قيل للطفل: إنّه سافر، وإذا أراد أن يسأل عن حقيقة من حقائق الحياة أجابوه بخرافات لا تروي ظمأه لمعرفة الحقيقة […] التي تؤثر في العقول الصغيرة الساذجة”.[5] أمّا الطّفل سلمان العودة (1956-)، ابن قرية البصر السّعوديّة، فيكتب في ” طفولة قلب”: “أهداف نبيلة، ووسائل مغرقة في الخطأ!”، [6] وهو يتحدّث هنا عن “قصص السعالي والجن والعفاريت، والقطط السود المسكونة، والأقراص الحامية والصواعق التي تهدد بها الأمهات صبيانها، فهي تنزل من السماء على رأس من يكذب أو يخالف كلام والديه!”.[7] إذًا، نوايا الكبار حسنة في معظم الأحيان، وقد تكون من باب “حماية” الطّفل والرّفق بمشاعره حينًا، أو من باب الظنّ بأنّه لن يستطيع فهم حدث جلل كالموت والتّعامل معه، حينًا آخر. وقد تكون الأسباب تربويّة تأديبيّة، من وجهة نظر هؤلاء الكبار، لغرض دفع الأطفال إلى القيام بسلوك ما أو الامتناع عنه. إلّا أنّ نتائج سلوك الكبار في الحالات المذكورة، وفي الحالات والمشاهد الّتي سنأتي على وصفها لاحقًا، وخيمة على قلب الطّفل ومشاعره وفكره وسلوكه. ويؤكّد سلمان العودة في هذا السّياق: “إنه تهديد يرتعد له قلب الطفل حين يتخيل عقله الطفولي أنه مستهدف بهذا الجرم الهائل الحارق”.[8]
كأنّي بالطّفل نقولا زيَادة (1907-2006) يغبط أخته هدى شعراوي حين روى لها الكبار أنّ من مات قد سافر! في العام 1915 توفّي قسطنطين أخو نقولا. يصف نقولا المشهد بقوله: “أذكر أنه حُملَ من البيت، وأذكر أن الفرشة التي ينام عليها، وكنا نتقاسم غرفة واحدة، لفت على نفسها على التخت. ولما لم يرجع قسطنطين من رحلته استغربت ذلك”.[9] وماذا روت الأمّ للطّفل نقولا ابن الثامنة عن غياب أخيه؟ يقول نقولا: “وكانت أمي قد قالت إنه ذهب إلى المدرسة”.[10] كان نقولا يكبر قسطنطين في السّنّ وعليه لم يجد تفسيرًا لتساؤله: “أما لماذا يذهب هو إلى المدرسة وهو الأصغر ولا أذهب أنا، فلم يفسره لي أحد”.[11] ويشاركنا نقولا نحن القرّاء متسائلًا: “وهل يتصور القارئ ما الذي شعرت به، بل وخفت منه، لما جاء الوقت للذهاب إلى المدرسة”.[12] ويجيب هذا الطّفل قائلًا: “خشيت أن لا أعود، وقد بكيت كثيراً”.[13]
ما دمنا في سيرة الموت فإنّ للطّفل عبد المجيد بن جلون ذكرى قاسية معه. يكتب في سيرته “في الطفولة” أنّه عندما توفّت جارتهم في منشستر مسز باترنوس الّتي كان يعزّها ويلعب مع أولادها ويقضي معهم الأوقات الممتعة في بيتهم، سأل مربّيته الّتي كان يدعوها “ماما” عن سبب بكاء آل باترنوس، فأجابته أنّ مسز باترنوس “سافرت وسوف لا ترجع أبدا، فلا تستغرب إذا أنت زرتهم ولم تجدها. سافرت إلى بلاد بعيدة، لا يرجع منها من سافر إليها. ثم قالت وكأن الكلمة قد أفلتت منها: ماتت يا بني”.[14] استمرّ الطّفل في السّؤال: “ماذا يعني ماتت؟”.[15] فأجابته: “ذهبت عند الله”.[16] واصل عبد المجيد مستفسرًا: “ومن هو الله؟”.[17] وفي هذا اللحظة ما كان من مربّيته إلّا أن “همست بنزعتها الدينية: اسكت. ثم بعد هنيهة اردفت: وحينما نجلس في المساء إلى المدفأة سأحدثك عنه”.[18] وليت ذلك المساء لم يأتِ وليت المدفأة لم تكن تشتعل النّار فيها، رأفةً بعقل وقلب ذلك الطّفل المستفسِر البريء! لا بدّ للمساء أن يأتي! يؤكّد عبد المجيد: “سألتها دون مقدمة: لماذا لا يرجع من يسافر إلى الله؟”. وكان جوابها: “لأنه لا يستطيع الرجوع”.[19] لم يكتفِ الطّفل بهذه الإجابة، وألحّ سائلًا: “ولماذا يسافر؟”.[20] هنا حدث ما لا تحمد عقباه. يصف عبد المجيد المشهد بقوله: “قالت وقد انعكس على محياها ضوء اللهب الأحمر، وبدت تقاطيع وجهها الحادة كأنها تمثل صرامة القدر، وكانت معانيها تتسرب إلى نفسي مجردة فيخيل إلي أن صوتها يأخذني من كل مكان: هناك عالم آخر يا بني خفي عن الأنظار، ونحن نقضي في هذا العالم عمرنا ثم نموت فيدفن جسمنا في الأرض وتنتقل روحنا إلى ذلك العالم الآخر. ويخلقنا الله حتى إذا متنا حاسبنا على الأعمال التي نقوم بها. فإذا كنا أخيارا أرسلنا إلى الجنة حيث نعيش دائما في سعادة، وإذا كنا أشرارا أرسلنا إلى نار نحترق فيها، ولذلك فلا بد من أن تحاسب نفسك وان لا تقوم بالأعمال التي لا يحبها الله، حتى لا يحكم عليك بالاحتراق حينما تموت”.[21] وهنا يجزم عبد المجيد: “لست اذكر ان حديثا أثار نفسي مثل هذا الحديث، فقد كانت كل كلمة من كلماته تهزني هزا عنيفا، ولم أفكر في الجنة ولا في السعادة الموعودة وانما فكرت في النار، وكنت انظر إليها بعينين ضارعتين متوسلتين كما لو كان في استطاعتها أن تنقذني من هذا المصير المروع الذي ينتظرني”.[22] وكان على الطّفل أن يتأكّد ممّا تقوله مربّيته، فسألها: “وهل سأموت أنا أيضا يا ماما؟”.[23] “طمأنته” قائلةً: “أنت وأنا وكل من في الدنيا”.[24] وكان عليه أن يتأكّد من مصيره، فشدّد بسؤاله الاستنكاريّ: “ولكن الله لن يبعثني أنا إلى النار؟”.[25] وكان جوابها صريحًا: “إذا فعلت الخير”.[26] واستمرّ الطّفل المرعوب في الاستيضاح: “وإذا فعلت الشر فسيأتي أبي وتأتي أمي وأنت فلا تدعونه يرسلني إلى هذه النار. أليس كذلك يا ماما؟”.[27] وجاء جوابها قاطعًا: “لا يتدخل أحد في شؤون الآخر هناك يا بني”.[28] يصف الطّفل عبد المجيد شعوره وفكره وخياله في تلك اللحظات كما يلي: “شعرت بيأس رهيب يتملكني، وكانت عيناي مثبتتين في اللهب المضطرم الراقص أمامي، وخيل أن ألسنته تتطاول لتلتهمني، وكان تفكيري مركزا في النار حتى أنني كنت أحس بروحي تصرخ بين ألسنتها”.[29] ويستطرد الطّفل واصفًا حالته خلال موته وبعده: “يا لليأس! لا مفر من أن أموت في يوم من الأيام، فيلقى جسمي في التراب المظلم ويظل هناك إلى الأبد يصرخ ويبكي، وتلقى روحي في النار وتظل هناك تصرخ وتبكي إلى الأبد أيضا، فلا اظفر بمساعدة أبي ولا أمي كما أظفر بها في الدنيا، ولا يأتي لإنقاذي أحد”.[30] وهل من نتائج وأبعاد إضافيّة؟! بالتّأكيد! يستطرد الطّفل عبد المجيد: “منذ ذلك اليوم اقتطع من نومي جزء ليس بالقليل، وعجت أحلامي في النوم واليقظة بصور مرعدة مبرقة. كنت أتمنى من صميم قلبي ان أجد شخصا يقول لي أن هذا غير صحيح، فلم أجده، وكان كل واحد يروي نفس الخبر ويختمه بدعوتي إلى عمل الخير، الأمر الذي ضايقني”.[31] ويخلص أخيرًا إلى سؤاله الاستنكاريّ: “فكيف أستطيع أن أفكر في الخير وأنا مهدد بكل هذا الويل والثبور”.[32]
نعود إلى الطّفلة عنبرة سلام الخالدي التي كانت معاناتها من زواجر الدّين الّتي شدّد عليها أستاذهم الشيخ مشابهة لمعاناة أخيها عبد المجيد بن جلّون، فتؤكّد أنّ معلّمهم الشّيخ كان “يصف عذاب يوم القيامة لمخالفي أوامر الشرع وما ينتظرهم من نار موقدة، ويصور ذلك باسهاب دقيق، حتى كانت تلك الصور تأخذ عليّ احلامي وتقلق منامي. ومع انه كان هنالك ذكر للثواب واوصاف جنات النعيم، ولكن العقاب وصوره المتعددة كانت تفوق كل ما عداها”.[33]
من ذعر الجنّة والنّار ننتقل إلى ذعر قابيل قاتل أخيه، ذعره هو، وذعر الطّفلة القاهريّة رضوى عاشور وأبناء صفّها. تعلّمت الطّفلة رضوى في إحدى المدارس الفرنسيّة – الليسيه فرانسيه – في القاهرة. كان على رضوى وأبناء صفّها حفظ قصيدة “الضمير” لفكتور هوغو عن ظهر قلب. تؤكّد رضوى: “تتناول القصيدة شعور قابيل بالذنب لقتل أخيه، تتّبع حركته مع أسرته، عبر الشعر الموزون المُقَفّى، وهو يحاول الهرب من عين كبيرة تلاحقه. يركض قابيل شاحب الوجه معقود اللسان ويرتجف. يرحل إلى حدود البسيطة […] يسكن قلعةً لها أبراج مشيّدة […] يحفر له أولاده ومناصروه قبرًا عميقًا يدفن نفسه فيه. ولكن العين كانت دائمًا تحدّق فيه وتملؤه بالهلع”.[34] وتخاطبنا رضوى نحن القرّاء قائلةً بمرارة: “تصوّروا أيها القراء الكرام وقع هذه القصيدة على أطفال لم يبلغوا الثامنة أو التاسعة من أعمارهم”.[35] كانت رضوى وأبناء صفّها “محظوظين” بعض الشّيء في أن تعلّموا القصيدة بالّلغة الفرنسيّة لا بلغتهم الأمّ العربيّة. وتقول في هذا الشّأن: “أحمد الله أن معرفتنا بالفرنسية كانت تحول دون وصول كامل شحنة الفزع المرسومة في القصيدة”.[36] وتضيف: “لم تكن القصيدة وأجواؤها الكابوسية هي المشهد، بل زميلتنا جُويْس”.[37] إليكم/نّ المشهد كما وصفته رضوى: “نادت المدرّسة. قامت جويس. تقدّمت إلى المنصّة الخشبية حيث مكتب المُدَرِّسة. استدارت لتواجهنا وبدأت في إلقاء القصيدة”.[38] ثمّ تصف “لغة جسد” جويس قائلة: “ركبتاها تصطكّان، ويهتز جزعها خفيفاً للأمام والخلف بشكل آليّ”.[39] ثمّ تتساءل في تلك اللحظات: “هل ترتجف زميلتنا من أجواء القصيدة أم من وقفتها أمام المُدَرِّسة، أم كان الاهتزاز مواكبةً عصبية ما لإيقاعات القصيدة ومثانيها (لكل بيتين ذات القافية)؟”.[40] وتجيب: “لا أدري. كل ما أذكره أن وقفة جويس أصابتنا جميعًا بالذعر، صار ذعرًا على ذعر لأن أحدًا منا لم يتح له الإفصاح عنه”.[41] لم ينتهِ المشهد بعد، فتضيف رضوى: “صرنا على يقين أن أيًا منا لن يتمكن من الوقوف لإلقاء القصيدة حتى وإن كان حفظها عن ظهر قلب، وربما أسمعها في الليلة السابقة لأمه أو أبيه، سواء كان يعرف الفرنسية أو لا يعرفها. لا أذكر على من نادت المُدَرِّسة بعد جويس، لإلقاء القصيدة. ولكنني متأكدة أنني عشت رعب اللحظة، وأن المُدَرِّسة لم تنادِني”.[42]
ولأنّنا لا نزال في القاهرة فسوف نزور فيها أخًا في الذّعر لرضوى يكبرها بستٍّ وخمسين سنة. يروي الطّفل إبراهيم المازني في “قصّة حياة” أنّه كانت تعمل لديهم خادمة وكانت لها بنت في مثل سنّه. كان إبراهيم يتوق إلى اللعب مع هذه الطّفلة ولكنّه يؤكّد: “كان شر ما يمكن أن يعاب الواحد منا نحن الصبيان، أن يراه أحد واقفًا يحدث بنتا أو يلاعبها. يا حفيظ! ولد يلعب مع بنت… هذا إثم كبير ومعصية توصد من دونها أبواب الغفران، فإنه عيب وسوء أدب وقلة حياء وفساد تربية”.[43] وكانت أسرة الطّفل والخادمة تحاولان منع الطّفل إبراهيم من اللعب مع بنت الخادمة. لكن هيهات. لغرض منع إبراهيم من اللعب مع ابنتها – والحديث هنا على لسان الرّاوي إبراهيم – كانت الخادمة عند حلول ساعة نوم إبراهيم المصرِّ على الاستمرار في اللعب مع ابنتها “تحدثني عن العفاريت وتصف لي ما تصنع بالأطفال الذين “لا يسمعون الكلام” ولا يفعلون ما يؤمرون، وتروي لي قصصا يقف لها شعر الرأس ويتقبض الجلد عن “المريرة المؤتزرة” و”أبى رجل مسلوخة” وغيرهما وغيرهما فأتضاءل ويدخل بعضي في بعض”.[44] وعندما كانت الخادمة تهمّ إلى تركه بعد أن تكون قد تأكّدت من أنّه لن يفارق فراشه من شدّة الخوف، كان إبراهيم يفعل ما يلي: “أصيح بها وأناديها وأدعوها أن تبقى إلى جانبي لأن “اللحاف” يحدق بي بعينين تقدحان شررًا، أو لأن دهان الحائط يبدو عليه رسم يشبه ما سمعت من أوصاف أبى رجل مسلوخة فأنا أخاف أن يتجسد ويخرج من الجدار ويميل علي باسنانه وأظافره”.[45] هل كانت هذه هي ذروة رعب هذا الطّفل؟ لا! لا! لا! إليكم ذروة أخرى كما يرويها صاحبنا: “فأنام وأنا أحلم بالعفاريت والامساخ والليل المخوف […] والسلالم المظلمة وما يختبئ لي عندها”.[46] ويضيف: “ولم تكن أحلامي تخلو من متع منغصة، وما أكثر ما رأيت في منامي أني لاعبت هذه أو تلك من البنات وأن أهلي دهنوني بالسمن والعسل وقيدوني ورموني في ركن حالك السواد وتركوني للحشرات وغيرها من المؤذيات والمرعبات”.[47]
مع أنّ ابن بور سعيد عمرو شريف (1950-) يصغر القاهريّ إبراهيم المازني (1890-1949) بواحد وستّين عامًا إلّا أنّه جابه، هو الآخر، التّهديد بدهن جسده بالعسل لغرض معاقبته. يروي الطّفل عمرو في “أصداء وظلال” أنّه دخل “حضانة الأندلس” قبل أن يبلغ الرّابعة، ويضيف: “كثيرًا ما حدثوني عن حجرة الفئران… وأنهم يدهنون جسد الطفل بالعسل الأسود حتى تأكله الفئران”.[48] ويخلص إلى القول: “ما أقساهم”.[49] حالفه الحظّ عندما استحقّ العقاب ذات مرّة، فيكتب في ذلك: “وعندما عاقبوني يومًا لم يرسلوني إلى هذه الحجرة، واكتفوا بتأجيل مِرْواحي من الحضانة ساعتين أو ثلاثًا، لا أذكر لماذا”.[50]
كان أهل الطّفل الدّمشقيّ محمّد كرد علي (1876-1953) يهدّدونه هو الآخر. يروي الطّفل محمّد أنّ الحمّامات في صغره كانت في الأسواق “والبيوت يومئذ لا تعرفها”.[51] ويقول في هذا الخصوص: “استثقل الحمام لما فيه من الحرارة الزائدة”.[52] وكيف كان يُقنعه والداه بالذّهاب إلى الحمّام؟ في سيرة الطّفل محمّد، كما في غالبيّة السّير، لا مكان للإقناع، فالإكراه سيّد الموقف. يصف الطّفل محمّد المشهد كالآتي: “ولكي يضطروني إلى الرضا بحكم والدي ووالدتي، كانوا ينصبون لي خيالاً أشبه برجل فظيع له قرون تنطح، يجعلونه وراء الخوابي في بيت المؤنة المظلمة، ويمسكونني بيدي لأرى الخيال، ويقولون لي هذا البُعْبُع، إذا لم تقبل أن تذهب إلى الحمام اليوم نقول له أن يأكلك، فأذهب صاغراً متألماً من هذا التحكم خائفا من سطوة البعبع”.[53] وكيف نجح في التخلّص من الذّهاب إلى الحمام؟ ما أجملها من صدفة! يروي الطّفل ابن السّابعة قائلًا: “وأذكر أن والدتي أخذتني معها إلى حمام النساء فقالت لها إحداهن: لماذا لم تأت بأبيه معه؟ فانقطعت أمي عن أخذي معها إلى الحمام من ذاك اليوم”.[54] للأسف، لم يخبرنا محمّد إن كان قد انقطع عن الذّهاب إلى الحمّام كلّيًّا أو أنّه انقطع عن الذّهاب إلى حمّام النّساء فقط!
إذا كانت الغاية من تهديد الطّفل محمّد هي إرغامه على الخروج من البيت والذّهاب إلى الحمّام، فقد واجه الطّفل الحِمْصِيّ عدنان الملوحي (1924-) التهديد لمنعه من مغادرة الدّار. يروي في “بين مدينتين”: “كنت أقف وأنا صغير عند باب الدار لا أتجاوزه، حتى لا تخطفني “السمَّاوية”، كما كانت تسميها أمي، لتخيفني بهذه المخلوقة الأسطورية التي صنعتها الأمهات من خيالهن لتخويف أولادهن بها، وبغيرها من المخلوقات الخيالية، وذلك حتى لا أخرج من الدار وأضيع في طرقات الحي”.[55] ويضيف: “وكانت الأمهات يخوفن أولادهن وأطفالهن، بقصص الجن، وحديدان والسِمَّاوية والغول وغيرها من الحيوانات الأسطورية المخيفة، ليناموا”.[56]
وفي العودة إلى السّلالم المظلمة الّتي ذكرها الطّفل إبراهيم المازني، فلدى ابنة فاس المغربيّة الطّفلة فاطمة المرنيسي (1940-2015) ذكريات مع هذه السّلالم ترويها في “نساء على أجنحة الحلم”. تحدّثنا عن دارهم و”الأدوار العليا فيها مكان مفضل لمن يحب الحكايات، عليك أن تصعد المئة درج من الزليج لتؤدي بك إلى الطابق الثالث والأخير في الدار، حيث السطح الممتد وحيث كل شيء أبيض وواسع وباعث على الترحاب”.[57] كانت فاطمة وأطفال العائلة يعشقون سهرات الحكي الّتي كانت تعقد أيّام الجمعة على ذلك السّطح، وتقول في ذلك: “كنا لا نكاد ننام ليلة الخميس من شدّة لهفتنا على حضور سهرات الحكي ليلة الجمعة”.[58] لكن! بعد الانتهاء من الاستماع إلى القصص في ساعة متأخّرة كان على الأطفال نزول الدّرج المعتم وهناك يواجهون خطر “الجان الذين يتجوّلون في كل الأمكنة بصمت، في انتظار الانقضاض عليك”.[59] لم يقف الأمر عند هذا الحدّ كما تروي الطّفلة فاطمة: “إن ابن عمّي سمير كان يقلّد الجان ببراعة إلى حدّ أنّني بت أعتقده منهم”.[60] وكانت هذه التمثيليّة ترعب الطّفلة. وكيف لها أن تجعل سمير يكفّ عن ذلك؟ تكتب: “وقد اضطررت مرّات عديدة إلى تصنع الغيبوبة لكي يكف عن تمثيليته”.[61]
في الكثير من الحالات كان للجدّات دور مركزيّ، وفي بعض الحالات دور “البطولة” في رواية القصص المرعبة للأطفال، لغرض التّسلية في بعض الحالات، ولغرض التأديب في بعضها الآخر. في سيرتها “أوراق شخصيّة” تروي القاهريّة لطيفة الزيات (1923-1996): “في طفولتي حكت لي جدّتي […] حكايات عن الجن والعفاريت والشاطر حسن […]”.[62] لكنّ أكثر ما كان يخيفها كما تذكر: “ملاكي الخير والشر اللذين ضقت طفلة بوجودهما على كتفيَّ، يسجلان حسناتي وسيئاتي”.[63] أمّا ابنة صور اللبنانيّة رجاء نعمة (1942-) فتروي في “مذكّرات امرأة شيعيّة” أنّ الحاجّة فردوس، جدّة صديقتها زينة، كانت تحكي لهنّ قصّة حوريّات البحر، “نصفهنّ الأسفل سمكة، والنصف الأعلى إنسان. شابّات ذوات شعر طويل لا مثيل لجمالهنّ […] الحوريّة قد تفعل المستحيل، لتجذب أحداً من أهل اليابسة إلى أعماق البحر! هكذا يغرق المتهوّرون”.[64] كما تقصّ هذه الجدّة “حكايات أخرى مخيفة يجود بها خيالها […] و”الغوليّة” التي تطرح ثدييها على هذا الكتف وذاك، بانتظار أن تلتهم من يخالف أمرها […]”.[65] وتؤكّد رجاء في هذا السّياق: “كانت الحاجّة فردوس تغدو الراوية والبطلة في آن معاً: نظراتها تبرق بالفزع. وحركات كفّيها تحاكي مسار الحدث، صعوداً هبوطاً، إلى هذه الناحية وتلك. حركات تجعلنا نرى ثديي الغوليّة […]”.[66]
لم تُميّز الجدّاتُ بين الذّكور والإناث في حكايات الرّعب، فقد قَصَصْنَ تلك الحكايات للإناث والذّكور على حدٍّ سواء. مساواةٌ تامّة! وأكبر إثبات على ذلك قصّة شوقي ضيف (1910-2005)، ابن قرية أولاد حمام في محافظة ضمياط. كتب شوقي في سيرته “معي”: “وكانت الجدة تقصُّ على الصبي أقاصيص كثيرة عن الجِنِّ والعفاريت، وكانت تحكيها للصبي وهي شديدة الإيمان بها، وخاصة أقاصيص الجن الذين يتراءون في الليالي الداجية المظلمة”.[67] وتضيف الجدّة: “إن الجن والعفاريت تتشكل أحيانا بأشكال بعض الحيوانات”.[68] كان لهذه القصص أثرٌ مهول على الطّفل شوقي، لكنّ تبعاتها بلغت كامل الأسرة، ففي سنّ التاسعة انتقل مع أسرته للسّكن في دمياط، وهناك “كان الصبيّ ينام في غرفة منفردًا وحده”.[69] وبدأت الإثارة! وأيّ إثارة! يروي شوقي: “ولم تمض إلا أيام قليلة حتى أخذ يشكو إلى أمه من أنه يصحو ليلا، فيجد بجانبه جسما ممتدا، ويضع يده فوقه، فيحس كأنه جسم عار”.[70] وماذا تفعل الأمّ؟ يروي شوقي: “وتراجع الأم أباه الشيخ، فيقول لها إنه إما هر وإما هرة”.[71] يعود شوقي إلى النوم في غرفته في الليلة التّالية “ويقرأ قبل أن ينام – كما علمته جدته في القرية – آية الكرسي ست مرات لحفظه وحفظ المنزل، ويدعو في نهايتها بهذا الدعاء، أقسمت عليكم يا خدام هذه الآية: آية الكرسي بحق الذي خلقكم وصوَّركم أن تحفظوني وتحفظوا هذه الدار من الأذى والضرر طوال ليلتي هذه حتى طلوع الفجر”.[72] حينها ينام الطّفل شوقي مطمئنًّا، لكن “لا يلبث أن يستيقظ ويحس بجسد ممتد بجانبه ويبيت مرتاعا”.[73] ويعود شوقي ليشكو لأمّه الأمر، فتبحث الأمّ في غرف الدّار كلّها، لكنّها لا تعثر على ذلك الهرّ المزعوم، ويعود شوقي إلى تلاوة آية الكرسي، لكن هيهات! إذًا، ما العمل؟ الحلّ عند الوالد الشّيخ. يؤكّد شوقي: “ويبادر الأب إلى اتخاذ قرار ترك الدار واستئجار دار جديدة، مع اعتقاده أن هذا كله إنما هو وهم من الأوهام […] إذ لا يؤمن بالأوهام ولا بالخرافات”.[74] بعد أن كبر شوقي أخذ يفكّر في ما كان يحدث له في صغره، وكتب في ذلك: “ربما كان حقا وهما جاءه من قصص الجن والعفاريت التي كانت تحكيها له جدّته، أو ربما كان هذا الجسد يده التي كان يتوسدها من الخوف، فإذا استيقظ ومدها بجانبه، وهي مخدّرة، ولمسها بيده الأخرى وهو بين اليقظة والنوم ظنها جسدًا آخر ممتدًّا بجواره ولا جسد ولا روح ولا عفريت من الجن”.[75]
لم تكن العفاريت الّتي ارتاع منها الطّفل توفيق الحكيم (1898-1987) وهمًا جاءه، كما حال أخيه الأصغر شوقي ضيف. في “سجن العمر” يعود الطّفل توفيق بنفسه وبنا إلى ذلك المنظر الّذي انطبع في ذاكرته منذ السّنوات الأولى من عمره: “منظر تلك العفاريت، المتدثرة في البياض أو السواد التي كانت تظهر لي خلف الأبواب، ثم تختفي بسرعة البرق!”.[76] ويصف شعوره قائلًا: “كنت أرتاع منها أشد الروع”.[77] لكن ما السّرّ، فهذا المنظر المتكرّر لم يكن من صنع الخيال! كان الطّفل يراه بأمّ عينه! يؤكّد الطّفل توفيق في هذا السّياق: “كنت أحار في تعليل طريقة ظهورها واختفائها”.[78] بقي الطّفل في حيرته ووجد الإجابة عن تساؤله بعد مرور الأيّام مؤكّدًا: “قيل لي فيما بعد إنها الخادم والمرضعة كانتا تتدثران في ملاءة الفرش البيضاء أحيانًا وفي ملاءة سوداء”.[79] ولماذا تقومان بفعلة مريعة كهذه؟! لقد فعلتا ذلك “لتخيفاني وتسكتاني. ذلك أني كما يروون كنت طفلًا مزعجًا، “بشقاوته وعفرتته””.[80] وعن حوادث عفرتته يكتب: “لا أذكر تمامًا مثل هذه الحوادث. إنها وقعت ولا شك في مرحلة خارج منطقة الوعي عندي”.[81] ويضيف: “كل ما أستطيع أن أذكره وأعيه في تلك المرحلة هي صورة العفاريت المتدثرة في البياض والسواد!”.[82]
تتساءل عنبرة سلام الخالدي بعد أن كبرت: “وانني لأتساءل الآن، هل يجوز ان يحذّر الأطفال من الشر بهذه الطريقة؟ وهل هي الوسيلة المثلى لحملهم على السير على الدرب المستقيم؟”.[83] ما رأيك عزيزي/تي القارئ/ة؟
بعد جرعات الرّعب هذه كلّها أظنّ أنّه قد آن الأوان للتّرفيه عن النفس المنقبضة ببعض النّهفات الّتي من شأنها أن تطلق الابتسامة وتبعث على الفرح. سيكشف لنا الطّفل نجيب محفوظ (1911-2006) سبب دعوته للثّورة وهو دون السّابعة! أمّا أنيس فريحة (1902-1993)، أستاذ اللغات السّاميّة في جامعة بيروت الأمريكيّة، فسيكشف لنا سرّ عودة ابنته ميَّة باكية من مدرستها وردّها عليه حين سألها عن السّبب: “يا بابا، أعطتني المعلمة صفراً في الإعراب، وقالت إنك حمار في الإعراب”.[84]
ألقاكم/نّ بخير.
……..……………….
[1] . سلام الخالدي، عنبرة. (1978). جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين. بيروت: دار النهار للنشر. ص 29.
[2] . المازني، إبراهيم عبد القادر. (2010). قصة حياة. وندسور: مؤسسة هنداوي. ص 17.
[3] . عاشور، رضوى. (2013). أثقلُ من رضوى: مقاطع من سيرة ذاتية. الطبعة الثانية. القاهرة: دار الشروق. ص 259.
[4] . سلام الخالدي، عنبرة. (1978). جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين. بيروت: دار النهار للنشر. ص 35.
[5] . شعراوي، هدى. (2013). مذكرات هدى شعراوي. القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. ص 7.
[6] . العودة، سلمان. (2011). طفولة قلب – دون التّذكّر… فوق النّسيان: سيرة ذاتيّة. الرياض: مؤسّسة الإسلام اليوم للنشر. ص 21.
[7] . المصدر السابق. ص 21.
[8] . المصدر السابق. ص 21.
[9] . زيَادة، نقولا. (1992). أيّامي: سِيرة ذاتِيَّة. الجُزء الأوّل. لندن: هزار بابلشنغ لمتد. ص 15.
[10] . المصدر السابق. ص 15.
[11] . المصدر السابق. ص 15.
[12] . المصدر السابق. ص 15.
[13] . المصدر السابق. ص 15.
[14] . بن جلون، عبد المجيد. (1993). في الطفولة. الرباط: دار نشر المعرفة. ص 10.
[15] . المصدر السابق. ص 11.
[16] . المصدر السابق. ص 11.
[17] . المصدر السابق. ص 11.
[18] . المصدر السابق. ص 11.
[19] . المصدر السابق. ص 11.
[20] . المصدر السابق. ص 11.
[21] . المصدر السابق. ص 11-12.
[22] . المصدر السابق. ص 12.
[23] . المصدر السابق. ص 12.
[24] . المصدر السابق. ص 12.
[25] . المصدر السابق. ص 12.
[26] . المصدر السابق. ص 12.
[27] . المصدر السابق. ص 12.
[28] . المصدر السابق. ص 12.
[29] . المصدر السابق. ص 13.
[30] . المصدر السابق. ص 13.
[31] . المصدر السابق. ص 13.
[32] . المصدر السابق. ص 13.
[33] . سلام الخالدي، عنبرة. (1978). جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين. بيروت: دار النهار للنشر. ص 29-30.
[34] . عاشور، رضوى. (2013). أثقلُ من رضوى: مقاطع من سيرة ذاتية. الطبعة الثانية. القاهرة: دار الشروق. ص 259.
[35] . المصدر السابق. ص 259.
[36] . المصدر السابق. ص 259.
[37] . المصدر السابق. ص 259.
[38] . المصدر السابق. ص 259.
[39] . المصدر السابق. ص 260.
[40] . المصدر السابق. ص 260.
[41] . المصدر السابق. ص 260.
[42] . المصدر السابق. ص 260.
[43] . المازني، إبراهيم عبد القادر. (2010). قصة حياة. وندسور: مؤسسة هنداوي. ص 16-17.
[44] . المصدر السابق. ص 17.
[45] . المصدر السابق. ص 17.
[46] . المصدر السابق. ص 17.
[47] . المصدر السابق. ص 17.
[48] . شريف، عمرو. (2016). أصداءٌ وظِلال: سيرة ذاتية. القاهرة: نيو بوك للنشر والتوزيع. ص 28.
[49] . المصدر السابق. ص 28.
[50] . المصدر السابق. ص 28.
[51] . كرد علي، محمّد. (1948). المذكرات. مطبعة الترقي بدمشق. ص 17.
[52] . المصدر السابق. ص 17.
[53] . المصدر السابق. ص 17.
[54] . المصدر السابق. ص 17.
[55] . الملوحي، عدنان. (1990). بين مدينتين: من حمص الى الشام. لندن: رياض السيد للكتب والنشر. ص 28.
[56] . المصدر السابق. ص 58.
[57] . المرنيسي، فاطمة. (2007). نساء على أجنحة الحلم. الطبعة الثانية. ترجمة فاطمة الزهراء أزرويل. الدار البيضاء: منشورات الفنك. ص 24.
[58] . المصدر السابق. ص 25.
[59] . المصدر السابق. ص 25.
[60] . المصدر السابق. ص 25.
[61] . المصدر السابق. ص 25.
[62] . الزيات، لطيفة. (2016). أوراق شخصية: سيرة ذاتية. القاهرة: الكرمة للنشر. ص 14.
[63] . المصدر السابق. ص 26.
[64] . نعمة، رجاء. (2013). مذكّرات امرأة شيعيّة: سيرة روائيّة. بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. ص 195.
[65] . المصدر السابق. ص 214.
[66] . المصدر السابق. ص 215.
[67] . ضيف، شوقي. (1985). معي. الطبعة الثانية. القاهرة: دار المعارف. ص 26.
[68] . المصدر السابق. ص 26.
[69] . المصدر السابق. ص 38.
[70] . المصدر السابق. ص 38.
[71] . المصدر السابق. ص 38.
[72] . المصدر السابق. ص 38-39.
[73] . المصدر السابق. ص 39.
[74] . المصدر السابق. ص 39.
[75] . المصدر السابق. ص 39-40.
[76] . الحكيم، توفيق. (1964). سجن العمر. القاهرة: مكتبة الآداب. ص 48.
[77] . المصدر السابق. ص 48.
[78] . المصدر السابق. ص 48.
[79] . المصدر السابق. ص 48.
[80] . المصدر السابق. ص 48.
[81] . المصدر السابق. ص 49.
[82] . المصدر السابق. ص 49.
[83] . سلام الخالدي، عنبرة. (1978). جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين. بيروت: دار النهار للنشر. ص 30.
[84] . فريحة، أنيس. (1989). قبل أن أنسى. الطبعة الثانية. طرابلس: جروس برس. ص 8.