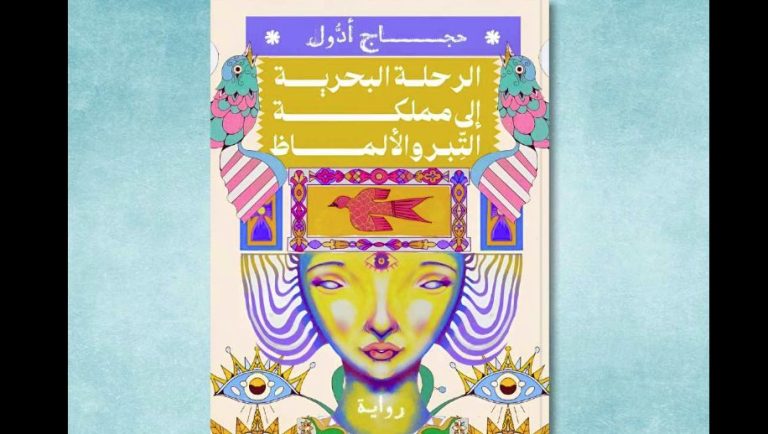سعاد الراعي
حين داعبت الشمس طفولتنا
لم يكن شط العشار مجرد مجرى مائي يمر بهدوء في أطراف المحلة، بل كان نداءً خفياً يدغدغ أرواح الأطفال المتعطشة للمغامرة والتحرر من قيود الواقع. كان يقع على بُعد بضع دقائق فقط من بيت العائلة، ان قربه هذا لم يكن سوى إغراء إضافيًا يدفع الصغار إلى تحدي الممنوع.
في أوقات العطلات المدرسية، وتحت لهيب تموز الذي يشتد على مدينة البصرة حتى يغدو الهواء نفسه كأنه نارٌ تلفح الوجوه. كانت مجموعات الأطفال تجتمع عند الشط، حيث يفضلون السباحة في المناطق الضحلة التي عُرفت بينهم باسم “منطقة الڰياش”، تجنبًا للموت الذي كان يبتلع أرواحًا غضة في تلك المياه العميقة كل عام.
عادل وأخوه، في الثامنة والسادسة من العمر، كانا ضمن أولئك المغامرين الصغار، رغم تحذيرات الأهل المتكررة ومنعهم الصارم لهما من السباحة، لم يكن الخوف من الغرق وحده ما يطاردهم، بل أيضًا شبح الأمراض المتفشية في المياه، وعلى رأسها مرض البلهارسيا، الذي تنقله ديدان مستوطنة في قواقع الشط.
لكن الطفولة لا تعترف بالتحذيرات، فكانت براعتهم في الاحتيال تفوق قدرتهم على الالتزام.
ينزعون ثيابهم خوفًا من بللها، يسبحون بملابسهم الداخلية، بعد ان يؤمنون ثيابهم عند صديق يجلس على الرمل حارسًا أمينًا. وعندما تنتهي مغامرتهم، يغسلون أجسادهم، يجففونها ويلبسون ثيابهم، ثم يبدؤون بتجفيف ملابسهم الداخلية بوسيلة عجيبة طالما اعتقدوا بفاعليتها.
كانت تلك اللحظات التي ينتظر فيها الأطفال مرور سيارات الحمل ذات العجلات الكبيرة على الطريق المحاذي للشط، بمثابة طقوس سرية لمغامرتهم الطفولية. كان المشهد يبدو كلعبة مثيرة تتحدى قوانين الزمان والمكان؛ يُلقون ملابسهم الداخلية على الإسفلت الحارق، لتسحقها عجلات السيارات وتعيدها إليهم جافة بسرعة تكاد تكون سحرية.
ولكن المغامرات لا تكون كاملة دون تلك المفاجآت التي تحمل طعم الخيبة المرير. فعندما تعلق الملابس بالعجلات، وتنطلق السيارة دون أدنى اكتراث لصراخهم البائس وركضهم المحموم خلفها، تتجسد المأساة الصغيرة في قلوبهم اليانعة كطعنة مؤلمة. المغامر التعيس الذي يخسر ملابسه الداخلية في تلك اللعبة الخطرة، لا يجد أمامه سوى العودة إلى البيت دون “لباس” تحت “الدشداشة”، محاولًا أن يخفي أثر فشله في عينيه البريئتين.
لكن الفضيحة لا تلبث أن تنكشف. الضحكات الساخرة من أقرانه تلاحقه كأشباح تتراقص حوله، وقصته تتحول إلى مادة للتندر والتسلية في مجالس الصغار. أما الأهل، فغضبهم لا يعرف الهدوء، وعقابهم يُكتب بصرامة لا تقبل المساومة.
ومع ذلك، لم يكن لأي عقاب أن يُخمد في قلوبهم جذوة التمرد على المألوف، ولا رغبتهم الملتهبة في اكتشاف العالم بطريقتهم الخاصة. كانت مغامراتهم تلك صرخة طفولية تتحدى كل شيء، كأنها محاولة مستمرة لإثبات الوجود في عالم لم يعرفوا منه سوى الحرمان والخوف والأحلام المعلقة على ضفة شط العشّار.
في وهج ظهيرة ثقيلة، حين عاد الأب إلى البيت متعبًا من عناء العمل، غابت أصوات أبنائه المعتادة، تلك الضوضاء الطفولية التي كانت تملأ أركان المنزل حياة. سأل الأم بلهفة مكبوتة: “أين هم؟” فأجابته بتردد: “لا أدري، لعلهم يلعبون في الخارج.”
زمجر بصوت يحمل قلقًا أكثر مما يحمل غضبًا: “في الخارج؟ ومن يطيق اللعب تحت هذا الحر اللافح؟” ردت الأم محاولة تبرير غيابهم: “ربما ذهبوا إلى الشط…”
“الشط؟!” كرر الأب كمن اكتشف فجأة مصدر هواجسه القاتمة. هرع خارج البيت مستشيطًا بالغضب، يكاد يشتعل كاللهب من قمة رأسه حتى أخمص قدميه. وما إن لمحه صديقهم الحارس، حتى أطلق نداءه المرتعد: “عادل! أبوكم قادم!”.
وصل الأب إلى الحارس وانتزع منه ثياب الولدين بعينين تقدحان شررًا. على الفور، اندفع الصبيّان مذعوران، يركضان بكل ما أوتيا من قوة نحو الشارع، يقطعان الطريق بأقدامهما الحافية وكأنهما يهربان من قدر محتوم. اختارا ملاذًا مألوفًا: بناية المكتبة العامة بسورها الواطئ المكشوف والذي لا يصلح للاختباء، وبناية الإدارة المحلية بسورها الحجري العالي الذي توهما أنه قادر على حمايتهما من بطش أبيهما.
رآهما حارس البناية يتقافزان كطيرين جريحين، والذعر يكسو وجهيهما المحترقين من الشمس، وأجسادهما العارية المشبعة بملوحة النهر. هرعا إليه متوسلين، يتعلقان بسرواله كما يتعلق الغريق بخشبة خلاص. “أنقذنا يا عم … أبونا سيقتلنا!”.
نظر إليهما الحارس بحنان الأب الذي لم يُرزق أبناء بعد، وقال: “لماذا يريد معاقبتكما؟” لكنه أدرك سريعًا حقيقة الأمر حين استنشق رائحة النهر تفوح منهما. “آه، فهمت. لم يسمح لكما بالسباحة خوفًا عليكما، وهذا العقاب الذي تفران منه.”
تشبث الولدان به كملاذ أخير، بكاؤهما ينساب كأنهار صغيرة من رجاء ويأس. وفي تلك اللحظة، اقتحم الأب المكان متقدًا غضبًا، يهدر بصوت يكاد يهدم السور نفسه: “ويلكما! إلى أين تهربان مني؟ تعالا فورًا!”
هنا تقدم الحارس بخطوات هادئة، وبصوت ملؤه الرجاء والاحترام، قال للأب: “يا اخي، أرجوك، لا تضربهما. لقد طلبا حمايتي، ووعدتهما بالأمان. أريد منك كلمة شرف، وعدًا من رجل لرجل، ألا تمسسهما بسوء.”
تجمد الأب مكانه، وكأن كلمات الحارس لامست شيئًا عميقًا في روحه. أطرق برأسه هنيهة، ثم مد يده مصافحًا الحارس، وقال بصوت خافت: “وعدًا… لن أؤذيهما.”
وما إن التقط الولدان همسات الوعد بين الرجلين، حتى انطلقا كطائرين أفلتا من شباك الخوف، يعدوان نحو البيت وأعينهما تلمع ببريق النجاة.
*
هدايا من عتمة الركام
وسط أنقاض الحياة وخيامٍ تتنازعها الريح، كانت هبة، ذات الأعوام الستة، مسجاةً إلى جوار والدتها المصابة وأختها الصمّاء، مقيدةً إليهما بحبلٍ يلف خاصرتها الصغيرة، وكأنّ الخوف نفسه قد شدّ وثاقها إلى هذا القدر الموجع. لم يُسعفها النعاس، فرغم الجوع الذي ينهش أمعاءها والقلق الذي يستبد بروحها، ظلت عيناها الواسعتان تحدقان في شقٍّ بأعلى الخيمة، شقٍّ نسيَت والدتها أن تسدّه بخرقة. كان ذلك الفُتات من السماء بوصلتها إلى الفجر، اللحظة التي انتظرتها طوال الليل لتنفيذ ما اعتملت به أفكارها الصغيرة.
في ظلمة الخيمة، تحركت بحذر، تلمّست أنفاس والدتها، تفقّدت الحبل المربوط بها، وعقدةً تقيّد حريتها. بأصابعها النحيلة، راحت تفكّها بصمت، حتى إذا انفلتت، غمرها شعور أشبه بنشوة الانتصار، إحساس لم تعرفه منذ ذلك اليوم الذي خُطفت فيه طفولتها على وقع القصف. كان يومًا أطفأ نور والدها وأخاها الرضيع، يومٌ خرجت فيه برفقة أمها وأختها لجلب الماء من آخر ما تبقى من الحياة، من حنفية الجامع التي ما زالت تقطر قطراتٍ يتنازعها العطشى في ملحمةٍ للبقاء، بينما عادوا ليجدوا منزلهم قد تلاشى في العدم، كل ما كانوا، كل ما يمثلهم، صار رمادًا وركامًا.
استعادت المشهد كأنه يُعرض أمام عينيها الآن، ارتجفت أصابعها، وأحكمت قبضتيها الصغيرتين المرتعشتين على فمها، تخشى أن تفلت منها عبرة فتوقظ والدتها، فتنهار خطتها قبل أن تبدأ.
جمعت ما تبقّى من شجاعتها، ومسحت دموعها بكمّ ثوبها، كأنّها تطرد بها الحزن العالق في مقلتيها. ربطت ضفائرها بخرقة انتزعتها من كمّها الآخر، مشدودةً كحلقات أملٍ واهنة، ثم انتعلت نعليها المهترئين وجلست تنتظر ميلاد الفجر، علّه يحمل لها بارقة رجاء، علّها تصل إلى ما ترجوه وتتمناه ولا يخيب ظنّها.
راودها طيف العيد، فتذكّرت بيتهم الدافئ، غرفتها التي كانت تمتلئ بهجةً في صباحات العيد، وفرحة ارتداء الثياب الجديدة، وتذوّق الحلوى التي أحبّوها، والهدايا التي كانت تُخبَّأ لهم بحبّ ليجدوا فيها مفاجأةً من والديهم. شعرت بمرارة الفقد، لكنّها سرعان ما طوّقت وجعها بقرارها الصامت.
ما إن بزغت ساعة الفجر الأولى حتى نهضت هبة، وتسلّلت خارج الخيمة، تسابق الريح بخطواتها الصغيرة نحو ما تبقّى من بيتهم. راحت تنبش في الركام بصبرٍ يليق بمن يفتّش عن كنزٍ، عازمةً أن تجد هدايا العيد لأمها وأختها.
ها هي الصغيرة، بين أنقاض منزلها، تسير كما لو أن خطواتها تبحث عن شيء يعيد إليها شعور الانتماء وسط هذا الخراب. غاب عن إحساسها الجوع، والخوف، وحتى الحذر، فلم يعد لشيء في هذا العالم وزن أمام ثقل ما تحمله في قلبها الصغير.
انحنت ترفع حجرًا، بحجم نبضها المرتجف، كان ملطخًا بلونين من الحمرة، كأنما احتضن آخر ما تبقى من حياة من كانوا هنا. نفخت عليه، أزاحت عنه الرماد والتراب بأطراف أصابعها المرتعشة، ثم شهقت بالبكاء، تهمس بحرقة تقطع نياط القلب: “بابا… هذا دمك ودم أخي… أنتما معي الآن!”
جففت دموعها بيد ثابتة، كما لو أنها ترفض أن تنهار. لم يكن الوقت وقت بكاء، بل وقت استعادة الذكريات المنثورة تحت هذا الركام. واصلت الحفر بأصابع صغيرة أرهقها البرد والتعب، حتى لامست شيئًا معدنيًا بارزًا. سحبته ببطء، وإذا به دبوس معدني، كان يربط لفافة أخيها الرضيع. تأملت لمعانه الخافت تحت ضوء الشمس الحزينة، ثم احتضنته وقبّلته، كأنها تلملم شيئًا من دفء الأيام الغائبة، من ضحكة أخيها التي لم تعد تسمعها، ومن حضن والدها الذي صار ذكرى.
نهضت، نفضت الغبار عن ثوبها المثقل بالبقايا والحنين، وحين همّت بالمضي، أحسّت بشيءٍ صلبٍ تحت قدميها. انحنت لتلتقطه، فإذا به بقايا إبزيم حزام والدها الجلديّ الجميل المحترق، الذي كان يشده حول خصره كل يوم قبل أن يغادر. تلمسته بأناملها، وكأنها تبحث عن نبضه فيه، وكأنها تستجدي رائحة الأمان التي تلاشت بين الجدران المنهارة.
فجأة، شعرت بعيون غريبة تراقبها. التفتت، فرأت كاميرا مصوبة نحوها، وعينين تتابعانها بفضول. كان مراسل إحدى القنوات يقف هناك، يراقب هذا المشهد، يحاول فهمه. اقترب منها، وانحنى قليلًا ليكون في مستوى نظراتها، ثم سألها بصوت خافت لكنه محمّل بالدهشة:
“ما اسمكِ؟ وماذا تفعلين هنا بين الركام؟“
ارتبكت لوهلة، ثم عدّلت من وقفتها، كأنها تستعد لإعلان شيء جلل، وقالت بصوت ثابت رغم كل ما يسكنه من وجع:
“اسمي هبة… كان هنا بيتنا… وأنا أبحث عن هدايا لأمي وأختي، لأن اليوم عيد، وأتمنى أن يفرحوا بها.”
تبادل المراسل والمصور نظرات متفاجئة، ثم عاد ليسألها، وكأنه لم يستوعب بعد:
“هل يمكن أن ترينا هداياك؟“
فتحت يديها الصغيرتين، وقدّمت لهما كنزها الغالي. تأمل الرجل ما بداخل راحتيها، لكن معاني الأشياء لم تصله بعد. نظر إليها بحيرة، ثم سأل مجددًا:
“هدايا؟“
تابعت بعينيها الكاميرا التي اقتربت لتلتقط تفاصيل كنزها الثمين، ثم قالت بثبات يشبه الحكمة التي لا تليق بعمرها:
“أريدها أن تكون مفاجأة لأمي وأختي… هذا الحجر ملطّخ بدم أبي وأخي اللذين دُفنا هنا، بين أحجار بيتنا، وهذا دبوس لفافة أخي الصغير، الذي كان أبي يحمله دومًا، ملفوفًا بإحكام حول صدره، أما هذا…”
رفعت آخر قطعة بين يديها، وكأنها تضع بينهما وصية رجل رحل ولم يترك خلفه سوى الحب والألم، وقالت بصوت مبحوح:
“هذا الإبزيم لبقايا حزام أبي الجميل… ينقصني فقط ورق نظيف لأغلفها.”
صمت المكان. لم يعد هناك سوى صوت الريح التي تداعب الغبار العالق في الهواء. المراسل لم يجد ما يقوله، والمصور خفض كاميرته قليلًا، كأن الصورة لم تعد تحتاج إلى تعليق. أما هبة، فوقفت بثباتها الصغير، تحدق في كنوزها، وكأنها تدرك أكثر من الجميع معنى هذه الأشياء.
ففي عالمٍ تحطّم أمامها، لم تكن تبحث عن أنقاض بيت… بل عن بقايا حياة.
تدور عدسة الكامرة، تبحث عن صورة تصوغ الحقيقة، فتستقر على وجه المراسل المذعور، الذي يحاول جاهدًا أن يستعيد توازنه. يمسح بقايا دموعه بسرعة، فلا مجال لانكسار المشاعر أمام الكاميرا، فالمهنية تفرض عليه أن يكون محايدًا، ولو أن قلبه يضج بالأسى.
يتنفس بعمق، محاولًا ضبط صوته المرتعش، ثم يمضي في حديثه:
“هؤلاء هم أطفال غزة… يولدون رجالًا من رحم المعاناة، يشتدّ عودهم بالصبر، ويستمدون صمودهم من الألم، ويتحملون مسؤولية الحياة التي تنهب أعمارهم يومًا بعد يوم. أنظر إلى هذه الطفلة، فتتراءى لي بائعة الكبريت الصغيرة، تلك التي أشعلت عيدانها في عتمة البرد واليأس، تمامًا كما يشعل أطفال غزة عيدان الأمل بين الركام، علّ الحياة تضيء ولو للحظات وسط الظلام الذي لا ينقشع.”
ينتقل نظره إلى يديها الصغيرتين اللتين تمسكان بحجر، وكأنهما تقبضان على آخر ما تبقى لها من وطن. يبتلع غصّته قبل أن يقول بصوت خافت لكنه جازم:
“حجارتها تذكرني بحجارة جدار برلين، ذاك الجدار الذي أسقطوه منذ أكثر من خمسة وثلاثين عامًا، فصار أنقاضه تباع كتذكارات للسياح، أما غزة… فتباع كلها، بأهلها، لسماسرة الحروب.”
قبل أن يكمل كلماته، يشق أزيز الطائرات سماء المشهد، يشتد الضجيج، فيرتبك التصوير، وفي لحظة خاطفة، يمسك بيد هبة الصغيرة، ويهرول بها بعيدًا… بينما خلفهم، تستمر الحكاية ذاتها، تتكرر يومًا بعد يوم، كأنها لعنة لا تنتهي.