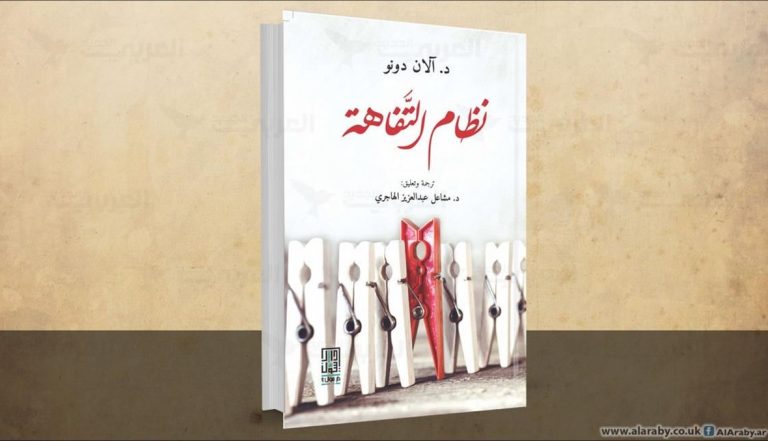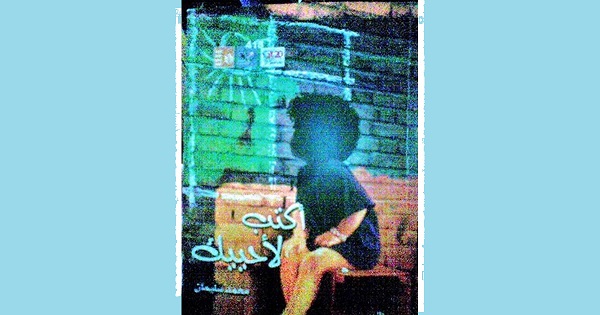أحمد عزيز الحسين
هذه قصّة قصيرة للأديب المصري عمّار علي حسن، وهو باحثٌ، وروائيٌّ، وقاصٌّ مصريّ معروف، له بصمةٌ خاصةٌ في السرد العربيّ المعاصر، ونتاجٌ أدبيٌّ وفكريٌّ ثـرٌّ، وقد قرأتها في صفحته الفيسبوكيّة فأعجبتُ بها لما فيها من تقطير وتكثيف، وسرد مراوغ، وبراعة في رسم الشخصية، وقدرة على اللعب بالزمن، وتوظيف تقنياته في بناء السّرد، وملاحقة تشظّي الشخصيّة، وما انتهتْ إليه من مصير دراميّ فاجع، ولذلك كتبت عنها تحليلا نقديّاً رغبت في نشره هنا، وفيما يلي نصّ القصّة والتّحليل لعلهما يحظيان بحوار نقديّ حولهما.
القصة تحتفي بفنّ الحكاية في تشكيل مبناها السردي، وتحرص على استثمار تقنيات القصّة الكلاسيكية في صياغة هذا المبنى، سواء في قدرتها على بناء استهلال سرديّ بارع يحفّز القارئ على المتابعة، أو في رسم حبكة شائقة، ونهاية بديعة ودالّة، أو في تمكُّنها من استثمار تقنية (الوصف البصريّ الخلاق) في تقديم الشخصية للقارئ، فضلا عما حقّقه ذلك في تشكيل المستوى الدلالي للشخصية نفسها، والإفصاح عمّا طرأ عليها من تغيُّر وتراجع أمام حركة الزمن الموّار الذي لا يرحم.
وقد أحسن الكاتبُ في توظيف حركة الشخصية (المثقلة بالرتابة) للإيحاء بما طرأ عليها من نكوص وهزيمة في واقعها المثقل بالخيبات والإحباطات، إذ إن الفتاة التي كانت قادرة على الهيمنة على المكان، ولفت أنظار من يمشي في الشارع، أمستْ مهزومة ومحبَطة ومهمَّشة أمامه، وقد استطاع إسفلتُ الشارع (ابتلاعَها) بعد أن كانت تدوسه، وتهيمن عليه، وجعَل حركتَها (رتيبةً) وبطيئة، وبدلا من أن تكون (طقطقة) الحذاء الذي تنتعله دليلا على شموخها، وعنفوانها، واحتدام نشاطها، وتمسُّكها بحلمها، أمسى حذاؤها (يئزّ) مصدراً صوتا دالا على التعب والانسحاق بعد أن كان صوته السابق (الطقطقة) دليلا على الشّموخ والقدرة على المواجهة والتّحدي.
وقد استثمر الكاتب (تقنية الوصف) بدلا من تقنية (الحذف الزمني) لملاحقة ما طرأ على مظهر الفتاة الخارجيّ من تغيّر، إذ إن التجاعيد غزت وجه الفتاة الناضح بالفتنة والجمال، وأجبرتها على الاستعانة ببعض المساحيق الرخيصة لتغطية الآثار التي تركها الزمن على وجهها، وأمستْ دليلا واضحاً على هزيمتها وتراجعها أمام حركة الزمن الموّارة التي لاترحم، كما كانت دليلا على تراجعها عن فعل الهيمنة على المكان ومسار الحكي، وهو ما أكدته (نظرتها الكسيرة) التي كانت توجهها إلى (الفراغ الساخن) وهي تتقدم نحو محطة السيارات.
والقصة تحمّل الفتاة المسؤولية عمّا آل إليه حالها من إحباط؛ إذ إنها كـ(حميدة) في (زقاق المدق)، رغبت في تغيير واقعها من خلال الاتّكاء على غيرها، والالتحاق بالشريحة الأعلى منها، لا من خلال فعل إنساني خلاق تقوم به، وقد جعلت شرطها للزواج ممن يرغب فيها أن يكون ( ثريّاً ) و( وسيماً) في الوقت نفسه، ويبدو أنها لم توفق في الوصول إلى ما طمحت إليه، واضطرت إلى الزواج من رجل مهمَّش مثلها، فكان ذلك دليلا على هزيمتها المدوية والمحبطة معاً.
وقد حرص السارد المشارك على جعل الشاب، الذي تلهف للزواج منها، جاهلا بما انتهتْ إليه فتاةُ أحلامه من إحباط وترهّل في جسدها كي يُبقي شعلة التّوهّج والحلم متقدة في ذهنه، أي إنّه استثمر (انطفاء) حلمها للتأكيد على بقاء حلمه (متوهّجاً).
والقصة لا تأتي على ذكر الوقائع والأسباب التي جعلت الفتاة تخفق في تحقيق حلمها، وإن كانت قد لمّحت في المسكوت من متن القصّة، إلى أن تطلُّعها (البرجوازي) هو السبب في ذلك، وقد أدانتها القصّةُ، كما أدانَ نجيب محفوظ قبلها (حميدة) في (زقاق المدق)، وجعل من (آلية) تطلعها لتغيير واقعها وموضعة حلمها على أرض الواقع سبباً في ذلك.
ولاشكّ في أن الفتاة لا تتحمّل وحدها المسؤوليّة عمّا آل إليه حالها بل تتحملها البنية الاجتماعية المعطوبة التي تندغم فيها، والشريحة التي تتحدّر منها؛ إذ إن البنية نفسها لم تمكّن حبيبها من تحقيق حلمه فظلّ(عزباً) هو الآخر يحلم بها حتى بعد أن ابتلعتها البنية الاجتماعية، وجردتها من القدرة على تحقيق حلمها ؟؟
…………………….
*كاتب سوريّ