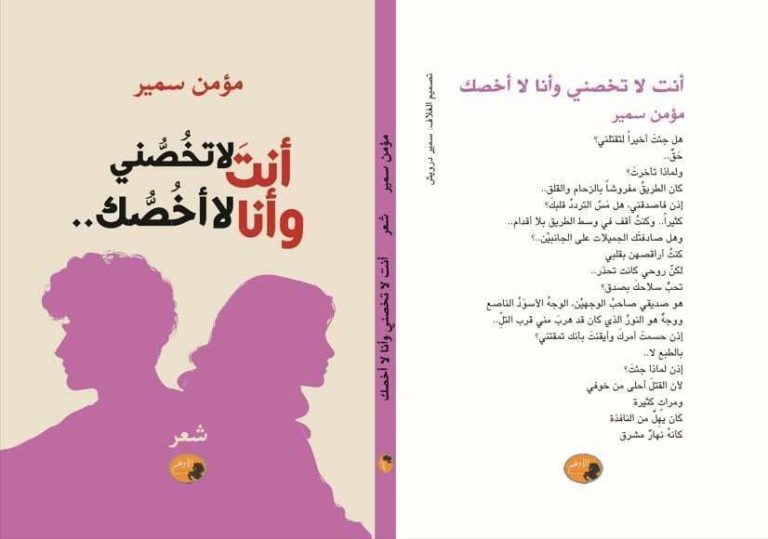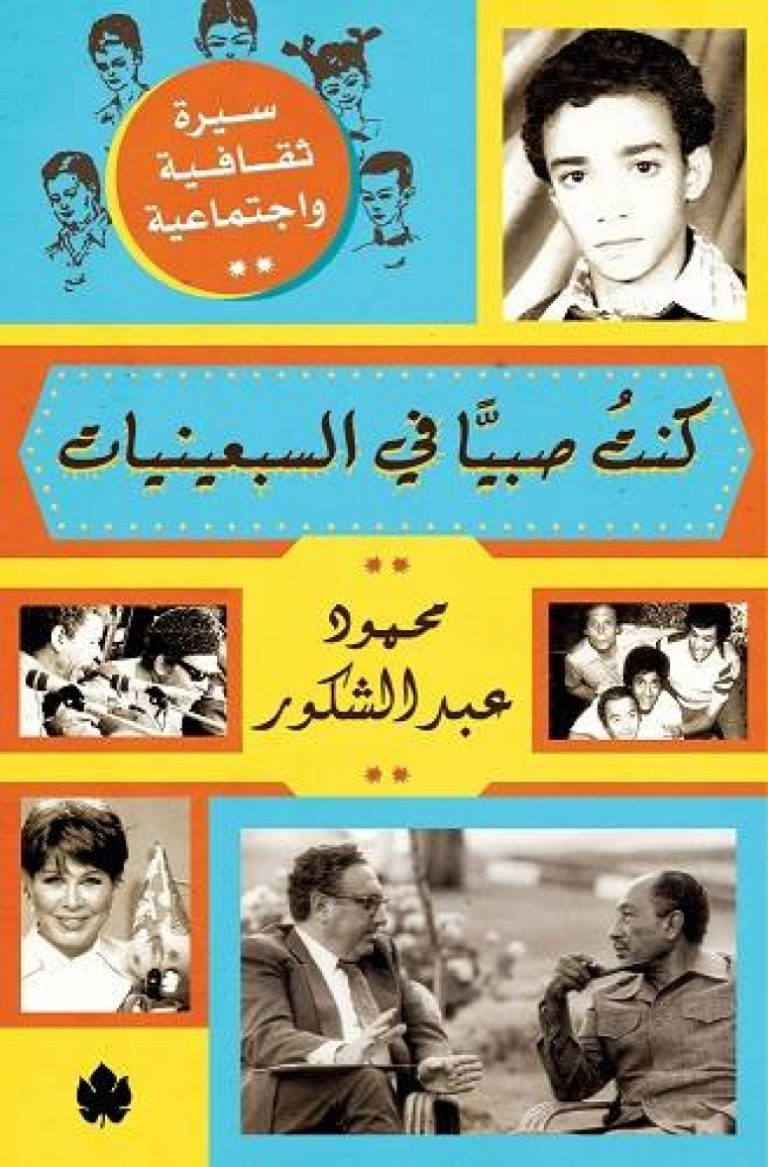تطل علينا “قانون الوراثة” بمقدماتها فنستشرف ملامحها التي تتبدى في تسامي الراوي العليم عن غمار الناس ليروي لنا مشاهد عن الطفل الذي سيبدأ بشخصه القَص علينا – في الأجزاء الأربعة التالية التي تكون مَتن الرواية – بضمير المتكلم. وبِتَحول صيغة السرد نقع في شَرك الرواي المتكلم ونتماهي معه على مدار الرواية مع تداخلات على استحياء للرواي العليم بين ثنايا الحكي بضمير المتكلم البطل متواريا خلفه. أما باقي الشخوص فتلتف حول الرواي، كلٌ في مداره يؤدي دوره كما كُتب له: استدعاء الأجيال التلاثة في سلاسة واقتضاب للتوثيق لثلاث حقب زمنية مرت بها البلاد دون حشد لكثير من التفاصيل: عهد ملكي يخص جيل الجد يليه عهد بدايات الجمهورية وحلم التصنيع الثقيل الذي فاق منه جيل الأب والمجتمع على انفتاح وهجرات راحت معهما أضغاث الأحلام ليرث الراوي هذه التركة ونرثها معه جاثمة على صدور الجميع.
لا يسبر الرواي هنا أغوار لا تُخصه. فقط يتركنا أمام مراياه الشخصية المستوية وتعدد مستويات الرؤية خلالها:
“فوق الصنبور خزانة صغيرة لحفظ معاجين الأسنان وما شابه، ضلفتاها على هيئة مرآتين تنفتحان إلى الداخل فتتواجها، وتمنحاك أعظم فرصة في حياتك: أن ترى نفسك في مرآة عبر مرآة أخرى.
أن تنظر إلى نفسك في المرآة مباشرة فأنت لا تراها، بل ترى عاطفتك نحوها التي تسبغ على الصورة المرسومة جمالا في كل الأحوال…لكن إياك والاندياح وراء التكرار اللانهائي للصورة في الانعاكاسات المتعاقبة، ذلك قد يمنحك وهما بالخلود.
اكتف بمساعدة الانعكاس الثاني لصورتك، في المرآة، ستتعلم ألا تعشق ذاتك ذاك العشق الأعمى، وتضبطها حين تتجمل، وتخضها لسياطك كي ترفع عنها كل ما ليس لها“.
كما ذكرت كون الرواية ترتكز ككثير من إبداعات ياسر عبد اللطيف على المكان، يُخيل لي أن الراوي سائحا بكاميرا حديثة يلتقط بها صورا ومقاطع فيديو من قلب الحدث جانحا إلى خيارات جمالية للمشاهد المُنتقاة، عدسات الكاميرا عالية الجودة ولا حاجة لها بتقنيات تنقية الصورة أو تذييفها حال سيره. كما أنه لا يتملص فيها من رومانسيته – على حد تعبيره– بل يحاول تقليصها قدر الإمكان.
فبين حين وآخر يلتقط لنا الراوي المتكلم صورة “سيلفي” تجمعه بمحيطه – قبل ظهور التقنية بصورتها الحالية بعقدين وبضع سنين- فنرى تصويره لكادرات تجمعه في المقدمات بذوي القرابة من الدرجة الأولى يليهم الأصدقاء فالزملاء بل وأحيانا “خلفه ذيل طويل من خيبة الأمل، ومصابا باحتقان في آماله.” مذيِّلا الصورة بعبارة: “مُعلمة الرسم، أعضاء مؤسسة الحرية، جامعة القاهرة … شكرًا”
ثم يعود في الجزء الأول المُعَنون “الفاشيون” لالتقاط صورة بِكَادر أوسع لتجمعه بتراتبية الجامعة الأم في وصف بديع على اغتراب صاحبه:
“أمم من المستظرفين ومن المكتئبين.. ومن المسيسين ومن الملتحين ومن الفتيات المحجبات ذوات العيون الحزينة وأنصاف العاهرات.. وقلة من الفتيات الجميلات داخل مؤسسة مبنية علي’ هيراركية'(تراتبية) الاحتقار فالأساتذة يحتقرون الطلبة والطلبة المسيسون يحتقرون غيرهم لأنهم قادة وأصحاب سلطة بالقوة. والطلبة المثقفون يحتقرون الجهلاء طلبة قسم اللغة العربية ومعظمهم من الجماعات الإسلامية يحتقرون جاهلية القرن العشرين. طلبة أقسام اللغات يحتقرون طلبة الأقسام الأخري علي أسس طبقية.. ونحن في قسم الفلسفة نحتقر كل هؤلاء لأننا أصحاب المعرفة الشاملة.”
ويضحى التصوير سينمائيا بامتياز في الجزء الثالث “جدول اللامعقول أوالمعادي صيف 88” حيث شلة مخدرات الكيمياء – بكافة أنواعها المُدرج منها في الجدول وما لم يُدرج بعد- والتسكع بين صيدليات المنطقة لإحياء العظام من رميمها وغُرز الحشيش بأنواعه وأوكارهم الخاصة في حلهم وترحالهم، لنصل لذروة الأحداث على لسان الراوي وهلاوسه فتغدو الصورة غرائبية على واقعيتها بحيل شباب يضج في رأسه كلمة : “يأس… يأس…يأس… وصار لسينها هسيس يتردد كصدى لا نهائي، كلما أوشك على الإذواء رنت الكامة من جديد وهسهست السين، صارت الكلمة تحتل رأسي بكاملها تُعرض علي حروفها الثلاثة مُفككة ثم مُتصلة، ويستمر صداها يدوي حتى خلتني أقرأ كتابا عن اليأس”. كما يقدم لنا ياسر في هذا الجزء تجربة التعاطي باندياحاتها المختلفة بسلالة سردية وبتوصيف أدبي راق لا يخلو من التطعيم ببعض العامية لتأكيد معاصرته. يبقى القول أن الوصف والتخييل في هذا الجزء يُقرب القاريء من التجربة الشخصية للراوي بشكل منقطع النظير فنتقزز لتقززه ونرى معه خيالاته وهلاوسه من الحشرات والحيوانات التي تحيط بهم.
وفي خِضم الحديث عن اللغة الياسرية -في عذوبتها و روحها ونكهتها الخاصة- لا يسعنا سوى الإقرار بإنها كتابة أسلوب بامتياز: فمن بين ثنايا الأحداث اليومية واستجلاب الماضي والتخييل حوله بنزعة تأملية للسرد يُعاد تثمين النص بمرور أزمان قراءته كالخمر المُعتق. فلا تناسب الرواية أو الكتابة الياسرية عموما ذلك القارئ اللاهث المتعجل لمشهدية مثيرة طوال الحبكة. أذكر أن ذائقتي قبل قراءة قانون الوراثة مباشرة كانت تميل لحكي مليء بالحركة على طريقة أفلام الإثارة والكتابات الشبيهة بها، فجاءت القراءة الأولى مُحبطة لذاك القارئ اللاهث داخلي ومع القراءة الثانية وقعت في أسر السرد المتريث المميز لصاحب “قانون الوراثة”: فمع القراءة الأهدأ تبدأ المعاني العَصِّية في التكشف والدُنو منك. فتتوحد مع مشاعر الأبطال من الصفحات الأولى فوددت لو كنت دُنيا التى احتضنت الراوي طفلًا “ولتحتل حياته لسنوات بعدها”. ثم لأُقارن وضع الجامعة في الرواية مع جامعتي اليوم، بل وداخل أروقة كليتنا “آداب القاهرة” وتصنيف الطلبة وأساتذتهم ورؤيتهم للآخر.
فكما نري ينأى السرد بنا من مجرد تقسيم ذكوري ونسوي لشخوصه لنخضع لسطوته مرة أخرى لما يحتمله الخط السردي من عبور الشخصيات الأدبية وفقا لما رُسم لها: فنري العم والأب والأم والجارة، الصديقة الفرنسية الكندية، زميلات وزملاء الجامعة، ندماء المعادي، الصيدلي وطبيبة الأسنان، وسط باقي شخوص الرواية. فما تم تأويله من حضور خافت للمرأة – والذي يتبدى لمعتنقي الجندرية ملمحا ذكوريا- يمكن توصيفه بأن الرواية تستبقى مشاهد مختارة وتغزل حولها حبكتها. فاختيار الكاتب للبطل الذكر والتخييل حول دور الوراثة في نشأته تُبرر حجم ظهور شخوصه. ويطالعنا الكاتب في نصوص أخرى بأنسجة مختلفة لها صفاتها أيضا التى ربما ترضي الجندريين بنفس الحس الجمالي لأسلوب الكاتب. أما فيما يخص الحوار رغم رؤية البعض لغياب الحوار أشعر أنه ورد متواترا على مدار الرواية ولكنه ربما لتخلله للسرد وللغته العذبة على جنوحها الطفيف نحو العامية بات شفيفا للعيان.
وفي إشارة إلى عنوان الرواية الذي يُكلل العمل من بدء السرد مع الطفل وسيره في طريق المدرسة بعد غياب الأب حتى نافلة القول : “ورأيت ظهره يبتعد في الزحام ، مسرعا في مشيته علي حافة الركض ، يتلفت خلفه كمطارد حقيقي . كنت أجاهد لألحق به ، بذلك الوجه ذي الملامح الغامضة التي أعادت إليَّ ذكري حكاية قديمة . بينما هو يفر أيضا من ملامح قديمة عرفها ، ملامح أبي وأعمامي التي تسكن وجهي– ” .وبين الهروب من عوامل الوراثة والفِرار إليها- نتأرجح دوما في خارطة طريق ما تلبث أن تتسع حتى تضيق حلقاتها وتستحكم من جديد في متتالية زمكانية لا مفر منها. فرحلة الذات في الطريق ورحلة الطريق في الذات بدأت بطريق مفروش بالعجين وانتهت في السعي في طريق آخر وتبقى فيه الأماكن خزانة وزادا تخرج لنا معين الكاتب: شعرا ورواية ومقالًا ولازلنا معه ومع الكتابة وسبلها التي لا تنضب.
تبقى الإشارة إلى أن كتابة ياسر عبد اللطيف تعد رأس ماله الحقيقي –كعادة أصحاب الكتابات الكبيرة- فهي تضعنا أمام حصيلة لُغوية ومعلوماتية وأحيانا روحية نكنز بها ذواتنا في سرده نثرا وشعرا بلغة مختزلة جامعة وقواميس متعددة تشمل جوانب حياتية متنوعة: في السياسة والدين والتاريخ وبل وتمتد لعوالم المخدرات كما بدا لنا في قانون الوراثة وغيرها. فحجم أعماله – في خفة وزنها وارتفاع قيمتها- تضعنا دائما فوق الحصان الرابح مقتنصا لحكي رائق ومستثمرا للوقت. فبحجز مقعدك بين جمهوره تثري روحك بحيوات النص التى تتعَدد بتعدُد الحيوات التي تطرق لها السرد في صولاته وجولاته -كعهد النصوص الأدبية التى تجذبك بخفة لتحن لإعادة الأُنس بها لتتفرس من جديد تلك الملامح التى لم تتكشف لك من القراءة السابقة- فإن لم ترجع بعدها بمعرفة مغايرة لن تفوتك متعة اللغة الرائقة التى تغسل عن روحك وعثاء السفر .كذلك يمكننا الرهان على أن للنص الياسري حيوات أخرى في اللغات التي سبق وقد تُرجم والتي سوف يُترجم إليها، على اعتبار أنها يمكن أن تُصنف بيسر في إطار “رأس المال الثقافي” للثقافة المصرية المعاصرة أو ربما إلى رأس المال الثقافي للثقافة العالمية.