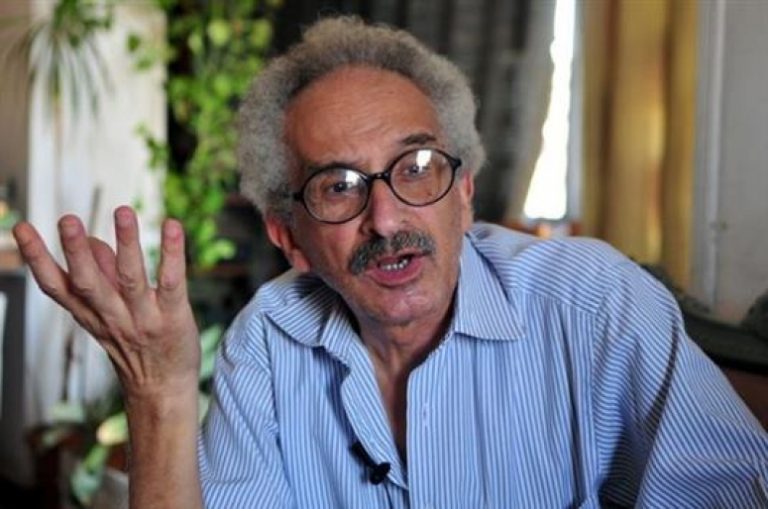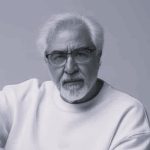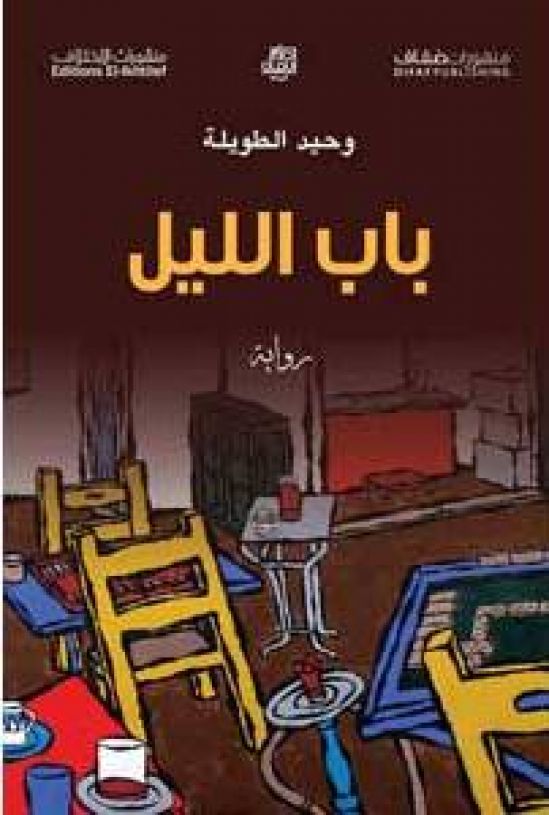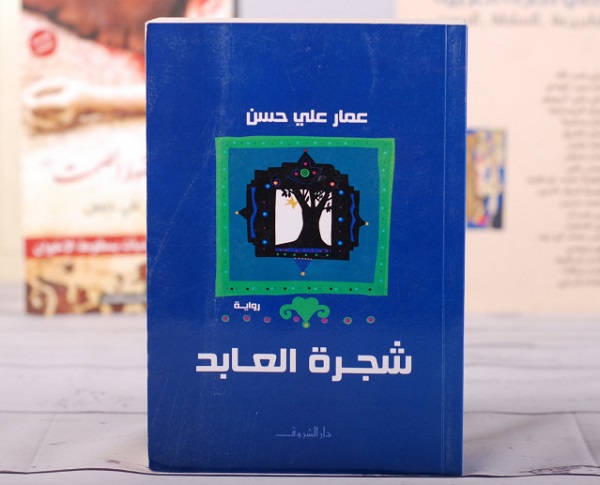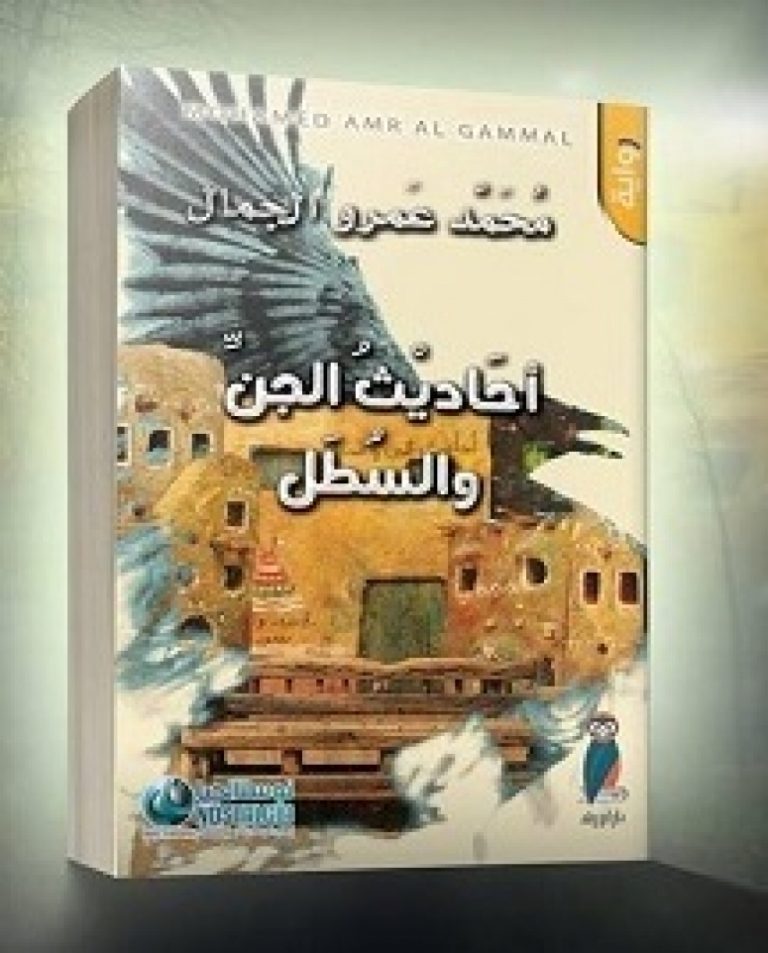مجدي نصار
في مجموعته القصصية “حبيبتي طبيبة العيون السرياليّة” الصادرة عن مؤسسة “بَتَّانة” الثقافية للعام 2022، يقدم لنا الكاتب أشرف الصَبَّاغ خمس قصص طويلة “نوفيلات” تتباين أحجامها وتتنوع في طرائق السرد وبيئته. فتتجلى “القاهرة” بالقصص الأربعة الأولى إلى أن تنال “الإسكندرية” نصيبًا كبيرًا وحضورًا أنيقًا وحظًا سعيدًا بالقصة الخامسة.
1. العنوان والصورة الوصفية:
يمنح الصَبَّاغ مجموعته القصصية وأولى قصصها عنوانًا طويلًا، رباعي المفردة وثلاثي العنصر، فيرسم لنا صورة كاملة لشخصية الحبيبة “حبيبتي” ومهنتها “طبيبة العيون” وتوجهها الفكري/ الفني “السريالية”، ما يضعنا في حالة تَشَوُّق للتعرف أولا على الشخصية وثانيا على حبيبها (صاحبها/ السارد) وأخيرًا على حكايتهما معا، كما يجعلنا نتوقع التعامل مع أنثى ليست عادية “سريالية/ فوق منطقية/ لا نظامية”.
2. المدينتان– الأصل والصورة:
بين عِشقٍ للمكان والناس ومسائلةٍ للواقع والحال والطبائع التي تَبَدَلَتْ، يجوب القاص المدينتين.
هو المُتَيَّم بالأحياء الشعبية للقاهرة حين يقول عنها بقصة (السيوفي– صفحة 63)، “غير أن وجود عدد من أضرحة ومقامات أهل البيت وأولياء الله الصالحين في مثل تلك الأحياء يجعل الحكايات والأساطير أكثر من حقيقية ويضفي عليها هالة من السحر والعراقة والقدم”.
كما أنه هو نفسه النافر من المدينة والكاشف لوجهها الحقيقي حين يقول بقصة (الورشة– صفحة 94) “مدينة شائخة ومشوهة. لا أحد يعترف بذلك إلا في القصص والأشعار. كلهم يتفاخرون بعراقتها ومجدها، ويتجاهلون عمدا تلك البثور والتجاعيد التي تغطي وجهها القبيح.” وحين ينتقد سكانها بنفس القصة (صفحة 95) “سكان يقسِّمون بعضهم البعض إلى قرويين وأبناء مدينة، مسلمين وكفار، يحددون درجة التحضر والمدنية بقدرتك على الإمساك بالشوكة والسكين، أو بطريقة تناولك الطعام، وهم يدركون جيدًا أن الخبز والماء لا يحتاجان إلى أي أدوات سوى بطن جائع وفم مفتوح”.
هو المفتون بالإسكندرية حين يصفها بقصة (أول الأرض وأول البحر– صفحة 135) قائلا “إنها امرأة بأجوائها المتقلبة وفصولها المتعاقبة، بطقوسها وتعاويذها وسطوة حضورها، بحنانها وحنينها وجموح بحرها، بتضاريسها المهيمنة على الروح، وبقدرتها على خلق الحياة ومنحها لأبنائها وللغرباء على حد سواء.” وهو المُبَجِّل للسكندري حين يصفه بنفس القصة “والسكندري هو أصل الإنسان، أما البقية فهم مجرد كائنات، يمكن أن نبحث لها عن أسماء مناسبة”.
ثم يعود السارد ليصف السكندري بقوله “السكندري كائن ملعون ابن شوفينية” ثم يسأله، “من الذي ألبسك هذا الزي الغريب والملامح الغريبة والكَلَم الغريب والسيف الغريب؟ ضد من توجه سيفك وفي قلب من تغرسه؟”
3. المعرفة والإحالة:
ما لا يمكن أن تخطئه عين تقرأ المجموعة هو امتلاك الكاتب لكم هائل من المعارف واتساع اطلاعه. فهو يتنقل بين المعارف التراثية “شرقية وغربية” والتاريخية “قديمة وقبل حداثية وبعد حداثية” والجغرافية والعلمية والأدبية والفنية “موسيقى وسينما وفن تشكيلي … إلخ.”، ما يحيل القارئ إلى مناطق سردية بعيدة وصور متنوعة ترتبط بالسرد…
قرب نهاية القصة الأولى يستعرض في فقرة واحدة عدد كبير من السرياليين من الأقدم إلى الأحدث. يحيلنا في القصة الأخيرة إلى (لورانس داريل) ورباعيته عن الإسكندرية التي “تبدأ فينا وتنتهي”. ثم يرتدي عباءة الجغرافي العظيم، الراحل جمال حمدان ليمنحنا فقرة بديعة في الصفحة (112) يبدأها بــ (للجغرافيا المتوسطية مفعول السحر، لأنها تؤكد أن لا شىء بعيد ولا شيء ثابت، ولا شيء ملموس ولا شيء ساكن….” هنا يكتب عن الجغرافيا بحُب يغلف به المعرفة. يعود بنا إلى “الإلياذة” ويمنحنا قائمة بالأقاليم المعاصرة وأسمائها الفرعونية القديمة.
4. اللغة ومستوياتها:
بلغة بسيطة ومركبة في آن- وصياغة تتراوح بين المعتاد والمغاير وتتنقل بين الهادف والأخَّاذ، وجمل تأتي قصيرة أحيانا وطويلة في أحايين، ومفردة فصيحة ورصينة تمتزج بأخرى عامية وشائعة– يسرد الكاتب قصص المجموعة.
إلى جانب المفردات الفصيحة على بساطتها والتي تمثل الركن اللغوي الرئيسي للقَصْ، يستخدم الصَبَّاغ ألفاظا أعجمية مثل “ميني سكيرت” وألفاظا عامية كما جاء في: “شبشبت له”، “من المنقي يا خيار”، “البِشلة”، “له شنة ورنة”، “الواد بلبل ابن الملعونة”، “يقعدان مع بعضهما على مقهى عم عبد العزيز”، و”بسمات تقول للقمر (قوم وأنا أقعد مطرحك)”.
تتجاور الجمل القصيرة مع الجمل الطويلة التي تحمل وصفًا يجعلها تقر في خاطر القارئ وعينه وذهنه ويدفع به داخل العالم السردي.. يقول “حبيبتي طبيبة العيون السريالية نورهان هانم أباظة”
يستغل تقنية التقديم والتأخير في بعض الصياغات مثل “لسيوفي كانت عيون كثيرة في الحواري.” كما يصنع صياغات مغايرة يبدل فيها مواقع الخبر والحال، كأن يقول بترتيب مختلف “وأن الكثرة تغلب دائما الشجاعة” عوضا عن “….. الشجاعة دائما”
ولعل أبرز ما يميز اللغة بالقصص هو تنويع الكاتب للمفردات داخل الجملة الواحدة ما يضفي عليها التوكيد ويمنحها اتساعًا في الأثر الذي تتركه في قارئها. يقول مثلا: “وفجأة نزلت على رأسي الكفوف (والقبضات) ولم ينسوا (الركلات) (والشلاليط)”، “كر وفر.. صراخ وبكاء.. فرح وانتصار”، “صداقتي وصحبتي وقضاء الوقت معي”، “الليل والوحدة والطريق” و”ننقل عن بعضنا قصص وتواريخ وبطولات وخوارق”.
5. الحس الفكاهي ومهارة إبداء السخرية:
لا بد للكاتب أن يعرف كيف وأين يغرس الفكاهة بين ثنايا الجَدّ. والحق أن السارد قد مارس ذلك بذكاء إذ جاءت العبارات التي تحمل حسا فكاهيا في موقعها تماما ودون ابتذال. في قصة (حبيبتي…)، يقول عن المفارقين للواقع أنهم يتحدثون في “اللا شيء في الفراغ الأسطوري المنطلق من خشاش الأرض…..”. وعن “دودو” في (قصة النملة) يقول “تعشق الفقراء والمهمشين لكنها تفضل أن تجلس بعيدا عنهم حتى تستطيع أن تفكر من أجلهم”.
6. الوصف:
يمتلك الكاتب قدرة بديعة على الوصف مستعينا في ذلك بأربعة تقنيات: الصبغة الجمالية التي يغلف بها الجملة، المفردات الواسعة التي ينوعها داخل الجملة الواحدة كما أشرنا سلفا، الحس الفكاهي، والمعرفة العريضة.
يصف الحبيبة السريالية بأنها “أجمل من ملاك وأشهى من الرغبة نفسها.” وبأن “كل ما فيها جميل ورائع وبديع، وملائكي ومثير في آن.” وحين يصفها وصفا فيزيقيا يبرع في ذلك، صفحة (10) “طويلة ورفيعة ومتناسقة الجسم والملامح بعيون سوداء وشعر فاحم وشفتين فاتنتين شهيتين وساقين طويلتين عاجيتين، وبشرة ملائكية ونظرات ترفع درجة الحرارة إلى ما فوق التسعين درجة مئوية، وابتسامة تذيب ثلوج القطب الشمالي وبحر النرويج والجزء الأشد برودة وصقيعا من سيبيريا”. يصف فستانها بأنه “فستان قصير لغاية الغاية نفسها!” وأنوثتها بأنها “موهبة أنثوية تثير الجبال وتقلب المجرات رأسا على عقب”
يصف “شرشر” في قصة (النملة) بأنه “أنتن من صرصار وأحط من فأر” ويصف الجُرحْ “البِشلة” في وجه (السيوفي) بأنه “يبدأ من تحت حلمة أذنه ويمر بخده الأيسر ووسط أنفه ليصل إلى خده من الناحية الثانية”. ببراعة يمنح “بطة” _ في قصة السيوفي_ جملة وصفية تغنيك عن صفحة كاملة من الوصف، فيقول “كانت تمشي في الشارع فتجبر الجميع على النظر إليها” ثم يعود ليقول في نفس الصدد وبنفس البراعة، “كأن لا أحد سواها يسير على الأرض”!
في قصة (الورشة)، وبعد أن يمنح جو الورشة وطبيعة العمل بها وصفًا تفصيليا جيدًا يُجمِل الوصف كله في جملة واحدة تختزل كل ما فات “عالم صغير ملىء بالأسرار والدفء والوشايات والمعارك والمرض”. ثم يصف الماكينة التي لا تعمل بأنها “ماكينة تقف كعانس يأتي إليها الخطاب ويفارقونها دون رجعة” في تشخيص بديع يضفي صورة شاعرية على السرد.
في (أول الأرض وأول البحر) يصف خيال السكندريين بأنه “بوسع البحر المالح” وضحكاتهم بأنها “واسعة مثل البحر” والإسكندرية بأنها “أول أرض التي ولدت الأراضي الأخرى” وعن نساء المدينة عند الشاطئ يقول “عندما تبدأ أولى أشعة الشمس في التلصص على أجساد نسائنا الحلوة المشدودة”.
يصف ضحكة (السيوفي) بأنها “ضحكة رائعة ورائقة” وابتسامته بأنها “خلَّاقة”.
7. المضامين الفلسفية:
على جودة السرد والوصف والحوار بالقصص إلا أنها تحمل رسائل وفلسفات يريد الكاتب توصيلها. تأتي الرسائل أحيانا مباشرة بالعرض والتقرير وكثيرا ما تأتي متوارية خلف حجاب السرد، لكنها جميعا تتحرك مع النص ولا تبدو منفصلة عنه.
ينقد الواقع ويُعَرِيه ويعري الذات والآخر؛ الأنا والـ”هو” والـ “نحن”. يقول عن رئيس التحرير الذي يعمل مرشدا للأمن، “رغم أنه يحصل على راتبه كاملا من الصحيفة وليس من وزارة الداخلية”. ينقد اليمين المحافظ واليسار على السواء ويتهم أناس من الطرفين بحمل نفس الأفكار الرجعية. يتطرق إلى فساد البعض في الوسطين السياسي والثقافي.
في (النملة) يستعرض أزمة ممارسة الكائنات الأقوى التسلط على الكائنات الأضعف، عائدا في التاريخ إلى زمن كانت فيه كائنات أكبر من البشر كالديناصورات هي الحاكم للبيئة، كما يستعرض بعض الأفات المجتمعية كالوصولية وانعدام الموهبة وتفشي الكلام وانعدام الفعل”. يصف البشر في عيون النمل “لكنهم لا يدوسون علينا ويقتلوننا نحن فقط، بل يفعلون ذلك مع بعضهم البعض”.
في قصة (حبيبتي) يتطرق إلى توريث المناصب “الدكتورة شفعات وابنها”.
بتفكيك الشخصيات في قصة (السيوفي)، تقترب طبائعهم من بعض الساسة المعروفين ونظرياتهم المتغيرة والتي رغمها ومعها يظل المواطن على حاله مقهورا مطحونا، فنجد أن “سعد ندا” يرفع شعارات الاشتراكية في الشارع والمقهى لكنه داخل مصنعه يمارس أقسى ما طعنت به الرأسمالية الفقراء والعمال، إذن نحن أمام شخصية ثرية سرديا، رجل متناقض اشتراكي القول ورأسمالي الفعل. يناقش كيف أن جيل الأبناء يخرج مشابها للآباء فتتكرر المأساة “سنكبر ونشتري– المخدرات– لأنفسنا، وسيشتري لنا أولادنا”.
8. الحوار:
يتسم الحوار عند الصباغ بثلاث سمات رئيسية: الديناميكية إذ يتطور بين المواقف، والفاعلية إذ يحرك الحدث إلى الأمام ويعكس طباع الشخصيات النفسية، والملائمة حيث يتناسب مع خلفيات الشخصيات وأعمارها وثقافتها وشعورها داخل الموقف القصصي.
نجد مثلا أن السارد الصبي في (السيوفي) يكرر كلمة (عم السيوفي) مع كل جملة يقولها للسيوفي فيما يقف قبالته مرعوبا مذهولا لحضرته. كما أن حوار الصبي نفسه جاء متقطعا وغير مرتب، ما يجعله متسقا مع حالة الخوف التي أصابته.
طبيبة العيون السريالية نورهان هانم بنت الأكابر، تتدنى سلوكيا فجأة وتسب السارد بألفاظ خادشة تعلمتها جراء مخالطتها لطبقة شعبية تتعاطى معها حيث تقطن.
9. الأسلحة السردية (الشخصيات والمشهديات والأدوات والأساليب):
– القدرة على رسم الشخصيات التي يألفها القارئ ويتفاعل معها بسهولة. تنعكس طبائع الشخصيات من خلال السرد التقريري الذي يمنحنا معلومات حولهم أو خلال السرد المرتبط بالفعل والموقف والذي يقدم لنا ما وراء الفعل. الشخصيات متوازنة بلا شر مطلق أو خير مطلق، فالسيوفي مسجل خطر لكنه يحمي الناس من بطش الشرطة والفتيات من معاكسات المتسكعين، و”عم جابر” تاجر المخدرات “رجل فيه خير وإحسان”.
– صناعة المشهديات الجديدة والغريبة أحيانا:
يتجلى ذلك في مشهد اعتراف الطبيبة بحبها للسارد والوصف الحركي للقبلة التي جمعتهما واللحظة وما حولها. كما يتضح في مشهد طرد الطبيبة لحبيبها من العيادة الخاصة بها والصَبَّاغ في هذا المشهد يكون صورة (كادرا سينمائيا) يمزج الثابت بالمتحرك ويجمع بين غرفة الكشف من الداخل والعيادة من الخارج حيث السارد يتحرك مطاردًا من الطبيبة وسط متابعة الزبائن وتجمع الأطفال حول حبات الفاكهة التي انفرطت بعد أن قذفته الطبيبة بها.
لدينا مشهد بديع يصف فيه نزول النساء السكندريات إلى البحر وحالهن بعد خروجهن منه.
يصنع مشهدا مفارقا يتخيل فيه الناس يتوقفون عن تعاطي الحشيش فيما يستمعون إلى خطاب عبد الناصر ولا يعودون إلى سيرتهم الأولى إلا مع انتهاء الخطاب واصفا اللحظة بقوله “بمجرد انتهاء الخطاب، يعتبر الناس أن مدفع الإفطار قد انطلق”!
– براعة الحكي وتنويع الأدوات.
الصَبَّاغ حكاء ممتاز يُلم بتقنيات الكتابة الأدبية (الوصف والسرد والحوار) ويمزجها بتقنيات الكتابة الصحافية/المقالية التي لا تتعارض مع السرد، بل تمنحه رسوخًا حين تُستخدم، مستغلًا نمطا لغويا يخصه ومعرفة واسعة فتخرج منتجاته القصصية مميزة بصبغته.
يتضح التأثر بالصبغة الصحافية مثلا في مناطق معينة يكسر فيها الإيهام: قصة (النملة) حين يقول “لا يمكن أن نأخذ كلمة (تُفَكِرْ) على محمل المزاح أو السخرية أو الجد أو الإنذار بالخطر”.
تعاود الصبغة الصحافية الظهور في (السيوفي) فعناصر السرد (الشخوص والمواقف والأمكنة) تبدو حقيقية رآها السارد رأي العين في حياته أو سمع بها فوضعها في قالب قصصي مكشوف دون مواربة أو ترميز.
يتضح التأثر بالكتابة السياسية والاجتماعية في عبارة كهذه بقصة (السيوفي) “فقرر سعيد أن يسير على نفس خط التصعيد”
– حيوية النص وتغيير أسلوب السرد وطرائق البدء والختام:
يتغير أسلوب السارد بين حين وحين. ينتقل من العام إلى الخاص ثم يعود للعام. يسرد من وجهات نظر متعددة: السارد العليم والسارد نصف العليم والسارد المتشكك ومن وجهة نظر المحيطين بالسارد.
أغلب الجمل السردية _ الطويلة تحديدا _ تعكس بذاتها صورة سردية (موقف أو فعل سردي) أو بعض صور؛ في (السيوفي) مثلا يقول، “لعبنا وجرينا وركضنا وتمرغنا على النجيلة الرطبة”.
يُنوع الكاتب بين طريقة بدء القصص وطريقة ختامها.. يبدأ (النملة) بــ “أنا نملة، لكنني لا أحب النمل كثيرًا”، يبدأ (السيوفي) بعبارتين وليس بجملة كاملة “والاسم، أو مكان الإقامة” وينهها بصورة خيالية يتخيل فيها السارد عودة السيوفي إلى الحياة بعد أن انتشر نبأ موته! يبدأ (الورشة) بجملة تشويقية يغيب عنها اسم البطل الموصوف “ذلك الشبح الصغير الذي يقف في عتمة الفجر بعينين مغمضتين تقريبا” وينهها بنفس المشهد ولكن بصياغة أخرى “شبح له قلب صغير يدق عندما يخاف وعندما يحلم”، يبدأ (أول الأرض وأول البحر) بــ (نحن السكندريون، خيالنا بوسع البحر المالح” ويختمها بعدد من التساؤلات..
في قصة (السيوفي) حكاية متطورة يتنقل فيها الحكي بين عدد من الشخصيات الذين يزورون مسرح السرد تباعا: السيوفي، صبحي أبو شرطة، بطة وسعد ندا بالإضافة إلى السارد ذاته. تتحرك الحكاية بين الشأن العام في الوايلي والشأن الخاص للأبطال وعلاقاتهم ببعضهم البعض.
السارد المتشكك دائما ما يجذب القارئ للنص أكثر من ذلك الذي يعرف كل شئ داخل نفوس الشخصيات وفي العالم خارجها. والسارد في مناطق كثيرة يتساءل كالقارئ تماما عن النوايا والمقاصد وما وراء الأفعال مما يمنح النص المصداقية.
في ثنايا السرد الخاصة بالفصول الأربعة لقصة (أول الأرض وأول البحر) يتساءل الكاتب عن سبب ما حل بالإسكندرية ومصر عموما، كما أنه ينهي الفصول الأربعة بنفس التساؤلات “ماذا حدث بالضبط؟ لا أحد يدري! لقد استيقظنا ذات صباح، فإذا الشمس غائبة، والقمر غائب، وملامحنا غائبة، والبحر غاضب، ووحوش سوداء كاسرة تحجب الهواء، وتغلق النوافذ والأبواب” ثم يضيف في نهاية الفصل الرابع ونهاية المجموعة “وكلما صحونا وجدنا مصر قد ابتعدت عن البحر وتوغلت في الصحراء” ليعلن لعنته على الصحراء وتمجيده للبحر.
تبدو طريقة السرد في (الورشة) كلاسيكية وتخالف المتبع في القصص الثلاث السابقة لكنها قُسمت إلى فصول صغيرة امتلأت جنباتها بسرد متطور وجمل مختزلة رشيقة ووصف بديع للناس والأماكن والمواقف. فقرة كهذه تمزج كل تلك الأدوات “سكت الأب. بينما راح هو يحكي لها- أمه- بفرح عن الترقية والمرتب الأسبوعي، وأنه سيوفر مصاريف الدراسة والملابس وسيساعد في مصروفات البيت. وكان في قرارة نفسه يحلم بالذهاب إلى السينما وشراء المجلات وكتب الألغاز. كان يرى بالفعل أنه اشترى هدية عيد الأم من حر ماله، وحذاء جديدا من باتا، وقميصا أزرق، وشورت، وبنطلون، وميدالية مفاتيح عليها صورة عبد الحليم حافظ، ويأكل ساندويتش شاورما أمام سينما ميامي يوم الأحد– العطلة الأسبوعية.” يتطور السرد في (الورشة) باستغلال التفصيل ثم الإجمال وإخلاء مسرح السرد من الشخصيات تباعا، فالورشة تضم الجميع في البدء ثم تخلو من النساء “الورشة بلا نساء” ثم تخلو من “سعيد” الذي مات “اكتسبت الورشة رائحة الموت”.
يٌقَسِّم (أول الأرض وأول البحر) إلى أربعة فصول يحلل فيها الواقع السكندري الحالي ويستعرض تاريخ الإسكندرية منذ القدم، ويصحبنا في جولة جغرافية متقنة التفاصيل داخل الأحياء وعند الشواطئ. يسرد كيف تبدلت الشريحة السكانية المقيمة بالمدينة وتحولت من التعددية والكوزموبوليتانية إلى نمط غريب دخيل ويتساءل كيف عبر هذا الدخيل الثقافي بحرا يربط قارتين واستقر في المدينة الجميلة كما استقر بمصر كلها.
في (أول الأرض وأول البحر) يعتمد الصَبَّاغ تقنية التكرار: تكرار الجمل مع تنويع الصيغة “أرض شماعة لا تشبه أي شيء سوى الفراغ – أرض شماعة لا تشبه أي أرض”، وتكرار التساؤل في نهاية الفصول “ماذا حدث بالضبط؟”. يحكي بعيون السارد طفلا ثم بعيونه صبيا ثم شابا ثم ناضجا يملك من الخبرة ما يُمَكِنُه من محاولة الكشف عما أصاب المدينة من تحول حتى “بُترَت” عنها “روح الخيال والجمال والجلال”.
– القدرة على التوليف بين العناصر.
أهل الإسكندرية توحدهم أربعة أشياء: رائحة البحر وصوت أم كلثوم وخطب عبد الناصر وصوت عفاف راضي. وجميع الجنسيات كانت تقطن الإسكندرية في الماضي، وتاجر المخدرات كان يجاور المدرسة ويحسن معاملة التلاميذ.
10. الفانتازيا:
إن الفكرة الرئيسية لقصة (النملة) فانتازية بامتياز يبدأها الكاتب بقوله “أنا نملة” ثم يعرض حياة البشر ومثالبهم من وجهة نظر حشرة لا تقارن حجما أو فكرا بهم ويعري واقعهم من خلالها ….
11. السريالية؛ في البدء وفي النهاية:
يصل الصَبَّاغ إلى ذروة التمكن السردي واللغوي بالفصل الثالث من قصة (أول الأرض وأول البحر) فيبدأ بما يشبه القصيدة- الدُنقُليَّة تحديدا- أو المعزوفة القصصية، على مستوى الصياغة وعلى مستوى المحتوى السردي ذاته. إذ إننا أمام لوحة سردية بديعة تمتزج فيها الصور الفانتازية والمفارِقة “وهبطنا إحدى درجات الوجود فاستوينا مع الآلهة صفا واحدا” بالصور الواقعية، وتتداخل فيها المستويات اللغوية بين الشاعرية والخيالية والمتناصة مع المقدس. تتجلى اللغة الشاعرية في “معجونون نحن بماء العفاريت”، والخيالية في “قال قائل من بيننا وأخرج قلبه بيده فقلده كل الرجال فتفتَّحَت ورودهن مثل كون شهي اشتهى أشهى ما فاضت به الروح والشهوة وفريضة الحب الأولى” والمتناصة مع المقدس في “تفتح شفتيها عن أسنان بيضاء من غير سوء في ابتسامة لا عين رأتها ولا خطرت على قلب بشر”.