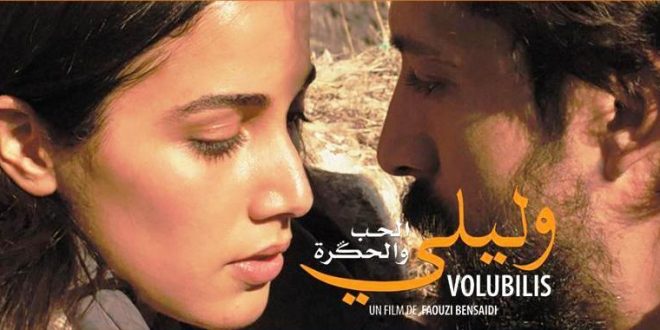محمد العبادي
في أحدث أفلامه يستمر الأمريكي المخضرم “مارتن سكورسيزي” في ممارسة هوايته المفضلة: إثارة الجدل، لكن ربما لم يتوقع هو نفسه أن يرتبط جدل فيلمه بالأحداث المتزامنة معه في النصف الآخر من العالم.. في أرض فلسطين.
فعبر مسيرته التي استمرت لأكثر من نصف قرن تعمد “مارتي” أن يقدم في أفلامه تساؤلات مختلفة عن الحياة بكل أبعادها ومكوناتها: الدين.. العرق.. أخلاقيات المجتمع. وإذا نظرنا بشكل أكثر تحديدا نجد أن هدفه الأكبر للتساؤل والجدل كان: الحلم الأمريكي الخادع، فمنذ بدأت مسيرته في البزوغ قدم نظرة مختلفة – قد نقول معادية – للنظرة التقليدية للمجتمع الأمريكي التي تصدره لنا دوما كمجتمع متحرر عادل يمنح فرص النجاح والسعادة للجميع، نرى نظرة “مارتي” المعارضة لهذا النموذج في عرضه لنيويورك وشوارعها الخلفية التي تعج بالمجرمين المهمشين المستبعدين من معادلة القوة والثراء، كما نراها في سائق التاكسي المجنون الذي يحوله هوسه الدموي بالأسلحة لبطل شعبي!، وهذه المرة نجده في سرده لحكاية جرائم قتل الأوسيج في أوكلاهوما في عشرينات القرن الماضي.
أشبهت الليلة البارحة.. الفيلم يؤرخ لفصل متأخر من قمع واستغلال أصحاب الأرض الأمريكية الأصليين على يد البيض المستعمرين الذين منحوا لنفسهم حق الظلم والعدوان، لم يكتفوا بطرد قبيلة الأوسيج من أرضهم الأصلية إلى أرض بعيدة وقاحلة بلا قيمة، بل استكثروا عليهم ما وجدوه فيها من الذهب الأسود، فاحتالوا ليسيطروا على ثرواتهم البازغة بكل الطرق، بالحب والزواج تارة، وبالعنف والقتل تارات.
مضى قرن على تلك القصة لكن لم يتغير الكثير، فقط انتقل الصراع من صحاري أوكلاهوما القاحلة إلى أرضنا، صرنا نحن “العرب” في مكان الأوسيج، وظل البترول والمال هما الهدف، وظل المحتل الأبيض يتنقل بين القتل والمهادنة ليصل إلى ما يريد، لكن للأسف اليوم تطورت أساليب الاعتداء على أصحاب الحقوق، فصارت الحرب إعلامية واقتصادية قبل أن تكون بالسلاح، وكما تحول السكان الأصليين لأمريكي إلى همج ومعتدين تحولنا نحن إلى إرهابيين لا نستحق الحياة، بل لا يستحق أطفالنا القتلى الشفقة.
الفيلم مبني على أحداث حقيقية ومأخوذ من كتاب بنفس العنوان لديفد جران، يؤرخ للجرائم التي ارتكبها البيض في حق السكان الأصليين من الأوسيج الذين أصابهم الثراء بسبب اكتشاف البترول في ارضهم، ولما لم ينجح البيض في الاستيلاء على ثرواتهم بالمصادرة والتهجير قاموا بذلك عن طريق القتل والتوريث
إنها نفس القصة لكن بشكل جديد تجري الآن، في الفيلم نلاحظ تعمد البيض التعامل مع الاوسيج بدونية، يصفونهم بالهمج ويصفون نساءهم بـ”البطاطين”، يقتلونهم بدم بارد، دون أن يبدو على القتلة أي قدر من التأثر أو الندم على ازهاقهم لكل هذه الأرواح من أجل النقود الملوثة.
بمقارنة التاريخ الذي يعرضه الفيلم بالحاضر نجد أن الفرق الأكبر هو ان المستعمرين أصبحوا أكثر احترافية وخبرة من اجدادهم، فسيطروا على الاعلام وسطروا القانون، ليتحكموا في من الذي يستحق الحياة ومن لا يستحقها.

ربما كان من حسن حظنا أو من حس حظ فن السينما عموما أن مارتن سكورسيزي قام بتنفيذ مشروعه هذا في هذه المرحلة من مسيرته، فقد أصبح مارتي الآن أيقونة سينمائية، ما أتاح له أن يصنع فيلمه كما يحلو له دون الإذعان لاشتراطات السوق وتحكمات شركات الانتاج، وحسنا فعل أنه لم يستجب للضغوط التي طالبته بأن يقصر وقت عرض الفيلم الذي بلغ ثلاث ساعات ونصف، لو استجاب لهم كان لينتج عملا مبتورا وربما قتلوا الفيلم كما قتلوا تحفة سيرجيو ليوني الأخيرة “حدث ذات مرة في أمريكا” من قبل.
ورغم الجدل الكبير عبر مراحل الانتاج عن طول الفيلم والمفاوضات لتقصيره إلا أن المتفرج العادي لا يشعر أنه أمام فيلم طويل، تمت صياغة إيقاع الفيلم بشكل جذاب، فالمشاهد لا يشعر بمضي الوقت، تجربة المشاهدة للفيلم لا تختلف كثيرا عن فيلم بطول ساعتين.
اعتمد مارتن سكورسيزي على خبرة مونتيرته المفضلة: المخضرمة ثيلما شوماكر التي عملت معه على مدى خمسة عقود وحصلت على ثلاثة جوائز أوسكار عن أفلامه، وربما تكون الأوسكار الرابعة في الطريق مع قتلة القمر، فقد استطاعت شوماكر أن تكسب التحدي الذي وضعها فيه المخرج أمام كل هذه المادة الثرية التي حفل بها الفيلم، فتعاملت معها بخبرة وحساسية كبيرتين، لتكون النسخة النهائية حافلة بالتفاصيل الفنية التي اجترحها المخرج على مستوى الصورة، وكذلك حافلة بتفاصيل أداء الممثلين الذين ظهروا في أفضل أداءاتهم، نسخة نهائية متماسكة بدون تسرع، ومتمهلة لكن دون أن تعطي فرصة لتسرب الملل للمشاهد.
تصوير المكسيكي رودريجو بريتو جاء متميزا مع تعدد مستويات الإضاءة في الفيلم تبعا لطبيعة المشاهد، خصوصا مع احتواء الفيلم لعدة مشاهد “حلمية” احتاجت لتطبيق غير تقليدي لتقنيات الإضاءة والالتقاط، كذلك واجه تحديات خاصة في مشهد الحريق، والمشاهد الخارجية التي حفلت بمصادر إضاءة خارجية: مثل أضواء الخوف التي أضاءت شوارع مقاطعة الأوسيج في الثلث الأخير من الفيلم.

نجح سكورسيزي أخيرا في الجمع بين “بطليه” في فيلم واحد: دي نيرو ودي كابريو، الثنائي الذي وثق فيهما عبر مسيرته فكان لهما نصيب الأسد في بطولات أفلامه، وإن كان قد نجح في منح الأوسكار الثاني لـ”دي نيرو” عن “الثور الهائج”، إلا أن ليوناردو لم يحصل على التقدير الذي يستحقه في “قتلة القمر”، أداء نجم هوليود الأبرز مفارق هنا لكل أداءاته السابقة، لا يغيب عن المتابع الفطن لمسيرة ليوناردو دي كابريو التغير النوعي الذي طرأ على مسيرته منذ فوزه بالتمثال الذهبي أخيرا عن دوره في”العائد”، من بعدها لم يقدم ليوناردو سوى ثلاثة أفلام، ما يدل على انتقائه لأدواره بتمهل وعناية فائقة، اهتم ليوناردو بسؤال الكيف وليس الكم، لهذا جاءت هذه الأدوار كلها متميزة وتركت أثرا خاصا في ذاكرة المشاهدين، لكن في هذا الدور بالذات تجسدت رؤيته لتطوير مسيرته باقتحام مناطق جديدة، لم نر في الفيلم ليوناردو الذي نعرفه، اختفى ليوناردو النجم بهي الطلعة تماما، وظهر لنا وجه مختلف: إرنست: الذئب الصغير كما وصفته “مولي”، ذئب استغلالي يبحث عن مصلحته الشخصية بلا نظر للاعتبارات الأخلاقية والانسانية، بل ربما هو أقرب للضبع الدني الذي يقتات على بقايا الآخرين، يذكرك أداءه الشخصية وملامح وجهه بملامح كلب البولدوج الأيقونية التي استخدمها مارلون براندو في أداء شخصية دون فيتو كورليون في الأب الروحي.
أداء دي نيرو جاء مناسبا تماما للدور – كما كتب للفيلم وليس كما كانت الشخصية الحقيقية، فبيل هيل الحقيقي كان أصغر كثيرا في السن – هي شخصية مكتوبة بعناية حيث يقع عليها عبء تحريك الأحداث، وأداها دي نيرو بالجودة المنتظرة، يتنقل بين شخصية الغني الخير الذي يتبرع للهنود ويتبناهم، والشيطان الاستغلالي الذي يصل لأهدافه بالكذب والخداع والمكيدة، ويستطيع ببساطة أن يقتل القتيل والقاتل ويمشي في جنازتيهما معا.
لكن المفاجأة الحقيقية للفيلم هي ليلي جلادستون في دور مولي، أداء أخاذ من الممثلة الأمريكية الأصلية التي لم نقابلها في أي أدوار معروفة لنا من قبل، أثبتت نفسها في حضور مجموعة من النجوم أكبر منها في الخبرة بعقود، شخصية مولي شخصية صعبة لأنها ذات أبعاد نفسية وثقافية خاصة، هي أم وزوجة مخلصة، لها انتمائها الخاص لعائلتها وقبيلتها، وثقافتها تشمل مزج بين ثقافتها الهندية الأصلية وثقافتها المسيحية التي اكتسبتها عبر المعايشة والدراسة، يضاف لهذه الأبعاد أبعاد شكلية بناء على كونها مصابة بمرض البول السكري.
ختام الفيلم أيضا كان نقطة قوة مبنية على قدرة مساحة الابتكار التي حصل عليها سكورسيزي لنفسه، عوضا عن كتابة لافتات صامتة على الشاشة قدم الخاتمة بشكل مسرحي مبتكر مقتبس من التمثيليات الإذاعية العتيقة.
أبدع سكورسيزي ورفاقه في تقديم مأساة سكان أمريكا الأصليين بعد قرون من الاضطهاد تحولوا فيها من أصحاب الأرض لأقلية منقرضة، خبر سعيد بالنسبة لنا، ربما إذا انقرضنا وتم تدجيننا تماما سيصنع الأمريكان أفلام عظيمة عن الظلم الذي تعرضنا لهم.
……………
* نشر في مجلة فنون