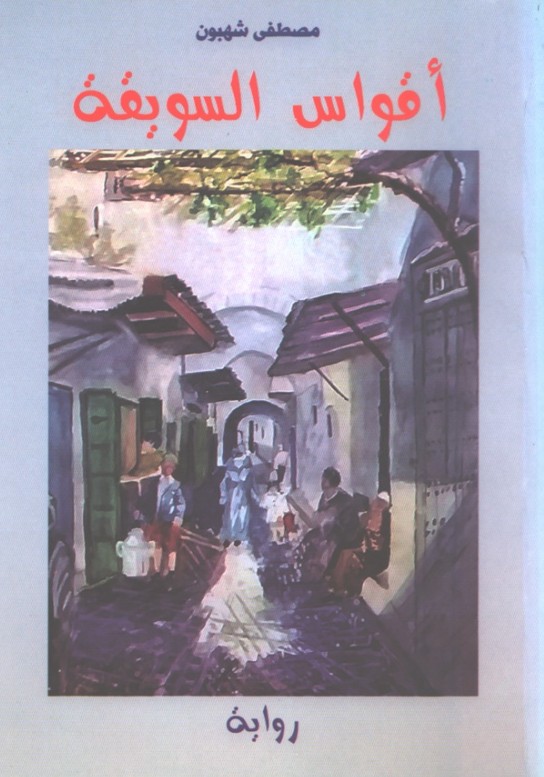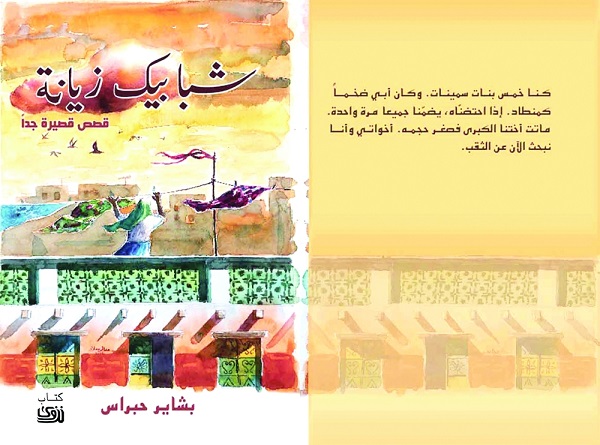ماجد ع محمد
من المرجح أن يأخذ العنوان القرّاء إلى أماكن نائية، ما قد يستدعي الأمر إلى الاِستعانة بالمركونات في الذاكرة والِانطلاقِ بعيداً عبر صاروخ المخيلة، والأمرُ على كلٍ لا يتعلق بمدى معرفتهم بأشكالِ أو مواضِعَ نصبَ الفِخاخِ، ولربما أوحى لفريقٍ منهم إلى أن الفخُّ هنا هو ذلك المعروض في أماكن مخصَّصة لصيد الكائنات الحية على اختلاف أحجامها وطبيعتها، أو يتصور البعضُ بأنه من كثرة انتشار جحافل الفئران أو الجُرذان فوصل الأمر بصاحب المحلِ أو المنزلِ إلى نشر الفِخاخ على الرفوف والطاولات.
وقد يكون التخمينُ لدى فريقٍ آخر هو أن ثمَّة فخٌ في الموضوعِ المطروحِ على طاولة البحثِ، في الوقتِ الذي يكون فخُنا قابعاً في مكانٍ آخر مرتاح البال، مستأنساً بعزلته ويغمره الرضا بكونه لم يخطر على بال معظم من حدَّقوا به طويلاً، وحاموا حوله من دون اقترابهم من المكان الذي يرمي إليه العنوان الذي فرض سلطانه على الكاتب وليس القارئ.
يُنقل عن الكاتب المصري الراحل عباس محمود العقاد بأنه كان يخفي ما يقرأه من الكتب عن الذين يداهمون خلوته، بينما محسوبكم صاحب الفخَّين الموضوعين علانيةً في مكانٍ مرئي وفي متناول الأيدي، فلم أكن أعارض آلية عمل المرحوم العقاد في هذا المجال، إنما كنتُ أرمي من وراء المعروضِ إلى شيءٍ آخر لا علاقة له بالذي كان يعمل عليه العقاد أو يشغل باله.
وإذا كان العقاد قد لجأ إلى تلك الآلية مع معاصريه من الكتاب والصحفيين حتى يحرمهم من معرفة المنهل الذي يتغذى منه، أو يمنع فضولهم من الدخول إلى مختبره الشخصي ليخفي عنهم أسرار مشغله الإبداعي، فمحسوبكم بخلاف العقاد لجأ يوماً في سورية قبل أيام الثورة إلى حيلة العلانية لوضع ساترٍ أمام رغبات رهطٍ من القادمين خطفاً إلى عوالم القراءة والكتابة.
فالفخ الأوَّل الذي نصبتهُ بتأنٍ وإحكام هو متعلِّقٌ بالأديب السوري سليم بركات، ولكنه ـ أي فخي أنا ـ لم يكن مرتبطاً بالفِخاخ التي أعلن عنها سليم وهو يخاطب القطا في “السيرتان”؛ والفخُ الآخر كان للكاتبة والمحامية العراقية سلام خياط “صناعة الكتابة وأسرار اللغة”.
كتابُ سليم وضعته في متناول يد الضيوف الفضوليين حتى إذا ما رمى أحدهم بذراعه إليه وتصفَّح بضع صفحاتٍ منه، فيغدو حاله كحال الأجنبي الذي درس اللغة العربية وعزم على الترجمة عنها إلى لغته ولكنه عندما صادف في إحدى المكتبات عملاً لسليم بركات اصطدم بوعورة لغته ووضع الكتاب لمكانه بصمتٍ وعلامات الإحباط باديةٌ عليه، حيث بدأ الشك يتسلل إليه عن مدى قدرته على الترجمة أصلاً، فيعيد آنئذٍ صاحب الذراعِ كصاحبنا المترجم الكتابَ من دون أيَّ حركةٍ إلى مكانه، وأخلص حينها من فضولية هذا النموذج البشري الذي لا يخصِّص قطُ أتفهَ مبلغٍ للتثقيف، ولا لديه وقتُ مخصَّص للتنمية الذاتية، إنما يقوم بمحاكاة هذا أو ذاك ممن سمع منهم شيئاً عن موضوع الغرفِ من القراطيس، وأراد تتبع خطواتهم ولكن ليس من خلال الشراء أو الذهاب إلى المكاتب العامة المختصة بإعارة الكتب، إنما حاول أن يعمل كالولد الذي لمجرد أن رأى شيئاً ملفتاً عند الجيران فأراد الاستحواذ عليه بشتى السبل، كالطفل الذي ذكره الكاتب “بو علي ياسين” في شطحاته الشباطية، ذلك الذي رأى عند الجيرانِ عروسة فطالب أهلهُ بواحدة مثلها.
أما فخُ الكاتبة سلام خياط فوضعته لنوعٍ آخر ممن يحاول واحدهم أن يصبح رساماً أو ملحناً أو ممثلاً أو مسرحياً أو كاتباً ولكن من دون أيَّ جهدٍ يذكر، ومن دون أيَّ إنفاقٍ على المجال الذي ينوي الدخول إلى معتركه، ومن دون حتى محاولة التعرف على شروط ذلك النوع الفني الذي يبغي أن يجد نفسه من أعلام أهله، مع أن كل معرفة هذا الفريق المتجه صوب التدوينِ بما يتعلق بالفن التأليفي هو ما تلقف واحدهم رغماً عنه في مرحلة الدراسة الإعدادية أو الثانوية ومن بعدُ فلم يتجشم عناء قراءة بضعة كتبٍ تعلمه وترسم الطريق أمامه إذا ما كان لديه حقاً شيءٌ جديرٌ بالقولِ والنسخِ والتسطير، إذ من خلال تصفح عدّة صفحاتٍ من كتاب الأستاذة خياط كان بعضهم يُغيّر حتى موضوع الكتابة ويلتفت إلى مسائل أخرى، بينما كتابُ سليم وللأمانة فقد أراحني كثيراً من هم بعض الفضوليين المتعكزين الذين لديهم الاستعداد لملء بطونهم بوجبةِ طعامٍ واحدة بسعر 700 ليرة، بينما ليسوا على استعدادٍ لشراء قرطاسٍ يُغذي عقولهم أو يوسع أفقهم أو ينمي خيالهم أو يملأ مخزونهم المعرفي لسنوات طويلة بـ: 50 ليرة.