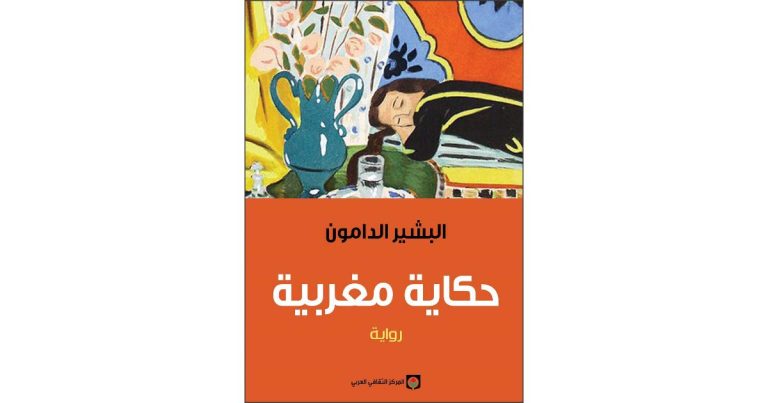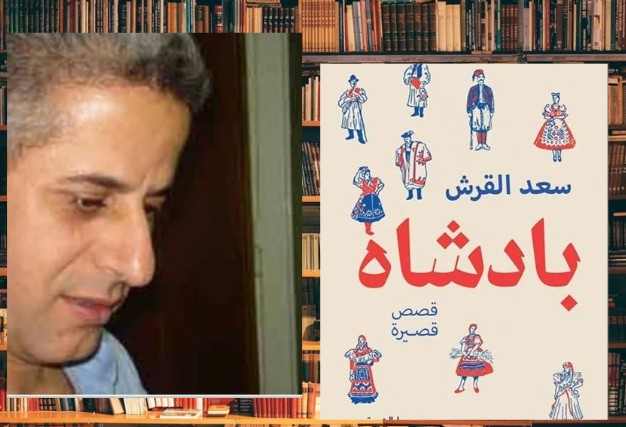أسامة كمال أبوزيد
كان عبد الفتاح الجمل من أولئك الذين لا يفرضون أنفسهم بالضجيج، بل يحضرون بهدوء العارف ووقار المُلهم، كشيخ طريق صوفى يلتف حوله المريدون بلا دعوة. لم ألتقِه ولا عرفته وجهًا لوجه، لكننى تعلقت بسيرته، ومعظمها إنسانى نادر ورهيف، يفيض بكرم الروح وصفاء القلب، حتى ليكاد القارئ يشعر أنه عرفه عمرًا كاملاً. كاتب وصحفى، لكنه قبل ذلك ضمير أدبى يقظ، عاش للأدب كما عاش للناس، ومضى تاركًا وراءه سيرة تبدو كأنها درس فى النقاء والوفاء. لم يكن مجرد شاهد على زمنه، بل واحدًا من الذين صنعوا لذلك الزمن ملامحه الثقافية والإنسانية.
حين صدرت جريدة المساء فى أكتوبر 1956 بإشراف خالد محيى الدين، كانت مصر على حافة النار، وكانت الصحيفة مشروعًا ثوريًا يفتح بابه للشباب وأحلامهم. هناك، فى عددها الرابع، ظهر اسم عبد الفتاح الجمل أول مرة فى نوفمبر بخطاب إلى أبطال بورسعيد. كان نصًا عاطفيًا مخلصًا، لكنه ينذر منذ بدايته بصوت مختلف: لغة مشبعة بالحياة، خشنة وواقعية، تلتقط التفاصيل الصغيرة وتحوّلها إلى صور نابضة. بعد أيام صار محررًا ثابتًا يكتب فى “يوميات الشعب”، يرسم وجوه الناس وصفير القطارات وصرخات الأزقة، ويحوّل مشاهد الشارع إلى قصص مكتوبة بصدق شديد.
لم تكن “المساء” مجرد صحيفة، بل ورشة حلم مفتوحة. صفحاتها الثقافية صارت بيتًا لجيل كامل: نشرت ليوسف إدريس وصنع الله إبراهيم وصالح مرسى، وأتاحت الفرصة لكل من طرق بابها. وكان عبد الفتاح الجمل هو الروح الأكثر نقاء فيها، يكتب ويحرر ويشرف، ثم يرث المدرسة كلها حين غاب رفاقه فى أواخر الخمسينيات. لم يكن بوقًا ولا خطيبًا، بل ابنًا للحرية والجمال، يكتب عن المسرح والسينما والتشكيل كما يكتب عن بلدته دمياط، التى خلّدها فى رواياته “الخوف” (1970) و”محب” (1992)، وكتابه “طواحين آمون”. قليل النشر كثير العطاء، منشغل أكثر بأن يمنح الآخرين فرصة الظهور، كأن مهمته أن يضيء للآخرين الطريق بينما يظل هو فى الظل.
منذ 1961 تولى ملحق “المساء” الأدبى والفنى، فصار مدرسة حقيقية. فيه كتب خليل كلفت وصبرى حافظ، وترجم يحيى حقى، وظهر جيل الستينيات كله تقريبًا. لم يكن مجرد محرر، بل كان يبنى الصفحة كمن يرسم لوحة، يراجع إخراجها بنفسه، يردد عبارته الشهيرة: “لازم المادة العظيمة تظهر فى شكل عظيم”. لم يكن الأمر مهنة عنده، بل حياة ورسالة. ولأنه عاشها بإخلاص، صار اسم الصفحة مرتبطًا باسمه هو: “صفحة عبد الفتاح الجمل”، كأنها جريدته الخاصة داخل الجريدة.
وفى سنوات السبعينيات، حين ضاق الهامش وانكمشت الأحلام، ظلّ يقاوم وحده، جالسًا كالصقر يحيط به أصدقاؤه من كتّاب جيله: يحيى الطاهر عبد الله، إبراهيم أصلان، محمد البساطى وغيرهم. كان أسطورة حية بينهم، حاد النظرة ومرح القلب، يحمى صفحته من الركاكة، ينشر فقط ما يرضى ضميره. وإذا ألحّ عليه أحد بنص ضعيف ردّ بصرامة: “الصفحة دى مش ملكى”. كان يعرف أن النزاهة وحدها هى ميراثه الحقيقى.
حين دخلت الثمانينيات، بدأ يشعر أن زمنه يبتعد. فى مشهد خروج المقاومة من بيروت 1982، التفت إلى صلاح عيسى وقال: “أنا كمان رحلت.. طلبت المعاش.. وانتهى الأمر”. لم يقلها بحزن بل بوعى، كأنه يعلن انسحابه بشرف بعد أن أدى رسالته كاملة. وبعد أكثر من عقد، فى فبراير 1994، جاء رحيله الطبيعى، لكنه ترك خلفه ما يشبه الوصية: أن الصحافة يمكن أن تكون أخلاقًا، وأن الثقافة يمكن أن تصير بيتًا يسع الجميع.
ولذلك لم يكن نعيه عاديًا. وقّع مئات المثقفين على بيان وداعه، يتصدرهم نجيب محفوظ وبهاء طاهر وصنع الله إبراهيم ورجاء النقاش وغيرهم. لم يروا فيه مجرد محرر أو كاتب، بل “ضميرًا حيًا”، رجلًا صنع مدرسة للنزاهة والجمال، وأبًا روحيًا لأجيال كاملة.
لقد كان عبد الفتاح الجمل أكثر من كاتب وصحفى، كان معملًا للأجيال، ضوءًا يحرس الحلم، مدرسة للصدق، وإنسانًا نادر المعدن. وحين نذكره اليوم نشعر أننا نتحدث عن ولىّ من أولياء الثقافة المصرية، عاش لها وأخلص لها حتى آخر لحظة. حياته لم تطل بما يكفى، لكنها تعمّقت بما لا يُنسى، ولا تزال سيرته علامة تضيء فى ذاكرة الأدب والصحافة، كبرهان أن النقاء ممكن، وأن الكلمة يمكن أن تكون حياة كاملة.