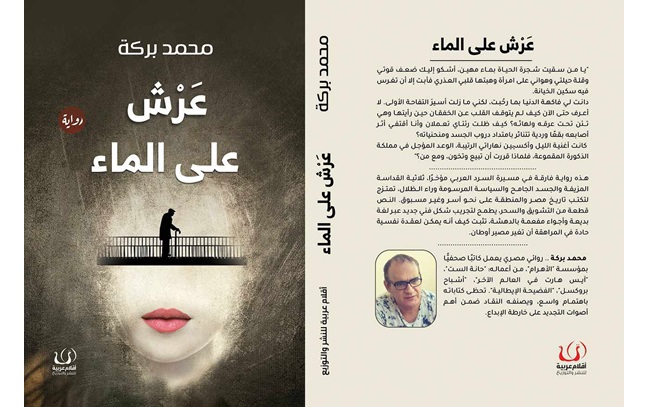بل رأيت ميلا جماعيا إلى تثبيته أيقونة لا إنسانا وموضوعا لا ذاتا. ورأيت جموحا إلى محاصرته ـ وهو الذي حُوصر مرات من أعدائه ـ في الرمزية الأولى وفي نتاجه المبكّر وفي صوره الأولى. ورأيت رفضا عقيما لسيره “الحُرّ بين الثقافات” ضمن مسار حياته هو شخصيا وشعريا وفنيا. لمستُ هذا الجمود في الفهم الجمعي مقابل هذه الحركة والحيوية في “فرد” محمود، في أمسيته الأخيرة في حيفا (2007)، عندما أجبره الجمهور على إلقاء قصيدة “أحنّ إلى خبز أمي”. وقف الجمهور بغالبيته وأنشد “أحنّ..”. عاد محمود إلى المسرح بعد أن أنهى من ناحيته العرض واضطُرّ إلى القصيدة تلك اضطرارا. وقد اعترف على مسامعي في اليوم الثاني أنها من أقسى اللحظات في حياته الشعرية والشخصية. يومها، أدركت عُمق الهوة التي تفصل بين الجمهور كمجموع سياسي وذائقة شعرية وهاجس وبين محمود. أو الأدقّ، أدركت كما تجاوز محمود ذاته ونصه وشعره وفكره نحو الألق وكم بقينا كجماعة في أفكارنا المتقادمة ومواقفنا الأقدم. فالشحنة التي ولّدها في فضاء حيفا الجبل والبحر كانت هائلة. كان يُمكن أن يُضيء حضوره هناك فوق الكرمل كل فلسطين لحساسية حيفا في حياته وشعره وتجربته الوجودية ولشدّة انفعاله وفيضه. لكن هناك مَن أصرّ على قطع هذه الشُحنة بجرّه وجرّنا إلى ماضٍ مضى ولن يعود بدل الذهاب مع الشاعر النبيّ والدليل إلى ذُرى جديدة. كأن الجمهور خذله في حركة نكوص غير مبرّرة من ناحية الشاعر الذي اختار تجاوز صورته وقصيدته وزمانه وحصاره ولغته.
كانت تلك اللحظات قاسية جدا على محمود وعلى كلّ مَن يسير معه كامل الطريق إلى الفيض. لحظات عكست في قسوتها تعاسة كلّ مَن يختار الطريق الآمن إلى القمم في إنسانيته وشعره وفنّه وفكره. جسّدت الحادثة ذاك العجز المتأصّل في “وطنية” ماضوية لا تقترح بديلا بقدر ما تجترّ الألم برومانسية تحولت أحيانا كثيرة إلى مازوخية لولبية تدور فلا تبثّ سوى الخيبة بعد خيبة والإحباط جيلا بعد جيل. عدم القُدرة على استيعاب إيقاعات محمود في نتاجه المتأخّر فيما اختاره من لُغة محصّلة طبيعية لعدم القُدرة على اللحاق بالزمن وقراءة التحولات، ليس في شعر محمود فقط بل في الواقع المتحوّل. وهي يقينا عدم قُدرة على قراءة الهوية والذات والجماعة في سريانها الدائم إلى اللا معلوم. وهي تعكس ارتداعًا عن تجديد المشروع الجماعي الذي انتكس وإعادة التجريب. فإذ مضى محمود إلى شرفة الوقت ينشد شمسا جديدة وكواكب اُخر وهواء القمم عاد أكثريتنا إلى الفناء الخلفي مختليا بنُدبته.
محمود لم يكن شاعرا عظيما لأنه كان رمزا وطنيا أو لأنه صاغ سِمات فلسطين، ذاك الفردوس المفقود، أو لأنه صاغ في شعره وتجربته هوية فلسطينية محددة نهائية. بل هو شاعر عظيم لأنه كان صادقا معه ومعنا، وأصيلا ومجددا ومطوّرا ومتجاوزا لما يبلغه من ذُرى في الإنسانية والفكر والتنوّر. وهو عظيم لأنه أخذ المسألة الفلسطينية كقضية إنسان ومجتمع وعدل إلى رحاب التجربة الإنسانية ورفض حشرها في خصوصية الجغرافية والضحية. ولعلّ منابع عظمته هو في كونه لم يواجه عدوّه فحسب بجسارة صاحب الحقّ والادعاء، بل بالأساس لأنه لم يتردد في مواجهة ذاته الشخصية والشعرية وبالحدّة ذاتها. لأنه وجّه نار السؤال كمستنير نحو كل شيء أنتجه كفرد ومجموع. عظمته في أنه فكّك ما بناه في البدايات ليُنتج بدائل جديدة. فهو المفكك الباني والمختلف المؤتلف والواحد المتعدّد في حركة لا تكلّ.
لم يُخفِ محمود في السنوات الأخيرة ألمه الحقيقي من طريقة تعاطي مجتمعنا العربي عامة والفلسطيني خاصة مع نتاجه وقصيدته وخياراته الفكرية. وشكى كثيرا من جمود طريقة التعاطي مع نتاجه الأخير في كل مستوياته. وأرجّح أن هذا الجمود نبع من تطوّر نقدية محمود الذاتية التي اعتبرها البعض نقضا للبناء الفلسطيني وتعديلا لمعمار فلسطيني مُستحب ولصورة الفلسطيني التي ارتاح لها الجمهور، فأكْثرَ من المرايا العاكسة لها ومن تمثيلاتها. ولم يكن مُريحا أن يأتي شاعر بقامة محمود ليشرئب بعنقه ووجهه وروحه فوق إطار الصورة وأبعد من حدود المرآة. صحيح أن مبنى القصيدة عند محمود شهد تغييرا واضحا لجهة التكثيف والتصوف في اللغة والاختزال لكن ليس هذا ما عكّر صفو التلقي وأقام مسافة بين محمود وبين الجمهور عموما. أميل إلى أن ما فتح الهوة هو ذاك السؤال الذي حملته قصيدة محمود في طورها الأخير ـ سؤال يطال كلّ شيء بما فيها الصورة وطريقة تشكّلها والاستكانة إلى جمالها. أي أن حوار محمود مع الجمهور، خلافا لتوقعات الأخير، هو مصدر التوتّر المُشار إليه ومصدر قسوة الجمهور و”الناقد” ـ إذا وُجد ـ في قراءة محمود ونصّه. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى حقيقة أن محمود الشاعر في القصيدة هو محمود الشاعر في الحقيقة لا يُمكن الفصل بينهما. فمن عرف محمود أو حادثه في المستوى الوجودي لتجربته يعرف أي تطابق كان بين الكيانين في الشعر وفي الحياة. وكأن هناك مَن أراد أن يأخذ شعر محمود منه أو يقطع الرابط الوثيق بينه وبين شعره. وهي حركة قام بها كثيرون رغم إلحاح محمود ألا يفعلوا. فقد خيّروه أن يتنازل عن شعره الأخير أو أن يتنازلوا هم عنه ـ محمود. إلا أن محمود هو محمود بعناده وحزمه واستنارته. رفض بابتسامته الآسرة الدخول في لعبة الاشتراط هذه مفضّلا الخلاف والاختلاف والتميّز والتقدّم بدل الانكفاء. فهو الذي انطلق في لحظة من الستينيات الأولى أصرّ على المضي إلى أمام رغم كل حركات التقهقر والمراوحة في المكان. ربما، لأنه كشف هذا الخذلان، ولأنه أشار إلى مواطن الضعف والانكسار والإعاقة كان نصيبه من القسوة كبيرا حدّ الاغتيال الفعلي والمجازي على السواء. فلن يكون من قبيل الصُدفة أن تعثر على نصوص تخوّنه وأخرى تتهمه بمسايرة العدوّ أو “التطبيع” معه وأخرى بـ”الانحراف” أو “التنازل” أو “التفريط” أو سواه من تُهم!
ولعلّ قصيدة “اغتيال” التي أوردها هنا تعبّر عن هذا الألم وبطريقة خلّاقة على عادة محمود في شعره وحديثه وفكره. إنه اغتيال مجازي في القصيدة لكنه يتبدّى لي أحيانا حقيقيا.
اغتيال*
محمود درويش
يغتالني النُقَّاد أَحياناً:
يريدون القصيدة ذاتَها
والاستعارة ذاتها…
فإذا مَشَيتُ على طريقٍ جانبيّ شارداً
قالوا: لقد خان الطريقَ
وإن عثرتُ على بلاغة عُشبَةٍ
قالوا: تخلَّى عن عناد السنديان
وإن رأيتُ الورد أصفرَ في الربيع
تساءلوا: أَين الدمُ الوطنيُّ في أوراقهِ؟
وإذا كتبتُ: هي الفراشةُ أُختيَ الصغرى
على باب الحديقةِ
حرَّكوا المعنى بملعقة الحساء
وإن هَمَستُ: الأمُّ أمٌّ، حين تثكل طفلها
تذوي وتيبس كالعصا
قالوا: تزغرد في جنازته وترقُصُ
فالجنازة عُرْسُهُ…
وإذا نظرتُ إلى السماء لكي أَرى
مالا يُرَى
قالوا: تَعَالى الشعرُ عن أَغراضه…
يغتالني النُقّادُ أَحياناً
وأَنجو من قراءتهم،
وأشكرهم على سوء التفاهم
ثم أَبحثُ عن قصيدتيَ الجديدةْ!
(*من مجموعته ـ أثر الفراشة)