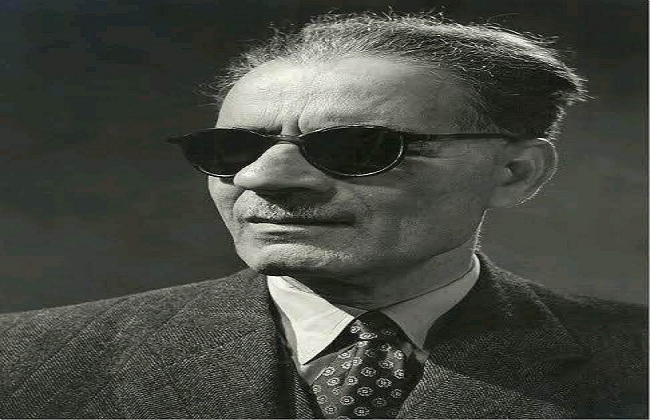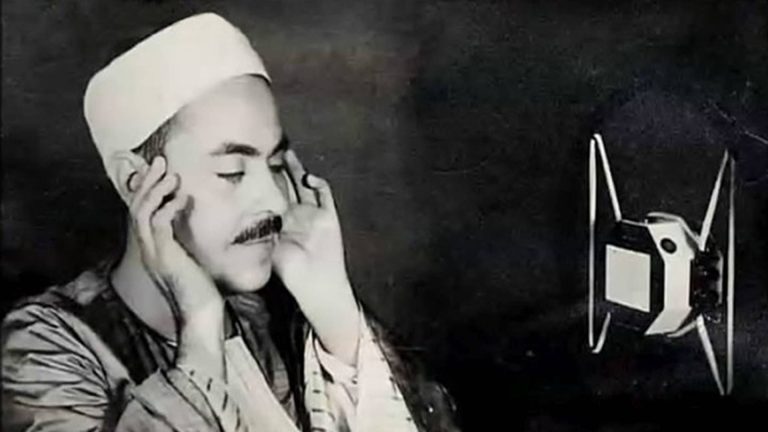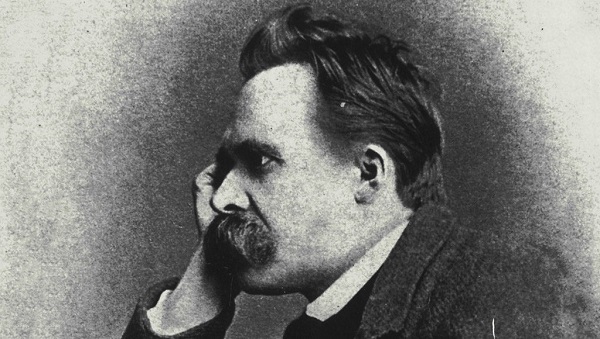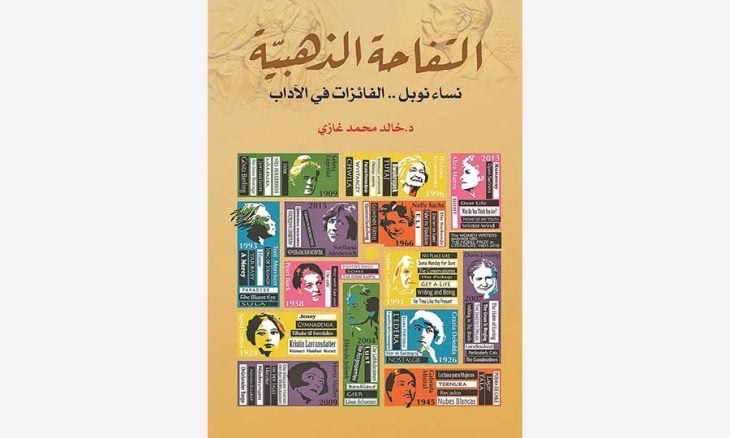عبد الهادي عبد المطلب
«حيث لا يوجد حوار، يبدا العنف»
سقراط
عالم يتصدّع..
في عالم يتصدّع من الداخل، تحكمه منظومة الصّراع من أجل المصالح والربح والخسارة، والسلطة، عالم تشيّأ فيه الإنسان حدَّ فُقْدان إنسانيته وهدفه الأسمى في الوجود، عالم تآكلت أخلاقه وقيمه وذائقته، وحبّه للخير، عالم افتقد أهمّ شروط الوجود: الحرية، الحوار، العيش المشترك، الكرامة، وهو بهذا، لا محالة، يتّجه سريعا نحو الهاوية، عالم تمرّغت أخلاقه في الوحل فأصبح قاب قوسين أو أدنى من الحيوان، لأن «الوجود الإنساني لا يكتمل إلاّ بالتّخلّق، لأن الإنسان يوجد بقدر ما يتخلّق»، يقول الفيلسوف طه عبد الرحمن.
لقد ظهرت الأديان، والفلسفة والفن والأدب والعلم، وبُدِلت الجهود من أجل التّخفيف من ثقل الألم على العالم والإنسان، من أجل الوعي بقيمة حرية الفكر والعدالة والمساواة، واحترام الاختلاف، ومن أجل التقارب وتبادل الخبرات والمعارف، والتواصل والتسامح والعمل المشترك لحياة إنسانية أفضل، لكن، وللأسف، في خضمّ التحوّلات المتسارعة، والمصالح المتضاربة، والصراعات التي يشهدها العالم داخل أصغر خرائطه مساحةً ونَسمَةً، ظهر الانقسام والتوتر، والأنا، ورُفعت رايات التهديد والحرب، والخوف من الآتي الغامض الذي يُعتمه الغبش والضباب والظّلام الذي يقود إلى الكارثة.
«لقد غزا الأقوياء العالم ليس بتفوق أفكارهم أو قيمهم أو ثقافتهم، بل بتفوّقهم في استخدام العنف المنظّم»[1]،
و«شهد التاريخ على امتداده، أبشع أساليب العنف والإهانة والتنكيل والإقصاء والتّهميش وسلب الحقوق»[2]، مارسها المالكون للقوة والمال، والعولمة المعرفية والصناعية، والهيمنة الإعلامية، وتفسير المفاهيم الإنسانية بما يخدم مصالحهم، كالديموقراطية والحرية والحق والعدل، واجتهدوا في فرضها باسم القانون الدولي والحماية والعالم المتقدم، ومسميات أخرى، فوقف العالم بين العقل والغباء، ووقف الحوار بينهما متأرجحاً كسيحاً، يظهر مُحتشما ليموت قبل أن يُعلن عن وجوده، ليتشعّب النّقاش شاهرا سلاح القوة والعنف وازدراء الآخر والتّشهير به، وغلق أبواب التفاهم والحبة والحوار.
اختلاف الرأي لا يُفسد للوُدّ قضية..
هذه قاعدة ذهبية من قواعد حوار العقلاء، ينتقل بها الإنسان من حالة العزلة والتّوحُّش والغباء وحبّ الغلبة إلى حالة الإنسانية الحقّة بمفهومها العام والشّامل، وهذه القاعدة يدعّمها قول الفيلسوف الفرنسي بول فاليري «علينا أن نغتني بخلافاتنا» لا أن نتصارع وننتظر من سينتصر، فالعقول السليمة حين يؤسّس قواعدها الحوار، تُحدث تغييرا إيجابيا في منهج تفكيرنا وسلوكنا وتعاملنا مع الآخر، ففي خضمّ المتغيرات والانهيارات المتسارعة لعديد من المفاهيم السياسية والأيديولوجية التي أطاحت بمجموعة من الأفكار والنّظم والمشاريع، إضافة إلى انتشار المعلومات الحقيقية والزّائفة والمضلّلة، والازدهار والتّطور المعرفي في ميادين العلوم الإنسانية، وتعاقب الثورات العلمية والمعلوماتية، أصبح من الضّروري الآن، أن يعمد الإنسان إلى إعادة صياغة أفكاره، وفهمٍ جديد للتّحوّلات التي تطرأ على وجوده، ومن ثَمّ يمكنه الانخراط، إيجابا، في تغيير الإنسان والعالم، عن طريق الحوار، في انسجام كامل مع تحولات العالم، وحين يفهم الانسان هذه الديناميكية المتسارعة، وصيرورتها وطبيعتها وهَمَجِيّة بعض تصوراتها، يدخل في حالة استيعاب ذاته أولا، ثم واقعه ثانيا، وبالتالي الآخر الذي يتقاسم معه الوجود، ويحمي نفسه من الوقوع في العزلة والتّوحّش، ويفتح للحوار آليات سجالية منطقية تؤمن بالتآلف والتّقارب، والاعتراف بالآخر، والحرية والكرامة، لأن الحوار مقاربة إنسانية لا تكثرت للانتماء أو اللون أو العرق أو الدّين، بل تُعبِّير عن رغْبة كامنة في عمق الإنسانية طمرها، على مرِّ عصور الصّراعات والجري وراء المصالح، العنف والتّفوّق والكُره، ولن تجلوها إلاّ قيم الحرية والمساواة والعدالة واحترام الآخر، في إطار المشترك والمُتَقاسَم الحضاري، باعتبارها المبتغى لأغلب المجتمعات البشرية للعيش الكريم والمساهمة في بناء الغد بما يخدم المعنى الإنساني القائم على التّنوّع والإتلاف.
والحوار هو نقطة النُّضج التي يجب تصل إليها الإنسانية لتجلس إلى الطاولة، تُرافع في غير تسلُّط، وتدافع في غير هجومٍ باغٍ أو تهديد، وتُنصت في غير نفاق أو تلصُّص، وتحاور في غير جدال أو قطيعة، لخلق مشروع كوني يفتح للمستقبل أسباب تلاقح وتفاعل الحضارات والثقافات والأجيال، وتبادل المعارف ووجهات النظر لحياةٍ إنسانيةٍ تقْتسم نفس الوجود. كما أن الحوار، «احتكام جماعي للضمير الإنساني» والانشغال بسؤال المستقبل الذي تجتمع حوله الإنسانية متطلّعة إلى الحرية والكرامة والتوافق في ظل العيش المشترك المبني على التبادل والاحترام، وتفعيل ممكنات إنجاح هذا المستقبل، وهو بهذا (أي الحوار)، تجديدٌ وجرأةٌ في التّفكير، تفرضه التغيّرات التي يعرفها عالم اليوم، الذي يتّجه إلى الكارثة، إذا لم يتم التّصدّي لها، ولعلّ الحوار يكون السبب الرّئيس لإبعاده عنها عبر مجموعة من النّظم أهمّها، الاعتراف والاحترام المتبادلين، وتقبّل ثقافة وثرات ومعتقد الآخر، فهو البديل للعنف، والقوّة والتّسلّط، خصوصا حين يُبنى على العقل والتّعقّل والتّبصّر وإرهاف سمع، واحترام الرأي الآخر، وفسح المجال للكلام والفعل في إطار التلاقح والتثاقف أخذاً وعطاءً.
والحوار مفهوم من المفاهيم التي نعتقدها بسيطة واضحة، غير أن هذه البساطة وهذا الوضوح، هما ما يجعل هذا المفهوم يؤخذ مأخذ السهولة والتعامل حين الوقوف على حقيقته، أخذاً وعطاءً، فعلا لا كلاما يُرْمى لتبرير موقف أو تحريف وإفساد رؤيا، يتبع ذلك ما يُضادّ الحوار من عنف وكراهية وتسلط، فهو في الأصل مفهوم فكري، تختلف النّظرة إليه ضيقاً واتساعاً، فعلا وكلاما، موقفاً وتنازلاً، أخذاً وعطاءً.
جاء في لسان العرب وغيره من المعاجم أن: «الحَوْر: الرجوع عن الشيء إلى الشيء، والمُحاوَرة: المُجاوَبة. والاسم من المُحاوَرَة الحَويرُ، تقول: سمعتُ حَويرها وحِوارَهُما. والتحاور: التّجاوب، تقول: أحرْتُ له جواباً وما أحارَ بكلمة، وكلّمْتُه فما ردّ إليَّ حواراً أو حويراً، أي: جواباً، واسْتَحاره: اسْتنْطقَه. والمُحاورة: مراجعة المنطق في المخاطبة، يقال: وهم يتحاورون أي يتراجعون الكلام»[3].واصطلاحا فالحوار «محادثة بين طرفين أو أكثر، تتضمّن تبادلاً للآراء والأفكار والمشاعر، وتستهدف تحقيق قدر أكبر من الفهم والتّفاهم بين الأطراف المشاركة، لتحقيق أهداف معينة، يسعى المشاركون في الحوار إلى إنجازها»[4].
العنف، تعطيلٌ للحوار..
العنف والكراهية والتّسلّط سلوكات لا مبرر لها، قد تنهض على حوار مُغَلَّف بالابتسامات المخادعة والزّائفة التي تعطِّلُ الفعل القائم على الاحترام والحرية والعيش المشترك، خصوصاً حين تتوجّه إلى الآخر في العالم العربي الذي يجر وراءه قرونا من التّخلّف والتّبعية والانبهار لكل غرْبيٍّ، إذ يُعتبر هذا العالم المصنّف «ثالثاً»، في خلفية الدول المتقدّمة المتحكِّمة في مصيرهم كوحش إمبريالي يسعى لفرض سطوته عليهم، والْتِهام مواردهم، وإقحامهم في حروبٍ لإضعافهم وتذويب هوياته وتغريبها، الشيء الذي يدفع بالعالم «الثالث»، أمام غَلَبَة الآخر وتمثلاته التي تصوّره الأدنى والأضعف أمام قوته، إلى تبنّي خطاب الكراهية الذي يحول من دون تفعيل منظومات الحوار، ويُعقِّدُ مساره، ويُبعثر أوراقَ خرائطه. من هنا، ورغم النّعوت المُحبطة التي تُفاقم انتشار خطاب الكراهية، والتي توقف مسار الحوار بين مختلف الأطراف، فإنّ الحوار يظل مَطْلباً مُلحّاً لتذويب الاختلالات والخلافات بما يخدم تقدم ورفاهية الإنسانية.
الحوار «شرف أن يكون الإنسان إنساناً» كما يقول الشاعر الفرنسي بول فاليري، «وذلك بما يجعل من الحوار كُنهَ الإنسان وماهيّته وخِصّيصته، إنّما الإنسان الحوار، فإن هو غاب عنه الحوار امتنع عنه أن يكون إنسانا كامل الإنسانية، وإن بقي في «مسلاخ» إنسان، فبالتّخطيط البدني فحسب»[5]. فحين نفهم هذا الشرف، شرف أن يكون الإنسانُ إنساناً، فمن شأن الحوار أن يُخرجنا من الفردانية إلى التفكير في الآخر، ومن الشّوفينيّة الضّيّقة إلى الانفتاح والتعايش، ومن الأنت إلى الهُوَ، ومن المحلّي إلى المحيط، إلى العالمي، ومن الواحد إلى المتعدّد الذي يفكّرُ بعقل منفتحٍ على ما يجعل من الإنسان إنسانا بمعناه الشمولي المُتخلّق، الذي يسهم في رفاهية الإنسانية من دون تمييز أو تفْرِقَة، «إذ أن نكون، معناه أن نتحاور، وأن نحيا معناه أن نساهم في حوار»[6]، به «نتشاطر أصوات، أصواتٌ تُتشاطر وتُتقاسم وتشترك وتشتبك»[7] لكنّها لا تتصارع، أو يفرض القوي جبروته، فبداية التّعايش حوار، وتقاسم الأدوار وتَشارُكُها خدمة لمستقبل العالم مهما اختلفت معتقدات وهويات وثقافات وألوان النّاس، لأنّهم يمثّلون، أبينا أم قبلنا، المجتمع الإنساني، «فلا وجود لأنسان خارج المجتمع، لا وجود له خارج التّاريخ، وحده الحيوان ينشأ ويبقى خارج التّاريخ، أما الإنسان فبعد نشأته الأولى، ولادته تكون له نشأة ثانية، اجتماعية ضرورية. فهو لا ينشأ مثلما ينشا أي كائن عضوي: نشأة مجرّدة عن الروابط»[8].
وبعد، نتصادم ونكره بعضنا، أو نتنادى للحوار؟
نتنادى للحوار، النّدّ للنّد، لا حوار غَلَبَة القوي وإرضاخ الضّعيف، أو استعراض القوى للهيمنة، بل احتراما للآخر ولثقافته وحضارته ومعتقداته، واجتنابا للسِّياسات الاستعمارية التّوسّعية أو المصالح الشخصية، وابتعاداً عن ثقافة الإلغاء والإقصاء.
نتنادى للحوار، ضدّاً في خطاب الكراهية الذي تصنعه وتدعو له القوى الفاسدة التي تتغذّى على الحقد الاستعماري بكل أنواعه والتّوسّع بكل تفسيراته، لسلب ثروات الآخر، لنُحيي الوعي بأهمّية العمل المشترك لحياة أفضل لكل النّاس، وإخراجهم من حالة البؤس والشّقاء والتّبعيّة إلى حالة المشاركة الواعية في بناء المستقبل.
نتنادى للحوار، لا يعني الوقوف عند حدود اللوم واللوم المتبادل، والنقد والنقد كردّة فعل، بل يعني صياغة خطاب يمتلك آليات تجاوز اللوم والنقد، إلى فعل بنائي مشترك بين الأطراف المتحاورة، وفتح الانسدادات التي تخنق الرّوافد التي تصبُّ في نهر الإنسانية لتسقي عروقها وتُمَكِّنها من بناء صرحٍ إنساني جامعٍ.
نتنادى للحوار، لأنه «كلّما ضاقت، يُفرجها الحوار» لا الصّدُّ ولا العنف ولا الكراهية، لأن الحوار إجلاءٌ للخلافات وأسباب الصّدّ والخوف وسوء الفهم، وتفعيلٌ لآليات المشترك والمُتقاسَم الإنساني، وفتحٌ لآفاق جديدة للعلاقات، ومحاولةٌ لاجتراح صيغ متطورة للتقارب والتفاهم والتآلف، وتعبيدٌ للطّريق نحو التّلاقي على أساس الاعتراف بالحق في الوجود.
ختاما..
بين الحوار والصّدّ، يصعب الاختيار داخل هذه العلاقة التّبادلية المتضادّة في ظلّ الاحتقان الذي تشهده الحدود، وانسداد قنوات الحوار والتّفاهم والعيش المشترك، وتضييق خناق الممرّات السالكة للاحترام، لتعويم الانسان في حالات من التّيه والشتات، وزعزعة يقينياته في ذاته وفي الآخر، وفتح المجال متّسعاً أمام الدّعيّ بالقوة، لينشر أردية الخوف والتّسلّط والازدراء.
لقد أصبح الحوار، الآن، لا الصّدّ، ضرورة تفرضها المتغيّرات المتسارعة للعولمة بكل أبعادها ومراميها لتحقيق التعايش والكرامة والحرية واحترام الآخر، لأن الحوار ثقافةٌ إنسانية، تبدأ من الإنسان وتنتهي إليه، ومن الاختلاف إلى الائتلاف لبناء المشترك الإنساني، والارتقاء بالإنسان إلى تحقيق كرامته واسترداد إنسانيته الحقيقية التي ميّعتها الكراهية والصّدّ، إذ معهما يحضر التّشدّد والفهم المغلق، ومع الحوار يحضر الانفتاح والتّواصل، ويُنظر إلى الانسان كإنسان، بعيدا عن معتقده وثقافته ولونه وعرقه، فالحوار حاضرٌ لبناء المستقبل على أسس إنسانية تحترم وجوده الإنساني، وليس موضوعا عابراً أو مؤقّتاً، أو ترفاً فكريا أو مجاملة كلامية، بل ممارسة راقية، تبدأ من الأنا/الذّات وتمتدّ إلى المجتمع والعالم لتصل إلى جوهر الوجود: الحرية والسلام.
لا يمكن أن يقوم للحوار صرحٌ مع التّفكير بأن الآخر، كائناً من يكون، لا يُحسن إلا الاستهلاك والتّبعية، وأنه لا يسهم في تقدم ورفاهية الإنسان، وأنّ وجوده في عالم ثالث أو نامي أو متخلّف، لا يعطيه حق الدّخول في الحوار والتّحاور، بل عليه الاستسلام والطّاعة وتقبل الأمر الواقع، لكن الحوار غير هذا، خلقٌ وتخلُّقٌ، تنازلٌ في غير ضعف، إرهافٌ للسمع في غير غباء، لأنه سيرة العقلاء العابرين طريق المحبّة والتسامح والتعايش والاحترام، إلى الضّفّة الأخرى، ضفة النّجاة، التي يحكمها العقل والتّعقّل، ويؤسس منطلقاتها الحوار والتعايش، بعيدا عن النزاعات الصّدامية والصّراعية، جامعةً شمل الإنسانية حول سؤال المستقبل الذي انشغلت به الحضارات والثقافات منذ قديم العهود. يقول المهاتما غاندي: «لا أريد لبيتي أن تحيط به الأسوار من كل جانب إلى أن تسدَّ نوافذه، وإنّما أريد بيتاً تهبّ عليه، بحرّية تامّة، رياح ثقافات الدّنيا باسرها، لكن دون أن تقتلعني إحداها من الأرض».
………………………….
[1] جمال حسين علي. بازار الثقافة الكبير. دار صوفيا للنشر والتوزيع 2024 (ص 65)
[2] نفس المرجع ص 65.
[3] ابن منظور. محمد بن مكرم. لسان العرب. ط1. بيروت دار صادر. (ص 217ـ218)
[4] منى إبراهيم اللبودي. الحوار تقنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمه. مكتبة وهبة. القاهرة 2005. ص 19.
[5] محمد الشيخ. محافل النظر في منطق الحِجاج والجدل. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. سلطنة عمان. 2022. (ص 79).
[6] المرجع نفسه ص 92.
[7] المرجع نفسه ص 92.
[8] المرجع نفسه ص 94.