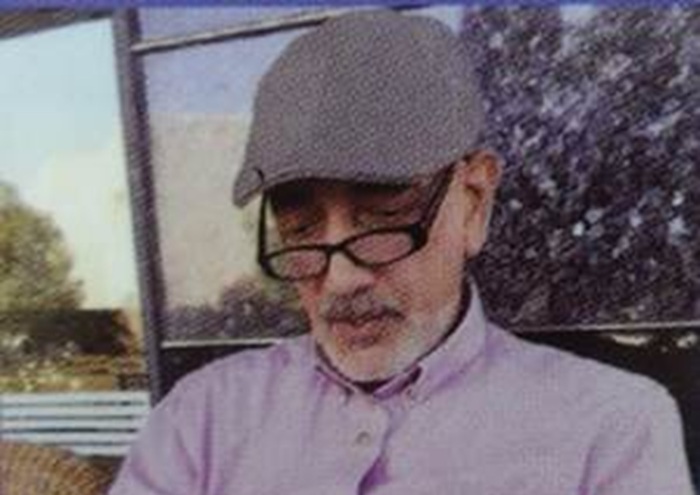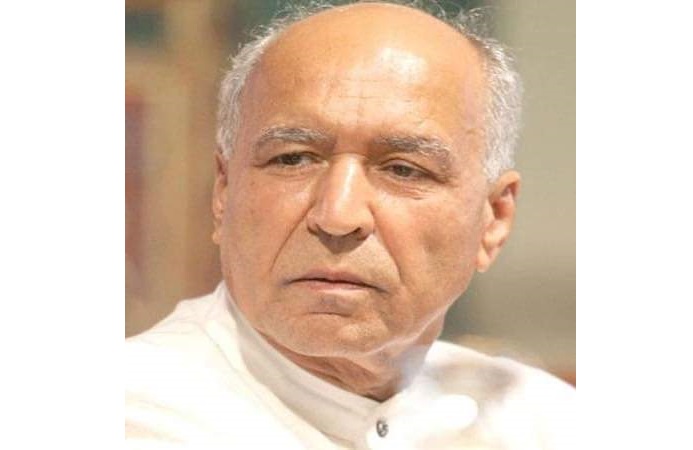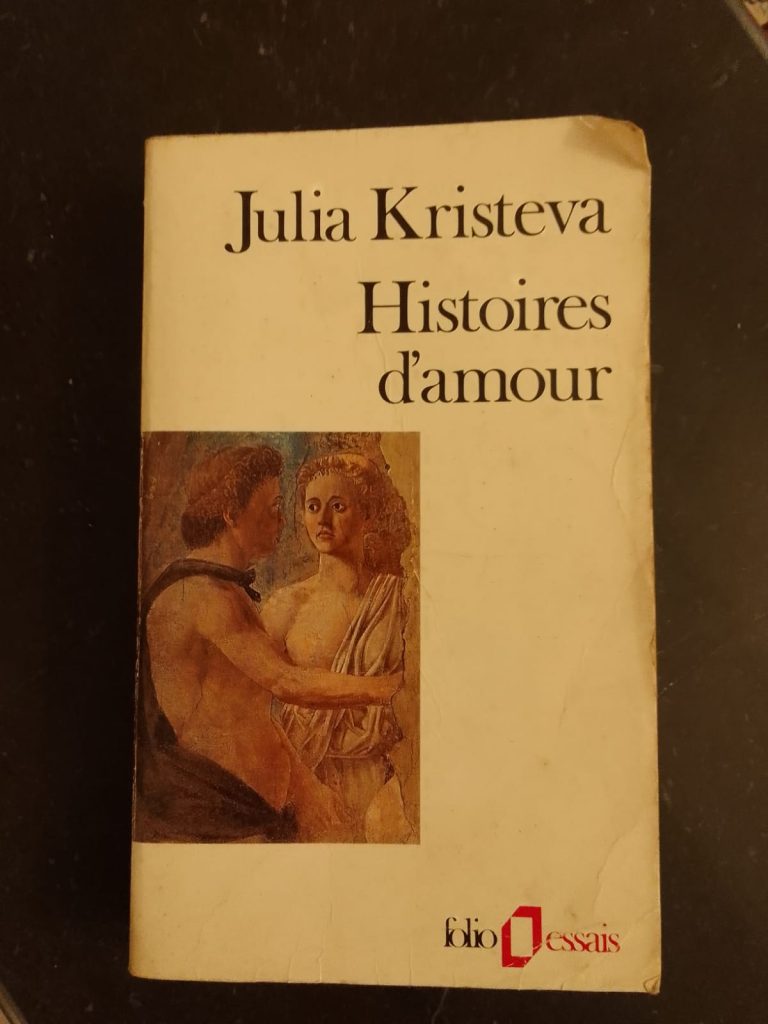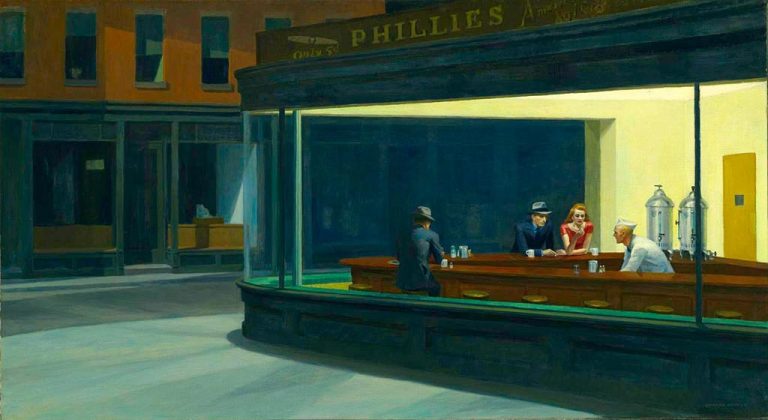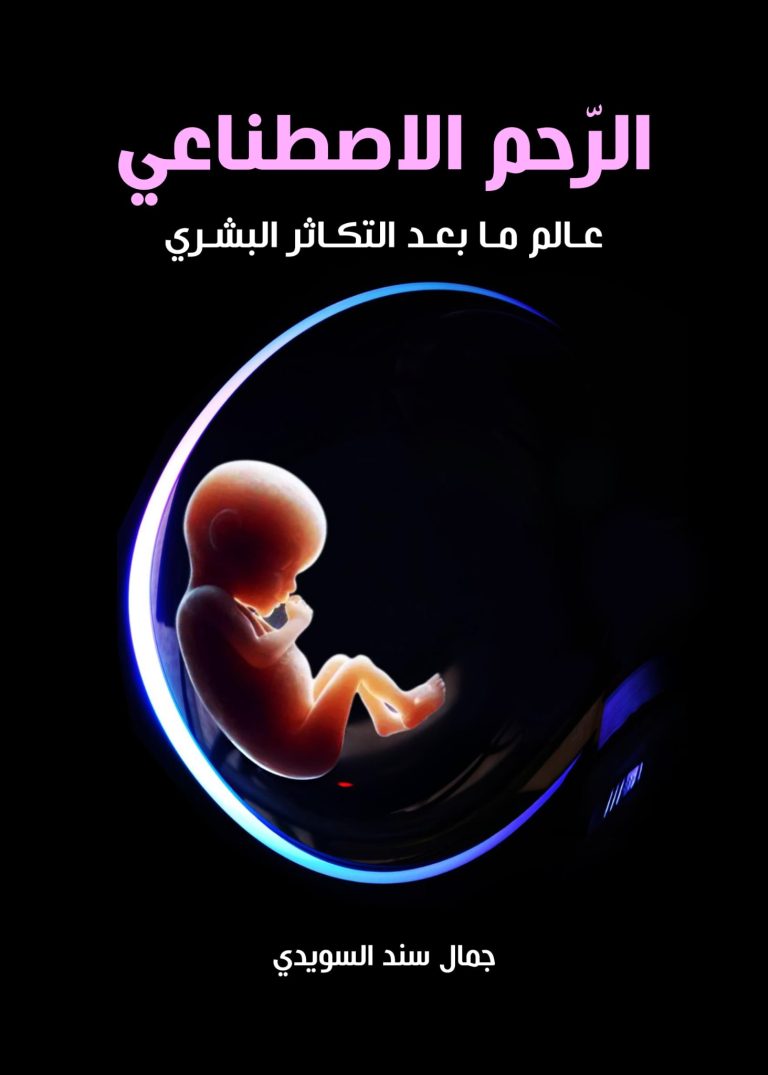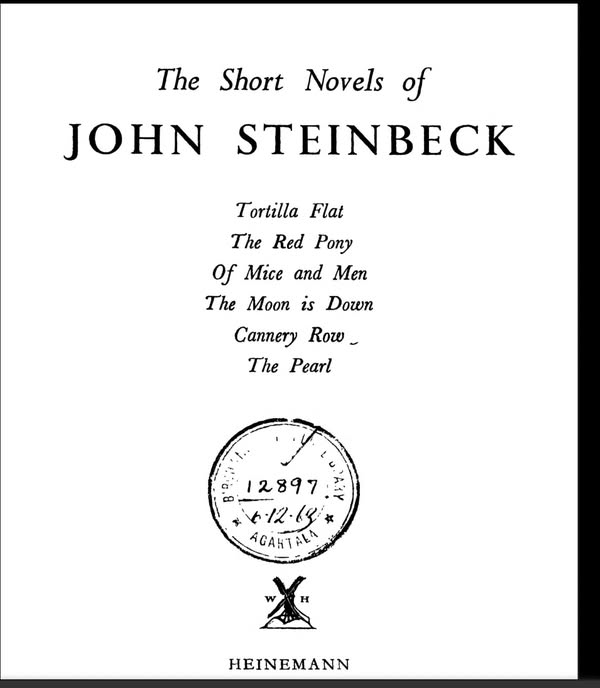عبد الهادي عبد المطّلب
1 ـ هل توقّف العقل العربي عن التفكير؟
باستحضارنا للكوجيتو الديكارتي “أنا أفكر، إذن أنا موجودّ، نقول ما أحوج وطننا العربي اليوم لممارسة فعل التفكير، وإعمال العقل، ليوجد، ليقف عند غاية وجودِه في عالم لا ينتظر التّافهين، لأن اليقظة الفكرية، رمزٌ للتّحرُّر من القيود التي تشُدُّ إلى القاع، وقيود العالم العربي لا تُحصى، بدْءاً من استهلاك الفكر دون إنتاجه، إلى أبسط الحقوق وهي التّحكّم في مصيرنا. ونحن في خضمّ عملية إعادة تدوير مُخلّفات الآخر، وما تقيّأه، استحْليْنا الانتظار، فتوقَّف الزّمن عندنا، وانسلّ من بين سنين وجودنا الوقت، ووقفْنا ننْظُر إلى بعضنا كحمقى في لُجّة الزّحام وفوضى الحياة، في انتظار صدقات تُؤجّل أو تُطيل شقائنا الإنساني، أ, في انتظار من يُبادر.
الجهل والتّفاهة حاضران بقوة في مشهدنا العربي، وهما عنوانه، والانسان العربي يعي مأساته وشقاءه، بل يعيشهما حين ينهشه الصّمت والألم والعذاب، فتفرَّقت به السُّبُل في انتظار من يأخذ بيده إلى شطّ الأمان، ومن عمقه التراجيدي والمأساوي ينبعثُ حارقا سؤاله الآني، ما الحلّ؟
سؤالٌ لإعمال الفكر والنّظر، ليظلّ السؤال قائما، ونقد الجاهز من الإجابات والأفكار والتّمثّلات، وتحريك الأفكار وتطويرها ووضعها في مواطنها المناسبة، لرفع بُنيان المعمار المعرفي العربي، والوقوف على الأفكار التي يواجه بها العرب حاضرهم بكل تقلباته وتغيراته، ومواجهة إكراهات الفشل والتراجع والتّأخّر الحضاري، لأن إعمال العقل بات مطلباً مُلِحّاً.
2 ـ هل العقل العربي في حاجة إلى تفكير أو من يفكّر له؟
هل يعقلُ أو يُسْتساغ أن يظلّ العربي في تخلّفه وجهله وتفاهته الضّاربة في كل مناحي حياته، وهو مُثْقل بثروة رهيبة، لا يعرف كيف يُصرّفها أو يوظّفها ليسير مع الركب العالمي، ربما سائقا، “وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَواهُ”[1] يجمع ثروته، يُحصيها، يُراكمها في غير وعي بقوة ما يملك إذا صُرفت في الاتجاه الصّحيح، حتى ترهّلت كرشه، وارتخت عضلاته، فاصبح، بثروته المخيفة، أقلّ ثمنا من برميل الزّفت الأسود، لا يُساوي في عالم الإنسانية المتقدمة مثقال ذرّة، يعيش الفواجع بكل صنوفها بعيدا عن الصّحوة الذّهنيّة، والانتباه العقلي، واليقظة الفكرية.
في ظلّ تشردمنا الدرامي والبائس هذا، وللخروج على البُنى الفكرية المُهْترئة والسّائدة التي أسهمت بشكل كبير وجليّ في قمع الشعوب، والزّجّ بهم في الخانات الضّيّقة، نبحث عن طوق نجاة يُخلّصنا مما نحن فيه من شتات وحروب وتخلف واستهتار وتفاهة، وبداية الخطو تكون بالتفكير الجدّي في حقيقة وُجودنا، وإشكاليات واقعنا، ونبذ التّصوّرات والآراء الجاهزة، وفتح الطّريق نحو الأصول لنبشها واستخراج كنوزها، وما جعل الأولين منّا يأخذون بزمام العلوم، والأخذ بآليات سبْرِ الواقع لاستخلاص مواطن القوة وتفعيلها وتحريكها نحو التغيير، ومواطن الزّلل لمسائلتها والتّحرّر منها، وطرح الافتراضات والفرضيات القمينة بالدّفع بقطارنا العربي إلى التّحرّك نحو الأمام، والمشاركة في صناعة الحضارة الإنسانية أو جزء منها، للانطلاق إلى آفاق جديدة للبحث في كل الميادين التي تدفع بالإنسان إلى الغوص في إنسانيته، لاستخراج ما يجعله فاعلا ومؤثّرا سائقا غير مساق، كبهيمة بكماء، في دروب الحياة.
بناء على ما سبق، من يملك آليات السؤال والبحث فيها؟ من بيده أدوات الرفض والنّقد والبناء؟ من يملك آليات تدوير مآزق الحال لإيجاد مآل سليم ينهض على الفكر والعقل والسؤال؟ ومن باستطاعته إيقاظ العقول المُغلّفة بالتفاهة والجهل؟
هذه الأسئلة وغيرها، ونقد ما نحن فيه، أصبح مطلبا مُلحّاً من أجل إعادة بناء إنسانٍ يعي إنسانيته وحقيقة وجوده، لا نريد أن “يكون الشرق من اختراع الغرب” كما قال إدوارد سعيد، أو يكون الشرق اختراعا غربيا كما قال بورخيس، شرقا عربيا صفرا على اليمين، لا تقوم له قائمة، يستهلك ويضحك وينتظر، بل نريد عالما عربيا ينتج، يؤسس، يساهم في بناء حضارة الإنسان، نريد أن نكون نحن، نفكّر بعقولنا ونتحدّى أنفسنا، ونضع أساسات عالم يتساوى مع الآخر، يُنتجُ أكثر ممّا يستهلك، يفكّر أكثر ممّا ينام، يسأل أكثر مما ينتظر الجواب، “لقد حكم التّاريخ ولا مردّ لحكمه، ولا سبيل إلى أن ننكر أننا شجرة أينعت وأثمرت زمناً ثم ذَوَتْ”[2]، لذا على عاتق المفكرين والأدباء والفلاسفة أن يُغيّروا هذه النّظرة، “ذَوَتْ”.
هل عجز الفكر العربي عن طرح السؤال؟ فالسؤال بداية الخطو وتلمّس معالم الطّريق، وطرح السؤال دليل على اليقظة والانتباه والصّحو، والنّظر إلى ما يحيط بالسائل ومحيطه، لأن الحال مستفزّ ونافر ومفضوح، ينتظر السؤال الحارق المستفز الذي يضرب في عمق المشكل ليُفتّت مكنزماته، ويُحيلها طيِّعة قابلة للتناول والحل، ووضع مشروع تنويري ينتشل البلاد من وحل التّخلّف بكل تجلّياته.
من هنا الانطلاقة، من السؤال، سؤال الثقافي والاجتماعي والسياسي، وقضايا الهوية، وحوار الحضارات والأديان، وحقوق الإنسان، وعلاقة ذلك بالإصلاح الشامل، وتجديد السؤال، والنّظر في السّابق وتصحيح منطلقاته حتى لا نعيش الاغتراب في عصر المعرفة المرتبطة بالإنسان في كل جوانبه، والنّظر فيها لتجديدها وإعطائها بعدها العربي.
3 ـ نكون أو نُعلنُ موتنا..
نحن في حاجة إلى أن نعرف ما نريد، “وهذه هي الحلقة المفقودة في تفكيرنا وممارستنا. هذا هو العائق الجوهري، وهو يبدأ بالسؤال. إنّنا لا نطرح الأسئلة ولذلك نقنع بأشباه الإجابات التي نتجاوزها بسرعة”[3]تفكير منظّم ينْبَني على التّغيير ويُسائله، ومشروع فكري شامل يمسّ كل المساحات الممكنة من إنسانيتنا، سياسيا وثقافيا واجتماعيا، وفي حاجة إلى الشعر والأدب والفلسفة والفن، أن يكونوا أدوات رفض ووسائل نقد وبناء، ورفض الجاهز والثّابت والمكْرور والمُزيّف، ونقد الحال وما يؤسّسُه وما يتأسسُ عليه، وما نؤمن به من أفكار ومسلّمات، وبناء حالات ونظريات وأفكار تعتمد العقل والتفكير كمنطلق للبناء، وفي حاجة إلى فتح حوار ونقاش عربي مسؤول، يتجاوز النّقاشات والتّراشقات، من أجل الوقوف على حالات الإخفاق والتراجع والرّداءة، وطرح ومناقشة المبادرات الجادّة للخروج من الحالة المستعصية التي أناخت بكلكلها على الأرض العربية، والانتقال من الحالة الأدنى والحالة الصّفر، إلى الحالة الأعلى، وخوْض نقاشات فكرية، سياسية وثقافية واجتماعية وإصلاحية، وذلك عبر السؤال والنّظر وعدم تسرّع الإجابات والحلول.
الشعراء والفلاسفة والمفكرون والأدباء والباحثين والخبراء، ومن يملك حسّ السؤال، وثقافة البناء والمشاركة، وإنتاج الفعل المُحرِّك، والقدرة على تصريفه بفاعلية تخدم الأهداف والمرامي الكبرى للإنسان العربي، هم وحدهم من يؤول إليهم النّظر في الحال، في عمق الحال، لتفكيكه وتشريح أسباب التّراجع والتّخلّف، وفضح الخائضين في الوحل ليدوم الحال على ما هو عليه، والذين يبنون ثرواتهم من مآسي العربي وتخلّفه.
نحن في حاجة إلى مفكرين لا يهادنون، لا يميلون حيث مال النّاس والهوى، لا يستكينون لسلطة ولا جاه، بل يمشون بصبر ضد التيار، في مواجهة غباء الطوفان والجهل والتّفاهة، يفتحون للآتي من الزّمن، صفحات تُشرق فكرا بانياً يناطح أسباب التراجع والانحطاط، ويفتح ما أُغْلِق من دروبٍ تؤدّي مساراتها إلى التّقدّم والازدهار، وينظرون بعين المتأمّل والنّاقد والمتسائل، لا بعين المُتأسّف العاجز أو المتفرّج الباكي، في ما من شأنه أن يُغيّر نظرة العربي إلى ذاته وإلى الآخر، نحن في حاجة إلى “باحثين، وخبراء، وأكادميّين، ومؤسسات، بوعي جديد، ورؤية مغايرة تتأسّس على قراءة نسقية لتاريخنا وفكرنا الحديث، وعلى نقد ذاتي لأنماط الوعي، وأشكال الممارسات التي لم تؤدّ إلا” إلى إضعاف لغتنا، وتهميش ثقافتنا، وتأخّرنا معرفيا. ولم يكن لذلك غير النتائج الوخيمة التي لم يتولّد عنها إلا التّقهقر والتخلّف والإنقسام، وأخيرا كل المآسي التي يتخبّط فيها كل الوطن العربي، والتي لا يقدّر أي كان كيفية تجاوزها أو الخروج منها”[4]
رغم تراكم سنوات التّخلّف، على المفكرين والمثقّفين أن يخرجوا من خلواتهم، ويقتحموا متاهات ومعاقل التّخلّف والجهل، أولى المعضلات وعوائق الإصلاح التي استأنسها الإنسان العربي وشدّته إلى القاع شدّاً مُحكما، وإثارة نقاش فكري أكثر عمقا للغوص في الأسس الفكرية والمعرفية التي تأسّس عليها التّخلّف العربي، لأن التحديث الحقيقي والمنشود، ينهض على تفكيك السائد ونقده، وإجراء دراساتٍ مسْحية له، وإحداث قطيعة تدريجية معه، وإعادة بنائه على أسس عقلانية قوية، تنهض على العقل والفكر باعتبارهما مطلبا ومسعى وحيد لربط العربي بماضيه وحاضره ومستقبله ليكون فاعلا في الحضارة الإنسانية وليس متفرجا سلبيا كصفر على يسار العالم المسرع في غير انتظار.
………………….
[1] قرآن كريم، سورة الأعراف 7، الآية 176.
[2] يحيى إبراهيم حقي. قنديل أم هاشم(رواية). سلسلة إقرأ عدد 18. دار المعارف المصرية، ط 3. ص 52.
[3] سعيد يقطين. اللغة، الثقافة، المعرفة، (إشكالات ورهانات)، دراسة. خطوط وظلال للنشر والتوزيع 2023 . (ص 121).
[4] نفس المرجع (ص 163).