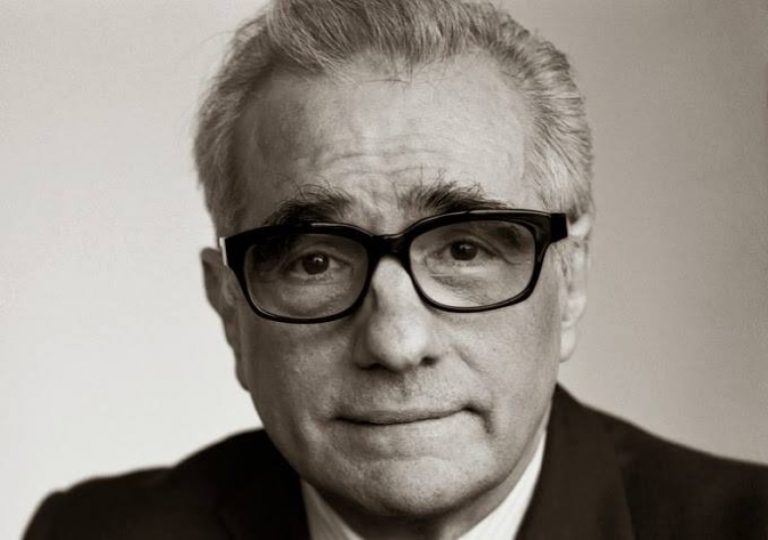ضربة سينمائية قدرية، سهم نافذ في القلب، قنبلة تفجر عقلك الخامل المستكين، تطيح بالثابت وتخلخل الروح وتفقدك توازنك، وتعيد ميلادك من جديد، فتصبح: نقيا وطاهرا ومبتسما وراضيا…وإنسانا من جديد.
أربع دقائق فقط، تشمل حنان الانتقام وقسوة الحب وشغف الامنيات ورقة الموت، بعدها سوف تصير شخصا آخر، تستطيع أن تصالح نفسك وتصالح الناس والحياة حولك، أربع دقائق تجعل قلبك يمتليء بالبهجة وتشعر بالرضا.
الرضا: تلك هي الرسالة التى يقدمها لنا هذا الفيلم، دون حوار وكلمات ودون مشاهد قاسية ودون استعراض عضلات في تصوير المشاهد.
أربع دقائق تجعلنا نقف، وقفة حقيقية.. نقف في أي مكان: في حديقة أو دورة مياه أو ميدان أو قمة الهرم، أو حتي أمام المرآة، كي نطل على داخلنا، داخلنا المسحوق والمفتت والمريض والمهزوم والغلبان – أيضا، نعم لم يعد أحد يستطيع شق صدره، كي يخرج ما بداخله، يفتت ذراته، يخرج البراري النفسية لكيانه ولإعضائه ويعرضها للهواء وأشعة الشمس، يعلو في السجيم ويصبح بخارًا، سحابًا،، أو حتي دخان بخور، لم يعد أحد منا عصفور يحط على غصن أو زقزقة في صباح هادئ أو وتر يكمل اللحن المفقود.
جميعنا غارقون وسط بحار الطلبات والأوامر والشد والجذب والصراعات والحقد والغيرة والتنافس والبحث عن النقود، غرقي وسط لزوجة العرق ووسط أكوام من الورق والمشكلات والتفاهات والشد والجذب والابناء والمدراس والتليفزيون والانترنت، الذين يلقون في عقولنا كل شيء، اصبحنا – جميعنا – سلة مهملات، مخلفات، يلقي فيها هذان الجهازان الرهيبان ما يشاءان، ولم نعد نحلل ونفلتر ما يقدم لنا، فلا أحد يستطيع أن يلحق الأخبار السريعة والصور المتدفقة منهما، وأصبح هؤلاء هم الرابحين في النهاية، ولتسحق أنت بهدوئك وودعاتك وعالمك وإنسانيتك.
حتي استكانتك بجوار الراديو كي تنظف اذنيك بمقطوعة موسيقية أو بآيات من الذكر الكريم لم تعد تستطيع أن تفعلها.
ويأتي هذا الفيلم المدمر، المزلزل لكل الخلايا والمفاهيم والأسس والبديهيات التى تركناها، يأتي في هدوء طفل يحبو بحثا عن ثدي أمه حالمًا بالدفء الاسطوري والشبع والامتلاء، يأتي براحة البال المفقود، ويجعلك بعد أن تشاهده ليس كما أنت أو حتي كما تريد، يأتي كي يضحك عليك، ويضعك أمام نفسك، ويتركك تتأمل حياتك وما يحيط بك، وهذه هي قمة المتعة، وهذه احدي نجاحات الفن السابع- السينما – أن تُجبر على التحرك والتفتت والتغير والتجدد والميلاد والاستمرار.
وقد ابدع المخرج الايراني الشاب ( نيما رؤوفي ) في أن يضعنا أمام أنفسنا وذاتنا لمدة أربع دقائق، بمنتهي الذكاء والدقة وخفة الدم والقسوة، وأيضا – بمنتهي الاثارة، في مواجهة أنفسنا ثم في مواجهة الحياة.
وأقام محكمته كي نحاكم أنفسنا، ونصبح نحن القضاة والجناة والمجني عليهم والشهود، ولكنه لم يصدر – قرارا أو حكما نهائيا ونافذا- بل ترك لنا نحن أيضا حرية هذا القرار.
يبدأ الفيلم بطفل صغير يجلس في حديقة خالية ولكن تأتي الأصوات من خارج الكادرو الضحكات وكأن العالم يسير ولا يشعر به وبوجوده. والمدهش أن كل مكان بالعالم يوجد هذا الطفل، في أغني مدن العالم أو افقرها، في أي حي وكل شارع. طفل فقير، ملابسه رثة، بنطاله ممزق، يشعر بأنه لا قيمة لوجوده، إنه وحيد، مهمل، منسي..ولا يمتكلك شيئا إلا جسده. ويريد أن يثبت انه مازال يعيش.
تشعرك نظراته وبؤسه وكأنه يقول: يبدو لي أن مجيئي للعالم.. كان أحد الأخطاء المروعة، وجميعنا نردد تلك العبارة دائما بداخل صدورنا، وسط حالة من اليأس والتخبط وعدم الإدراك والهرولة خلف لقمة العيش، لا نقف كي نتسريح لحظات، ونلتقط أنفاسنا.
ويستمر الطفل جالس، منكس الرأس، ينظر إلى حذائه الممزق والذي تخرج منه أصابعه، يحركها في إحباط، فهي دليل على بؤسه وفقره، لكن على وجهه علامات متناقضه ما بين رفضه لهذا الحذاء وبالتالي رفضه للحياة التى يحياها وشعوره بالاستسلام لتلك الحياة أيضا، فلا مفر.
ينهض ويتجول في الحديقة، ثم يقف على كوبري تمر من أسفله ترعة صغير، وتداهمك الاسئلة، هل يريد أن يري نفسه على سطح الماء؟، أم يريد أن ينتحر ويتخلص من حياته البائسة؟.
تنتقل بنا الكاميرا إلى أعلى حيث طائر يعبر المشهد وتسقط منه ريشه تهبط في هدوء، على طفل آخر جالس في الحديقة، يبدو وجهه الممتليء إنه في يسر ونعيم ويرتدي ملابس شيك وفاخرة وحذاء رياضيا غالي الثمن، الطفل جالس على دكة خشبية لا نعرف ما به وما يدور بداخله، بعد لحظات يأتي الطفل صاحب الحذاء الممزق، وينظر للطفل الآخر، ثم يجلس على الطرف الآخر من الدكة، يبادله النظرات، وينظر إلى حذائه الثمين والسليم أيضًا، يشعر بالضيق والبؤس، بينما الطفل الآخر يريد أن يتجاوب معه ويشير له.
ينهض الطفل صاحب الحذاء الممزق حزيناً، ويتجه إلى شجرة ويجلس أسفلها وهو في حالة من الضيق والحزن، يخلع حذاءه الممزق ويضع كل فردة حذاء في يد، وتبدأ كل فردة حذاء تحدث الآخري مثل ما يفعله فنان الأراجوز عندما يحرك أبطاله ويشرح مشكلته على لسانهما، تبدأ كل فردة في الحديث رافضة ما يحدث له ورافضه تلك الحياة الفقيرة، وامنياته بأن يكون مثل الولد الثري الذي يبدو كاملاً وفي صحة جيدة، ويصرخ الطفل على لسان الحذاء: أريد أن أكون مثله، اريد أن اكون مثله، هكذا تصرخ فردة الحذاء للفردة الآخري.
والمدهش أن المخرج يجعل تلك الأمنيات تتحقق كأن السماء استجابت رجائه وحققتك أمنياته. ويصير ذلك الطفل صاحب الحذاء الممزق هو الطفل المكتمل صاحب الحذاء الفاخر السليم، فيشعر بالفرحة والسعادة. لكن هنا، وهنا فقط يأتي المخرج بسكينه كي يذبحنا ويجعلنا نفيق.
حيث تأتي سيدة تبدو أنها أم هذا الطفل وهي تدفع أمامه كرسي متحرك، ولنكتشف أن الطفل صاحب الحذاء، طفل عاجز عن الحركة، لا يستطيع أن يتحرك رغم ارتدائه هذه الملابس الغالية وهذا الحذاء الفاخر.
وينتهي الفيلم وسط الفرحة الغامرة والكبيرة للطفل البائس بحذائه الممزق وبقدميه وهو يقفز وكأنه يريد أن يصل لعنان السماء، فرحًا ورضا وشعوراً بالنصر والسعادة التى هو فيها حتي ولو كان لا يرتدي حذاء في قدميه ويعيش كل هذا البؤس، بينما الطفل الآخر تدفعه السيدة على مقعده المتحرك وتخرج من الحديقة.
وهكذا ينتهي الفيلم، وقد عاد لنا طفلا سعيدا بحريته وبحذائه الممزق الذي تخرج منه اصابعه، سعيد بصحته، وبرضاه وبقدرته ونصيبه ومصيره، حتي ولو كان شخصية تعاني الاحباط والفقر إلا إنه راضي بصحته وبما يحيا عليه.
ولقد لعب الدور البسيط طفل صغير لا يتعدي العاشرة من العمر، الا انه يمتلك قدرات مذهلة على تأديه ما يريده المخرج، إنه يتألم..ويغضب ويبدو يأسا .. يعبر عن الألم والمعاناة، وفي لحظة يصرخ فرحا ويجري في سعادة وحبور، ساعده على ذلك نظراته وقدرته على التلون من شخصية الطفل البأس إلى شخصية الطفل الثري.
وهكذا يقدم لنا المخرج الإيراني الشاب (نيما رؤوفي ) رائعته فيلم ( حذائي ) الذي حصل على جائزة أفضل فيلم قصير في العالم، ويقدم فيه تجربته ونظرته إلى الحياة ورحلة الإنسان فيها.