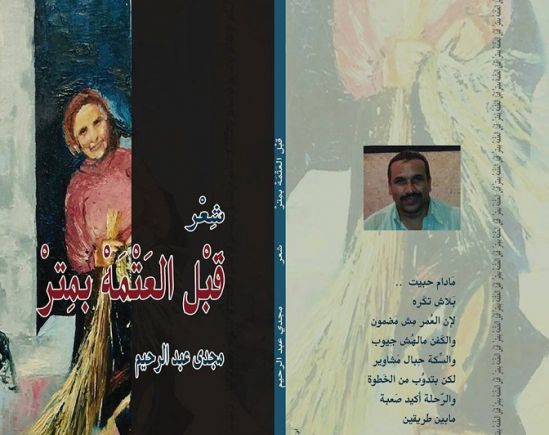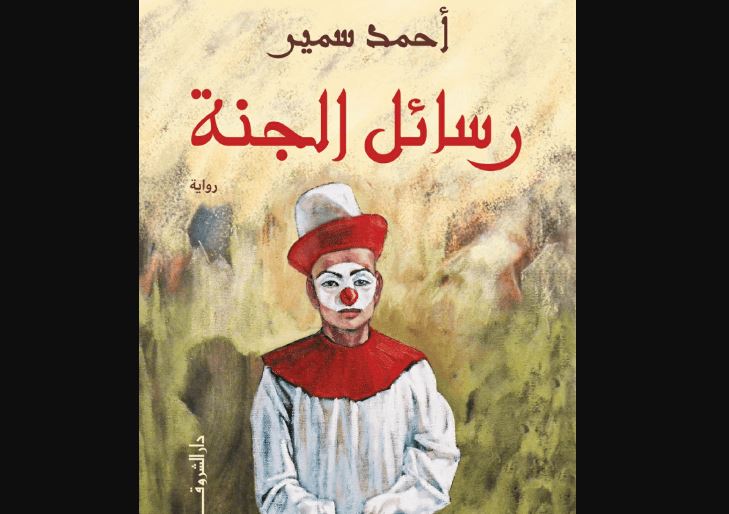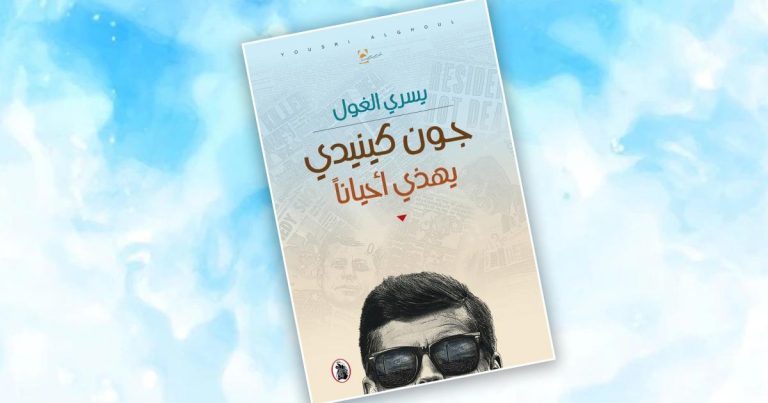شوقى عبد الحميد يحيي
لم تنس “سهير المصادفة” أنها قبل أن تكون روائية، كانت شاعرة، على الرغم من أنها سارت بخطواط ثابتة، نحو تثبيت صفتها الجديدة “روائية” لها رؤيتها التى حاولت الاقتراب منها منذ أولى رواياتها “لهو الأبالسة”(2003) وعبر خمس روايات أخرى، وصولا إلى أحدث رواياتها “الحديقة المحرمة”[1]، التى أمعنت فيها بالغوص إلى أعماق المَشَاهد والرؤى، وكأنها تسعى لإخفاء تلك الرؤية التى كانت أوضح فيما سبق من أعمالها. مستخدمة -هنا- تلك المشاهد التخيلية، والتى تعود بنا إلى بدايات التاريخ، المؤثر، والمحرك، فى الواقع المعيش، وكأنها تؤكد أن اليوم هو ابن الأمس، يحمل من جيناته، التى تجعلنا نعيش اليوم، وكأننا نعيش فى الأمس. مقتحمة تلك التابوهات الثلاث المحرمة، بحرص، وتَحسُس، وفقا لاعترافها (الضمنى) {فى الصباح مرّ علىَّ “سيكا” العبيط، وبلغنى بآخر أخبار النجع، لأعيد صياغتها وكتابتها على الكمبيوتر، ثم أرسل المناسب منها، الذى أثق أن لا يكسر أى سقف سياسى أو جنسى أو دينى إلى إيميل جريدتى المحلية “صوت الزرايب” التى لا يقرأها أحد، وهذا كل ما أفعل فى هذه الحياة، فأنا كما يطلقون علىَّ هنا “جورنالجية”}ص 8. لتلقى –من طرف خفى- الضوء على ما يعانيه الإعلام من قيود فى النشر، ولتضعنا فى الحاضر منذ البداية. ولتكشف عن الشاعرية التى احفظت فيها، برؤيتها المغموسة فى المَشاهد والشخصيات، وتركت للقارئ أن يُمعِن النظر، والتفكير.
وتروى (الحكاية) أن معركة دارت فى “نجع الجواميس” – التى تربطنا بلهو الأبالسة- وكأنها الخيط الممتد عبر المسيرة الروائية، وتُسهم فى الكشف عما وراء السطور-. قُتل في المعركة ثلاثة أخوة – مسيحيين -. يراها الأخ الأكبر “عبد القادر” فرصة للتخلص من أخيه الأصغر”ألهم” –للانفراد بالميراث- فينادى عليه –دون أن يراه أحد- بأن يكتفى بهذا، ليوحى للآخرين بأن “ألهم” هو القاتل، فتسوق الأم “وحيدة” ابنها الأصغر للهرب، حتى لا يقتلوه بجريمة لم يرتكبها، فيهرب إلى الصحراء، وفيها يسقط عبر صخرة –تمكن من إزاحتها، وإعادتها لموضعها بعد عبوره- إلى عالم مجهول، بدائى، وكأنه يرجع إلى بداية مسيرة الإنسان، وليجد أناسا لهم رئيس “سلطان” هو الحاكم لهذه البلاد. الذى يسأل “ألهم” من أين جاء وكيف وصل لهذه الأرض المحرمة، والتى أسموها “الجنة”. غير أن هذا الكبير كان يعانى المرض فنجح “ألهم” فى علاجه ، بما تعلمه من جده “ألهم الكبير”. فكان ذلك مدخل للمعيشة معهم، وراح يشرح للكبير كيف وجد نفسه فى هذه المنطقة: {لا أعرف من أين جئت، ولا أعرف كيف ولدت ومن رمانى فى هذه الصحراء الواسعة، كما أننى لا أعرف هل يوجد ثمة مدخل أو مخرج من نبعكم المقدس إلى بحر الرمال الوسيع الذى وصفته لكم أيها الحاكم؟!}ص59.
وهناك، تبدأ رحلة “ألهم”، ورحلة التاريخ،التى تكشف لنا عن الجذور، كما تبدأ رحلة الكشف عن شخصية ذلك الأدلهم. فتبدأ من مصر القديمة، إلى جدودنا الفراعنة، والذين كان قسمهم، ألا يلوثوا مياه النهر، فيعلن القادم من السماء، كبير النجع “سلطان” ، حين لم يصدقوا ذلك الغريب {اشهدوا علىَّ الآن يا ناس، سأكون قربانكم لتواصلوا ما جاء فى وصايا جدودكم الأوائل بألاتُغضبوا إلهكم بتلويث نبعه المقدس }ص49. حيث كان أجدادنا الفراعنة يتلون هذا القسم العظيم: (لا أسرق ـ لا أقتل ـ لا أزنى -لا ألوث مياه النيل) حيث بدأ التاريخ فى مصر بالقسم بعدم القتل.
ثم تبدأ مسيرة السماء ، التى تبدأ معها الرواية رحلتها من آدم وابنيه قابيل وهابيل، اللذين زرعا الفتنة والقتل بين الأحفاد { وهل خُلق هذ العالم إلا ليقتل الإنسان أخاه الإنسان؟ حتى إسألى سيدتك الأجنبية عن قابيل وهابيل..}ص112. وكأنهما وضعا بذرة القتل ومشروعيته، والغيرة وتجذرها، وفتنة المرأة وغوايتها، منذ نزول الإنسان على الأرض. الذى تروى “جميلة “عنه وكأننا أمام آدم أبو الخلق جميعا {يوم نزول سلطان من السماء، وبعد أن ركع له أهل النبع، حتى من كانوا يحقدون عليه،…. أزاح الصخور من مدخل أكبر الكهوف وأوسعها ففتحه. وظل طوال النهار يعمل على سد كل ثغرات الجدران، منع الجميع من الدخول لمساعدته، حمل الأحجار الجرانيتية الثقيلو وحده}ص119.
ثم نعايش أبو الأنبياء إبراهيم، فى التناص مع القرآن الكريم { فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. قال هذا ربى. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى. فلما أفل قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى. هذا أكبر }[2]. استحضرتها الكاتبة، بل نسجتها فى صميم الحكاية، حين يروى “ألهم” بعد وصوله النبع، وبما يعيد إلى الأذهان، قصة إبراهيم، ورحلته من الشك إلى اليقين {فى البدء ظننت أن الرمل الذى يصغر أمامه كل شئ حين يغضب هو ربى. ولكننى اكتشفت بعد حين أن العاصفة هى التى تحرك الرمال. ثم عرفت أن الرياح هى صانعة العاصفة، فدربت نفسى على التقاط هسيسها قبل أن تقترب منى، بل أصبحت أستطيع تمييز رائحتها، صارت لدى قدرة عجيبة على الاستماع إلى دبة النملة وهى على بعد عشرات الأميال، أو زحف ثعبان ضخم وهو يسعى ناحيتى تحت الأرض}ص58.
وحيث أن الفكر الدينى لم يكن غائبا عن “رحلة الضباع” التى كتبتها الكاتبة فى العام 2013. فوجود ذلك الخيط-أيضا- ما يربط بين أعمالها السابقة وعملها الحالى-“الحديقة المحرمة”- والتى لم يقتصر فيها، التناص مع القرآن، عن إبراهيم فقط، ولكن كانت قصة “يوسف” ايضا حاضرة، وكى تكون رمزا، ومدخلا، إلى عالم روايتنا. حيث يوسف، هو “أمين خزائن مصر”، لتكون البداية التى تربط الكاتبة، هذا، بذاك، حيث عُرف عيسى بالجمال الفائق، الذى أغوى النساء فقطعن أيديهن، وهو ما تقول به “وحيدة” أم ألهم ، حين علمت بعودته {كان ابنها ألهم الذى أنهضتها رائحة كتابه من رقدتها، هو آخر من خرج من هذه الحفرة .كان يرتدى ملابس جميلة جدا}ص72.
حملت الساردة “وحيدة” كتابه -“كتاب ألهم”- ورغم أن الجدة “وحيدة” لا تعرف القراءة والكتابة، إلا أنها اشتمت رائحة كتاب ابنها، وقد شُفيت من مرضها الذى كانت تعانى منه قبل رحيله، وكأننا أمام “يعقوب” أبو يوسف عليه السلام. ثم يسأل ألهم عن امه “وحيدة” التى بلغت الثمانين، وهم عائدون به بعد أربعة أعوام من الغياب فى الكهف: {لم يتكلم كثيرا، فقط سألنى: وأمى وحيدة! فقلت له “بخير . بخير وهى تنتظرك مذ رحلت: ألا يعرف أنها تقترب من الثمانين من عمرها، وأنها لا تحتمل مشقة هذا الطريق ليطلبها كشرط لخروجه من هذا الجبل الغريب! أخبرنى العقيد محى الدين الهوارى ونحن فى الطريق إليه، أنه صاح فى وجه أول من أطل عليهم من ذروة الجبل: لن أخرج قبل أن تأتوا لى بوحيدة وعبد القادر محمد ألهم من نجع الزرايب}ص73. لنستحضر الآية الكريمة[ فلما دخلوا علي يوسف ءأوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا][3].ولنلاحظ هنا، أن قصة سيدنا يوسف قد حظيت بنصيب كبير من مساحة الرواية، وكأنها إشارة لمصر التى عاش بها المسيح قرابة الأربع سنوات.
ثم تأت الإشارة إلى الإسلام، حين هبط الكبير من السماء، وأراد كل أن يجذبه لكهفه {أراد كل منهم جره إلى كهفه… ولكنه قال لهم: سأسأل النبع المقدس، بالدوران حوله وما إن يأمرنى بالتوقف أمام بقعة ما، سأقف عندها ليكون هذا كهفى. ودار حول النبع ، وما إن شرع فى الثالثة حتى توقف أمام بيت الجن، فصاح: هذا سيكون كهفى. فصاحوا : ولكن هذا بيت الجن يا كبير.
-نعم ، أعرف وسأسكنه، وأغلبه}ص50. وهو ما يستحضر قصة النبى محمد، حين هاجر من مكة إلى المدينة، وأراد كل من بها أن يستضيفه، فركب ناقته وقال لهم “دعوها فهى مأمورة.
كما تُعلن “لبيبة” التى تُظهر للغريب الكره، وهى تحمل فى أعماقها الغيرة من نظرات أختها له :{أيها الغريب الغبى، حكايتك البلهاء لا يصدقها حتى البهيم، إذ أنه سيسأل نفسه: إذا كان قد ولد فى الصحراء ولم يلتق بإنسى قط، فمن علمه إذا الكلمات العربية التى تشبه كثيرا ما يتعلمه المسلمون فى الكتاتيب؟}ص68.
وكأن “ألهم هو خليط من كل ذلك التاريخ، المعتمد على الغيبيات. حين تكتب “لبيبة” (العرافة) فى أوراقها:
{هذا الرجل الغبى مسكين ولا يعلم أننا نعيش فى بيضة هائلة الحجم، ليس لها مخرج}ص124.
{وقبل أن تغرب الشمس أَمَّل جلستى، فأنهض لأجده واقفا قدامى، يزداد يقينى بأنه من فصيلتى نفسها، بمجرد أن يفح فى وجهى كثعبان:
-توقفى عن مراقبتى، فأنت فعلا ترعبيننى مثل شبح.
-هل ترى عن بعد مثلى
-لا
إذا كيف عرفت أننى وراءك؟
يكز على أسنانه بغيظ:
يا امرأة أنا ممن أوتوا العلم.
-العلم!
-يا الغريب
يتوقف ويعود إلىَّ عابسا
-ألهم. ألهم رددى ورائى: ألهم
ألقى بنفسى بين ذراعيه وأنا ذاهلة عمَّا وعمَّن حولى:-فلأكن ربتك يا ألهم، فأنت أوتيت هذا العلم، وأنا أرى ما لايمكن للآخرين رؤيته، ولو اجتمعنا سنحكم أرض النبع المقدس إلى الأبد.
فيربت على وجهى، ويبعدنى عنه بيديه القويتين، ثم يهتف بنبرة مغايرة ومحايدة: لن تكون ربتى امرأة مهما كانت، بل سأكون أنا ربُ جميلة، فمع الأسف يا أختاه لا شئ فى دنيانا هذه ينافس الجمال}ص128.
فنحن أمام شخصية، عنيدة، تسعى لأن تنفرد بحكم النجع، فيبدأ التخطيط لذلك. بدس السم البطيئ للكبير “سلطان” حتى ينجح بالفعل فى إحتلال مكانه.
وهنا يجب أن ننتبه للإشارة الدالة، حيث يعتقد أهل النجع المقدس بأن “سلطان” نزل من السماء، وقد حَرَّمَ ذكر الموت، فغابت الكلمة عن النبع. بينما على الأرض، فى الواقع، نرى أن كل من حملوا رسالة السماء، من آدم وإبراهيم ويوسف وعيسىى ومحمد. لم يدعو واحد منهم للموت، بل حرمه، وعلى الرغم من ذلك، بل سَخِرَ من إخفاء كلمة الموت عندهم {أتذكر جيدا أن ابتسامته – سلطان الكبير- لم تغادر شفتيه قط، وأن جفن عينه اليمنى ظل يرتجف بعصبية، هل قلت له: يا رجل، يا مسخرة، يا كافر، هل تعلمهم هنا أنه لا يوجد موت؟ كيف نزعت يا كافر كلمة موت من نفوسهم، وهى اسم من أسماء الله الحسنى، فهو الممُيت كما هو المحىى، يا أيها الكاذب.” ثم قهقهت عاليا وأجبته عن سؤالى: آه نَسيتُ أن إلهك يسكن فى نبعك المقدس}ص67. فلم يتورع “ألهم” عن القتل، وكان أول من أصر على ذكر الموت فى النجع المقدس، وكأنه لوث طُهرَه، ونقاءه. فقط من (يتوفى) يلقى به فى “النبع المقدس، كقربان” وكأنه النيل، وقصة عروسه التاريخية.
ولم يكتف “ألهم” بقتل الكبير، بل قتل حبيبته، وزوجته، فى لحظة عشق، فقط، لأنه اكتشف أنها تعرف مكان الحجر المخبأ للخروج من النبع، ويأبى إلا أن يظل الوحيد الذى يعرف هذا الطريق رغم أنها من كشفت له عن مكانه. وليفاجأ بانه تحت أقدامه، وهو نفسه الذى خبأه، دون أن يعلم. وليتزوج بعدها أختها التى هامت به عشقا، ولتتفجر قوة المعارضة من “تمرة” عشيقة “لبيبة”، والتى ترى أن ألهم اختطف منها جزء مهما من حياتها، فتهتف فى كل النبع {يسقط الغريب ـ يسقط القاتل، قاتل الشجر والنبع، يسقط السجان}ص223. ويبدأ الأفول يغزو النبع المقدس، فتغيب ابتسامة “تمرة”، وكأنها فرشت حزنها على الجميع {وزعت بنت الحرام- تمرة- حزنها وصمتها على أهل النبع بالتساوى، فكانوا يسيرون صامتين حزانى، مطأطئ الرؤوس مثلها، ينظرون إلىَّ باشمئزاز عندما أمر أمامهم، وكأننى كلب جربان….. صاموا عن الضحك والكلام فتبدلت رائحة الجو وأصبحت ثقيلة بعرقهم المنفر بعد جفاف مرتع الكباش فجأة أتلفتُ حولى فأرى كل الأشياء قد شاخت، وصارت الجبال جرداء من زهورها وزرعها الأخضر…. يدعوننى بلا مبالاة لدفن أحد مواتهم بطقوسى التى كانوا يعتبرونها غريبة وقبيحة.. حتى تحولتُ يوما بعد يوم من المجبراتى إلى دفَّان النبع المقدس}ص229. فتقول المجذوبة “كسيبة” : تفرجوا معى على غضب الرب.
و تموت “لبيبة” هى الأخرى. وبعد أن كان قد عُرف فى النجع كله ب”المجبراتى”، لعلاج كل مريض أو مكسور، وبدأ فى بناء سجن جديد، وأصبحت كلمة الموت مباحة، وبدأت مراسم الغسل والدفن لمن يموت من أبناء النجع. تبدل الحال، وتبدلت نظرة الناس إلي “ألهم”.
ثم تأتى الإشارة التى جاءت كما لو انها عفوا – فى حينها- وكأنها بدون مقدمات، ولا تعقيبات. حين سألت “الحورية”- وهى زوجة الكبير، ووالدة كل من “جميلة” و “لبيبة”، وهى والمرأة الإنجليزية التى رفضت الاحتلال، ووقعت فى حب مصر- :
-هاه، وبعد أن قامت الثورة يا ألهم، ماذا فعل جمال عبد الناصر؟
أقول لها بحنق لكى أغيظها، لعلها تتركنى أنام:
-طردنا الإنجليز وأعوانهم من مصر.
ولكنها تصفق بيديها فرحة:
والله برافو يا مصر، وبعدُ يا ألهم، وبعد..}ص145. وكأنها تسأل عما بعد ذلك. وليجيبها التاريخ بأن ثورة جديدة فى الخامس والعشرين من يناير، بل وثورة أخرى فى30 يونيو، تقدمتها وجوه غير وجه جمال عبد الناصر.
وهو ما تكشف عنه الكاتبة، بصيغتها المبطنة، والمخبأة فى أعماق الأحداث، وكأننا نقرأ قصيدة، تأبى أن تبوح بسرها للعابر.
فبعد أن استقر “ألهم” فى النبع المقدس”، كانت “الحورية” من بين من تعرف عليهم، و حكت له قصتها: {تعيد إلى مسامعى الحكاية نفسها بالكلمات نفسها ربما للمرة الألف..
كنا فى صيف 1950، حين وصلت هذا المكان. كنت آنذاك فى السادسة عشر من عمرى، ابنة مدللة لأبويها، أبى هو الجنرال إدوارد رون، أحد كبار رجال الحامية البريطانية على مصر، ولدت فى القاهرة ودخلت مدرسة الفرير بالخرنفشْ .. كنت أسأل أبى أسئلة كثيرة، أسئلة زملائى المصريين: لماذا نحن هنا، لماذا نستعمر هذه البلاد الجميلة؟ وكان لايجيب عن أسئلتى، إلا بكلمة تخرج من أنفه بسخرية: استعمار …إممم} ص212. لتنضاف الإشارة الزمنية (1950) إلى تلك الإشارات المكانية (مصر) لنبدأ تحسسنا للفضاء الروائى، الكامن وراء السطور، على الرغم من وجود إشارات أخرى، تقود إلى مداخل مختلفة للرواية، كالرؤية الاجتماعية، التى يمكن استخلاصها، حين قابل ألهم فى الصحراء مجموعة من التماسيح، غير أنها لم تقترب منه، فتعجب: {أكانت إلى هذا الحد شبعانة، أم أنها كانت أحن علىَّ من أخى الذى ألقانى فى هذا الجُبِّ؟!}ص22. وكذلك تقول الساردة “وحيدة” عن أعمامها( وكأنهم أخوة يوسف): {أفكر فى كلمات عمى ألهم، لماذا يكتب عن أخيه أنه ظالم يريد قتله، وأن التماسيح كانت أكثر عطفا عليه منه، وأنه هو من ألقاه فى هذا الجُب؟ يمتلئ رأسى بدخان كتابه، ويكاد يحترق من اصطدام شذرات حكاياته بعضها ببعض، فلا أستطيع الإمسك بخيط واحد لأسير خلفه. هل كانت أمى مريم حبيبته هو أولا وخطفها منه أخوه عبد القادر؟!}ص82.
وكذلك الرؤية النفسية التى يمكن عليها بناء الرواية، من قتل “ألهم” لزوجته وحبيبته، وفى لحظة العشق المدلهم. وتلك المعاناة التى تعانيها الساردة، جراء غياب الكثير من الحقائق.. التى تعنيها. فضلا عن المعاناة –النفسية- التى يمكن أن تشعر بها بعد إكتشاف حقيقة أنها ابنة غير شرعية، وهى الرؤية التى تقودنا للرؤية السياسية، والتى ننظر من خلالها، لما حولنا، ومسيرة التاريخ ، وكيفية إعادة دورتهن ومن خلالها نستطيع القول بأنها “وحيدة”، الساردة المشاركة، هى الشخصية الأولى فى الرواية.
مثلما نتعرف على المكان. “المدق المسحور”، الذى ساق (القدر) “ألهم” للتواجد فيه، والمسمى لديهم “الجنة”، والتى يصفها بنفسه: {إلى يسارى نخيل وأعناب وأشجار زيتون وجميز وتوت ومانجو وخيزران، لو لم تكن هذه هى الجنة.. فكيف تنبت كل هذه الأشجار معا هكذا فى موسم واحد، لا. بل فى يوم واحد. أتأمل فُرجة السماء ، تبحث عيناى عن صاحب النخل والشجر والزرع، عمن بذر كل هذه البذور التى لا تجتمع فى مكان واحد، بدون شك هو يراقبنا من مكان ما، أبتسم لوجوههم وهم يطوفون حول حقولهم وكهوفهم طوال اليوم، أينما يلقون بذور الفاكهة والخضراوات بطول أذرعهم ينمو فى مكانها شجر جديد، يحصدون الثمار، ويخمرون العنب والشعير فى قنوات واسعة، حفروها خصيصا لذلك}. حيث تعيدنا تلك الأوصاف إلى الحديث القدسى، الذى يصف الجنة بأن بها [ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر]. كما يقول القرآن [مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آَسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى][4]. وهو ما يؤكده “ألهم حين يقول{لطالما تخيلت الجنة هكذا فى كُتَّاب نجع الزرايب}. لنتذكر على الفور مقولة الحورية { هل تعرف يا ألهم، هذه الأرض مقدسة بالفعل، إنها جنة}ص221. ونتذكر قول الله تعالى: إدخلوا مصر آمنين.
جميلة
قد تشترك “جميلة”، مع “وحيدة” الساردة، فى البعد الرمزى، فكانت هى من احتلت الاهتمام الأكبر، ليس من طرفى النزاع “سلطان” و “ألهم”، فقط، وإنما من كل أهل النبع جميعا، وهو ما يعطيها الصفة الجمعية {عبر ستة مواسم حصاد بالكمال والتمام، أصبحت “جميلة” أسطورة الناس الجديدة، ألفوا عنها الأغانى، وبالغوا فى وصف جمالها وفتنة غمازتيها، وخصوبتها… وبالغوا كثيرا فى وصف جمالها وفتنة غمازتيها، وخصوبتها.. قالوا إنها كانت تغتسل بماء النبع المقدس فتحمل منه، وتقف تحت نخلة، رافعة وجهها إلى سباطات بلحها العالىة فتساقط فوق رأسها، ثن تصرخ صرخة أو صرختين فلا ينزلق من بطنها إلا رجالا يشبهون الأسود… تشير إلى أماكن بذور الشجيرات التى على وشك الانقراض، فيغرسونها لتنبت من جديد … }ص219.. ولذلك كان رفض الكبير زواجها من الغريب، الذى شعر بنواياه، وتصور أن “جميلة، هى السلم الذى سيرقى عليه للصعود. فكلف ابنته العرافة “لبيبة” بمراقبة كل حركاته وتحركاته. حتى وصل الأمر إلى أن يروى ألهم فى كتابه {والكبير لم يعد يكلمنى، تقريبا لا يسمح لى بالدخول إلى ركنى بكهفه لأنام، فأصبحت مطرودا أتسكع من طلوع الشمس وحتى غروبها، وأنا لا أعرف ماذا يُضمر لى، هل سيقتلنى أم سيسجننى كما نصحته ابنته العرافة لبيبة؟}ص84. وبعد موتها، او غيابها-مثلما حاول ألهم أن يصور الأمر. قالت الحورية {ستعود الجميلة ذات صباح مشرق، وعلى رأسها تاجها}ص220.
لذا بموتها، أوغيابها، كان الحزن قد سرى، فتقول “كسيبة” وكأنها نعيق البوم:{ فى البداية سيسقط مطر أسود غزير، ثم تطير فوق رؤوسنا طيور فضية عملاقة لم نرها من قبل، ثم يفيض النبع المقدس حتى يُغرق كل شئ، كهوفنا والناس كلهم، لكى تأخذ دوامته الرمادية ما تشاء من القرابين} فيسأل ألهم الحورية{طيب قولى لى يا الحورية، ماذا كان ينقص سفينة نوح؟}ص232.
ويطارده شبحها، بينما هو يسير نحو بقايا زوجته “جميلة”، حيث دفنها ..{فجأة تنير أشعة القمر الخافتة بطن الجبل….. ولكننى أتوقف وأواصل المشى نحوها، أصرخ، اصطدم بها: أما زلت حية؟!}ص231. وكأنها تأبى الموت. فتتجمع أشلاء الجميع لتطاره، وتحنى ظهره:
{أرى وجوه كل من أحببت، مريم وأمى وحيدة وجميلة ولبيبة وجدى ألهم، أحاول إزاحة سيقان الجثث التى تتدلى من على كتفى، فلا أستطيع، أعود إلى أرض النبع المقدس ثانية، وظهرى محنى}ص232. لتتحول “جميلة” إلى أيقونة الخصب والنماء، والحب. ولتتحول من فتاة أو إمرأة، إلى رمز، قتله ألهم بطمعه وشهوته للسلطة.
فنحن إذن أماما أمام رجل ساقته الأقدار لدخول الجنة، فأعجبته وسُحر بها، فأرد إمتلاكها، ولم يجد من وسيلة إلا قتل الحاكم، ليجلس مكانه. وقد علم أن هذا الحاكم هو الوحيد الذى يملك سيفا، وهو ما سَيَدَهُ على المكان، فضلا عن أنه الوحيد الذى يتحدث العربية الطليقة- والتى هى لغة الغريب القادم- لينشأ الرابط بين الأثنين.
وإذا نظرنا إلى الكيفية التى دخل بها “ألهم” المكان، سنجد صخرة، كان حاكم المكان قد استخدمها فى منع أى غريب يدخلها، اكتشفها “ألهم” فأزاحها ودخل، ثم تم إخفاؤه من جديد {أنا لم أقل شيئا، هم لا يعرفون بعد من أين أتيت، أنا لم أقل لهم سر الحجر المخفى}. وقد كان ل”ألهم” ما أراد، فحكم البلاد. ورغم رحيله بعد إكتشاف الصخرة- تحت قدميه- وقتل زوجته “جميلة”. وهو ما يشير، ويعود بنا إلى “أسطورة جلجانو” حيث (أراد جالجانو أن يصنع صليبًا على التل ، ولكن مع عدم توافر الخشب بالمكان ، قرر أن يزرع سيفه في الأرض ، ويقال أن السيف قد أصبح على الفور قطعة واحدة مع الأرض بحيث لا يمكن لأحد إزالته}[5]. وهى الرؤية التى تعود بنا من الوادى المقدس، إلى الوادى الأرضى.
التقنية الروائية
شيدت الكاتبة فضاء الرواية من طابقين، فى الطابق الأول، الأرضى، الذى اسمته “نجع الزرايب” ليُسقط الإسم كل دلالاته، على ما يمكن أن يكونه مثل هذا الإسم.
شُكل فضاء الرواية من التحرك على سطح الأرض، المسكونة بالقتل، والضغينة، والفساد، والكذب. حيث البشر العاديون، الطبقات المنسية من الرعاية الحكومية، يستخدمهم القادرون، فيصبحون مطية للطبقات الأعلى مثلما نرى محمد العزبى {تسلل ليلة أمس محمد العزبى أكبر ملاك الأرض ناحيتنا إلى مطبخه، وجثم بسنواته السبعين على جسد خادمته الفقيرة-أمل- التى لم تبلغ السابعة عشر من عمرها، وهتك عرضها، ولما حكت لأمها –عواطف- الحسادة، ظلت المرأة تحلب النجوم طوال الليل، ليقلب الله نجع الزرايب عاليه واطيه، وينزل غضبه على الأرض كلها، ويبيدها عن آخرها}ص9. ومثلما نرى الأخ يرتكب الجرائم، ويلصقها بأخيه للتخلص منه، طمعا فى الميراث، دون حساب لما يستتبع ذلك، وهو كثير. ففى عركة بعد سهرة مع البوظة، انطلقت أعيرة قتلت ثلاثا من الشباب. وعلمت الأم أن ابنها “ألهم” هالك لا محالة ، فطاردته حتى ابتلعته الصحراء: {منذ هذه الليلة المشؤومة أغلق نجع الزرايب وإلى الأبد فمه على هذه الحكاية، كما صمت الجد الكبير ألهم صمت القبور حتى مات بعدها بأيام}ص12.
{أبطال هذه الليلة المشؤومة هم أبى عبد القادروأخوه ألهم القاتل الهارب}. فعلى الرغم من أن عبد القادر هو المسئول عن الجريمة، كان “ألهم” هو الضحية من جانب، وهو الجانى، من جانب آخر. حيث فى ذات الليلة، كان فى أحضان مريم، التى أنجبت الساردة، وهربت. لتحمل الساردة “وحيدة” لا اسما فقط، وإنما هى الوحيدة التى حملت أوزار هذه الليلة (المشؤمة)، بإعتبارها هى الوريثة، لما كان بها، الموروثة لفاعليها.
فإلى جانب الوجود الرمزى لاسم الساردة “وحيد”، فإن الإشارة إلى أنها من أم مسيحية، وأب مسلم، كإشارة أخرى للمجتمع، كيف كان، وكيف أصبح. وأيضا إلى جانب أنه من نتائج تلك الليلة، أن ألهم (الكبير/الجد) كتب للأسرة المسيحية كل أملاكه، نظير السكوت عن القضية. شرط ألا يُعلن ذلك لأحد. وليصبح “ألهم الصغير”، ومن ورائه “وحيدة” بلا ميراث، أو يمكن القول بأن العائلة أصبحت “مفلسة”. فكان ميراث الساردة – وما تمثله- من البؤس، مضاعفا.
ثم تكشف الواقعة سر تجمع أعمام الساردة واحتلالهم بأبنائهم وأحفادهم البيت، حين علموا بأن “ألهم” حى.. فأيقظ ذلك الطمع فى الميراث الذى توقعوا توزيعه من قبله. ثم انصرفوا دون أن تعلم الساردة السر وراء إحتلالهم للبيت، أوانفضاضهم عنه، باحتمال معرفتهم لحقيقة الوضع، وبألا ميراث هناك. لتتكثف شبكة الضباب حول رؤيتها، والتى ما إنزاح، حتى تكشفت الأمور عن مأساة، لم تقع على أحد قدر ما وقعت عليها. لتضعنا أمام وجودها الرمزى، ولننظر إلى تاريخنا القريب، وكيف انقشع الضباب ليكشف عن الهوة المدفونة. والتى تعود بنا إلى بداية الرواية، والانطلاقة الأولى والصارخة، بأن … ألهم حى.
أما الطابق الثانى، “النبع المقدس”، فهو يعلو عن الأرض، (فوق الجبل) وكأن الكاتبة تُقربه من السماء، حيث تتحكم السماء فى سلوكه وأحكامه، وفى قناعات أهله بأن حاكمهم “سلطان” مُنَّزلُ من السماء، وأن هذا الوادى (مقدس). حتى أن نرى القادم (الأرضى) سرعان ما تطهر من ذنبه باقترافه ممارسة الرذيلة مع العنزة- الأمر الذى يضعه فى بؤرة رؤية “وادى الزرايب- لكن صوت الضمير والتأمل، والفلسفة يصحو {نظرت إلى جسدى الخامد الفارغ من أى رغبة فى رفع يد أو رجل وقلت:يا رب، كيف لقطعة بائسة من لحمى، منكمشة الآن على نفسها مثل الدودة أن تكون سببا فى هرك ذلك الجسد القوى؟!}ص65. فيعلن التوبة، بذبح العنزة حتى لايقع فى الغواية مرة أخرى. غير أنه، ومن أفعاله التى لوث بها ذلك العالم (الطاهر)، يجتمع بإخريات ويمارس معهن العملية الجنسية، فى الحرام، وفى الحلال، ويستمتع بالعملية، دون شعور بالذنب، أو الخطيئة، لا لهذا، ولا لما إقترفه من خطايا أخرى، والتى منها القتل والكذب، والاستمتاع بالسلطة، بل والسعى إليها بقتل (القادم من السماء). ليحدث التشابك بين الطابقين، وكأن القادم من الأرض، قد لوث مياه النهر المقدس، فأصبح مُدانا، فى نظر آبائه الفراعنة، وفى نظر أهل النجع المقدس.
كذلك حرصت الكاتبة على الاحتفاظ بقارئها، منذ بداية الرواية، وحتى نهايتها. فدائما تعلق عملية الكشف عن المجهول، أو تترك فراغا، ودعت القارئ أن يملأه. فتبدأ الرواية، بما يشبه الحركة الأول لسيمفونية “القدر يطرق الباب”، لبيتهوفن. فتبدأ الكلمة الأولى فيها “ألهم حى” . وكأن أدهم قد بُعث من الموت، فكان حدثا شاذا. فشد انتباه الجمع، ، وتحرك الناس كيوم الحشر، وسيطر الترقب واالدهشة على الجميع، فجاءت المقدمة سريعة، لاهثة. فقد{تجمع الناس من القرى القريبة، وتحول فضاء البيت الكبير من الهدوء والعزلة كمنطقة عصية ومحرم الاقتراب منها إلى ما يشبه سيرك الغجر} وكأننا أمام فيلم فضيحة هذ العائلة الغامضة أو {“المفترية” كما كانوا يصفونها فيما بينهم سراً}ص7. فنحن منذ الانطلاقة الأولى، أمام سر يكمن وراء “ألهم” هذا، وكذلك أمام عائلة غامضة أو “مفترية”. وقد حرصت الكاتبة أن يصاحب هذا (الغموض) حول لماذا هي مفترية، دون أن تكشف عن هذا السر إلا فى آخر الرواية، وكأننا أمام قصة بوليصية، نبحث فيها عن (القاتل)، حتى وإن كان برئيا من قتل الثلاثة فى نجع الزرايب، فإنه ليس بريئا من قتل ثلاثة الوادى المقدس(سلطان وجميلة والرجل الذى ظنه جميلة قامت من الموت)، على المستوى الواقعى ، أما على المستوى التخييلى، فهم أكثر بكثير. ولذلك نجحت الكاتبة فى فرض الغموض على المصير المنتظر، لهذا الألهم، حيث لا نعرف.. لماذا ذهب البوليس للقبض عليه؟ ولا المكان المحدد للقبض عليه، هل قُبض عليه فى الوادى المقدس، أم بعد خروجه منه إلى الصحراء، أم عند دخوله إلى نجع الزرايب من جديد، ثم ما هو مصيره؟. ثم لماذا أصر العقيد محيى الدين الهوارى أن تكون الساردة فى صحبته لرحلة القبض عليه؟. كل ذلك فجوة واسعة تركتها الكاتبة للقارئ، يبحث عن مخرج، ويتأمل فى ماضيه، وحاضره، بحثا عن ألهم الحى. فرغم كونه مات منذ سنوات- فى نظرهم-، فإنه لازال حيا.
فعلى الرغم من أن الشواهد والإشارات، تشير إلى شخص بعينه، فإننا إن نظرنا إلى ذلك التاريخ الممتد من “نزول آدم” من السماء إلى الأرض، ورغم كل الرسل، والأنبياء، من آدم وإبراهيم ويوسف و محمد (عليهم جميعا السلام)، الذين لم يدعُ أحد منهم للقتل، فإنه ما زال يمارس القتل. خاصة وأنه فى النبع المقدس، يؤمنون بتناسخ الأرواح، فمن يقدم قربانا للنهر المقدس، ينتظرون فى الغد طفلا يولد (بروحه). وعلى الأرض نجد أنه رغم أنها ظاهرة إجتماعية متوارثة، أن الأحفاد يُوسَمْونَ بأسماء الأجداد. فنجد الساردة “وحيدة” على اسم جدتها ” وحيدة’، ومريم فى الوادى المقدس، ومريم على الأرض، ثم “ألهم” الحفيد، على اسم ألهم الجد. إلا ان الكاتبة هنا- كما نتصور- أرادت بذلك ليس الظاهرة الاجتماعية، ولا تناسخ الأرواح، وإنما: التاريخ يعيد نفسه. فها نحن نمارس، نفس ما كانوا يمارسونه. فإذا كان سلطان ، قد استخدم الحجر لمنع أى غريب دخول الوادى المقدس، فإن “ألهم” من بعده قد استخدم السيف، رمزا، والقتل منهجا، ليحكم ويتسيد الوادى الذى كان مقدسا، وكان جنة، وتحول إلى قطعة من الوادى الأرضى.
فها هى سهير المصادفة، تتوغل فى طريق الرواية، لتصل إلى قمة إبداعاتها الروائية، حيث تقتحم “الحديقة المحرمة” وكأنها تقتحم كل التابوهات (المحرمة) فى الإبداع العربى، بمغامرة محسوبة، وموزونة بميزان المبدع العارف بقواعد اللعبة، فمنحت كلا، ما يريده، فمن أراد الدخول –لروايتها- من أى باب، سيجد الأقفال مفتوحة.. وليس عليه إلا الدخول والتجول، لينهل ما يشاء.
………………………………………
[1] – سهير المصادفة – الحديقة المحرمة- المجموعة الدولية للنشر والتوزيع ط1 2021.
[2] – سورة الأنعام – لاية 78.
[3] – سورة يوسف – الآية 100.
[4] – سورة الرعد – الآية 35.
[5] – إيناس – أسطورة القديس جالجانو والسيف في الصخرة- موقع البديل – 14 / 10 /2018