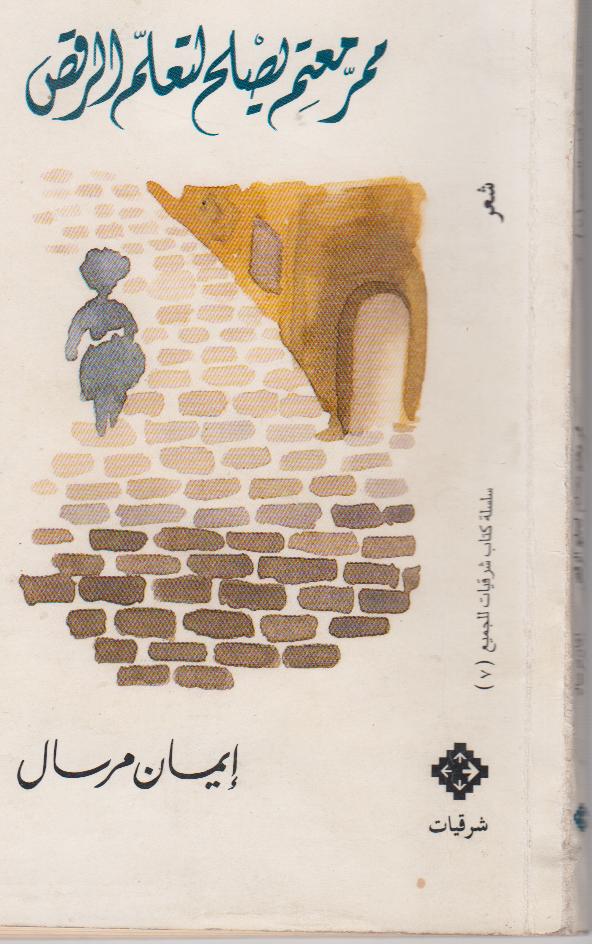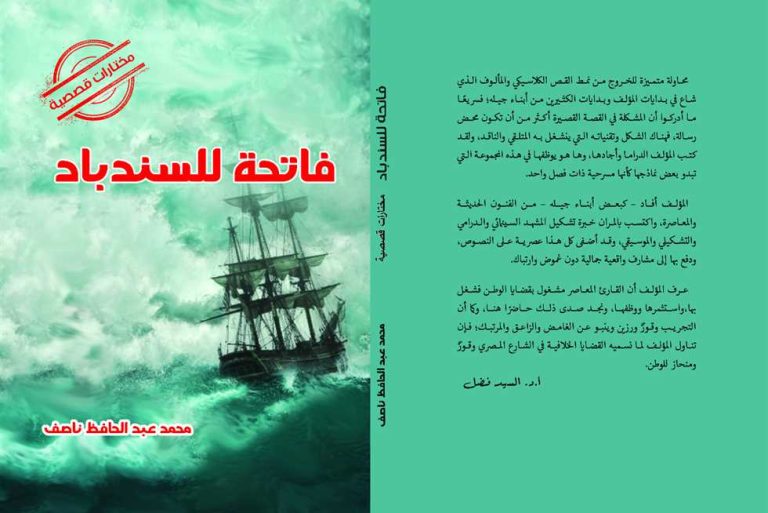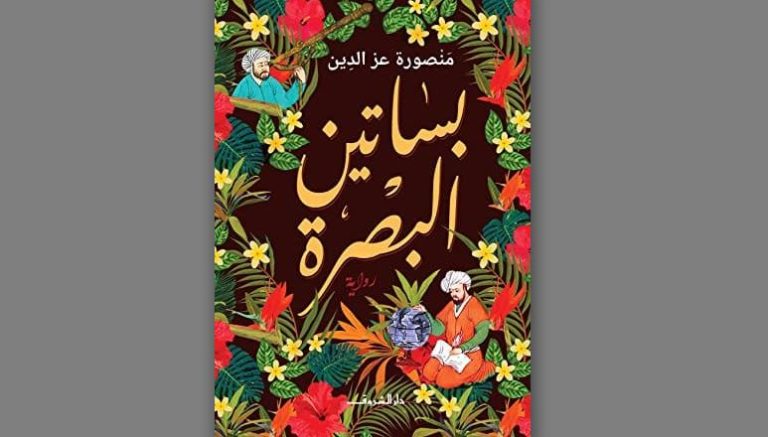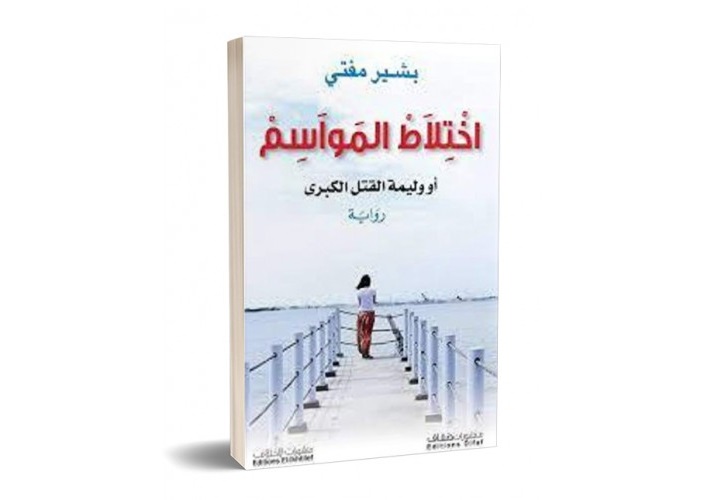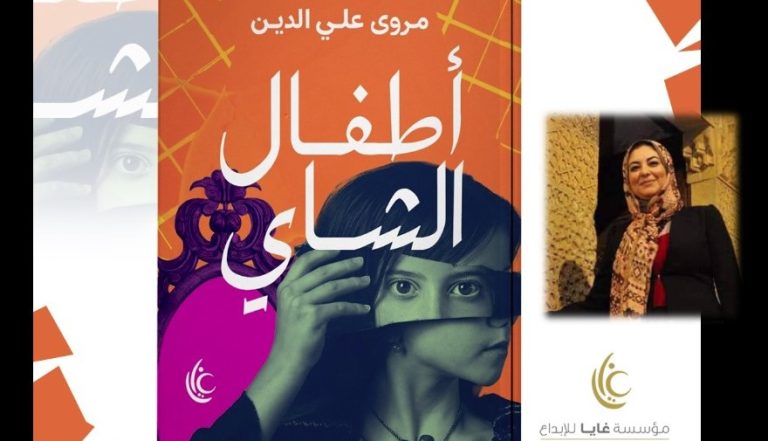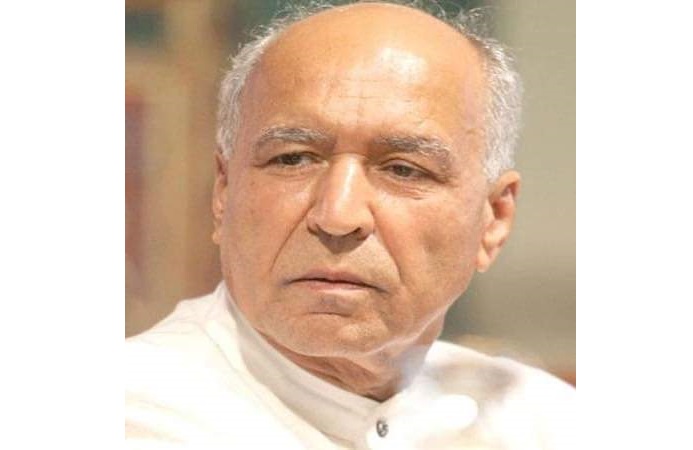د. أشرف الصباغ
أصبح من الصعب أن نتتبع أي فكرة جيدة، أو نواصل أي جهد بنَّاء ومهني، في ظل هذا الركام الإعلامي والافتراضي والرقمي. ولا شك أننا في مرحلة انتقالية تتسم بالغموض، رغم وضوح كل شيء. هذه المرحلة الانتقالية ليست بالضبط بين قرنين أو زمنين، وإنما بين حالتين من الوعي بالواقع والعلاقة بالوجود. وبالتالي، فهذه المرحلة الانتقالية التي نعيشها بكل تقلباتها وتحولاتها، هي مقدمة لكرامات القرن الواحد والعشرين: قرن تعدد الأبعاد والقياسات، وتراجُع الثقة بالواقع، والتوالد السريع للمهرجين والأفاقين، وتنامى التزييف والتصنُّع، والنَسْخ الإعلامي، والمَسْخ الإعلامي، والأشباه الإلكترونية، والعوالم المتعددة.
هناك بعض قصص الكاتب الروسي أنطون تشيخوف التي تم تحويلها إلى أفلام روائية طويلة، وإلى أفلام قصيرة أيضا، بل وإلى عروض مسرحية درامية، مثل “الراهب الأسود” و”السيدة صاحبة الكلب” و”فانكا جوكوف”، وعشرات من الأعمال السردية الأخرى. هذا إضافة إلى أن غالبية أعماله السردية، وبالذات القصيرة والقصيرة جدا، تمثل مصدرا خصبا لمشروعات التخرج لدى طلاب معاهد السينما والمسرح في روسيا وغيرها من الدول الأوروبية.

أما الجانب السحري والساحر في هذه الأعمال، هو أن الكثير منها تحول أيضا إلى عروض باليه، مثل قصة “كمان روتشيلد”، وهناك قصص أخرى تم تحويلها إلى أفلام كارتون للأطفال وإلى أفلام قصيرة مثل قصة “فانكا جوكوف” (إلى قرية جدي).. وهناك قصة “الراهب الأسود” التي تم تحليلها موسيقيا، لأنها تتكون من بناء موسيقي يشبه “السوناتا” الحديثة من أربع حركات موسيقية. غير أن الأهم، هو أن العديد من قصص تشيخوف القصيرة إما أدخلت تعبيرات ميثيولوجية في الحياة اليومية، أو أن فكرتها تحولت إلى عبارات وجمل وتعبيرات على نمط الأمثال الشعبية. ما يعني أن الأدب لا يقف فقط عند استلهام الشعبي والميثيولوجي وإعادة إنتاجهما، وإنما يتجاوزهما إلى طرح أشكال وتعبيرات وجمل جديدة تتحول بدورها إلى مصدر للتعبير وللسرد وللتوطين في الثقافة الشعبية والعامة للمجتمع.
غير أن المفارقة التاريخية في البحث الأدبي، تكمن في أنه خلال مرحلة نضوج الكاتب الروسي أنطون تشيخوف، وصفه بعض النقاد، ومعهم نقاد مجلة “الأسطورة ” آنذاك، وجيل الرمزيين الكبار، بأنه “مُغَنِّى الجهلة والخاملين وأشباه المثقفين من الطبقة المتوسطة”. بل وذهبوا إلى أنه “مجرد كاتب تصويري بعيد عن الشعب بُعْدَه عن نخبة الموهوبين والمفكرين، ومُدَوِّن تواريخ الناس المملين الكئيبين والصراعات عديمة الجدوى، وأنه كاتب لا يمتلك هدفا عظيما، وليس لديه فلسفة عامة”!
إن الفكرة الأساسية عند تشيخوف هي التناقض الواضح بين مجموع التصورات الإنسانية عن الحياة، بل وحتى يمكن القول بين الخبرة الحياتية للإنسان، وبين حياته نفسها، مما يجعل منهج تشيخوف مرتبطا بمذهب العبث في القرن العشرين. فقد كان ينظر إلى الموقف الحياتي العادي والمألوف كموقف استثنائي طارئ، وتبدو لديه الأحداث في سيرها غير القابل للعودة إلى الوراء واضحة وعادية بدرجة كبيرة، بل وفيها بعض القسوة مثل: فشل وانهيار البدايات الإبداعية- المواهب- أمام قهر الواقع المؤلم. وبشكل عام فالبحث عن مَخْرَج من المواقف المعقدة يؤدى بالبطل التشيخوفي إلى الاصطدام بالأسئلة والقضايا النهائية- الجوهرية للوجود، وكذلك حالة العالم وعلاقات الأبطال به والتي تبدو كبحث عن مواقعهم في الحياة، وفي هذا العالم، وكمحاولة للاتصال والتواصل مع القوانين الإلهية المُنَظِّمَة للكون، كلها في مجملها تُكّوِّن جوهر النص المسرحي التشيخوفى.

وعليه فأحد مستويات الصراع في الدراما التشيخوفية ليس ببساطة عبارة عن كتلة- خليط- من التناقضات بين الناس على الأرضية الاجتماعية الفلسفية أو الأخلاقية، وإنما- هذا المستوى- يعكس علاقة الأبطال بالواقع نفسه في جميع صوره المختلفة، وفي كليته ووحدته أيضا. فالعالم يرمز من ناحية إلى الجماعة المحددة بأطر وظروف معيشية معينة، ومن ناحية أخرى هو المجرة بالكامل: اليابسة والسماء والناس والحيوانات والنباتات. ومن خلال خط البطل- العالم (الاجتماعي الفلسفي) في وعينا يضع الكاتب في آن واحد نموذج البطل ونموذج العالم. ومن هنا تصبح قضايا بناء العالم غير منفصلة على الإطلاق عن قضايا الوعي والتصورات الإنسانية.
وفي النهاية، كما يرى الناقد الروسي ألكسي زفيروف، يقدم لنا علم الجمال (Pan-aestheticism) التشيخوفي العام أسلوبه الخاص، من أجل حياة الإنسان والفن، عن طريق تركيب وتوحيد النزعات الجمالية والملامح المميزة لمختلف الاتجاهات الفنية لهذا العصر، وخصوصا النزعتان الطبيعية والرمزية، ووصل العوالم الفنية المتباعدة- مستحيلة الاتصال- عن طريق العلاقات البوليفونية باستمراريتها وتواصلها الحيوي وتنوع ألوانها.
فضاءات “كمان روتشيلد”- انطباعات شخصية
كنت دائمًا منبهرًا بباليه “كمان روتشيلد” المأخوذ عن قصة بنفس الاسم لتشيخوف. وكنت دائمًا اتفرج عليه بنفس الوتيرة التي أسمع بها أم كلثوم وفيروز وبقية مطربينا المحبوبين.
باليه “كمان روتشيلد” لوحة فنية- إنسانية رائعة، مبنية على قصة قصيرة ساحرة وفي غاية الإنسانية لأنطون تشيخوف. وأن يتم تحويل قصة قصيرة إلى عرض باليه، فهذا معناه أن القصة مهمة على كل المستويات من حيث البناء الدرامي، والنوازع الإنسانية، والقيمة الأدبية، والأهمية التاريخية، وقبل كل ذلك البنية الجمالية والبصرية.

في عام 2004 قام المخرج الروسي “كاما جينكاس” بمغامرة عجيبة وغريبة، حيث أخد النص السردي وحوله إلى نص درامي- مسرحي، وأخرج عرضصا “تراجيكوميدي” كان في وقتها معجزة مسرحية. ومن المعروف إن غالبية قصص تشيخوف، مثل “الراهب الأسود” و”السيدة صاحبة الكلب” وعشرات القصص الأخرى، تحولت إلى عروض باليه وأفلام طويلة. وبطبيعة الحال، فإن قصة “الراهب الأسود”، واحدة من النصوص السردية المبنية بناء موسيقيًا على شكل سوناتا حديثة من 4 حركات. وهذا البناء الموسيقي للنص السردي يعقد الأمور أمام المخرج وأمام المؤلف الموسيقي للفيلم، لأن السرد نفسه مبني بناء موسيقيًا، وعلى كل من مؤلف الصورة ومؤلف الموسيقى أن يتجاوزا البناء السردي الموسيقي أصلًا، ليفجرا معاني النص ودلالاته، ومجازاته الإنسانية المركبة.
نعود إلى قصة “كمان روتشيلد” التي تمثل إحدى أهم القمم الفنية السردية في العالم التشيخوفي، وتعتبر واحدة من أهم القصص القصيرة التشيخوفية المثيرة للجدل التاريخي والعقائدي، فضلا عن قيمتها الفنية الجمالية والإنسانية. في عام 2004، أي قبل أكثر من 20 عاما، ظهرت مسرحية كاما جينكاس التي “كسرت الدنيا” بلغة المسرحيين والعامة على حد سواء. وبعد أن كنتُ أدمن الفرجة على باليه “كمان روتشيلد”، أصبحت أدمن الفرجة على مسرحية “كمان روتشيلد” بالضبط مثل إدماني المَرَضي على سماع أم كلثوم وشادية ونجاة وعفاف راضي، والفرجة على فرقة رضا وفرقة الفنون الشعبية المصرية.
تم عمل عروض مسرحية كثيرة لقصة “كمان روتشيلد”، كان آخرها في عام 2022. أي قبل ثلاثة أعوام فقط. والمدهش أن لا عرض يشبه العرض الآخر. إذ حرص كل مخرج على أن يتناول القصة من زاوية مختلفة لتتعدد زوايا الفهم، والقراءات، والمعالجات الفنية.

“كمان روتشيلد” بين الواقعي والافتراضي
أحيانا يصل البخل والشُح بالإنسان إلى حالة استثنائية، ينتقل خلالها الشخص من إنسان طبيعي إلى كائن مشوه ليس فقط روحيًا، بل وأيضا عقليًا. والبخل والشح هنا، ليسا بالمعنى المادي المرتبط بالمال فحسب، ولكن أيضًا في ارتباطهما بالمشاعر والأحاسيس من جهة، وبعمل العقل وعطائه من جهة أخرى. بمعنى أن حالة الشح والبخل هذه تظهر كحالة عمى روحي، أو نضوب للروح مع جفاف المشاعر والأحاسيس. وفي الوقت نفسه، حالة غياب للعقل، لأن البخل عندما يرتبط بالحماقة والشح يتحول فيما يتحول إلى غياب عن الواقع، ولجوء إلى واقع افتراضي يشبه فيما يشبه الغياب أو “الغيبوبة”: انفصال عن الواقع مع تبلد الأحاسيس.
قبل أكثر من 130 عاما، كتب أنطون تشيخوف قصة “كمان روتشيلد” التي تحولت خلال القرن العشرين إلى فيلم سينمائي، وعروض مسرحية (عرائس)، وعروض باليه. هذه القصة التي تم تناولها من زوايا عدة، على رأسها السامية ومعاداة السامية، وكُتِبَ عنها مجلدات من النقد والتفسير والتحليل، سواء في علاقتها بالتركيبة النفسية والروحية لليهود والروس، أو بالمسألة اليهودية، أو بعلاقة أنطون تشيخوف نفسه بقضية الضابط الفرنسي- اليهودي ألفريد دريفوس، (L’affaire Dreyfus )، التي هزت أوروبا في منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر (1894).
قصة “كمان روتشيلد”، حزينة ومؤثرة، تختلط فيها المشاعر والأحاسيس الإنسانية بالموسيقى والدموع، وبالقسوة وقلة الحيلة، وبالحب والوفاء، وبوحشية الإنسان في مجتمع غارق في العفونة الروحية والعقلية. في مركز القصة نعثر على كل من ياكوف إيفانوف الحانوتي أو صانع التوابيت الذي يجيد العزف على آلة الكمان ويعمل عازفا في فرقة اليهودي “موسى شخكيس”، ومارفا زوجة ياكوف التي تقوم بكل الأعمال تقريبا برضاء وعن طيب خاطر، والصبي اليهودي روتشيلد الذي يجيد العزف على “الناي” لدرجة الإبكاء، وألة الكمان التي يعزف عليها ياكوف.
أربع شخصيات رئيسة في تلك القصة الملهمة التي كتبت قبل أكثر من 130 عامًا، ونشرت لأول مرة في جريدة “الأنباء” الروسية عام 1894، ولا تزال قيد القراءة والبحث، ومصدر إلهام، وأداة لتفسير ما يجري في الواقع، حتى في عصر الواقع الافتراضي، وعصر سطوة الإعلام وسيادة الكذب والتضليل وتزييف الواقع، عصر الصورة الخادعة، وحلول الحكاية المزيفة محل الحكاية الواقعية، والقدرة الشريرة على إقناع البلهاء والحمير بأن الحكاية المزيفة هي الحقيقية، حتى ولو كان هؤلاء البلهاء والحمقى والحمير يرون بأعينهم أحداث الحكاية الحقيقية على أرض الواقع.
لن نحكي أحداث قصة “كمان روتشيلد”، سنركز فقط على مشهد واحد يتعلق بصانع التوابيت ياكوف إيفانوف البخيل القاسي العدمي. إن ياكوف إيفانوف هذا يبدد وقتا طويلا في حساب الخسائر. وإذا توقف الأمر عند ذلك، فهذا شيء طبيعي بالنسبة لشخص يعمل في مجال البيزنس. ولكن ياكوف لا يحسب فقط الخسائر المباشرة الناجمة عن استخدام الأخشاب والمسامير وأدوات النجارة أو المنافسة، بل يذهب إلى حالة نادرة واستثنائية. إنه يقوم بإحصاء عدد كبار السن في القرية، الذين يجب أن يموتوا في أوقات معينة. وعندما لا يموتون، يعتبر أن ذلك خسارة له. ومن الأفضل أن نورد المشهد أو الفقرة المقصودة: “كان ياكوف في مزاج سيء باستمرار لأنه كان يتعين عليه دائماً أن يصبر على الخسائر الفادحة. وعلى سبيل المثال، ففي أيام الآحاد وفي الأعياد كان من الإثم أن يعمل، ويوم الاثنين يوم صعب.. وبهذا الشكل يكون المجموع حوالي مائتي يوم يتعين عليه فيها أن يجلس، خلافا لإرادته، عاطلاً عن العمل، بينما في ذلك خسارة.. وأية خسارة إذا أقام أحد ما في البلدة عرسًا بدون موسيقى، وكانت خسارة أيضاً إذا لم يدع شخكيس ياكوف.. ولقد ظل رجل البوليس المراقب بالسجن مريضاً يعطس طوال عامين كاملين.. وانتظر ياكوف بفارغ الصبر متى يموت، ولكن المراقب سافر إلى المركز للعلاج، ومات هناك.. وكم كانت الخسارة إذ ضاعت على الأقل عشر روبلات، لأن الأمر اقتضى أن يصنع التابوت على نحو آخر مستخدمًا نوعًا خاصًا من القماش لتزيينه”. ويصل بخل ياكوف وشحه إلى الذروة عندما يعتبر أن التابوت الذي صنعه لزوجته مارفا من ضمن الخسائر، لأنها ببساطة لن تدفع ثمنه!!!

إن حالة البخل والشح وتبلد الأحاسيس انتزعت ياكوف من الحسابات والتقديرات الواقعية، ودفعت به إلى مساحة افتراضية في غاية القسوة تسمح له بحرية مطلقة لحساب خسائره “الافتراضية” الفادحة. وفضلا عن أنه سيء المزاج بشكل دائم بسبب الخسائر، وبسبب ضيق الحال، هو أيضا قاس يكره جميع من حوله تقريبا، بمن فيهم زوجته مارفا.
هذا المشهد أو المقطع، برز فجأة عندما بدأت وسائل الإعلام الروسية في نهاية شهر يوليو 2025 الحديث عن زلزال بقوة 8.8 درجة بمقياس ريختر. وبعد عدة دقائق بدأت الحديث عن تسونامي قد يجتاح شمال شرق روسيا بالكامل، ويمتد إلى اليابان. وبعد عدة ساعات، بدأ الحديث عن أن موجات تسونامي ستصل إلى 15 مترًا، وستصل سرعة الرياح إلى 500 كلم في الساعة، فضلا عن تهدم المباني والانزياحات والتشققات الأرضية. وظلت الآلة الإعلامية الروسية تنفخ في آثار الزلزال والتسونامي حتى انتقلت العدوى إلى وسائل الإعلام المجاورة، ثم إلى المنطقة العربية وأمريكا اللاتينية. غير أن الوضع في الفضاء الإعلامي الروسي كان أكثر إرباكًا، لأسباب كثيرة أخرى، من ضمنها الحرب الدائرة في أوكرانيا للعام الرابع على التوالي، والمشاكل الاقتصادية، وبقية النتائج الاجتماعية والسياسية المترتبة على حالة حرب طويلة ومواجهات وتهديدات بين روسيا والغرب.
ظلت حملة “النفخ” في الزلزال لمدة يومين أو ثلاثة. وعندما لم تظهر النتائج التي تحدثوا عنها وبالغوا فيها، بدأوا استراتيجية جديدة مزودة ومدعومة بالصور ومقاطع الفيديو. فمقدم النشرة أو مقدمة البرنامج، تتحدث عن الزلزال وقوته، ثم التسونامي، وتقول إن “المياه اندفعت إلى الساحل بمقدار 40 سم فقط، ولم يرتفع منسوبها أكثر من 4 أمتار، ولم تجرف المياه البيوت والأكواخ. ولكن زلزال بهده القوة المدمرة كان من الممكن أن يقضي على كل شيء.. ولنتصور أنه تسبب في تسونامي، فماذا كن من الممكن أن يحدث؟! كانت المياه ستغطي شمال شرق البلاد وتدمر البيوت والمؤسسات وووو”.. هذا الكلام يكون مصاحبا لمقاطع فيديو وصور في مستشفى أو لجدار بيت أو بلكونة، ولا يوجد به أي شيء خطير.. فهناك ممرضة تضحك مع المرضى وتقول لهم: “لقد نجونا”، وهي ترفع ملعقة من فوق الأرض.. وهناك طفلة تقف على الرصيف وتنظر إلى جدار في الطابق الثاني وقد سقط طلاؤه.. بينما امرأة تقف في البلكونة أمام الكاميرا لتصف كيف شعرت بالهزة فقامت لتجد أن لوح زجاج النافذة قد سقط…

وفجأة ينقطع كل ذلك ليظل صوت المذيعة أو مقدم البرنامج موجودًا، وتظهر صور أخرى صممها الذكاء الاصطناعي وعاملو المونتاج بحرفية عالية تحكي عن الآثار الافتراضية المدمرة، وتكرار ذلك بأشكال مختلفة من أجل تعميق الحالة. والنتيجة الطبيعية والمباشرة، هي ظهور علامات الخوف والفزع والرعب على وجوه المشاهدين، لتتحول إلى حالة من الارتباك والشك وانعدام اليقين. وعلى الفور، تنتقل هذه الحالة عبر الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي في شكل حكايات وأحاديث حقيقية، يستشهد الجميع فيها بما قالته مذيعة النشرة أو مقدم البرنامج. وكلما انتقلت الحكايات زادت وتضخمت، لنكتشف أننا نواجه زلزالًا وتسونامي، والعالم يغرق ويتلاشى من حولنا.
وتبدأ المرحلة الثانية برفع راية المظلومية واستجداء التعاطف، واجترار سرديات تاريخية عن الظلم والاستبداد والكوارث الطبيعية، لنغطي على حروب يموت فيها النساء والأطفال، وعلى أزمات اقتصادية وفساد سياسي واقتصادي، وقمع واستبداد. ولا يخلو الأمر من اجتراح المعجزات، وإظهار أبطال خارقين ظلوا على رأس عملهم أثناء الزلزال، وأطباء واصلوا إجراء العمليات الجراحية الخطيرة، بينما التسونامي يجتاح الكرة الأرضية.. ويصل الأمر إلى الإعلان عن جوائز ومكافآت ومنح الأوسمة والميداليات لهؤلاء الأبطال..
غير أن المضحك والمبكي هنا، أن شيخًا في بني سويف، التقط الموضوع، ووظف خطبة الجمعة يوم 6 أغسطس 2025، ليعلن أمام المؤمنين “أن القيامة ستقوم قريبًا، فالأرض انشقت منذ يومين في روسيا، والزلازل والبراكين تجتاح العالم، وعلينا أن نسارع بعمل الخير، ونغسل ذنوبنا، ونطهر أنفسنا من أجل لقاء وجه الرحمن ذي الجلالة والإكرام بقلوب ناصعة وصحف بيضاء”.
ربما تكون هذه الزاوية بعيدة نسبيا عن العالم الكلي لقصة “كمان روتشيلد” لكن المقطع الخاص بياكوف إيفانوف وبخله وشحه وعدميته وقسوته يقفزان إلى الذهن مباشرة عندما تشرع وسائل الإعلام والسوشيال ميديا في ممارسة وظيفتها الوضيعة بدفع الناس بعيدًا عما يجري في الواقع لتسحبهم مثل المواشي إلى حدود “الغيبوبة”. فضلًا عن تغيير أولويات الناس لتجبرهم على نسيان الواقع واللجوء إلى ما ورائه، والغرق في أساطير تم صنعها للتو.
إن قصة “كمان روتشيلد” أبعد وأوسع من المقطع الذي أوردناه. إنها قصة “إشكالية” أثارت، ولا تزال تثير الكثير من اللغط السياسي والتاريخي والعقائدي. فيكفي أن تشيخوف قام بنعومة شديدة ليلصق صفات “اليهودي” بياكوف إيفانوف الروسي، الأمر الذي أثار لغطا وضجيجا لم يتم حسمهما حتى اليوم. ويكفي أن تشيخوف قام بنفس النعومة والشجن بتطوير الشخصيات إلى نقائضها في لحظات درامية حاسمة وبنتيجة دوافع إنسانية استثنائية، لتنتهي القصة نهاية استثنائية أيضا. ولكن هل يمكن أن يحدث ذلك في واقع تتراجع فيه الثقة بالواقع نفسه، ويتوالد فيه المهرجون والأفاقون، ويتنامى فيه التزييف والتصنُّع، والنَسْخ الإعلامي، والمَسْخ الإعلامي؟!