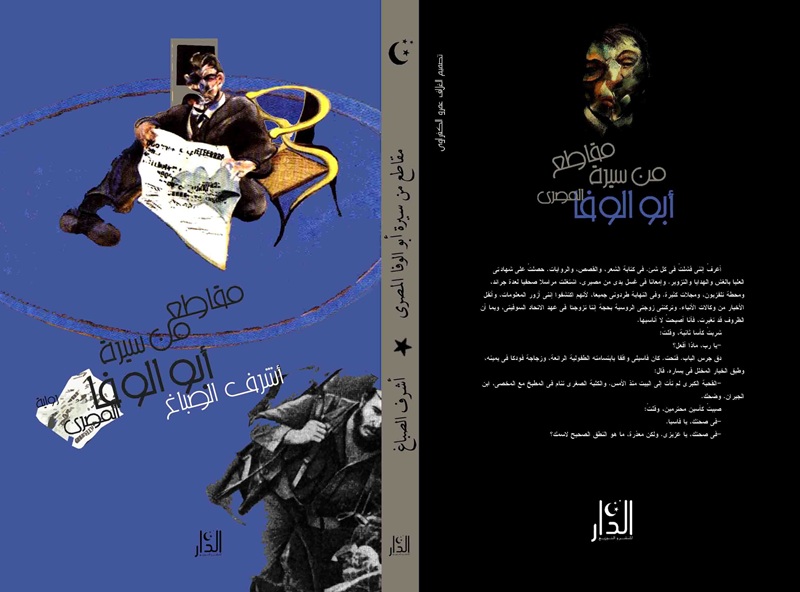أشرف الصباغ
-تصور! هذا الكافر ابن الكافرة لعن دين أبي وانصرف باصقا في وجهي..
قال سعيد عبد النصير هذه العبارة، وأنا أكاد أتقيأ نصف لتر الفودكا الذي عببته معه عبا من دون أي “مازة” إلا الضحك. الضحك- لأن سعيد عبد النصير لا يستخدم مثل هذه الألفاظ أبدا. ومن النادر أن تسمع من لسانه العفيف أي سباب أو شتيمة حتى لأسوأ الناس بيننا، ومن ضمنهم أنا ومحروس وغيرنا. والضحك أيضا- لأن سعيد كان يحكى بصورة كاريكاتورية يختلط فيها الحنق بالدهشة بالغيظ، بالتمثيل والتشخيص والبانتوميم. وتصل الحالة إلى ذروتها عندما يندهش سعيد، الذي كان قد فارق الدهشة منذ سنوات طويلة واعتبر أن كل ما يجري في العالم، ومن حوله مجرد كابوس قد ينتهي في زمن ما. هذه الدهشة النادرة كانت مرتبطة بالدرجة الأولى من “خيابة” محروس- على حد وصف سعيد- عندما يتحدث عن مجده في عالم الصحافة، وعن ضباط الحدود في المطارات العربية حينما يتعرفون عليه ويُذَكِّرونه بالعبارات التي يقولها في تقاريره السياسية الهامة.
سعيد عبد النصير هو ضميرنا الحي، كما اصطلحنا ضمنا على تسميته. فهو الوحيد الذي يعمل بالكتابة فقط. يكتب من رأسه، ومن الناس، ومن الحب، ويتحدث في السياسة برأيه هو وليس بما يسمعه من الآخرين، أو يقرأه في الصحف. وهو أيضا حالة من الضحك والتنكيت والطاقة الهائلة. وعندما يصيبه الحزن، يلتزم البيت والصمت، ويتخذ الفودكا ملاذا له من السقوط في الأخطاء البشرية. لكل هذه الأسباب صار “ضميرنا الحي” عالة علىَّ. فهو يكتب قصصه التي لا تنشر، ومقالاته النقدية عن أعمال الشابات والشبان الجدد، والتي غالبا ما تلقى في سلة القمامة بمجرد مطالعة رؤساء الأقسام الثقافية بالصحف والمجلات العربية للأسماء المكتوب عنها.
أنا شخصيا أمارس كل رذائلي، وحماقاتي، ونفاقي، وتملقي، ولكن عندما أجلس معه أشعر بقوة غريبة تدفعني إلى التطهر، والإقلاع عن كل تلك الصفات التي أشتهر بها بين أصحابنا. نجلس فتوحدنا الخمر، والحديث عن النساء الجميلات فقط، والقحاب الجميلات بشكل خاص. هو لا يحب كلمة “قحاب” أو “شراميط” كما أحب أنا تسميتهن، ويفضل مصطلح “فراشات الليل” باعتبارها كلمة مهذبة، وتتضمن مجموعة من المعاني الفلسفية والأخلاقية.
سعيد عبد النصير يحكى بلسان ثقيل عما حدث بينه وبين محروس عبد البديع. يحكي بجدية، ولكنني لا أستطيع التوقف عن الضحك. أنا شخصيا أعرف محروس جيدا، وأعرف كل ما يحكيه سعيد عنه. إلا إن الموقف في حد ذاته يقتل من الضحك. فمحروس في العهد السوفيتي كان شيوعيا مخلصا. بل كان يمشى دائما مع أعضاء التنظيمات اليسارية في موسكو على الرغم من عدم اعتراف أي تنظيم بانتماء محروس لعضويته. وعندما انفض السامر، وأخذ الاتحاد السوفيتي الصابونة، أصبح فجأة وطنيا يقدر مواقف الحكومات العربية بإيجابية تبعث على الدهشة. وراح يهاجم إسرائيل هجوما شرسا باعتبارها سبب مصائب العرب المساكين. ثم جاءت حرب الشيشان، فاتخذ جانب “المجاهدين” في سبيل الدين والحرية ضد الدب الروسي، والنصرانية. كل ذلك كان يجري إلى جوار خط آخر لم يكن يلحظه إلا القليلون. فقد بدأ محروس عبد البديع يقلع عن الخمر. وبدأ يعتكف في شهر رمضان. وراح يرفض أي طعام روسي. ثم طلق التدخين بالثلاثة.
إلى هذا الحد كان من الممكن فهم محروس. ولكنه فجأة بدأ يعلن الجهاد ضدنا. بدأ يثير المشاكل أثناء جلسات الشراب. شرع في الهجوم على من يأكلون لحم الخنزير. راح يرفض الكلام ليس فقط مع “فراشات الليل”- على حد تعبير صاحبنا سعيد عبد النصير-، وإنما أيضا مع زميلاته في العمل، ومعارفه من أيام الدراسة. وبطبيعة الحال مع زميلاتنا وصديقاتنا، لأنه كان يكبرنا بعدة سنوات، أو بالأحرى بجيل كامل. ومع ذلك كان في بداية تعارفه بي يحاول التعرف بأصدقائي والتقرب من جيلنا، وكأنه سيرشح نفسه للانتخابات المقبلة. والغريب أنه في البداية اقترح أن نناديه بدون ألقاب، ولكنه لم يكن يرفض عندما يتوجه إليه أحد بلقب “أستاذ” أو “دكتور”.
ووقعت الطامة الكبرى عندما رفض محروس ذات مرة مصافحة جرجس حنا باعتباره نصرانيا كافرا. هنا فز سعيد عبد النصير كالملسوع وقال له:
– انت ابن كلب.
كانت لحظة واحدة كافية لتتطاير القناني والكؤوس والأطباق والملاعق، وقلب الطاولة والطبيخ على الجالسين رجالا ونساء. وقفت دميانة زوجة جرجس في مواجهة محروس وصلصة الطماطم تغطى جزء من صدغها ورقبتها، وقطعة لحم لا بأس بها قد غاصت في فتحة صدر فستانها الذى كانا أبيض منذ دقائق معدودة:
– يا أخي عيب عليك. الولد اسكندر ابننا يحبك، ويسأل عنك دائما. وميلادة لا تقول عنك إلا “عمى محروس”. وفى النهاية نطلع كفرة وأولاد كلب؟!!
أنا شخصيا لم يكن يهمني في هذه المعركة سوى القناني التي تهشمت وسال ماؤها يكوي القلب والروح. ليذهب الجميع إلى الجحيم، ولكن أن تطير نقطة خمر بعيدا عن فمي، فهذا ما لا أحتمله، ولا يحتمله أي ضمير حي. محروس مجنون، وسعيد لا يفارق عالمه وأدبه الجم وتقشفه إلا وقت الضرورة، وفي الحالات القصوى فقط، ودميانة لم تكن تشرب ولا تدخن، وإنما كانت تأتى مع جرجس لتقود هي السيارة تفاديا لتطفل شرطة المرور. وجرجس نفسه ابن صرمة قديمة، لأنه كان من المفروض أن يبصق في وجه محروس على الفور، أو يناوله لكمة محترمة تهشم فكه الشبيه بكعب الحذاء.
طلبتُ كأسا من الفودكا، وصببتُ عليها بعض بقايا البيرة التي كانت فى زجاجة يتيمة تحت مقعدي، عادة ما أحتفظ بها في بداية كل جلسة تخوفا من معركة مفاجئة تنتهى بخسائر فادحة. ومع خبرتي المتواضعة في هذه الأمور، أعرف أن ذلك خطأ كبير. إلا إن شيئا ما داخلي دفعني لذلك. وبمجرد أن دلقت الكأس في جوفي، جرت الدماء في عروقي، واتجهت إلى محروس عبد البديع قائلا:
– أنت الكافر والحقير. ومن اليوم نرجو ألا تجالسنا أبدا- ثم أشرتُ إليه إشارة فاضحة بيدي.
فنظر إلىَّ ساخرا:
– حتى أنت يا منافق يا سكير! أنت أوسخ واحد في كل هؤلاء. وإذا كانوا سيدخلون النار بتهمة الكفر، فستدخلها أنت بجبل من التهم أقلها الكفر والزندقة والنميمة والمداهنة. سيصنعون لك نارا خاصة تعادل كل جرائمك في حق البشرية. هل يمكن أن يتغاضى الله عن أشعارك السخيفة والتافهة والكافرة؟ وهل يمكن أن ينسى أحد شتائمك للجميع بسبب وبدون سبب؟ ومن يعلم، أليس من الممكن أن تكون لوطيا أيضا؟!!
لحظتها حطت علىَّ حالة من الضحك لم أرها من قبل. وكررت له إشارتي الفاضحة. فضج الجميع بالضحك. وتبخر هو مثل ضراط عفوي ساحبا رائحته خلفه.
قال سعيد عبد النصير:
– كنت أجلس في حالي، وأمامي قنينة الفودكا والخيار المخلل. قلتُ يا ولد يا سعيد فلتقرأ قليلا. وجلستُ أقرأ قصة قصيرة لفتاة جديدة. وفجأة..
صب سعيد قدحين، ولم ينتظرني:
– وفجأة وجدته جالسا أمامي بدون سلام أو كلام. قلتُ له: “السلام عليكم يا مولانا”. فلم يرد. طلبتُ كأسا ثانية، وقطعة لحم محترمة. صببتُ له قائلا: “في صحتك يا مولانا”. فقال: “أنت تعرف أنني لا أقرب هذا الكفر”. فشربتُ الكأسين تباعا، وقلتُ: “إذن، لماذا أنت هنا يا ابن الشرموطة”. فقال: “احترم نفسك يا سعيد، ولا تطيل لسانك مثل السافل ابن الكلب”. فسألته: “من؟”. فقال: “إبراهيم عفيفي”. أى أنت يا محترم.
هنا رفعتُ كأسى ضاحكا، وقلت:
– وماذا بعد؟
– دعوته للأكل. فقال إنه لا يأكل الخنزير. فقلتُ: “هذا ليس خنزيرا، إنه لحم حمار. ولولا إنك جالس الآن أمامي، لشككتُ أنه لحمك”. وهنا ثارت ثائرته، ولعن دين أبى وانصرف، ثم أتيت أنت.
* * *
أنا شخصيا أكتب شعرا سيئا، وقصص ومقالات أسوأ، بدليل أن كل المجلات ترفض نشر ما أكتبه. ولكنني أقرأ كثيرا بقدر وقت الفراغ الذي أعيشه. أعمل يومين فقط في الأسبوع. اليوم الأول عندما ألتقط “الزبون” الذي يريد التأشيرة “المضروبة”. والثاني عندما أتسلمها من الموظف بعد اقتسام الغنيمة معه. دخلي جيد. أصرف منه على سعيد عبد النصير وصديقته كاتيا، وصديقتي ماشا. كان لدينا أحلام كثيرة في الشعر والقصص والنقد والنشر. ولكن حدث وأن فات القطار، وانتهى الأمر. نعيش حياتنا معا، نسكر ونكتب، ونقرأ لبعضنا البعض. وكل منا يعتبر الآخر أعظم شاعر أو ناقد أو روائي في الوجود. صديقة سعيد تعبده، وصديقتي تقدسني، ودميانة أعظم امرأة في العالم بشهادة حتى أخونا جرجس العظيم.
أنا، والعياذ بالله من كلمة أنا، أحب الكلام على الآخرين، ولكن من دون ضرر، إلا ما يسمح به الموقف واستجابة الآخرين لنوع الضرر وحجمه. أي ببساطة أحب النميمة، والقيل والقال. الجميع يعرفون ذلك، ولا يتضايقون. أتصيد الأخبار على الرغم من انني لا أعمل مع أي جهة أمنية. وطبعا كنتُ أتمنى أن أعمل مع أية جهة، ولكن للأسف، يبدو أن المواصفات المطلوبة لا تتوافر لدى. فعلى رأي جدتي “المنحوس منحوس حتى لو علقوا على طيزه فانوس”.
في الأسبوع الماضي، بعد معركة المجاهد الأكبر، وعقب إعلانه كفر سعيد عبد النصير، كتبتُ بعض الهلوسات التي يرى سعيد عبد النصير أنها تحف فنية. قرأتها لماشا ونحن فى الفراش. فبكت، وعانقتني بشدة. قالت:
– أنا لم أطلب منك أي شيء طوال سنوات عديدة. ولكنني أرجوك ألا ترحل.
– من أين جاءت لكِ هذه الفكرة؟
– كل كلامك في القصيدة يوحي بذلك.
بكيتُ ولجأتُ إلى صدرها. فاحتوتني رحما حنونا ودافئا وكونِيّا. راحت تمسح على رأسي، تقبل أذنيَّ ووجهي ورقبتي، وتبكي. وفجأة قالت:
– لو حدث شيء سأموت.
في تلك اللحظة فقط، أدركتُ أنها أقرب إلىَّ أكثر مما كنتُ أتصور. وفي اليوم التالي، حكيتُ لضميرنا الحي عما حدث. فقرأ القصيدة، ثم نظر إلىَّ نظرة غريبة: باردة ومحايدة وحادة. دمعت عيناه، فأدار وجهه نحو البار طالبا لترا كاملا من الفودكا. وراح يحكى حكاية..
قال إن إحدى الممثلات الشابات أبلغت المخرج العربي الشهير أن مخرجا شابا، ذاع صيته في السنوات الأخيرة، يريدها في أحد الأدوار بفيلمه الجديد. فهددها المخرج العجوز المشهور بأنه سيقضي على مستقبلها إذا وافقت. فذهبت الممثلة الشابة إلى أحد زملائها المقربين تستشيره في الأمر. فقال لها: “يجب أن تنظري إلى المستقبل. صاحبنا العجوز رغم شهرته وسطوته لم يبق له إلا القليل في هذه الدنيا، والمستقبل كله أمام هذا المخرج الشاب الموهوب”.
شرب سعيد عبد النصير كأسه كاملة بدون مازة، وصب أخرى:
– تصور، يا إبراهيم يا عفيفي! المخرج الشاب هو الذي مات بعد أسبوعين!
ضحكتُ. فقال:
– لماذا تضحك يا حمار؟
عببتُ كأسي:
– على حال هذه التعيسة، الممثلة المنحوسة..
فضحك سعيد أيضا. ثم انتابتنا نوبة بكاء صامت. فالمخرج الذي مات كان صاحبنا، وكنا نحلم معا أيام الصبا.
فجأة لاح على ذهني سؤال:
– ولكن لماذا حكيت هذه الحكاية الكئيبة، يا مثقف؟
كرر سعيد نظرته الجريحة الباردة، ولم يتفوه بأي حرف.
* * *
جاء صوت كاتيا صاحبته في سماعة الهاتف باكيا ومجروحا:
– سعيد انتحر.
في الجنازة، همستْ لي ماشا:
– عندما حكيتُ لكاتيا عن قصيدتك، قالت لي: “انتبهي، ربما يرتكب حماقة ما”. وعندما حكيتُ لدميانة، قالت: “يمكن الواد اتجنن!”.
وراحت تبكي وتنظر إلىَّ، بينما ركزتُ عينييَّ في عينيها بنظرة محايدة وباردة ومجروحة. وكان جرجس يبكي كامرأة وهو متشبث بذراعي، وكأنه يخشى أن أطير.