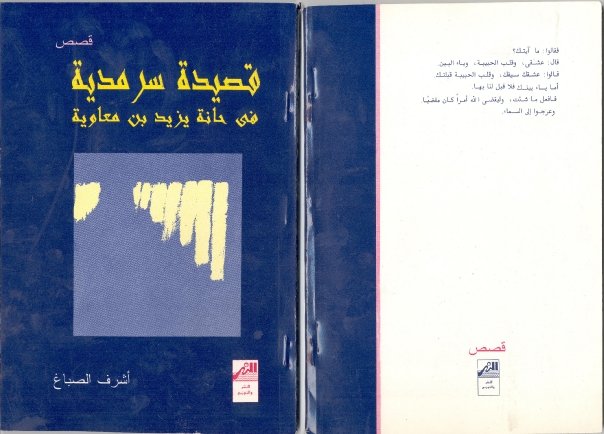هدى حمد
كنتُ أنوي رفع قبضة يدي في وجه الطبيبة المُتبلد، عندما قالت جُملتها الصادمة لجارتي كأنّما تقول لها “صباح الخير”. كانت تتمعن في شاشة تُظهر رحم جارتي المُمددة على السرير. قالت دون انفعالٍ أو أسفٍ أو حتى التفاتة: ” لقد فقدتِ حياة توأمكِ”. لم ترفع الطبيبة عينيها الباردتين عن جهاز الكمبيوتر أعلى مكتبها، “عادة لا ينجح الأمر منذ المحاولات الأولى” هكذا قالت. شعرتُ بغيظٍ هائلٍ يتصاعدُ كالحموضة ووجدتُ الكلمات تفرُ من رأسي، بينما كانت جارتي تسترُ بطنها بتعجلٍ، كأنّما لم يعد من اللائق أن ننظر إليه بعد أن خلا من نبض التوأمين.
بدا أنّ الطبيبة لا تفكر بأكثر من طابور المرضى الذين ينتظرونها في الخارج. بدتْ معتادة على أن تقول أخبارا من هذا النوع لمرضاها. كان الصمتُ كثيفا بيننا، لا نسمعُ سوى نقر أصابع الطبيبة على الكيبورد وهي تكتبُ التقرير وتترك وصفة الأدوية لنصرفها من الصيدلية. قلتُ بصوتٍ مخنوق: “لكنها دفعتْ مبلغا هائلا لأجل هذه المحاولة.. لقد..” ثم شعرتُ أنّي سأبكي بينما تمتمتْ جارتي بكلمات خافتة لم أسمعها على وجه الدقة.
في طريق الذهاب إلى العيادة، كنتُ أحدثُ جارتي عن نبض الجنين، عن ذلك الصوت الذي يغدو تحت الأجهزة وكأنّ خيولا جامحة تركضُ في برارٍ شاسعة دون أن تهدأ. أقودُ السيارة وألتفتُ لها بين الحين والآخر لأخبرها بأمرٍ اختبرتُه قبلها، وستتعرف عليه بعد دقائق قليلة. كنتُ ألوح بيديّ بكثيرٍ من الانفعال، بينما تجلسُ جارتي بهدوءٍ ورقة مُصدرة ابتسامتها الهادئة. تمررُ يدها اليمنى على ذلك النتوء الصغير فوق بطنها محاولة تصديق ما أقوله لها. أعاود التحدث عن الخيول الجامحة التي تركض بداخلها، فتتدفق الدماء إلى وجهها الخالي من أي مساحيق، إلى أن تشوبها حُمرة تُعيدني دوما إلى مشينا الطويل تحت أشجار الغاف بالقرب من فلج مزرعتنا في القرية النائية، وآنذاك وحسب أشعرُ أنّ سعادتي مُكتملة.
خرجنا من البوابة الفخمة للعيادة. نزلتْ جارتي الدرج بخفة أكبر، على عكس الطريقة الحذرة التي دخلنا بها ونحن نتأملُ ثبات التوأمين.
ركبنا السيارة، فشعرتُ بدموعٍ لا نهائية تغزو عينيّ، وصوتي شابه تغيرٌ حاد، بينما بقيتْ جارتي مُحتفظة بحزنها في أبعد نقطة يمكن أن نتصورها. كان وجهها مخطوفا لحظة تلقي الخبر، ثم ما لبث أن راق قليلا. ظلتْ تنظرُ من نافذة السيارة للأشياء التي تعبر بسرعة. لم يكن يبدو أنّها تريد التحدث بشأن ما حدث، وكان هذا أفضل، إذْ لم تكن بحوزتي كلمات تصلحُ للمؤازرة.
وصلنا إلى بيتي. ستمكثُ معنا ريثما يعود زوجها ليأخذها مجددا إلى القرية. كنتُ أتساءل بيني وبين نفسي بامتعاضٍ شديد، “هل تبددتْ أسبابُ بقائها في منزلي؟”.
جلسنا مُتقابلتين على الأريكة. لم يعد طفلاي من المدرسة بعد، وزوجي ليس هنا على كل حال. حزنُها لم يكن يطفو على السطح بوضوح، الأمر الذي صعّب عليّ مواساتها. أردتُ أن أذكرها بأنّها لم تتناول الحبوب التي صرفتها لها الطبيبة، ولكني قررتُ أن أتظاهر مثلها أنّ الأوضاع يمكن أن تذهب إلى الأفضل، فما دام الجنينان لم يسقطا بعد، فلمَ عساها تتناول الأدوية التي تُساعد على إسقاطهما! آنذاك أدركتُ أنّها تتشبثُ بالأمل، ماذا لو عاد النبض إلى قلب الجنينين. ماذا لو دبتْ الحياة فيهما، ربما تكون الطبيبة على خطأ وأنّ قلبيهما لم يتوقفا بعد عن النبض. ربما تكون المشكلة في الجهاز اللعين. تبين لي في ذلك الصمت العسير أنّه يتوجب عليّ أن أشاطرها الأمل. القليل من الأمل وحسب ليستمر بقاؤها في بيتي.
كان لا بد أن أدعوها لتناول شيء ما. تطلب منها الأمر أن تفكر لدقيقة كاملة، ثم قالت كمن استيقظ للتو من غيبوبة: ” شرابٌ بارد. عليّ أن أتجنب ما يمكن أن يضرّ التوأمين”. هكذا ذكرتهما وكأنها تستمعُ لركض الخيول بداخلها، وكأننا لم نتلقَ خبرا مُفزعا منذُ نصف ساعة!
اختلط نشيجي المتقطع بصوت الخلاط المرتفع في المطبخ وأنا أحضر العصير. شاهدتُ بين دموعي الكثيفة قطع الموز تُفتتُ نفسها بسخاء لتمتزج بالحليب والثلج. جففتُ دموعي وغسلتُ وجهي وسكبتُ لنا العصير البارد. بقينا متجاورتين لا يصدرُ عنا أي صوت. لم يكن هنالك سوى صوتِ المُكيف ينجزُ مهمته الجبارة بصبرٍ هادئ في وجه القيظ الذي حبسنا دون نسمة رطبة.
ارتشفتْ القليل من العصير وظلتْ شاردة. في ذلك القرب بيننا انتبهتُ للتصبغ اللوني الذي نال من وجنتيها وإلى أصابع يديها بالغة النحافة وأظافرها المقصوصة أكثر مما ينبغي، ومجددا تلعثمتُ ولم أجد كلاما أقوله لها. رفعتْ رأسها: “أنا فقط أفكر، كيف سأخبر زوجي بالأمر؟”. شعرتُ برغبة في أن أقول لها: “فكري الآن في خسارتكِ أنتِ” ولكن آنذاك لم تكن جارتي تفكر في شيء سوى الطريقة التي تقول الأمر لزوجها.
أردتُ أن أكون صديقة جيدة وودودة ولديّ كلمات جيدة تقال في ظرفٍ كهذا، ولكن اللامبالاة بشأن التوأم وانشغالها بأمر الزوج وأسرته وما ينبغي أن يُقال، دون أن تمنح نفسها فسحة للحزن، بدا لي مسألة غير عادلة البتة!
لم تكن المحاولة الأولى. سبق وأن كانت هنالك محاولات كثيرة. لكنها المرة الأولى التي تنغرسُ فيها البويضة في جدار الرحم ويُظهر فحص الحمل خطين متوازيين. أيُ معنىً للسعادة تملكنا فور سماع الخبر. كان عليها ألا تبذل مجهودا وأن تبقى هادئة وألا تصعد الدرج وأن تأخذ إبر المثبتات بصورة مستمرة. الأمر الذي تطلب مكوثها في مسقط، حيثُ لا أقرباء لها.
لا قرابة تجمعنا أنا وهي أكثر من الجيرة التي استمرتْ بين عائلتها وعائلتي منذ عقودٍ طويلة وحتى اللحظة. إلا أنّ ذلك لم يكن ليمنع مبيتي في بيتهم أو مبيتها في بيتنا، لم يكن ليمنع حروب وسائدنا وأسرارنا الليلية.
لكن قد تبدو الجيرة شأنًا تافهًا بالنسبة لزوجها الذي رفض في البداية مسألة إقامتها عندي، لا سيما أنّ زوجي مسافرٌ للدراسة في الخارج، وزياراته متنائية ومتباعدة، إلا أنّه لاحقا وجد أنّ هذا سببٌ أدعى لموافقته لا رفضه. الأمر الآخر الذي رجّح إقامتها عندي كان يتعلق بالعيادة التي يذهبان إليها بشكل دوري، والتي بالكاد تبعدُ ثلاثين كيلو مترا من بيتي، كما أنّي أقود سيارة ويمكنني تدارك أي حدث طارئ قد يلمُّ بالتوأمين. تلك الأسباب وحسب هي التي جعلت زوجها وعلى مضض يشعرُ بجدوى وجودها في بيتي.
لطالما كان مُنتقدا لي. المرأة التي تعيش في مسقط برفقة طفلين وعاملة منزل. “أي نوع من الأزواج هذا الذي يتركُ زوجته ويذهب للدراسة!”. كان يشعرُ بشيء من الازدراء تجاهي. الحقيقة أنّه لم يقل لنا يومًا شيئا من هذا القبيل، ولكن يمكنني تخمين الأمر بيسر، فكيف لي أن أفسر شُح زيارات صديقة العمر لي. لطالما كان يتحججُ ويرفضُ دعواتنا لأسبابٍ غير كافية بالنسبة لي، لا شيء غير الازدراء يمكن أن يُبرر تصرفاته الشائنة تلك.
جهزتُ غرفة الضيوف ودورة المياه. كل شيء لأجل أن يصل التوأمان بأمانٍ إلى الحياة، “القليل من الجهد، الكثير من الطعام الصحي، الكثير من النوم”، هكذا كنتُ أقول لها كل يوم.
أعود متلهفة من عملي لأعرف أخبار التوأمين. ما يمكن تجهيزه لهما. وتقول جارتي دوما: “ما زلتُ في الأشهر الأولى”. أفتحُ لها الستائر: “دعي الضوء يدخل. الكثير من الضوء. ينبغي ربطهما بالحياة من الآن”.
لم يكن بين جارتي وزوجها قصة حب. كان زواجا تقليديا، أمّا الحب فكما يقول الجميع لنا يأتي لاحقا. كنتُ أختلف عنها. كنتُ أريد قصة حب. ولطالما كان وجهها يحمر وتتغضن رقبتها ما إن أخبرها عن رغباتي. كانت تمتلئ بالإعجاب بي وتؤيدني دوما ولا تلومني على شيء. رغم أنّها لم تقل يومًا إلا جملة واحدة بصيغ مختلفة من قبيل “إن شاء لله، سأفعل”. لم تقل “لا” لأي شيء، حتى لتلك الأشياء التي نغّصتْ حياتها.
كنتُ أرغب في كسر رأس والدها عندما رضختْ له وصدقت أنّ التعليم المختلط سيفسدها في الجامعة. أردتُ أن أدفعها لأن تذهب معي لنكمل أوراقنا معا لكنها كانت تقول بإذعان قاتل: “والدي يعرف كيف تؤول الأمور دوما”. أفلتُّ يدها وتركتها وقررتُ أن مجرد التحادث معها سيجلبُ لي جلطة. كنتُ أثور في داخلي وقلتُ إننا لن نتحادث مجددا. ذهبتُ إلى الجامعة وتضاعف رصيدي من الصديقات ولكن لا أحد مثل جارتي الخرافية. ظلت تنتظرُ عودتي إلى القرية لأحكي لها شيئا عن الأحداث الأسبوعية. تنظرُ لي كما لو أنّي مسرحٌ كبير، وأنا أحكي لها أشياء بين الحقيقة والخيال، فتصدق ولا تعترض أبدا، ولا تلوم، رغم طيشي وجنوني، تبحلقُ بي بنظرتها الحالمة تلك، فأجدُ دوما ما يستحق أن يُحكى لأجلها.
نتمشى أنا وهي بطول مزرعة جدي ونحكي، وعلى عكسي لم يكن لديها ما تحكيه. القليل وحسب. تملكُ من الصمت ما يجعلني مندفعة بالكلام إلى أن قالت مرّة: “أبي قال سأتزوج”، وهنا وقفتُ ونظرتُ لها: “يا الله أنتِ صغيرة. أنا وأنتِ لدينا الكثير من الوقت لنعيش”. نظرتْ لكثافة البرسيم أمامنا وقالت دون أن يشوب صوتها اهتزازٌ أو توتر: “قال أبي لا يوجد ما يؤخرني. لا دراسة ولا يحزنون”. شعرتُ لحظتها بالحزن وبانقباضٍ كبيرٍ في قلبي.
نقطعُ أنا وهي طريقا طويلا بين أشجار النخيل، ولا يقطعُ صمتنا سوى صوت خرير الماء في الساقية أو عصافير الدوري التي ارتبط ضجيجها وهي تعود لأعشاشها في أشجار الغاف بموعد أفول الشمس وضرورة عوتنا إلى البيت.
قبل أن نودع بعضنا قالت إنها لم تتعرف على خطيبها بعد ولم تنصت إلى صوته وأنّ والدها يرى ذلك غير ضروري. لقد سأل جيدا عن أخلاقه. شددتْ كثيرا على كلمة “أخلاقه” وظلت تنتظر مني تعليقا أو تهجما كما اعتادت مني ولكني لم أعلق. تركتها دون أن نتصافح حتى.
طوال السنوات الماضية احتفظتُ بمنظور كئيب لحياة جارتي. أتصورها دوما وهي تقول “إن شاء لله. حاضر. سأفعل”، وأصابُ برغبةٍ في التقيؤ.
انتظرتُ رجلا أقع في حبه إلى درجة الخبل، ولذا بدا جليا أن أرفض كل الذين تقدموا من أبناء القرية. تزوجتُ من رجلٍ جذره يعود إلى القرية لكن حياته في مسقط. ظننتُ أنّه سيكون أكثر تحملا للفوضى التي أحدثها. ولكن على كل حال، لم تذهب حياتي إلى مكان أفضل. أنا وزوجي نتشاجر بصورة دائمة والأولاد يستمعون لصراخنا دوما، وأقول لنفسي بحسرة: “أنجبنا أولادا ليسمعوا صراخنا”. حصل الأمر بالتدريج، أصبنا بالفتور ولم يعد شيءٌ قادرًا على إيقاظ الحرارة في حياتنا. انصرف كل منا في طريق رغم أننا تحت سقف واحد. في الماضي كنتُ أتحلى دوما بالأمل: “سوف يتلاشى الفتور. سنتوهج بطريقة أو بأخرى كالليالي الأولى لوقوعنا في الحب”، ولكن تلك الارتعاشات كانت تصبح أكثر نُدرة بيننا بمرور السنين.
جارتي لا تلوم لا تنهر لا تغضب. فقط تمتلئ بالدهشة، وعلى كثرة الحكي الذي دار بيننا طوال الشهرين المنصرمين في بيتي، لم أجرؤ على أن أقول لها شيئا بشأن زوجي، وهي الأخرى لم تكن تجرؤ على أن تنكأ جراحا من هذا النوع، ولكني كنتُ أخمنُ أننا مُتعادلتان، الأمر الذي يُشعرني بطريقة أو بأخرى بالعزاء.
زوجي لم يكن يرى الفتور الذي أتحدث عنه. كان يرى حياتنا مستقرة وتمضي على نحوٍ جيد. لم يكن يتذمر من أي شيء، ولا يتحدث في أي شيء. كان مُطمئنا، ذلك الاطمئنان الذي يُحرض غضبي وصراخي الدائم. الغضب الذي دفعه لأن يعقد حقائبه مُندفعا لأبعد بقعة من العالم.
في ليلة من الليالي حصل أن نكأتْ جارتي جُرحها، الأمر الذي دفعني إلى سعادة لم أشعر بها منذ أن ركضنا في حقول القرية ونتائج الثانوية العامّة بين أيدينا، “لا يحب الفساتين. لا يحب الخروج الكثير. كان علينا أن نجمع المال من أجل الطفل”. هكذا فتحتْ جارتي قلبها لأول مرّة. طوال السنوات التسع كانا يعملان دون توقف، هو سائق لحافلة المدرسة وهي بائعة للبخور. لم يفعلا يوما أي شيء. لم يتنزها أو يُسافرا ولم يذهبا إلى مطعم، لم يصرفا مالهما في أي شيء إضافي. لا الملابس ولا السيارات ولا أي شيء. لم يُغيرا طلاء الغرفة التي سكنا فيها في بيت أمّه وأبيه وإخوته، لم يشتريا فراشا جديدا لسريرهما. اكتفيا بفراشٍ واحدٍ منذ ليلة الدخلة. تغسله جارتي وتجففه تحت الشمس ثم تُعيد فرشه في المساء ذاته. لا شيء على الإطلاق. كان هنالك هدفٌ واحد وحسب، أن يكون هنالك طفل لكي تُعاش الحياة كما يأملان.
على نحوٍ غامضٍ كنتُ أدنو من خفقانٍ مُفرحٍ بداخلي، وآمل في أعماقي أن تُصَدّر جارتي احتجاجا مُتلاحقا على حياتها المُفزعة، “الحياة مؤجلة لأجل طفل.. يا الله” هكذا قلتُ لها لأدفعها لمزيدٍ من الشكوى. بذلتْ جارتي جهدا مُضنيا لتؤكد تفهمها لدوافع زوجها وأنّه يفعل ذلك لأجلها أيضا. ولكني لم أكن لأصدق دفاعها اللاحق. فأنا أفهم ما كانت تُداريه. لم تشأ أن يُفضح أمره. لم تشأ أن يبدو رجلا مُقرفا في عينيّ، “لا تقلقي يا عزيزتي. كلهم هكذا” قلتُ لها وأنا أربتُ على ركبتها المجاورة لي، ولم أكن لأسمح لها بأي حال أن تبرر فظاعته لي.
أعرفُ قصصا تُحكى عن زوجها في نمائم القرية، لم تأتِ جارتي يوما على ذكرها. من قبيل أنّه كلما فشل مجيء الطفل كلما اتخذ طريقه إلى الصحراء مخمورا وغائرا في حزنٍ لا نهائي. تقول جارتي بهذا الشأن: “كم يحبون تأليف القصص عنّا”. الحقيقة لم تجمعني بزوجها مائدة طعام ولا أحاديث ولا حتى اتصالات، ولكني أود بشغفٍ تصديق القصص التي تُروى عنه وتفضحُ خواءه وضموره، هكذا أشعرُ بالارتواء وكأني منذ زمنٍ بعيدٍ أتخذه عدوا لا مرئيا.
صعدتُ إلى غرفتي وملأتُ الحوض وبقيتُ لساعة كاملة أغمرُ نفسي بالماء وأتوهجُ بسعادة تنبتُ من مكانٍ خفي في جسدي.
تفضلُ جارتي أن تنعزل مساءً في الغرفة التي أعددتها من أجلها. تقول إنها تود أن تجري اتصالا مُهما. لم أكن مُهتمة بالأمر في البداية ولكن عندما تكرر الأمر لليالٍ متواصلة، شعرتُ بالحنق لا سيما عندما أكون قد حضرتُ طبقا من الحلويات أو جهزتُ فيلما لنشاهده معا. يستمرُ الاتصال لما يربو الساعة يوميا دون أن أجرؤ على سؤالها. يأكلني الفضول والحسرة عندما تزهد بكل مقترحاتي المسائية وتنزوي إلى غرفتها المجاورة. في ليالٍ لاحقة لم أكن احتمل غيابها ولا الغليان المتصاعد بداخلي، ولذا حصل وأن فاجأتها مراتٍ عديدة بدخولٍ غير متوقع وسألتها عن أشياء تافهة دون أهمية تذكر. كانت تتوهجُ بحُمرةٍ ويختنقُ صوتها بعيدا، الأمر الذي ضاعف استيائي.
وفي ليلة من الليالي التي انتظرتها فيها طويلا بعد أن أعددتُ الشاي المغربي والبسبوسة، ودون طرق لباب غرفتها دخلتُ وبدأتُ بفتح الخزانة الجانبية. أصدرتُ ضجيجا مُتعمدا وكنتُ كمن يبحث عن شيء. الأمر الذي أصابها بالحرج وكتم صوتها. آنذاك سمعتها وهي تنطق اسم زوجها وتغلق المكالمة. “هل كان زوجكِ؟” سألتها. رفعتْ عينيها بحرج: “نعم”. فتحتُ أدراج الخزانة تباعا وتناولتُ مناشف مطوية: “الخادمة الغبية لم تُغير مناشف الحمام. لطالما قلتُ لها المناشف ينبغي أن تُغير نهاية كل أسبوع” قلتُ بنبرة مرتفعة وأنا أحدثُ قلفعة مزعجة. ضمتْ جارتي ساقيها إليها تحت الملاءة ولم يصدر عنها أي صوت أو حركة. بينما ضممتُ أنا المناشف بين يدي ثم تركتها على طرف سريرها، “أعتذر.. للمقاطعة.. أنا لا أعرف كيف أجعل العاملة تنجزُ عملها بدقة دون أن أضطر لمراقبتها على هذا النحو” قلتُ بارتباكٍ عارمٍ وعدتُ لأغلق الأدراج. “لا بأس.. هل أساعدك في شيء؟” قالت بصوتٍ خافت. “ألم يكن زوجك أيضا الذي اتصل في الليالي السابقة” سألتها دون تفكيرٍ وسرعان ما ندمتُ على طرحي السؤال على ذلك النحو من الفجاجة. تورد خدّاها: “يتصل ليطمئن و..” قالت. درتُ في الغرفة ذهابا وإيابا لأكثر من مرة دون أن أفسر تصاعد الغيظ بداخلي. تنفستُ بعمقٍ وجلستُ على طرف السرير، ودون أن أنظر لعينيها قلتُ: “لابد أنّه متشوق للطفلين. يتغير الأزواج بادئ ذي بدء لنبأ تحولهم لآباء، ثم يغدو الأمر أقل حماسة”. رجعتْ جارتي بظهرها إلى الوراء وانكشف قميص نومها الفضفاض ذو الأكمام الطويلة والأزرار البارزة: “لا يحبذ زوجي النوم دون أن نتحادث.. لقد اعتدنا ذلك”. وقفتُ وأنا أقضم ظفر سبابتي بقواطع أسناني وضحكتُ تلك الضحكة الفاترة: “إنه الاعتياد. بعض الأزواج يعتادون على..” وبدأتُ أحركُ يديّ أكثر مما ينبغي، “أقصد يدخلون العلاقة في روتين يعتادون عليه.. أليس كذلك”. بحلقتْ بي متفاجئة: “لا أفهم ماذا تقصدين!”. وآن ذلك تبدى لي أنّ حوارنا سيذهبُ إلى مزلق كبير، ووجدتني أدفع بيديّ أمامي وكأني أصدُ هجمة مرتدة: “لا شيء. لا شيء البتة. تأخر الوقت سأذهبُ إلى النوم. أراكِ غدا”. اقتربتُ منها وانحنيتُ وقبلتها على خدها برقة.
في سريري بكيتُ طويلا وتناولتُ بعض الأدوية التي وصفها لي الطبيب من قبل. ظلتْ الدموع تنزلقُ لتحفر بسخونتها خديّ إلى أن غلبني النعاس ونمتُ في سريري الكبير والفارغ.
في اليوم التالي جلسنا أنا وجارتي متقابلتين بعد أن تأكدتُ من صعود أبنائي إلى حافلة المدرسة. اتصلتُ بمدير عملي وأخبرته عن عارض صحي ألمّ بي ومنعني من الذهاب للعمل. كان ينبغي أن أكون جوارها. وعندما لم يكن ثمة ما نفعله وقد فرغنا من تناول الإفطار، أردتُ أن أخترع شيئا ما؛ شيئا يُخرجنا من صمتنا، “لديّ فستانٌ ضيقٌ بعض الشيء، فستانٌ أزرق وجميل. لم أرتده بسبب تغير مقاسي بعد الإنجاب ولكني أخمن أنّه يُناسبكِ” هكذا قلتُ. ابتسمتْ تلك الابتسامة المليئة بالامتنان ودخلنا إلى غرفتي. أظهرتْ قَصّة الفستان خصرها النحيل جليا، وكسرات الشيفون التي انسابت فوق ساقيها جعلتها تبدو غير ما أتصور، “لقد أزاح الفستان سنوات من عمركِ.. تبدين أصغر بكثير” قلتُ لها قولي ذلك.
لم ترتدِ جارتي يوما أي فستانٍ يُبدي جسدها بذلك الوضوح ولا حتى في الأعراس والمناسبات. لطالما كانت تتخفى تحت الثياب الفضفاضة. نظرتُ إليها وقلت: “سوف يُفتن زوجكِ بكِ”. احمر وجهها النحيل شديد السُمرة، ثم رفعتْ شعرها بالغ السواد أعلى كتفيها وصنعتْ به كعكة، فتبدى لي عنقها الدقيق الذي لم أره منذ طفولة بعيدة وعظمتا الترقوة، ” لقد طلب مني ألا أرتدي فساتين من هذا النوع” قالت جارتي. قلتُ لها وأنا ألكزُ ذراعها المكشوف: “البسيه له هو”. قالت: “هو لا يحبذ ذلك حتى فيما بيننا. لديه تصورات أنّ…” واختنقتْ الكلمات في حلقها. ربتُّ على كتفيها، ثم جلسنا أنا وهي على طرف السرير، تلعثمتْ ولم تنظر في عيني: ” لا تغضبي مني، هو يقول الفتيات سيئات السمعة يلبسن أشياء كهذه من وجهة نظره”، ولفرط العبثية وجدتُني أنفجر ضاحكة. ضحكتُ حتى طفرتْ دموعي. قلتُ لها: “ما رأيك أن نضع أحمر الشفاه. لنرَ كيف سيبدو عليكِ”. لم تكن مُتحمسة ولم تكن رافضة أيضا. أغمضتْ عينيها وسمحتْ لي أن أمرر أحمر الشفاه القاني فوقهما ببطء بعد أن رسمتهما لها بقلم شفاهٍ داكن. طلبتُ منها أن تبقى كما هي ثابتة مُغمضة العينين لا تنظر إلا لداخلها. رسمتُ لها حاجبيها المبعثرين اللذين لم يسبق لها حفّهما بالخيط من قبل، ثم أخذتُ أطبطبُ أعلى وجنتيها بالكريم لأخفي تصبغهما اللوني. أكادُ أجزم أنّها لم تدخل يومًا صالونا تجميليا. خيوط الشمس المُتسللة من ستائر غرفتي أخذتْ تصنعُ خطوطا متقاطعة فوق وجهها المستسلم ليديّ. رأسها مائلٌ إلى الوراء بينما تسندُ جسدها بمعصميها الهزيلين على طرفَيْ السرير. رسمتُ بالكحل نصف قوسٍ فوق جفنيها، وما إن فتحتهما، ونظرنا لبعضنا البعض من ذلك القرب، حتى تبدت لي امرأة أخرى.
ناولتها المرآة وبدت متعجبة من شكلها. تناولتْ منديلا، ولكني طلبتُ منها برجاء أن تُبقي وجهها كما هو ولو لساعات قليلة. كانت مختلفة وملامحها أشدّ وضوحا وجمالا، وسُمرتها الداكنة تشي بحرارة عميقة. لوحتْ بيديها كأنها ستقول شيئا، لكن هاتفها رن. كان زوجها هو الذي يتصل. شحب وجهها: “ما عساي أقول؟”. ووجدتني أضطربُ معها. كانت تنظر إليّ بضعفٍ مُحبذ. تريدُ أن أنقذها. كان الأمر مُغريًا بالنسبة لي في موقفٍ حاسمٍ كهذا: “قولي له: كل شيء على ما يرام”. ترددتْ وقالت: “لكن الطبيبة قالت..”. همستُ لها بحزم: “ما يزال الجنينان بداخلكِ لم تفقديهما بعد. أنتِ لا تكذبين”. أخذتْ نفسا عميقا ثم عضت شفتها السفلى غير منتبهة للون القاني فوقهما. تركتها وخرجتْ.
تحدثا لما يربو على عشر دقائق. توترتُ كثيرا: “ماذا عساهما يقولان لبعضهما كل هذا الوقت”. خرجتْ جارتي من الغرفة بهدوء، يدها على بطنها، والألوان تضجُ بوهجٍ فوق سُمرتها، رغم أنّها أسدلت غطاءً فوق رأسها لتغطي شعرها وكتفيها تحسبا لدخول أحد: “لستُ مرتاحة” قالت. ووجدتُ صوتي يرتفع: “لماذا كل هذا الذعر؟. أنتِ لم تكذبي عليه. وإن كنتِ لم تقولي له الحقيقة بعد، ففيمَ كنتما تتحدثان؟”. بدا الحرجُ واضحا عليها: “إنّه يحبُ أن نتحدث وحسب”.
ثار الغضبُ بداخلي، فجلستُ على الصوفا وبدأتُ تقليب محطات التلفاز وجسدي ينتفض دون أن أدرك سبب ما أنا فيه من غيظ. جلستْ جارتي جواري مُترددة، تقبضُ الكلام خشية أن يهرب منها: “سيأتي هذا المساء” قالت بصوتٍ هامس. بدتْ آنذاك كامرأة مُشتاقة ومُتلهفة، وبدا أنّ افتراقها عن زوجها ليس بالأمر الهين عليها. “ظننتُ أنكِ سعيدة هنا؟” قلتُ لها برفق. “أنا سعيدة جدا ولكن..” قالت. وهنا التفتُّ لها بحدة دون أن أجد تفسيرا ملائما لتصرفي، أمسكتُ بكتفيها الهزيلين بين يديّ: “ستعودين إلى حياتكِ الشاقة. هذا ما تريدينه. ستتركين كل هذا الرخاء الآن”. ثم تداركتُ الأمر وأنا أشدُ أكثر على ذراعيها: “يمكن أن نحافظ على الطفلين. من يدري لم يسقطا بعد فعليا. يمكنكِ البقاء هنا”. نظرتْ لي جارتي لأول مرّة منذ أن تعارفنا نظرة لومٍ جادة، وآنذاك كنتُ أغلي لأبعد ذرة في كياني، كأن أحدهم يسرقُ مني شيئا لطالما أردتُ الاحتفاظ به. وجدتني أقول لها بنبرة حادة مجددا: “لطالما كانت حياتكِ وراءكِ. لم تفعلي شيئا من أجلكِ. حتى الطفلان لم يكونا من أجلكِ بل من أجله هو”. تجلتْ شراسةٌ لم أختبرها من قبل في عينيها الغاضبتين. شراسةٌ أفزعتني إلى درجة لا يمكن تصورها، وتحت طبقات المكياج الذي تضعه لأول مرّة، ظهرتْ قسماتُ وجه جارتي أكثر حدّة من أي وقت مضى.
أخذ صدرها يعلو ويهبط بوتيرة مُتسارعة تحت فستان الشيفون وكأنها ستبكي أو سيغمى عليها، فيما كانت حبيبات العرق تتراقص أعلى جبينها. سارعتُ إلى المطبخ لأحضر لها عصير ليمون. كنتُ أعصر كل غضبي مع كل ليمونة. لا أدري ما الذي أوصلنا إلى هذه النقطة، “يمكننا تفادي الأمر” هكذا حدثتُ نفسي وأخذتُ نفسا عميقا وعدتُ إليها.
كانت جارتي واقفة، في نفس النقطة التي تركتها فيها في الصالة. دموعٌ حارة غزت وجنتيها، فسال الكحلُ وخرجت الحُمرة عن الخط الذي رسمته لها، أمّا فستان الشيفون ذو الكسرات فقد خالطه احمرارٌ داكن.
…………………
*قاصة وروائية عُمانية