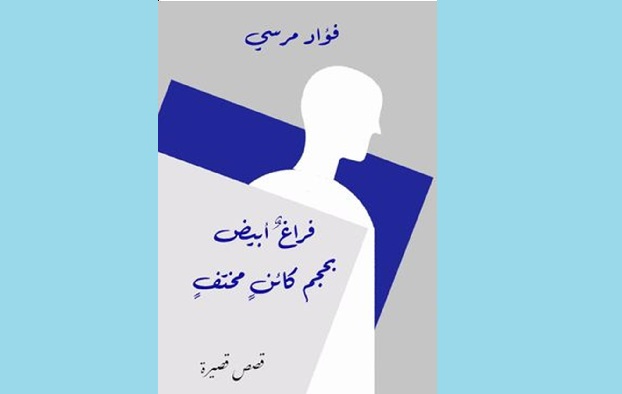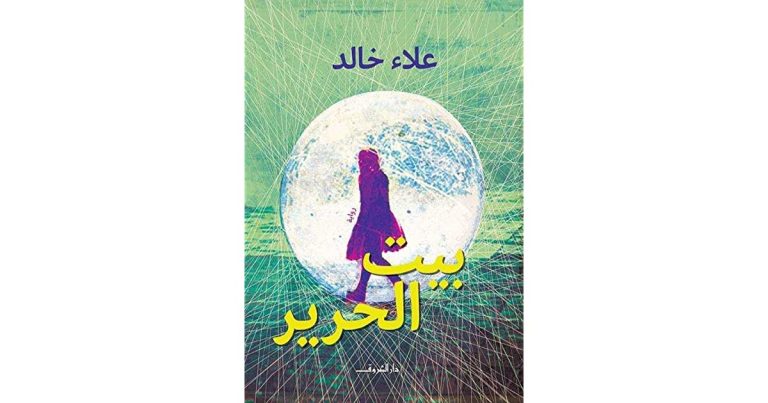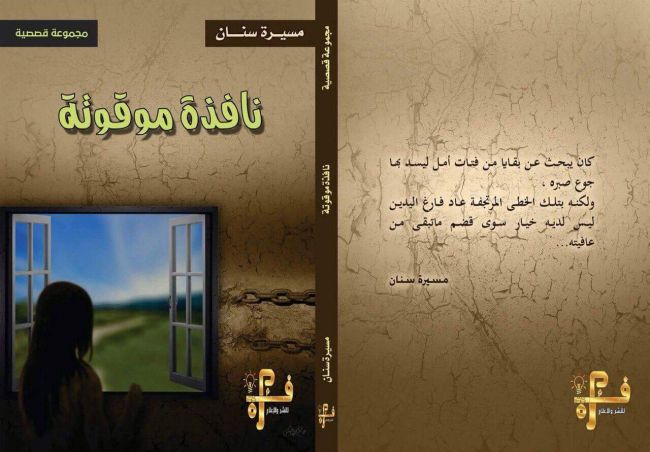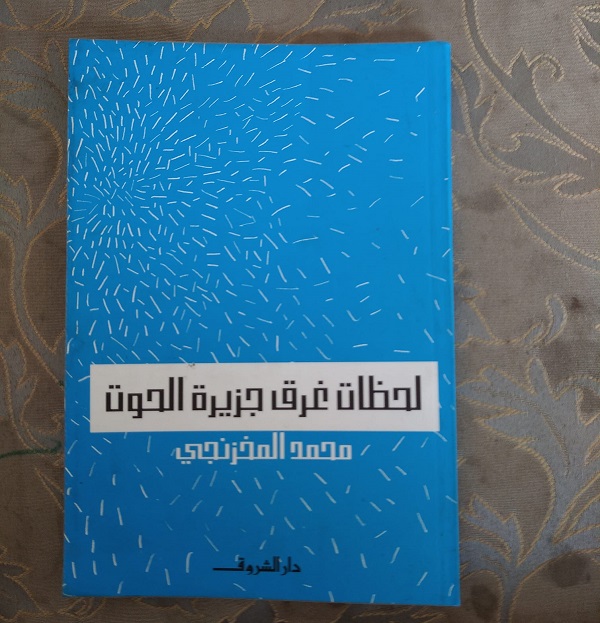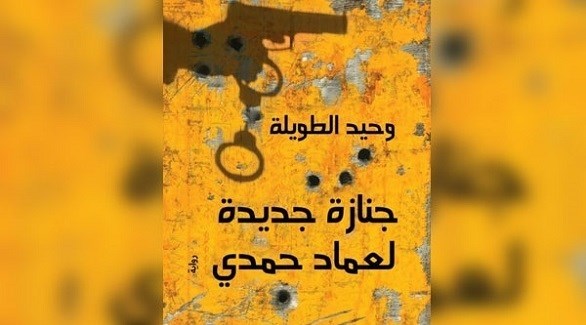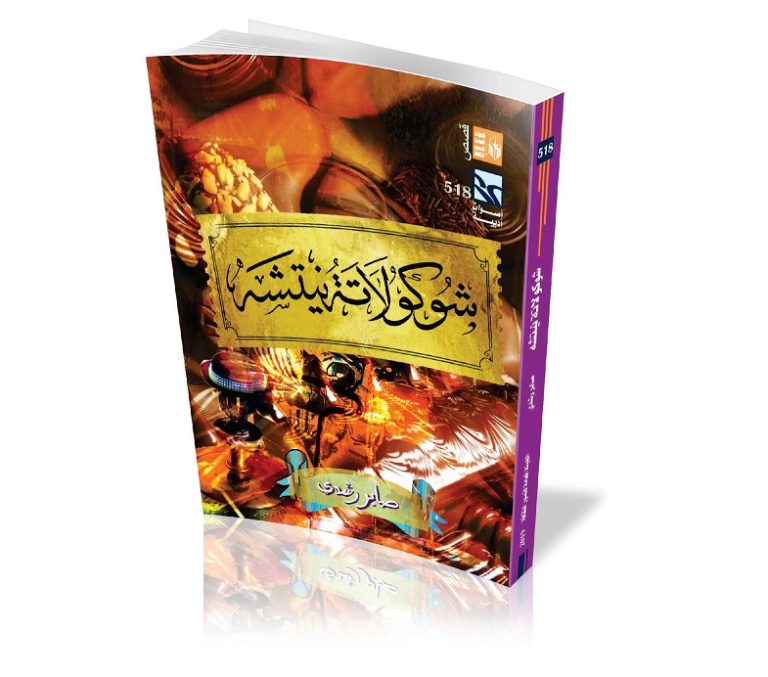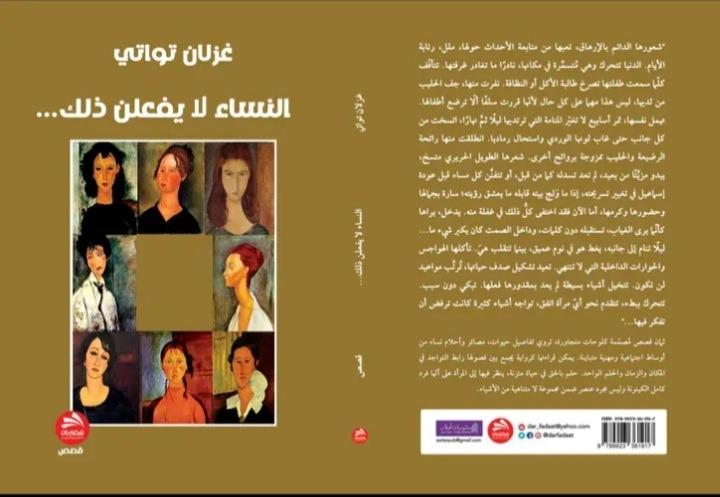محمد أبوالدهب
كتب فؤاد مرسي قصص مجموعته الجديدة (فراغ أبيض بحجم كائن مختفٍ)، الصادرة عن دار سنابل، كما لو أنه يقدّم بيانًا أخيرًا ونهائيا يعلن فيه عزلة الكائن، العزلة المطلقة التي خابت مرةً بعد مرة محاولاتُ كسرها ومناورات استبدالها، فترسّخت كَسِرٍّ عظيم، غير خفيّ مع ذلك، يحكم وجوده -الكائن- ويثير لديه نزعة التّباكي على الذات والوقوع في مأزق النفور العام! ويغبش علاقاته في اللحظة الراهنة السخيفة، فالإنسان الأعلى الذي بشَّر به نيتشه هو نفسه الأعلى عند فؤاد مرسي، لكنه الأعلى المعزول، المطأطئ، الأسيف. كل شيء ولا شيء كما يقول بورخيس.
وليس “محمد سيد عبدالفتاح عاشور” وحده من غادر مكانه في الصورة ليترك فراغًا أبيض بحجمه في القصة التي تحمل المجموعة عنوانها، بل إن معظم كائنات فؤاد مرسي تركت أماكنها، أو أُجبرت على تركها، الإجبار الذي يُبقيه السرد معنويا وجوانيًّا وذا طابعٍ فلسفيّ قبل أن يمهر بَصمَته في واقعها، وخلّفت الفراغ الأبيض الكثيف والمرسوم نفسه، لكن هل تراها ستشغل حيّزًا ملموسًا مرئيًّا من فراغٍ جديد (مثلما انتقل محمد عاشور من الصورة إلى الباحة الخارجية لمسجد السيدة زينب ليختار مَن يلقي عليهم تعاليمه ونبوءاته ليزيدهم تورُّطًا وارتباكا) أم أنها فقط سَتهِيم من “فراغ أول” إلى “فراغ ثانٍ” إلى “فراغ ثالث” لتروح للأبد في “فراغ لا نهائي” مثلما قسم فؤاد مرسي قصص كتابه.
حين نقرأ من قصة (كباش بربارة): “نعاين تكوينات الصخور الفانتازية، ونغترف من حلاوة ماء النيل الرائق”.. قد نتساءل: أيّ هولاء الصّحاب، الخارجين في نزهة، استمتع فعلًا بجمال المعاينة وحلاوة الاغتراف؟ بعدما نثر الكاتب بذور الصدود -حتى قبل أن تبدأ الرحلة- والرغبة في الاعتزال بل والارتكان إلى الموت لدى أحدهم، الذي حاول الانتحار مرارا ورفض مرافقتهم أولاً قبل أن يوافق ويترك أوراقه في ذمة صاحبه كوصية ثم يموت هناك في البر الآخر بعدما نضج اللحم للغداء وتأهب الجمع للاحتفال، لكن أيضا بعدما طارت الأوراق مع الريح إلى النيل.. كان ذلك دأب فؤاد مرسي، فما يتحقق في قصصه الذهابُ لا العودة، النقص لا التمام، والذي يتأكد عنده الانفصام دون الالتئام، والموت وحده راسم البسمة في النهاية على الوجه المعذَّب. وليس هذا السياق بمنفصل عن قصة (الاستراحة) التي تسبق في الترتيب قصة (كباش بربارة) فزائر مرضى الاضطراب الوجدانيّ ثنائي القطب في المصحة النفسية يربّت على أكتافهم ويمنحهم السجائر العزيزة عليهم حتى أنهم صاروا يترقّبون زيارته بين وقت وآخر رغم حيرتهم في صفته التي تسهّل له الدخول عليهم، عندما يجري تنبيهه إلى قدوم قطار يكاد يدهمه وهو سائر شارد على سكة الحديد يحسب أنه لا يزال بينهم في المصحة وأن واحدًا منهم يرى قطارًا لا يراه غيره، لينفر منه (عليّ) أحد نزلاء المصحة السابقين ويزعق بأنه سيترك له الدنيا كلها كردّ عن سؤاله المتعاطف العاديّ (إزيك يا علي) حتى أن هذا التهافت الحثيث إلى الاعتزال وتقطيع العُرَى يربكنا كقراء فنُحسّ بالشفقة على زائرهم ولا نستبعد صيرورته واحدًا منهم.
في قصة (رفيف أجنحة الحمَام) نراقب المحاولة الأبرز والأشد قسوة للخروج من أسْر العزلة، وخلع رداء الوحدة الخشن الثقيل، بين شوارع وسط القاهرة تحت المطر، يحاول استنهاض الحبيبة للنزول ليستقطر معها لحظات من الدفء. فانهمار المطر يجعله يشتهي صحبتها ليحتميا ببعضهما لكنها تركن إلى دفء الفراش ولايكات الفيس بوك. ورائحةُ السبّيط وطزاجته مرة والسمك المشوي أخرى تجعله يشتهي أكلهما معها، وهي قابضةٌ على عدم مغادرة عالمها، بل إنه لما فكر بالكشري عدل عن الفكرة لمجرد سابق علمه بأنه يستثير معدتها كما لو أنه افترض واقعَ أنها معه بالفعل منضمّةٌ إلى عالمه، لنفاجأ بأننا أمام اثنين لكل منهما عالمه الافتراضي، أرسلت العزلة أحدهما (هي) إلى عالم هوائي متوهّم وقيّدتِ الآخر (هو) داخل عالمه الذاتي القائم على فوضى الأوهام أيضا. وتأتي لحظة فضّ الاشتباك بين العالمَين حين تقولها له: (أنا لست لك) دون أن ينفعه دعمه الجرئ لقصة حبٍّ بين شاب وفتاة عبرَ بها في أثناء محاولته ضبط هواجسه، فيموت على رصيف شارع عماد الدين محاطًا بكومة من حمامٍ ميت، مختارا أن تكون عزلته أبدية، ولا بدّ أن صفحتها على الفيس كانت من بين الصفحات التي تداولت خبر موته بمشهده الفريد.
وتنوّعت في قصص المجموعة مناحي النزوع إلى الاعتزال كاختيار أخير لا مناص من الاستسلام له، أو إلى العزلة كإجبار فرضته الظروف والأفكار والمشاعر. يظهر في قصة (رائحة سكر محروق) كفقدان ذاكرة، وإن كان فقدانا مؤقّتا، إذ يقوم في الصباح فلا يدري أين ولا بين مَن استقبل يومه، وربما كانت مقدّماتٌ كثيرة قد هيّأتْ له توقّع طفرةٍ كتلك، فقرّر من أول اليوم أن يعيد قراءة كتاب (فلسفة الوجود) وكأنه سيخُطّ فلسفةً جديدة لوجوده ذاته تتوافق مع عزلته الآخذة في التّغوُّل. وقصة (نقطة ارتكاز) التي يبدو فيها التواصل متحقّقا ظاهريًا بين شخصياتها الثلاث، لكن انسيابية اللغة وشعرية الوصف والنبضات الخفيفة الموحية في ثنايا السرد توحي بشيء آخَر، تدفعنا لنستشعر أن هذه الشخصيات تنادي من طرفٍ خفيّ، كلٌّ على حدة: أنا هنا. وتودّ لو تكمل النداء: فمَن ياترى هناك؟ للحدِّ الذي يحرضنا على استنباط الدافع وراء حرص الشخصيات الثلاث على تناول أقراص الدواء بانتظام، كما لو أنها ليست أقراصًا مقاوِمة لمغص أو صداع إنما مضادة للعزلة وفاتحة لشهية التواصل المفقودة!
وفي قصة (صوت غليظ خشن) التي تضعنا داخل قطارٍ من عشرات القطارات الذاهبة العائدة حاملة المتعَبين الشاردين (يظل القطار دائما النموذج المصغّر والأصدق دلالةً وتشخيصا للحياة في مجتمع ما) لا نعلم طول القصة -طول الرحلة- مَن يَقبل مَن كآخَر، مَن يستحق التعاطف ومَن يستأهل البغض، مَن يثبت على مبدئه إلى النهاية، ومَن ومَن ومَن….. إنها فقط أصوات خشنة غليظة، إنه محض غياب تامٍّ للروح! وإنْ تبدّت الصورة على نحو أوضح في قصة (القصير والبدين) فالذين فشلوا في إبراز مهاراتهم في التواصل والتفاهم والانفتاح أبرزوا بديلًا عنها مهاراتهم الحاضرة والفعّالة في القطيعة والتنافر وترسيم الحدود!.. ونقرأ من قصة (مقهى الحرية): “الشوارع كما هي.. خواء يتسع يومًا بعد يوم.. هذه المدينة تحتاج إلى رفيق” فنعرف أنه على الجانب الموضوعي ليس ثمة خواء، بل إنه يخوض في زحام وصخب وضجيج، وعلى الجانب الذاتيّ يمضي مفردًا تماما، وحين يظن أنه عثر على الرفيقة المنتظَرة تتهرّب من رفقته سريعا بحجّة مفضوحة الكذب.
ورغم كل ذلك نصادف إشارات ليست بالقليلة، مبذورةً هنا وهناك على مدار قصص المجموعة، إشارات خاطفة مثل لمبات تضيء مرة واحدة ثم تُطفأ للأبد، تقدم الدلالتين معا: تصلح لتكون برهانًا على الاندفاعات القوية الحثيثة للتخلّص من جثامة العزلة وتصلح أيضا برهانا على نهائية الاستسلام لهيمنتها في الوقتٍ نفسه، مع التأكيد على عدم اعتبارها كذلك إلا داخل سياق قصتها، أقصد أننا لا نستطيع اجتزاءها كمقولاتٍ ذات طابع تجريديّ، منها: (لم أرفض الدعوة الصامتة، انضممت إلى صف الفقراء والأيتام والمساكين وعابري السبيل والعاملين عليها).. (عاد إلى غرفته، التقط “فلسفة الوجود” وتعمد أن يحرك غلافه أمام عينيها مرارا قبل أن يضعه تحت إبطه).. (أخذ يصفق لهما وينحني محييًا، ثم كتب على ورقة: قل لها أحبك.. وضع الوجه المكتوب من الورقة على الزجاج).. (لقد اكتشفت أن هذا المكان جميل جدا، أجمل ما فيه أن تُتابع هؤلاء الجالسين في ركن المشروبات الروحية وتتأمل استمتاعهم البالغ وهم يفرغون أكواب البيرة في أجوافهم).. (أضبط عيني تحاولان العثور على نهر صدرها من بين أزرار قميصها الرجاليّ، دون جدوى).. (تعثرت قدمي في قضيب حديديّ صدئ، حدقتُ فيه، كان ثمّ قضيب آخر يوازيه، لا يفصل بينهما سوى عرض قطار، أخذت أزيل الرمال عن القضبان بمعاونة المطر، كلما انتهيت من مسافة شجعتني على كشف الأخرى، صار الطريق ممهَّدا لقطار….).
في آخِر قصص المجموعة (ناظر محطة العريش)، وهي بالمناسبة من أكثر قصص المجموعة عذوبةً وشجنًا -وإنْ شاركتْها قصص أخرى في العذوبة والشجن (فراغ أبيض بحجم كائن مختفٍ.. رفيف أجنحة الحمام.. مقهى الحرية.. نقطة ارتكاز.. الأسطى رجاء)- جملة باهظة الدلالة مع نفَسها الشِّعريّ، تختزل كل هذا الذي ندندن حوله، وأضفتْ على عزلة الكائن بُعدًا أشد خطورة إذ أوصلتْ إلى تقطيع أوصال الوطن ذاته: “نزلَ ناسٌ تضوّعتْ من جنباتهم رائحة طمي الدلتا، وحملَ ناسًا لمعتْ في عيونهم رمال الصحراء) وكأنه لم يعد هناك مجال لاجتماعِ وتآلف الملامح والسمات في مكان واحد، حتى بين أبناء الوطن الواحد، فحيثما تحلُّ طائفةٌ تسارع الأخرى بالرحيل!
بمقدورنا الرّبط الصريح، والمنطقي فنّيًّا إذا جاز الوصف، بين قصة وأخرى، في أكثر من حالةٍ بالمجموعة، بل لِمَ لا نتجرّأ فنفتئت على فؤاد مرسي نفسه ونسائله: لماذا لم تدمج قصّتيْ (رفيف أجنحة الحمام) و(مقهى الحرية) في قصة واحدة بقليل من التَّصرّف، أو لماذا لم تضمّ قصة (الهازم والمأزوم) كمقطع ثانٍ من قصة (الاستراحة) مثلما كان خيارك بالفعل مع مقطعيْ قصة (فراغ أبيض بحجم كائن مختفٍ)؟.. وكما افتأتنا عليه في المسائلة سنفتئت عليه في الإجابة، بتساؤلٍ جديد: هل هذا الواقع المتفسّخ المنفصم المنبَتّ الذي ناولَنا إياه فؤاد مرسي يحتمل قولبته في أية تراتبيّةٍ من أيّ نوع، وهل العلاقات التي تشكّلت بين ناس هذا الواقع تحتمل صبّها في متتالية واحدة أو مجموعة من المتتاليات الصغيرة، وهي علاقات إما أنها تشكّلت قويةً ثم وهنتْ، وإما تشكّلتْ واهنةً من الأساس، أو أنها من صناعة الوهم والهلاوس في النهاية؟… إن واقع فؤاد مرسي يحتمل بالتأكيد لغته الكثيفة المدقّقة الأخّاذة وروحه الأصيلة بإنسانيتها اللاهثة وعزلتها المؤبّدة في آنٍ معا.