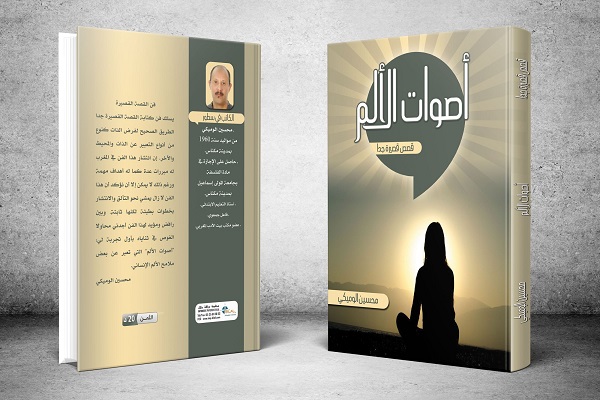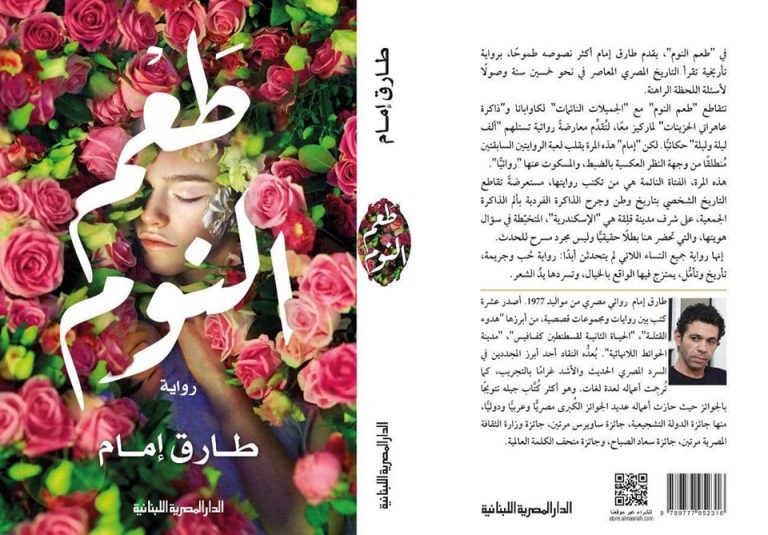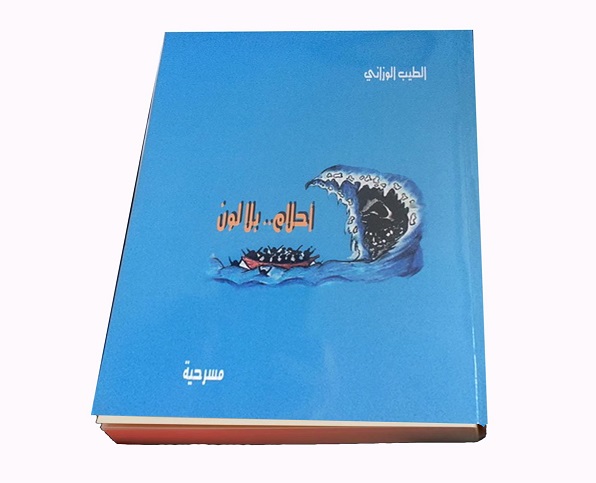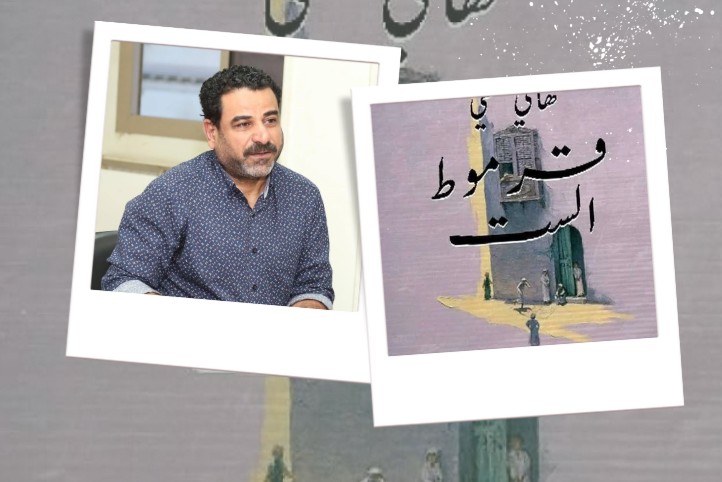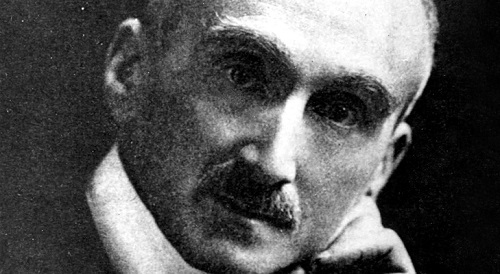د.خيرة مباركي*
الإبداع حالة فردية تعبر عن ذات عميقة وسعي لا محدود في إدراك النموذج المنشود، عبر رؤية يندمج فيها عالم هذه الذات مع دهشة العالم الموضوعي، هي مغامرة عند من يروم التميز والتفرد، يحكمها وعي جمالي مختلف أساسه التجريب وغايته تجاوز النموذج وقيود التسليم والجمود إلى حرية الحركة والخلق. واقتحام عالم قصيدة النثر مغامرة أخرى، بما تقوم عليه من خصائص غير ثابتة يمكن أن تحقق شعريتها وتنشئ مقوماتها وأسسها، وكذلك بما تواجهه من رفض عند البعض من أنصار عمود الشعر جعل منها شكلًا فوضويًّا يثير الجدل ويعمق الخلاف، يحمل وجوه التناقض في ذاته، مما جعل شاعر قصيدة النثر يسعى غالبًا إلى الإقناع قبل الإمتاع. فتغدو كل عملية إبداعية رقصًا على أوتار الشعرية، تتميز مع كل تجربة وتنمو بخصوصية وتفرد يحفظان لكل صوت شعري جهوريته ونغمته الفارقة.
والشاعر المصري سمير درويش صوت من هذه الأصوات التي ترنو إلى التميز، أبى إلا أن يكون خطابه على غير نموذج، وخاصة من خلال مجموعته الشعرية “ديك الجن”. عمل إبداعي وفضاء شعري يثير عديد الإشكاليات ويدعو إلى البحث والمساءلة الجمالية، لذات مبدعة لها هوية نفسية وتكوين ثقافي، نظرت إلى الواقع والشعر بنظرتها الخاصة، ليلتقي الوعي الفكري والوعي الجمالي في هذا المنجَز عبر أسلوب مغاير ولغة مخصوصة، انطلقت من الواقع محلقة في أبعادها النائية لتشرف على الواقع من جديد. لعله أسلوبه الذي يميزه ولكنه أمر وثيق الصلة بالشعرية باعتبارها “الاعتناء بالخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحدث الأدبي وبيان جمالية النصوص الإبداعية “(1).
قد تكون (الشعرية) من ضروب الغواية في معنى من معانيها وهو الخروج عن المسار المألوف والانقياد إلى رغبة ذاتية في التميز، أضلها شيطان الشعر حتى يرقى ويتفرد، ولعل توظيفنا لمثل هذا المصطلح (الغواية) في سياق مثل هذا من قصيدة النثر في مثل هذه المجموعة الشعرية، مرده الأساسي هذا الانزياح في اختيار الفضاء النصي بكل ما فيه من خروج عن أصول الشعرية العربية، وعما حدده السلف من مقومات قصيدة النثر، وتلك رؤية الشاعر في إحداث نموذج نصي يتجاوز النماذج القديمة، ويخرج عن حدود الرؤية الغربية وتعريبها، بما يلائم الراهن العربي بعموميته. وكذلك من خلال رؤية المبدع للواقع واختياراته الفنية لتشيكل مخصوص يجعله ينشئ صورة لواقع جديد وفق تصوراته الخاصة ومواقفه منه، يخلص منه إلى موضوع لصيق بذلك الواقع وجزء لا يتجزأ منه وهو كتابة الشعر ذاته. فنعيش مع الشاعر لحظاته الإبداعية في مشهدية “ملحمية” يتواشج فيها السرد والوصف ليشكل فضاءً نصيًّا يختلف عن الأفضية العادية إلى إحداث فضاء شعري تغدو فيه القصيدة عالمه الفسيح والمضني الذي يرتاد عبره عوالم الإنسان الأخرى، قد تكون صورة لواقع المبدع العربي في ظل الراهن بكل ملابساته (الإبداعية، الاجتماعية، العاطفية، الفكرية، الفلسفية..) ولكنها موقف من الأدب والحياة. وسنحاول أن نقتحم فضاءه لنكشف عن خباياه ومظاهر الغواية فيه، لعلنا نصل إلى بعض خصوصيات قصيدة النثر في هذه المجموعة.
يتنزل عمل سمير درويش الشعري ضمن مشروع تكاملي اشتغل عليه في أغلب أعماله، فجل دواوينه تكاد ترتبط بفكرة واحدة وهي معاناة الكتابة وتفاصيلها واستدعاءاتها. وهذا من شأنه أن يسيِّر عملية التأويل في مدار قريب يحيط بهذا المشروع الشعري، نحاول اكتناه عالمه معتمدين على ثنائية التحليل والتأويل.
أول مظاهر الغواية ما تعلق بالعتبات النصية في المجموعة، قد يكون الأمر مألوفًا، في الظاهر، لأن هذه العتبات باتت من متعلقات النص الحديث بكل أشكاله وأنواعه، وباعتبارها “على صلة بالنص (..) فهي تستمد حياتها من النص وتعد امتدادًا له”(2). وأبرزها العنوان الخارجي “ديك الجن”، وهو العنوان الوحيد في المجموعة، مخاتل، تجاوز العلاقة المألوفة بينه وبين النص التي تقوم على ثنائية السؤال والجواب إلى علاقة مغايرة هي علاقة سؤال بسؤال آخر “بات يمثل غواية لا تقدم لنا شيئًا بقدر ما تفاجئنا وتفتننا”(3). وأول ما يجول بالخاطر عند مباشرتنا لهذا العنوان الشاعر الحمصي ديك الجن، وهو من شعراء التمرد والرفض لكل ما هو سائد ومألوف. قد لا نجد لذلك صدًى مباشرًا لهذه الشخصية في الديوان، بل لم تذكر في نسيجه الداخلي، ولكننا حين ندرس الديوان تتراءى لنا خصوصية شعر سمير درويش التي تشبه إلى حد كبير أسلوب ديك الجن الشاعر القديم في الكتابة ورغبته في إحداث المختلف والمتفرد المتميز، وكذلك في طبيعة تشكيله للصور الشعرية التي تتراوح ما بين الصور المفردة والصور المركبة، مما يشكل اللوحة المشهدية الكاملة.
وقد لا يستند اختيار العنوان إلى فكرة بعينها، بل غايته المخاتلة وصناعة الدهشة لما في معاني الألفاظ من دلالات تتوارد في المجموعة وتتكرر. ويتكون من مركب إضافي المضاف فيه “ديك” وقد ورد مفردًا أمام المضاف إليه الجمع “الجن” وهو “من جن يجُن جَنًّا: ستره (..) وسمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار”(4). ولكنه قد يتجاوز هذا المعنى إلى معانٍ أخرى توحي بالاكتمال والطول والازهار إذا ما ارتبط بالنبت والزهر والنخل(5). أو بالصبا والشباب في معاني البداية والجدة والنشاط إذا ما أطلق الاسم على مراحل العمر عند الإنسان(6). بهذا قد ترتبط كلمة “الجن” بالحداثة واكتمال المرحلة وازهارها، وهنا قد يحيلنا العنوان على تجربة قصيدة النثر فيكون الديك رمز للشاعر المتفرد الذي يطلق صوته بشجاعة، إيحاءً باليقظة وانبلاج الصباح وانتصار النور على الظلام والجن بحداثة الرؤية وتفردها وكذلك ازدهارها وإزهارها:
أنا الطفلُ الذِي يخافُ منْ خيالِهِ
لا أزعجُ أبناءَ الجَانِّ الذينَ
يرفعونَ أصواتَهُم-أحيانًا- ليعلِنُوا عن وجودِهِمْ
أبناءُ الجنِّ طيبونَ يا أُمِّي.. أُدرِكُ ذلكَ
مثلُ الموسيقيِّ ذي الشعرِ الأبيضِ المُهَوَّشِ
والعجوزِ التي تتفادَى برَكَ الأمطارِ(7)
بهذا لم يعد العنوان يرسم استراتيجية القراءة، فهو لا يقول ولا يحدد ولا يوحي بل يربك ويطرح التساؤل، فيحتاج حينئذ إلى قوة مضادة تقتنص المعنى من خبايا فكر الشاعر يتجلي في أعطاف النص.
إضافة إلى عتبة العنوان الخارجي ينطلق الشاعر من إهداء “إلى الشاعر حلمي سالم.. وإلى سهيل وسيف في البدء والمنتهى”، وهو ما يضعنا أمام تجربة شعرية بامتياز وذلك لهوية المهدى إليه وما يتراءى من قيمة في ذات الشاعر “الذي كان يقول للشعر كن.. فيكون”، وهو إهداء لا يخلو من انفعال ارتبط أساسًا بنوع من التمجيد الذي يحمل الكثير من المغالاة والتقديس. إضافة إلى مُهدى آخر: “سهيل وسيف في البدء والمنتهى”، قد يمثلان ذات الشاعر وإنيته مقابل الآخر، وهو الطرف المقابل للرؤية الشعرية، ويتحول الشاعر فيها إلى جزء من التعدد الذي يشكل الحاضر، وتغدو رؤيته تصورًا للشعر والشعرية وهو ما يؤكده في التصدير:
نسخة مني
تداعب السحابَ
وبفرحٍ تحملُ العصافيرَ
وتنقُلُ حبوبَ اللقاحِ
لتُقبلَ الأزهارَ في شفاهها
مدعية أنها الهواء..
ونسخةً أخرى
تجلسُ في هدوءٍ
على شفتيها ابتسامةُ الحكمةِ
توزعها على عابرين لا تعرفهم
وفي يقينها أنها تمنحهم سببًا للوجودِ..
وتسعى لاستقطارِ الحياة
في قصيدة(8)
مثل هذا التصدير الذي عده جيرار جينيت (Gérard Genette) “حركة صامتة تحتاج إلى كفاءة القارئ”(9)، يخرج عن مقاصده هو جزء من الغواية وذلك أنه لم يضطلع بوظيفة التعليق على العنوان أو المتن بشرحهما وتوضيح معانيهما، بل اتجهت الوظيفة إلى صاحب التصدير وأهميته عند الشاعر، فهو على صلة برؤية شعرية تكشف عن دور الذاكرة في تفعيل أصوات النص الداخلية. قد يدفعنا الأمر إلى التفكير في جوهر العلاقة بين العتبات والنص، ولعل الشعر هو الواصل بين هذه العناصر، فيكون التتابع والانصهار بين تجربة سابقة وأخرى لاحقة، بين “نسخة مني” في مقول عادل سميح، و”تلك قصيدتي لا يكتبها الفراغُ” لسمير درويش. وهذا التتابع لا يخص علاقة العتبات النصية ببعضها البعض، وإنما يتعلق أيضًا بالنصوص الداخلية التي غابت فيها العناوين فتظهر هذه النصوص عارية (textes nus) دون دعم يحيط بها ويمثل امتدادًا لها. قد يكون هذا الغياب نتيجة وعي الشاعر بأن النص هو إعادة إنتاج للعنوان. وهي لعبته في التجريب. وتعويضها بالتواريخ يجعلها أشبه بنص مفتوح قريب من المذكرات في بعض خصائصه مع تقنية الحذف هذه نتجاوز البحث في وظائف حضور العنوان إلى وظائف غيابه، وهو ما يضعنا أمام رؤية الشاعر والوظيفة الإجرائية التي يمارسها (Fonction séductive) تقترن بالوظيفة الإيحائية، وهذا من شأنه أن يدفع القارئ إلى إحداث العناوين الفرضية (Thematiques) التي يستجليها من مضامين النصوص، فتستنطق الغائب وتكشف الخفي. وهو ما يفتح على البعد التواصلي الذي يرتبط بحضور طرفيْ الخطاب، فإذا كان المرسل هو في الأغلب الشاعر باعتباره المسؤول الأول عن النص، فإن المرسل إليه هو قارئ يمكن أن يكون المتقبل العادي والمتذوق للنص، ويمكن أن يكون القارئ الفعلي الذي يبحث في ميتافيزيقا النص.
وهذا القارئ قد يكون الشاعر نفسه المتقبل الأول للخطاب، فلا يحتاج إلى العناوين الحاضرة فعليًّا، فيجعل من عراء النص غطاء للتأويل، وتغدو مثل هذه النصوص العارية انثيالات عاطفية ومواقف فكرية لرؤى فنية، يبعث من خلالها تصوُّرًا مخصوصًا لقصيدة النثر يندرج ضمن إطار التجريب الذي ندركه من خلال جملة من القرائن النصية على كامل المجموعة الشعرية، كأن يتكرر لفظ “القصيدة” في المتن الشعري (78 مرة) كما يتكرر ما يحيل على هذا المعنى (الشعر/ الشاعر/ الشعراء/ كراس أشعاري/ الصور الشعرية/ الكتابة/ بلاغة تقليدية/ مجازًا ثقيلًا..(33 مرة)/ (ديوان/ رومانتيكيًّا/ مساءلة النص/ إعادة صياغته..) وهو ما يولد رؤية للشعر تجعلها مدار القول في كامل المجموعة الشعرية.
ولعل أبرز مظاهر هذه الرؤية التخلي عن العناوين الداخلية، وهذا ما يجعلها بمثابة قصيدة واحدة يجمعها الموضوع الواحد، وهو الشعر ومعاناة القصيدة. ذات بنية مقطعية رغم الحدود الفاصلة بين النصوص التي بدت حدودًا تاريخيَّة يحكمها التأريخ والتوثيق لكل نص (من 21/ 05/ 2020 إلى 31/ 05/ 2021)، وكأنه بذلك يؤرخ لفترة مخاض متقاربة أنتجت دفقة شعرية وشعورية مدارها القصيدة ومجالات الكتابة، بما فيها من تداعيات وتفاصيل ترافق اللحظة الإبداعية، وهو ما يجعلنا نستجلي مقاصد الشاعر التي تركزت أساسًا على معاناة الشعر باعتباره الشاغل الرئيسي للديوان.
بهذا تتحول المجموعة الشعرية في كليتها من التشتت إلى الوحدة، ولكنه مع ذلك يخضع لظاهرة البياض والسواد، فأغلب المقاطع ذات بنية سباعية أو ثمانية وأحيانًا تتراجع إلى سطرين وأحايين أخرى تصل إلى 12 أو 15 سطرًا، وهذا يختلف حسب رغبة الشاعر وقدرته على إخراج طاقة كلامية، فتتراوح هذه النصوص بين ضيق مساحة التعبير وشساعته وفقًا لطبيعة التجربة التي يخوضها مع الكتابة. وهو ما ينطبق على المستوى الأفقي أيضًا، وذلك حين يطول النفس الشعري أو يقصر، تغدو معه القصيدة فضاء للنفس وانفعالاتها لحظة التلفظ. فنجد أسطرًا شعرية يغزوها البياض فتكون في درجة صفر من الكتابة، مقابل أسطر يتدفق فيها الكلام وتتكثف اللغة والسواد فيتحول إلى ذلك “الخزان الحاوي لكل الأشياء والحياة”(10) تعكس حياة مشوشة بالاكتظاظ والفوضى:
الشوارعُ مكتظَّةٌ كعادَتِهَا: السياراتُ متلاصقةٌ، أعمدةُ الإنارةِ مطفأةٌ وتشغِلُ الأرصفةَ، بجوارِ أكياسِ الشيبسي وثلاجاتِ الصودَا، والترابُ يتكوَّمُ بإخلاصٍ.. ويتمدَّدُ، الضوضاءُ، الشحَّاذُونَ المتجوِّلُونَ، ماكيناتُ الصرافَةِ التي يصطَفُّ الفقراءُ أماَمَها كطوابِيرِ الجُنْدِ، باعةُ الياميشِ وبالُونَاتِ العيدْ!(11)
هذا المقطع وغيره من نصوص المجموعة يجعلنا نلحظ اهتمام الشاعر بتفضئة النص (Spatialisation)، ولعلها خاصية مميزة وثيقة الصلة بالنظرة السيميائية التي تميز القصيدة الحديثة عن الشكل الشعري القديم وطريقة الإخراج التي تشكل الدال البصري، فمن الصعب إغفال هذا الجانب خصوصًا وأننا أمام قصيدة النثر التي “تُعرض على الصفحة على هيئة النثر، وإن كانت لا تعد كذلك”(12)، وهذا ما يعطي أهمية للشكل توازي أهمية المضمون. وهو ما يجعله يحيد عن الجمالي الشعري في سبيل الفكرة والهاجس، يخرج معه المعنى من ارتباطه بالقصيدة والشعراء إلى وصف المكان وصفًا أقرب إلى القص، ولعله الوجه الآخر للشعور بالفوضى في واقع مترهل:
لا يجدُ حبيبانِ فراغًا يناسِبُ شوقَهُمَا
(..)
يرتِّقُ الفراغَ الشَّاسِعَ
الذِي ينتظِرُ فرصةً مواتِيَةْ!(13)
يكشف الفضاء النصي عن صورة للمكان تعبر بدورها عن فضاء نفسي يشعر فيه الشاعر بالغربة والفراغ، وتغدو معه القصيدة ذلك الفضاء الذي يحتضنه ويؤطره، صوت خفي من خلال هذه المشهدية يرتبط بوظيفة حقيقية للشعر تتجاوز المنابر المغلقة والعالية لتلامس الواقع وتنفتح عليه بكل تناقضاته. يرصد مظاهر المعيش اليومي ليس رغبة في الوصف بل تأكيدًا على علاقة ذلك بالشعر عامة وبقصيدة النثر خاصة، فالقصيدة ينبغي أن تتغذى من البيئة التي تمنحها دهشتها ولغتها. هي الحبيبة أو الحبيبة هي، القصيدة بكل ما تحمله من هواجس ومشاعر وكذلك المواقف والأفكار:
كفَّا حبيبتِي أبيضانِ كالعاجِ
(..)
تعرفانِ أنَّنِي أريدُ مداهمةَ المساحاتِ الفارغةَ
في روحِهَا
كنمرٍ وجدَ فريسَتَهُ
لكنَّهَا تعرفُ أكثرَ.. أيضًا
أنَّ الشعراءَ المتلصِّصِينَ يتراصُّونَ بتفانٍ
على أرصفةِ المقاهِي(14)
قد تخرج المقاهي في هذا السياق عن دلالتها الأصلية وهي كونها إطارًا مكانيًّا للتجمع وهو المحل، إلى الحال ومعنى القهوة في رمزيتها التي قد تفتح على الانتشاء والتخدير، فالشاعر المتلصص إنما هو صورة للشاعر الذي يطل على واقعه من برجه العاجي، دون أن يعبر عن مشكلات الواقع ويكشف عن ترهلاته وآلام الإنسان فيه ومعاناته، ويسهم في إصلاحه وتغييره. لعله موقف من القصيدة الرومنطيقية، قصيدة الأنبياء المغرورين الذين يتأبدون المطلق والوهم وينزوون بعيدًا عن الواقع ومشكلاته:
أنا الشاعرُ الذي دهسَ ستينَ عامًا
قبلَ أنْ تصفُو روحُهُ كالأنبياءِ المغرورينَ
كأبناءِ السبيلِ
الذينَ لا يحتاجُونَ سوَى لذَّةٍ محرَّمَةٍ
وفاكهةٍ تنبُتُ على حوافِّ الأسرَّةِ(15)
صورة تنطوي على أبرز مظاهر التفكير الرومنطيقي (النبوة في الشعر، الجنة الضائعة، الفاكهة التي تنبت على الأسرة، الحنين..) إنه عالم الفردوس والمثل العليا ولكنها مثل مسروقة من أرض الواقع وفي عيون المحافظين الجدد الذين يتربصون للقصيدة الحديثة، أوصياء على الشعر:
سأرمِي قصيدةً على الرصيفِ بإهمالٍ؛
بجوارِ البضائِعِ الرخيصةِ وأكياسِ الشيبسِي
(..)
قصيدةٌ فارغةٌ عنِ التُّرابِ
والقبلاتِ التي يتبادَلُهَا المراهقُونَ على الكورنيش
القبلاتُ التي يسرقُونَهَا من كاميراتِ المراقبَةِ
والمحافظينَ الجُدُدِ
ودورياتِ الشرطيينَ السرِّيينَ(16)
ويعلن ذلك صراحة:
لا ضيرَ أنْ تكونَ رومانتيكيًّا كقصيدةٍ قديمةٍ
كشاعرٍ مُنعزلٍ في شقَّةٍ مغلقةٍ
(..)
لكنَّكَ كرومانتيكيٍّ عتيدٍ
لنْ تعترفَ أنَّ دماءَ القصائِدِ أُريقتْ على فحذيْكَ
(..)
إنِّي لمْ أكنْ رومانتيكيًّا قطْ!(17)
ويقدم رؤيته الذاتية في محاولة لإبراز علاقة الشاعر بالقصيدة، ومن ثم يؤكد على الوظيفة الحقيقية للشعر، وهي ملامسة الواقع ومباشرته، والشاعر الحقيقي هو الذي يترجم أحاسيسه ومشاعره انطلاقًا مما يعايشه ويحياه، فمشكلات الواقع المعاصر أعمق وأعنف من أن يعرض عن آلام أفراده وأوجاعهم. وقد عبر في أكثر من موقع في هذه المجموعة عن صورة مأزومة يعرضها أحيانًا صراحةً وأحيانًا أخرى يوردها عبر التلميح من ذلك “صورة العجوز التي تتفادى بَرَك الأمطار/ “فيرونيكا” التي ماتت قبل الوباء/ الدماء التي تفترش خريطة الشرق (ص14)/ صورة الأحرار الذين يذهبون إلى وظائف تافهة يوميًّا (48)/ والأطفال الذين يمرحون في عتمة دائمة (ص69)”.
صورة للشعر المعبر عن شواغل الذات وهواجسها، مفارقة للقصيدة المحلقة في فضاءاتها البعيدة التي ترتفع عن رغبات الإنسان إلى عالم وهمي بديل، بهذا قد تكون قصيدة النثر ذلك الخطاب المضاد الذي يستهدف الشعرية الغربية في اطمئنانها وبعدها عن الواقع العربي بكل تناقضاته. ولعله من ضروب التأسيس لقصيدة نثر عربية قادرة على استيعاب هموم الذات والمجموعة، وعصف بقناعات رواد قصيدة الحداثة بكل أشكالها بداية من الرومنطيقية وابتعادها عن مشاكل الإنسان المعاصر إلى قصيدة النثر وما شهدته من سفر في واقع غريب عن الواقع العربي. وقد وجدنا صدى فلسفة ذاتية في هذه المجموعة وهي أساسًا رؤية فردانية من حيث الموضوعات التي تتناولها، وكذلك من حيث طرائق التعبير والتصوير. هي قصيدة المعاناة والعقل يعيها الشاعر “زمن النشاط الكوني”. وهذا ما جعله يجرب قواعد مغايرة لقصيدة النثر العربية التي تجعل من المبدع ذلك المستقل بذاته، يشكل الشعر وفق رؤيته الخاصة، ويوجد قواعده انطلاقًا مما يراه مناسبًا وقادرًا على استيعاب مشكلات الواقع وهواجسه فيه. وهو أمر جعلنا نقف في هذه المجموعة عند جملة من الموضوعات التي عرضها في محاولة تعريف القصيدة، فيطرح جملة من القضايا المتعلقة بها ومنها مشكلة قصيدة النثر ليست من أين أتت وما مرجعياتها. فقد تكون “قصيدة التاسعة صباحًا” تخرج مع الخارجين لمواجهة الحياة بكل حالاتها ومشاغلها:
قصيدةُ التاسعَةِ لا تحتاجُ لغةً
لا تحتاجُ بلاغةً تقليديَّةً أو مجازًا ثقيلًا
تحتاجُ امرأةً بيضاءَ مسكونةً بالجنِّ
وترتيلًا كنسيًّا
وشبابيكَ مغلقةً أمامَ العيونِ، ونشاطًا بيولوجيًّا.(18)
وقد تكون ابنة ليل:
تجمَعُ أشياءَهَا من نهارِ الشوارعِ والميادينَ
من أشجارِ الزينةِ علَى الأرصفَةِ
ومنْ واجهاتِ المحلَّاتِ(19)
هي أكثر من ذلك:
القصيدةُ أخاديدُ في القولُونِ الهائِجِ
القصيدةُ دمٌ قانٍ يتجدَّدُ على سجادةِ الطُّرقَةِ
القصيدةُ يدُ طبيبةِ التخديرِ
ابتسامةُ طبيبِ القلبِ من خلفِ جدارٍ
هواءٌ يتصاعَدُ من أفواهِ المحرومينَ
السائرينَ في الأسواقِ بلا هُدَى
القصيدةُ سيَّارةٌ طائشةٌ تدهسُ الهوَى المُتصاعِدَ
القصيدةُ نظرةُ مشتاقٍ لمشتاقةٍ
وبحرٌ من الأجسادِ المتلاصقةْ!(20)
هي كل ذلك، ولكنها لا تتلون بلون، تقتلها القواعد وتنهكها القوالب، إنها “الفوضى الوحيدة ضد قيود الأنظمة”، بهذا فالأهم من كل ذلك كيف تشكلت؟ وكيف يمكن أن تعبر عن ذاتها بما أوتيت من صفو اللغة وبلاغة التعبير ورونق التصوير؟ وكيف يمكن أن تدرك جوهر شعريتها؟ لعلنا نجد بعض الإجوبة عن هذه الأسئلة من خلال مجموعة الشاعر، تختزل رؤيته في ما أبداه من تجريب في مستويات متعددة من التشكيل الفني.
وأول مظاهر ذلك ما ارتبط بغياب العنونة الداخلية كما سبق وذكرنا في بداية هذا العمل، وهذا الغياب أفرز نصًّا طويلًا مفتوحًا، عزز هذه الخصيصة طبيعة الموضوع الذي يكاد يكون موحدًا، فتتشكل النصوص وفق نظام أقرب إلى بناء تتابعي يلجأ من خلاله الشاعر إلى رسم لوحات متلاحقة من شأنها أن تحيط بأبعاد القصيدة ومعانيها كاملة، مما يعطي تجسيدًا حيًّا للمعنى الذي يقصده الشاعر (مفهومها، استقلاليتها، مكانتها، علاقتها بالأشكال السابقة، مظاهر التعبير فيها..) يحكمها بناء يقوم على أساس مشهدية فنية تقترب من مفهوم اللقطة السينمائية. وتغدو بذلك نصوص المجموعة لقطات تعبيرية صامتة وصاخبة في ذات الآن، تستبطن ما هو غامض ومستتر في النفس، يدعم المحتوى الدرامي الذي تنطوي عليه في هذا الجمع بين النسق الوصفي والنسق التعبيري الذي يغذي الحدث ويمده بأسباب الحياة وخاصة عند تجليات الـ”أنا الشاعرة” وحضور الـ”أنا الظاهرة” بوصفها مركز العملية الشعرية. هنا يظهر حجم اللقطة في ارتباطها بحركة عين الكاميرا التي يمسك بها الشاعر يمكننا أن نميز فيها بين ما هو تعبيري وما هو تجريدي وكذلك ما هو وصفي، بذلك فلقطة الشاعر هي الزاوية التي يقرر فيها المخرج وجود الكاميرا:
النَّاجُونَ من الموتِ أربعةٌ:
العصَافيرُ التي كانتْ تزقزِقُ بغزارةٍ وقتَ الظلامِ
ووقتَ تفتُّحِ الضوءِ
قبلَ أنْ يقطعُوا الشجرةَ الكبيرةَ بجوارِ نافذتِي
الموسيقَا التي تتردَّدُ في سقفِ ذاكرتِي
وأنا أتهيَّأُ للنومِ وحيدًا(21)
تتشكل اللقطة بتركيز الاهتمام على جملة من العناصر الجزئية المكونة للمشهد، وهي صورة العصافير التي تزقزق بغزارة، صورة الشجرة الكبيرة المهيأة للقطع، أصوات الموسيقا، الاستعداد للنوم وهو الحدث الأبرز في هذه المشهدية تعاضده موسيقا تصويرية تلازم المشهد تجعل منه ملحمة كونية تحيلنا على نوع من التشكيل السردي يبرز جملة من المفارقات (الظلام/ الضوء- زقزقة العصافير/ قطع الشجرة. كل ذلك في ظل ثنائية الحياة والموت/ البداية والنهاية. ثم يتحول في مشهدية ثانية يحول عين الكاميرا نحو الموضوع المركز وهو “القصيدة”:
القصيدةُ قُبلة ٌعلى جبينِ الحزانَى
أولئكَ وهؤلاءِ الذينَ يتوزَّعُونَ في تفاصيلِ يومِي
يعضُّونَ أنامِلِي
ويكتُبُونَ عرائضَهُمْ علَى حوائطِ الشقَّةِ
وينفجرُونَ -أحيانًا- كالعُشَّاقِ
وأبناءِ السبيلْ!(22)
وفي ظل هذا التحول يبحث القارئ عن الانسجام الذي يختفي وراء هذا التشتت للعناصر المكونة للمشهد. يتشكل فضاء ديناميكي يؤكد ذلك البعد الحركي والتعاقبي. قد يكون تجاوزًا للقاعدة ومظهرًا آخر للغواية ولكنه الإبداع والتفرد وكذلك الرغبة في التجريد سمة الشعر الحديث، ولعلنا نستحضر قولة بيكاسو الشهيرة “اتق القواعد كمحترف حتى تتمكن من كسرها كفنان”، ودرويش حاول كسر هذه القواعد في مغامرة خاضها وقف فيها على شفا النثر بهذه المخاطرة في تشكيل نصوصه عبر لغة شعرية تجاوزت ما استقر من أعراف لغوية وتقاليد شعرية، ليوظف أسلوبه المخصوص في نبرة متفردة، فالشاعر ما فتئ يبحث عن لغة تعبيرية جديدة يستوحيها من اليومي والواقعي، ولكنه ينشئها في فضاء مخصوص من التعبير، حيث تصبح كل قصيدة جديدة ولادة جديدة للغة في أنساقها وعلاقاتها الأيقونية. والملاحظ إقامة هذه اللغة على أساس الاسترجاع الذي يؤصل الحدث الشعري ضمن أبعاده الدرامية والتعبيرية، ولكنه يستحضرها بشكل تلقائي مما يجعلها في غالب الأحيان أقرب إلى الاستطراد والتداعي الحر للأفكار، يشكل من خلالها تراكمية مدهشة تحكمها طاقة الحواس والشعور، يجعله ينقل النص من فاعلية القص والحكاية إلى فضاء التشكيل الشعري بإيقاع جلي بدا حاضرًا بكثافة في المجموعة. وهو أمر يجعله يبني قوله الخاص في عالم فاجع، وهو ما يؤسس لـ”بلاغة العدول” حيث ينزاح الشاعر عن كل نظم النص الإيقاعية والنحوية والدلالية المألوفة ليقيم طرائق في إجراء القول جديدة، وهذا العدول ليس عملًا خاليًا من المعنى وإنما هو المخرج الذي لا ينال بغيره، ووسيلة إدراك ما لا يستطاع التعبير عنه بغيره، قد تكون محاولة شاعر من شعراء قصيدة النثر في إحداث المختلف والتأكيد على اللاقاعدة في الشعر تجاوزت صورة البيان الشعري في النقد إلى محاولة تأسيس جديدة. هنا بكل ما رأيناه في هذه المجموعة من مظاهر إبداع وغواية في الاختيارات الفنية وما ارتبط بذلك من مغامرة في الكتابة الشعرية قد نتساءل تساؤلًا نراه مشروعًا: هل الطاقة الشعرية موجودة في القصيدة وما يشكله الشاعر فيها أم القصيدة في طاقات اللغة التي يقتنصها القارئ من أشكال أخرى يتمثلها في ذهنه؟ الإجابة عن مثل هذا السؤال قد تعطي مشروعية أكثر لقصيدة النثر في علاقتها بالشعرية الحديثة.
…………………………
* باحثة وناقدة، كلية 9 أفريل تونس.
1- تزفيتان تودوروف، الشعرية، ترجمة شكري مبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال، المغرب، 1987، ص6.
2- رضا بن حميد، عتبات النص في حدث أبو هريرة قال، مجلة الخطاب، العدد18، ص15.
3- شعيب خليفي، هوية العلامات، دار الثقافة، الدار البيضاء، 2005، ص20.
4- ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، ط1، 2000، المجلد الخامس، ص217.
5- المصدر نفسه، ص220.
6- أنظر نفس الصفحة.
7- سمير درويش، ديك الجن، ص47.
8- عادل سميح، ديوان “عزيزي الكونت دراكولا”، دار ميريت للنشر، 2015.
9- Gérard Genette، Figures II، Paris، Ed. du Seuil، 1972، p145.
10- رضا بن حميد، الخطاب الشعري الحديث: من اللغوي إلى التشكل البصري، مجلة الحياة الثقافية، عدد مزدوج 69/70، 1995، ص16. عن:
Jean Chevalier، Alain Gheerbant: Dictionnaire des symboles، simbole Noir، Ed. Robert LafondL Jupitier، Paris، 1982، p 671.
11- سمير درويش، ديك الجن، دار ميريت للنشر، القاهرة، مصر، ط1، 2021، ص65.
12- Princeton Encyclopedia of poetry and poetics، enlarged ed، Princeton university press، 1974، p 664.
13- سمير درويش، ديك الجن، ص65.
14- سمير درويش، ديك الجن، ص63.
15- المصدر نفسه، ص29.
16- المصدر نفسه، ص30.
17- سمير درويش، ديك الجن، ص 32- 33.
18- سمير درويش، ديك الجن، ص11.
19- المصدر نفسه، ص29.
20- م، ن، ص58.
21- سمير درويش، ديك الجن، ص25.
22- المصدر نفسه، ص25.