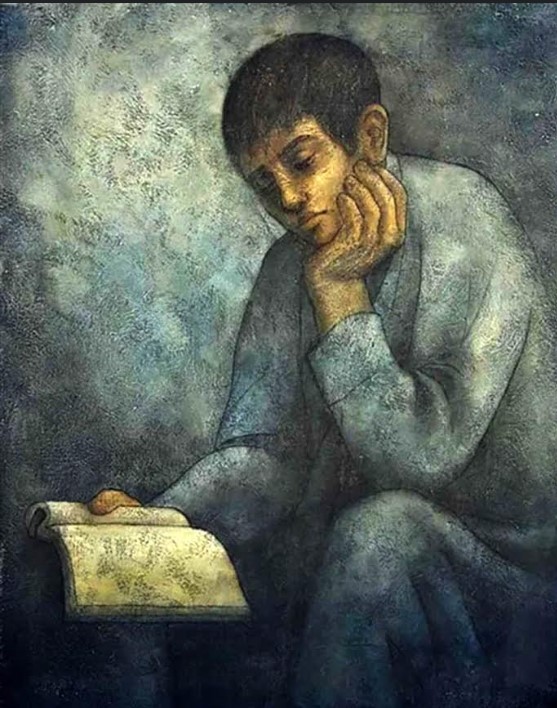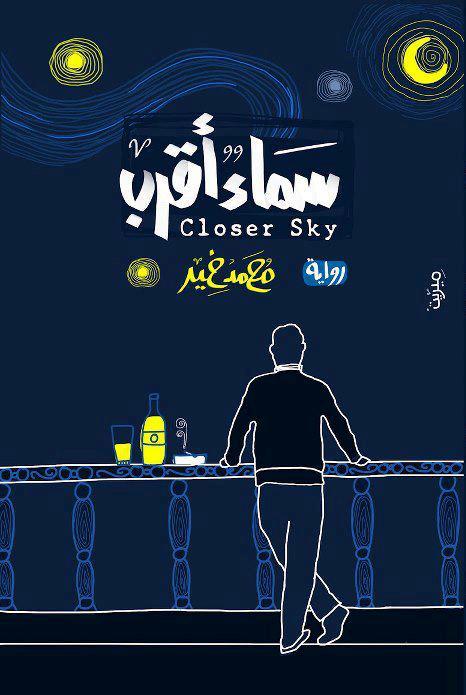رجب سعد السيد
يقعُ المُجمَّع السكني للعاملين في جامعة الخليج العربي، بالمنامة، في منطقة (الصخير) الصحراوية، غرب مملكة البحرين، حيث أقمت خلال فترة عملي بالجامعة.
وكان مسكني عبارة عن بيت مخصص لعائلة، وأنا لم أصطحب عائلتي.. وكان الطابق الأرضي يضم قاعة استقبال رئيسية، لها باب زجاجي، يطل على ممشى خارجي، تسهل من خلاله مراقبة الحركة الخارجية. وكان يحلو لي الجلوس قرب هذا الباب، كأنني بانتظار زائرين، مكتفياً بالإنصات إلى أصوات محركات السيارات التي يتصادف مرورها قرب بيتي، وكنت ألاحظها، بل أرحب بها، لندرتها، ولأن بها بشراً. أما أعذب الأصوات، فكانت لطيور لم أرها على الإطلاق، لأنها ليليات. وكانت قبل مجيئ ديسمبر تتجمع بعد غروب الشمس، لتبدأ معزوفاتها المتداخلة، وهو ما استنتجتُ منه أنها تنتمي لأكثر من نوع، لكل منها صدحاته وزقزقاته الخاصة. كانت تشكل جوقة عبقرية، كأنها تدربت على تلك المعزوفات سنوات طويلة.
ودفعني الأرق، ذات ليلة، إلى مغادرة فراشي، وظللتُ أدور في البيت المتسع حتى نال الإجهادُ مني، فألقيتُ بجسمي على طرف كنبة، هي أقرب قطع أثاث القاعة الرئيسية إلى الباب الزجاجي المطل على خارج البيت. ولم ألبثُ أن سمعتُ
سمعتُ أصواتاً أقرب إلى الاحتكاك بالزجاج منها إلى محاولة اقتحام الباب، فالتفتُّ باتجاه الصوت، فهالني ما رأيتُ!
كانت تقف خلف زجاج الباب، تنظر إليَّ بعينيها الواسعتين المكحولتين الأخَّاذتين، كأنها تعرفني!.
إستوعبتُ الموقف بسرعة فائقة. وكانت هي – الغزالة الصغيرة – مستمرة في النظر إليَّ، فلم أملك إلاَّ أن أبتسم، فاستجابت لابتسامتي، وكفَّت عن (خربشة) الزجاج!
وتحامقتُ، فقمتُ أقصدها، وأفتح لها الباب، علَّها تدخل، فجفلتْ، واختفت في عتمة الخارج. جلستُ أنتظرها، أملاً في أن تعود، فطال انتظاري.
غير أن زيارتها التالية فاجأتني بعد أسبوع. ووجدتُني أتقدم باتجاه الباب الزجاجي منحنياً، محاولاً إظهار المودة بكل السبل، بل لقد كنت أرحب بها مبتسماً، هامساً: أهلاً .. أهلاً .. أهلاً!. وتوقفت تماماً عندما أحسستُ بها تتقلقل. وجلستُ أمامها أتأملها وقد غادرها التقلقل واستقرت، يلامس بوزُها زجاج الباب. ففكرتُ في أنها قد تكون جوعانة أو عطشانة. وراجعت ما أختزنه من طعام قد يكون مناسباً لهذه العاشبة الرقيقة، فلم أجد. فقلت: إعطها ماءً .. قد تكون بحاجة له.
وانسحبتُ بخفة، متراجعاً إلى المطبخ، حيث صببتُ قدراً من الماء في آنية مسطحة؛ وعدتُ إليها وأنا أمد يدي بالآنية، حاسباً أنها ستقبل أن أفتح الباب ليكون الماء بمتناولها. فما إن فعلتُ حتى وجدتُها تفر مختفيةً. خاب مسعاي، لكنني استجبت لفكرة أن أضع الآنية بالخارج، وأغلق الباب، فربما تجد في ذلك إشارة أمان. وقد نجحت الفكرة. فقد جلست أنتظر عودتها، فعادت، وتفحصت ما حولها، وتشممت الماء، ولم تلبث أن راحت ترتشفه بإقبال يدل على ما بها من عطش.
وعند المغرب، في اليوم التالي، كانت (مائدة الغزالة) مُعدَّة: طبقٌ كبير من الورق المُقوَّى، مفروش بسيقان وأوراق الجزر، مع أعواد من الخسِّ، توزعت فوقها شرائحٌ من الجزر الأصفر والخيار. وتركتُ الطبق، مع إناء الماء، أمام الباب الزجاجي مباشرةً، وجلستُ أنتظرُ ضيفتي العزيزة.
لم تخيِّب ظني، فقد رأيتها تتقدم متمهلة محاذرة، غير أنها ما إن لمحت الطعام إندفعت إليه، وأدهشني أنها بدأت بأوراق الجزر والخس، غير ملتفتةً إلى شرائحهما، حتى أتت عليها تماماً. واستدارت، واختفت في الظلام للحظات، ثم وجدتُها تعود وتشرب كثيرا من الماء. ورفعت رأسها، وتهيأ لي أنني وجدتُ في نظرة عينيها ما اخترتُ أن أحسبه شكراً. واستدارت ثانية لتغيب في الظلام.
وعند مغادرتها في آخر لقاء لي بها، لمحت ما حسبته عصبة من الكلاب البرية الشرسة، تنطلق مطاردة غزالتي. ولم يكن بيدي أن أفعل شيئاً إزاء هذه المداهمة المتوحشة، فعدتُ إلى مجلسي وأنا كلي أمل أن تنجح غزالتي في الإفلات من الكلاب، لتعود لقاءاتنا الجميلة. غير أن غيابها طال كثيراً . . حتى الآن!