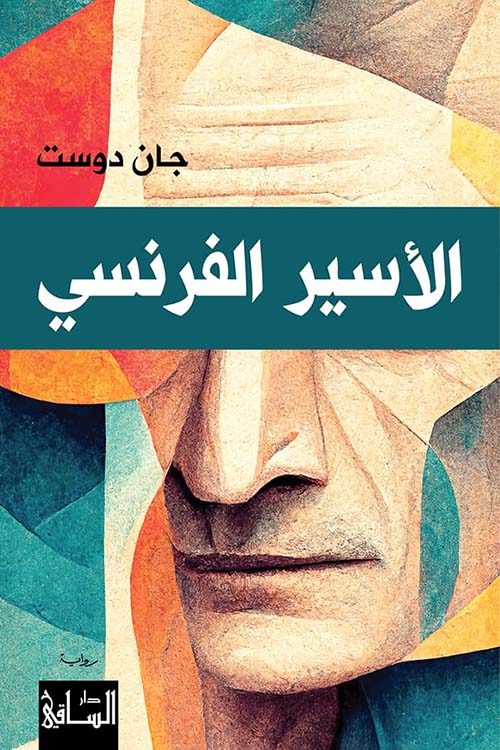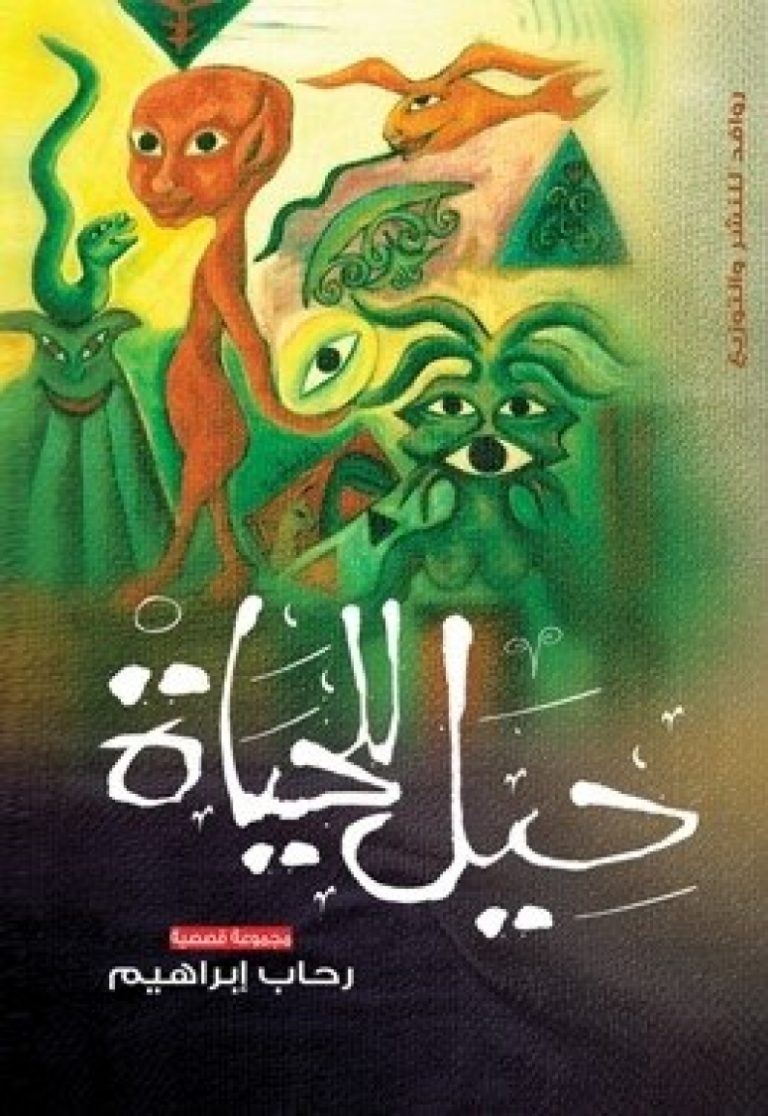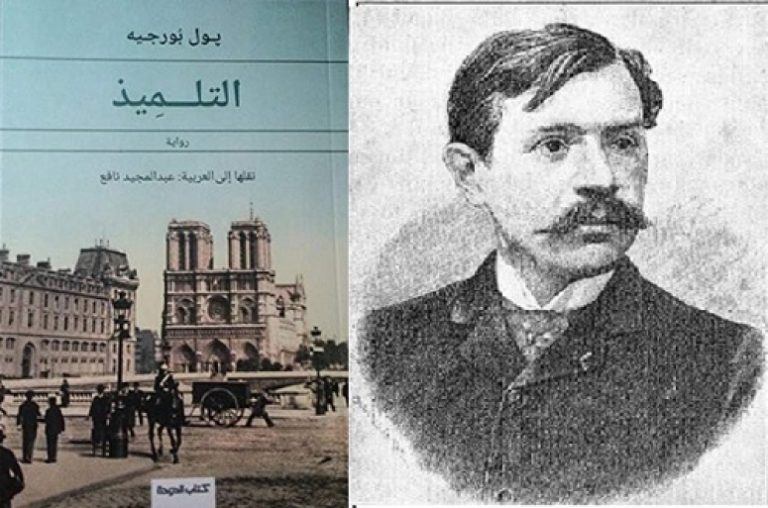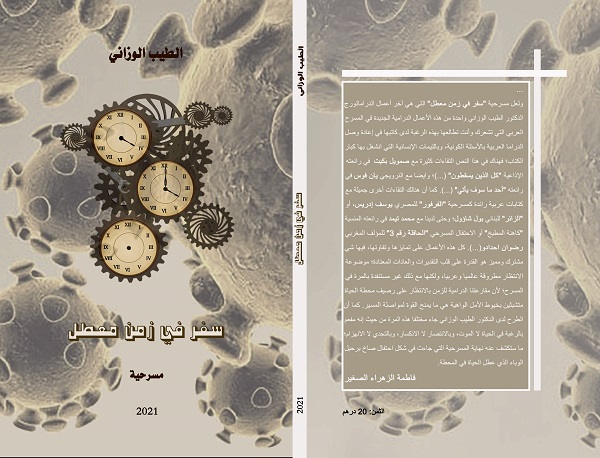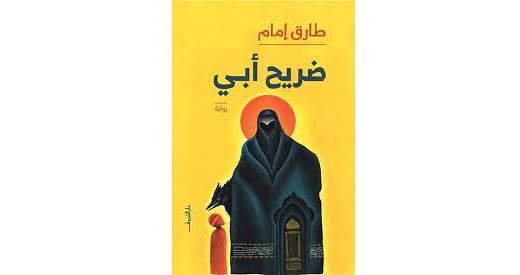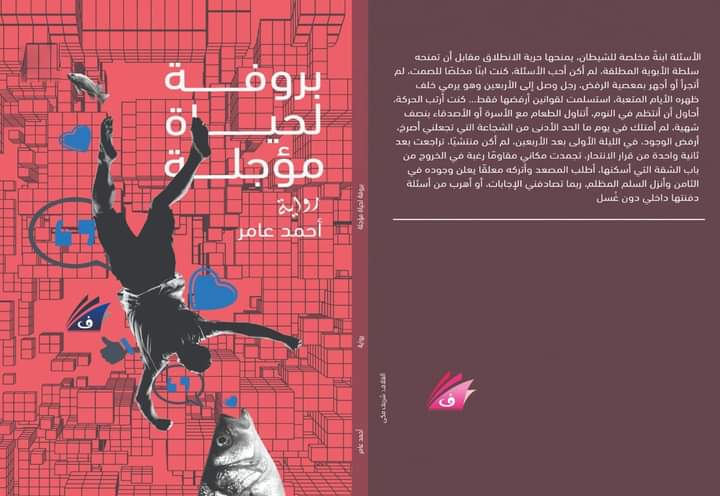«وفي محيط الخواء
توجد أسماء وأسماء وأسماء
وفي محيط التيه
توجد أسماء
من يجيب على دفقة الروح هذه
التي تناديهم؟
تَمَوج من أسماء وأسماء وأسماء
ما الذي يفصلهم عن الموت العظيم
في أحضان من كانوا؟»
هكذا في مُستهل روايته يُحيلنا صاحب العمل الأرجنتيني فيديريكو جانمير لأبيات شقيقه في الوطن خوان خيلمان، وبين عنوان الرواية التي تدعو لاختبار خِفة تفوق الهواء واستهلالها بهذه القصيدة بجَرس موسيقي يعززه تكرار لفظة أسماء -ونظريتها في لغة النص الأم بالطبع- ربما نتوقع من الروائي جانمير فراغات ما في السرد رغم تعدد الحكايات والشروح، وكذلك تسوقنا لتتبع حيرة ما تتمثل في أسئلة الذات الشاعرة التي ربما تتقاطع بصورة ما مع الذات الساردة في متن الرواية في تطلُّع ما للخلاص، فقد يجمع الحنين أصحابه بمن أحبوا وحاضنوا.
وبنظرة سريعة على غلاف العمل -مع قراءة النبذة المختصرة على الغلاف الخلفي- قبل الشروع في قراءته سواء في نسخته العربية (عن دار مسعى للنشر والتوزيع) أو للغلافين الآخريين للعمل في لغته الأصلية نجد أن ثلاثتهم يشتركون في تيمات محددة: سيدة تبدو كدُمية عجوز تجلس على كرسي، ونسيج تحيكه المرأة ويشغل النصف العلوي من الغلاف (في النسخ العربية) ومنتصف الغلاف (في إحدى النُسخ الإسبانية) بلون يميل للزُرقة التي قد توحي بالعُزلة والوحدة في أحد دلالاته، هذا النسيج المغزول يشف ما تحته ولمساحة تزيد عن ثلثي الغلاف بنسيج من الصوف الأحمر القاني (في النسخة الإسبانية الثالثة) ويعد اللون أحد الألوان الساخنة وأقدمها والذي قد يعبر عن مأساة وإثارة، وفراغ يحيط بالسيدة الوحيدة مع غزلها. هل يمكن أن يقرأ الغلاف هنا على أن غَزْل هذه المرأة يمثل صبرها على الوحدة؟ هل يمكن أن يكون بديلا عن الحديث الذي استمرت في سرده طوال الرواية والذي يزيد في زمنه عن سنوات عمرها ال93؟ هل أحببت أكثر الأغلفة الفاتحة لونها التي ربما تسر الناظرين أم توحدت أكثر مع الغلاف صاحب النسيج الدموي؟ هل ستغير رأيك بعد قراءة الرواية أو هذه السطورعنها أم ستظل متعلقا بنظرتك الأولى؟
من هذا المُنطَلق يمكننا تتبع راوية العجوز عبر المونولوج الطويل على مدار أربعة أيام هي زمن الرواية والتي أرَّخها في مبتدأ كل فصل/يوم (من الخميس 19 نوفمبر إلى الأحد 2 ديسمبر).
فبضمير الأنا تقُص المُعلِّمة المتقاعدة على مُخَاطب بائس أبرز القصص التي شكلت وعيها واستدعتها ذاكرتها حال حبس هذا المراهق المُحتجز بين يديها لسوء طالعه. ما أثقل علىَّ قرائتي للرواية – رغم تكريس عنوانها للخِفة – هو هذا الاحتجاز أوالإقامة الجبرية التي فرضتها علينا -مع الصبي سانتي- هذه المرأة طوال السرد. نسمع ردود اللص المُراهق على لسانها ووصفها لما مرت به في أيامها، ليس هذا فقط بل أيضا حكيها عن أمها والحادثة التي تعرضت لها سنة ١٩١٦. نرى بأعينها وخلال كلماتها؛ أي من وراء حجاب، الاختلافات في الطبقة الاجتماعية فضلا عن السِن وما يترتب عليه من فروق ثقافية ومعرفية. كل هذا والمسكين داخل الحمام، نعم أطعمته وسقته لكنها حبسته في الحمام فلا هي سلمّته للشرطة ولا هي حررته ليأكل من خشاش الأرض كقطط الشوارع. اشتقت الراوية لنفسها اسما من اسم أمها ديليتا فطلبت من سانتي أن يناديها ليتا. ولكن شتان بين شخصية الأم و ابنتها وفقا لروايتها هي للأحداث فالأم مثابرة تجري وراء حلمها مهما كلفها ذلك. حلمت الأم بالطيران في الهواء وفي سبيل تحقيق حلمها بأن تصبح أخف من الهواء لتحلق بحرية تصطدم رغبتها الأخف مع مصيرها بالسقوط ولكنها تحظى بشرف أنها صاحبة التجربة الأولى للتحليق بالطائرة.
تقنية السرد هنا ليست جديدة عليّ فقد خبرتها من قبل في رواية «خمس ساعات مع ماريو» (1966) للكاتب الإسباني ميجيل ديليبس مع فروق جوهرية في السياق. فماريو في رواية ديليبس الأشهر كان ميتًا لتوه وجالسته زوجته لخمس ساعات في غرفته قبل دفنه لتحكي له سنواتها معه. كانت خمس ساعات في صُحبة مَيِّت وليست أربعة أيام يُحتجز فيها مراهق واعِ مسلوب الإرادة. أثقيل عليك ما تفعل بنا العجوز أو أنك ترى أن اللص يُكافأ حق المكافأة على صنيعه؟
يقول فيديريكو جانميرعن الرواية في أحد الحوارات أنه تعمد أن يجعل بطلة العمل أكبر ما يكون ورفيقها طوال زمن السرد بدوره أصغر ما يكون، كما تعمد إبراز إنعدام الحوار بينهما فمن لديه السلطة هو من يستطيع الكلام ويدير دفة الحديث أينما عنَّ له. وفي سياق متصل يقول بابلو دي سانتيس (أحد مُحكمي جائزة كلارين والتي حصدتها الرواية عام 2009) أن الراوية هنا تتقمص شخصية شهرزاد لكنها شهرزاد تسعينية كابوسية تحكي من خلف باب موصد لشهريار مراهق كي لا تموت من الشعور بالوحدة. ورغم رغبة هذه السيدة في الحكي إلا أن الباب المغلق على الضحية هنا كناية عن انعدام التواصل بين الأجيال بل وتقييد الأقوى سُلطة لبراح العالم الغَض للأصغر واستغلال حداثة عهده بالحياة حاصرًا إياه بين أربعة جدران.
القراءة الأولية للرواية يمكننا أن نسمع فيها سرد السيدة عن حياتها وحياة أمها قبلها بأسلوب يتذبذب بين الشدة واللين مع المخاطب فمن مطلع الرواية وأول فصولها نجد تأريخًا قبل الشروع في القصص:
( الخميس، 29 نوفمبر
أرجوك، اجلس فوق غطاء المرحاض. لا تحسب أنني أُجبرك. إني فقط أظنك سترتاح عليه أكثر. أنا أيضا سأجلب مقعدا وأضعه بجوار الباب. سأقص عليك أمرا ما. لا تُزمجر. سيسوءك هذا الحال، ولن تكسب شيئا، ربما حتى قد يرتفع ضغطك. أقسم لك… سبق أن حدث هذا لي. هناك حكاية… حكاية ما سأقصها عليك وأرغب بشدة في البوح بها.)
كما ذكرت آنفا فالسيدة هنا مُعلمة متقاعدة، تمارس على تلميذها قهرًا وبمنهجية عفى عليها الزمن في التدريس سُلطة أبوية بإرغام الغلام على الإصغاء لحكايتها فيما يمكن تسميته بضِيق الأُفق المهني أو professional deformation فحواراتها في الرواية تميل تارة للترهيب وتارة أخرى للترغيب بسياسة العصا والجزرة ولكنها لا تتورع في استخدام سلطة السجَّان وقت الحاجة كما في المقطع التالي:
( استمع لما تتفوه به. أنا أحبسك، هذه حقيقة، لكن من أجل مصلحتك أعلمك كثيرا من الأمور التي كنت تجهلها، وأُبعِدك عن خطر الشارع، وفوق كل شيء أحميك من نفسك. لم أختطفك. كيف لي أن أختطفك؟ إذا سمحت لك بالخروج فستتوجه مباشرة للبحث عن أختك المسكينة، وهو أمر لا يمكنني التسامح معه. (…) حقوقك كإنسان؟)
هنا لا أملك إلا التوحد مع السَجين الصغير بل وجدتني حال إعادة القراءة أتهكم على السيدة التي بدت لي مضطربة نفسيا، فأخذت أتذكر أنها تُكرر بصيغ مختلفة جملة حوارية شهيرة لباسل خياط في مسلسل “الرحلة” وقد باتت معادل موضوعي له في حواره لزوجته التي يحبسها بدوره: أنا هنا عشان أحميكي من الناس اللي بره دول .. الوحوش اللي بره دول. أي وصاية وحماية إذن تمارسها هذه السيدة على سانتي الأعزل في بيتها بين أربع جدران. بل وتزيد من جرعات توبيخه والحكم عليه وعلى العالم أجمع حينما تقول له:
(أنت ضائع يا سانتي. آسفة جدا، لكن هذه هي الحقيقة.
والعالم أيضا ضائع. أنت والعالم، أنتما الاثنان ضائعان تماما). فأي سياسة ومنهجية تعليمية تنتهجها المُعلمة ليتا مع تلميذها؟!
وفيما يخص قراءات الرواية يقول دولوز: ” الكاتب يكتب أيضا من أجل من –ليسوا- قراء، أي، ليس موجها إليهم، بل “بدلا عنهم” ومن ثم، تعني “من أجل” شيئين: موجها إليهم وبدلا عنهم. (…) حين يكتب المرء، فإنه لا ينشد شأنا صغيرا خاصا (…) ليست الكتابة شأنا خاصًا لأي أحد، بل تعني بالأحرى قذف المرء لنفسه في شأن عام، سواء رواية أو فلسفة”.
أظن هذه النظرة الدولوزية يمكن تطبيقها على العمل برؤيته من زاوية أوسع كمثيل للأفراد المعزولين والمهمشين إما عمريا أو اجتماعيا والذين يمكنهم اقتراف جرائم مختلفة بحق الآخرين إثر ظروفهم وعدم احتضانهم مجتمعيا بالشكل اللائق. فيمكن أن تمثل ليتا سُلطة الحضارة ورأس المال بينما يمثل سانتي المقاومة الفتية البدائية لكل ما يعيق نموه الطبيعي وما لا دخل له به في تنشاته وظروفه. وهو ما يمكن اسقاطه على الكثير من المجتمعات وليست الأرجنتين فحسب.
وفيما يخص ترجمة العمل للعربية وبمتابعة بعض أراء بعض قراءه على موقع جودريدز وشفاهية أعجبني عدم حرق أغلبهم للأحداث وتساؤلاتهم التي عززتها الرواية عن مدى تماهيهم مع الشخصيات وكذلك السؤال عن ما هو حقا أخف من الهواء: الذكرى؟ العُمر؟ الوقت؟ الأماني؟ الحلم؟ أم رغبة المرأة كما صرحت لنا الراوية. خواء الرواية الذي استبقناه من أبيات خيلمان عزز فضول البعض لإكمالها لا لمعرفة أسماء أو احداث جديدة مما تحكيه العجوز فحسب بل لتنضب حكاياتها ولنعرف مصير هذا الحبيس الصغير. أعجبني أيضا أن بعضهم أطلق العنان لخياله ليخرج بنهاية ترضيه بأنه ما من طفل هناك وأن كل ما تسرده العجوز هو محض خيال، دلل أصحاب هذا الطَرح على وجهة نظرهم بافتراض اختلاق العجوز المُهلوِسة لحوار مع مخاطب مُتَخيَّل لذا هي من تسرد علينا كلامه طوال الرواية.
لا يجب إغفال سلاسة الترجمة وهي تعد الترجمة الخامسة لمحمد الفولي بعد »هذيان« و»الشرق يبدأ في القاهرة« و» أغرب حكايات في تاريخ المونديال« و»حكاية عامل غرف«. هنا أقتبس من مراجعة الزميل المُتأسبن أحمد محسن على موقع جودريدز حين قال:
(( المرة الثانية التي أقرأ فيها ترجمة للصديق العزيز محمد الفولي، وأكدت لي أنني حين أقرأ كتابا ترجمه محمد فسأضمن قراءة ماتعة بلا شك، السبب كما هو واضح من أول صفحة في الرواية أن محمد مترجم متحكم في القلم الذي يمسك به أثناء الترجمة، أو الكتابة. وهو أمر شديد الوضوح أيضًا في الترجمة، هو أنه كاتب قبل أن يكون مترجما، له أسلوبه العربي، له معجمه الفصيح والثري والمتنوع. (…) كاتب يحسن أن يقول في رواية قصيرة واحدة على سبيل المثال: قلب الموضوع، وصُلب الموضوع، ولُب الموضوع. مترجم يستخدم في أقل من عشر صفحات، على سبيل المثال: علاوة على ذلك/حينما اشتد عودي/ريعان الشباب/ردح من الزمن/بئر البلاهة/استعد رشدك/بهية الطلعة/أنبس ببنت شفة/هذا يزيد الطين بلة/الأمران بالنسبة لي سيان/بين الفينة والأخرى/أنثى هشة ذات نسب/تترجل بمعنى تمشي/دماثة. هذه التعبيرات والألفاظ مستخدمة في نسيج متجانس للغاية، يجعلك تشعر أنك تقرأ نصا عربيا بينك وبينه ألفة، ويحافظ على سهولة اللغة وعدم إغراقها في الغرابة جنبا إلى جنب مع عدم جعلها لغة تشبه العصير الذي كله ماء خفيفا مائعا، لا عُصارة فيه«.
جدير بالذكر أن الرواية تم تحويلها لفيلم قصير من إخراج كارولينا دوخاس ومن بطولة إيلدا ماركو وكيفين روبرتو، فضلا عن العرض المسرحي ببطلة وحيدة هي بتيانا بلوم وإخراج جابريلا إسكوبيتش (يمكن الإطلاع عليهما على يوتيوب). ما يميز الفيلم القصيرعن العمل الأدبي الأصل وما يجعله أخف ربما هو اتساع المجال البصري فنرى أمامنا الأشخاص من “لحم وعظم” كما يقول التعبير الإسباني. نرى سانتي ماثلا أمام ليتا ونرى أمها ومن سلبها خفتها في مشاهد الفلاش باك ونرى القسيس وعاملي المحال التي تبتاع منها ليتا مستلزماتها والصيدلية وخلافه. ربما هذا هو الاختلاف الأهم بين العمل الأدبي ومعادله السينمائي.
هل بعد كل هذا الحكي سترتاح ليتا وتشعر بالرضا والتعافي بمشاركة سانتي ومشاركتنا أفكارها؟ تجيبنا هي في ختام الرواية عن هذا السؤال حينما قالت:
»لا أظن؛ فأنت أيضا لم تفهم أمي، لم تفهم أن ما هو أخف من الهواء، رغبة المرأة.« إذن كما نرى فختام الرواية يحيلنا مرة أخرى لعنوانها ومآلها بخيبة أمل البطلة في تعاطف من أسرتهم معها طوال صفحات الرواية.
بقى الإشارة على أن مؤلف العمل كاتب وأكاديمي وباحث في آداب العصر الذهبي بجامعة بوينوس آيرس. عاني كثيرا -على حد قوله في أحد اللقاءات التليفزيونية- لنشر أعماله وذلك قبل حصوله على الدكتوراه وتحسنت الأوضاع بعدها فله حتى الآن أكثر من عشرين عملا منشورا. حازت روايته »ميترى« على جائزة ريكاردو روخاس كأفضل رواية أرجنتينية سنة 1997 فضلا عن جوائز أخرى من ضمنها جائزة كلارين عن هذه الرواية ومن آخر أعماله »كعوب عالية« (2016) و»محبات مسمومة« في نفس العام عن دار نشر أناجراما.
…
نُشِر المقال في عدد نوفمبر 2019 من مجلة عالم الكتاب