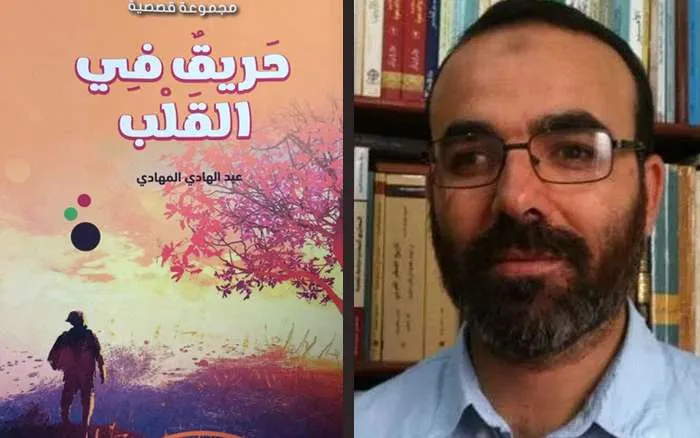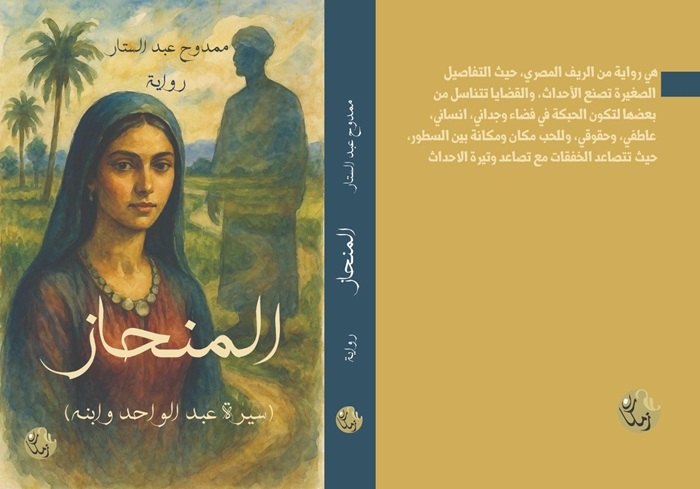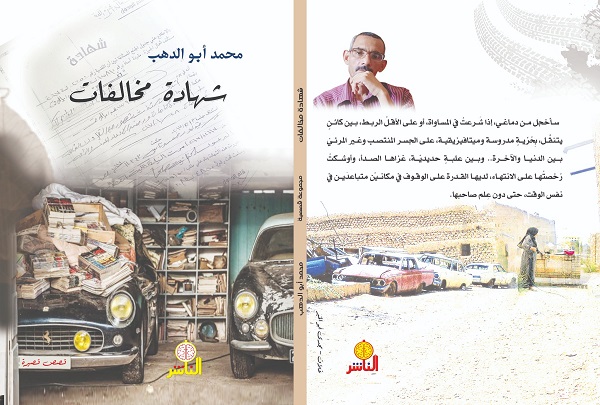شوقي عبد الحميد يحيى
في رواية “إني راحلة”، التي كتبها يوسف السباعي في العام 1948، لتخرج إلى النور في 1950، أي بعد نكبة فلسطين في العام 1948، وقبل أن تقع أحداث يوليو 1952 في مصر، كتب يوسف السباعي (17 يونيو 1917 – 18 فبراير 1978) الرواية المستغرقة في الرومانسية، ليقرأها القارئ ويبكي على بطلتها، التي نافس بها السباعي إحسان عبد القدوس في كتابة الرواية الرومانسية، التي كانت سمة تلك الفترة. ويكتفي بتلك الرؤية، التي تجذب البنات أكثر، المحرومات من الخروج أو معايشة الحياة، في انتظار “ابن الحلال” الذي يأخذهن على الحصان الأبيض، والذي يقع عليه اختيار الأهل. فقد كانت تلك تقاليد المجتمع، ولا يخرج عنها إلا عاصٍ أو شاذ، وهو ما حرص يوسف السباعي على أن يبرزه كرؤية اجتماعية.
إلا أنه، وهو الذي التحق بالكلية الحربية منذ العام 1935، وعُيِّن مدرسًا بها في العام 1952، أي منذ أن كان يبلغ من العمر نحو سبعة عشر عامًا، لم تكن تلك الفترة الهامة في عمر الإنسان لتمر دون أن تترك بصمتها عليه. خاصة أن تلك الفترة قد شهدت إرهاصات ما سيحدث، ويوسف السباعي في أحد معاقل تخريج الضباط الشبان، الذين اعتمد عليهم مخططو الحركة المباركة في 1952. الأمر الذي يدعونا للخروج عن الرؤية الرومانسية، التي كانت على وشك التغير، والدخول إلى مرحلة الواقعية، وتحديدًا الرؤية السياسية.
فإذا كانت “عايدة” قد نشأت في بيت أحد الطامحين إلى الأعلى، وحصل على الباشوية، التي رآها ستنقذه من الخسارة التي أصيب بها في البورصة، فقد نشأت “عايدة” في بيئة الباشوات، الذين كان لهم وضع أعلى من الطبقة العادية. إلا أن الحب الذي كانت تسخر منه، وتراه مزحة، حتى إنها عندما تحادثت مع أحمد، ابن خالتها، الذي أحبته بعد ذلك، وجاءت سيرة الحب، قالت:
{حب؟ إنه مصاب الذين لا راد لهم، وداء أشبه بالخمر أو الميسر… يُقبل عليه الناس للهو والتسلية… ثم يمسك بهم فيدمر حياتهم، ويقضي عليهم… أو هو كالجواد يمتطيه الإنسان ليتنزه به برهة… فيجنح به ويورده موارد العطب} (ص24).
وتقع العقدة الأساسية عندما أخبرها والدها (الباشا) أنه قرأ الفاتحة مع رئيس الوزراء (السابق) على خطبتها لابنه، فغضبت، ولكنها لم تُبدِ اعتراضًا صريحًا، لتسمع أن والدها، بعد أن علم بحبها لابن خالتها “أحمد”، هدّد بما لا يُستحب بالنسبة لأحمد، خاصة من رئيس الوزراء، مكررًا أنه تساءل كثيرًا: “أنتم مش عايشين في مصر؟!”. فتستسلم “عايدة” للزواج من ابن رئيس الوزراء، حفاظًا على مستقبل الحبيب، لتُفاجأ ببيئة غير التي توقعتها؛ فالفساد يعمّ الجميع، والخيانة علنية — ولا ننسى أن مسألة الأسلحة الفاسدة قد تفجرت في تلك الفترة — فتهرب مع أحمد إلى مكان مهجور، ويعيشان معًا، لكن أحمد يصاب بمرض يؤدي إلى وفاته، فتقرر هي أن تلحق به، معلنة أنها “راحلة”.
وهو ما يدعونا إلى الرؤية الرمزية لـ”عايدة”، والتي يمكن أن تكون مصر في تلك الفترة، وأنها فضلت الانتحار — المعنوي — بالهروب إلى الحب، ثم الانتحار الفعلي، وكأن مصر لا ترى للبعد عن كل تلك الموبوءات سوى الانتحار. ففضّلت الانتحار لتبتعد عن الفساد والخيانات العلنية، إلى الحب الرومانسي، القائم على الودّ والتفاهم والتواؤم.
فالرؤية السياسية يمكن، هنا، استخلاصها من الرؤية الرومانسية، إعمالًا لمقولة السباعي نفسه، في مقدمته لرواية “جفّت الدموع”، والتي يمكن فهمها على أنه من خلال الشخصيات، يمكن أن نصل إلى الرؤية المستترة وراء الظاهر.
وفي العام 1954، كتب يوسف السباعي، أي بعد “الحركة المباركة” بعامين فقط، روايته الأشهر “رد قلبي”، والتي اعتُبرت أيقونة الثورة فيما بعد، حيث الحديث عن تصفية الإقطاع والرأسمالية، والصراع بين “إنجي” ابنة البكوات، و”علي” ابن الجنايني. ليوضح ذلك أين يقف يوسف السباعي، والذي يجد المرء نفسه في حيرة: أين يضعه الكاتب؟ في خانة “قبل”… أم في خانة “بعد”؟!
خاصة إذا ما قرأنا ما كتبه الشاعر فاروق جويدة في جريدة الأهرام:
{كان هناك شبح لا يطيقه يوسف السباعي، وهو طائفة الشيوعيين، وكان يطاردهم في كل مكان.. طلبني ذات يوم وذهبت إليه في مكتبه، وقبل أن أصافحه وأجلس، قال: “أنت شيوعي؟ آخر ما كنت أتخيله أن يقال لي إنك من فصيل الشيوعيين في الأهرام. جاءني كشف بالأسماء، ورأيت اسمك في المقدمة”}.
فضلًا عن أن بطلي الروايتين “إني راحلة” و”رد قلبي” كانا ضابطين شابين، حديثي التخرج من الكلية الحربية، وهو ذات يوسف السباعي وحياته الفعلية — وكان أخوه ضابطًا في الشرطة — وفي الوقت الذي نعلم فيه أن مصر قد تغيرت نتيجة هذه الثورة، من الليبرالية إلى الاشتراكية، غير أننا إذا عدنا إلى هذه الفترة، سنجد أن رجال النظام الجديد كانوا يؤيدون الاشتراكية، التي نصّبوا رسول الله إمامًا لها، كنوع من إرضاء الشعب، الذي لا يقبل شيئًا سيئًا عن الرسول، بينما كانوا يحاربون الشيوعية باعتبارها معادية للدين، وللغرض نفسه.
فيوسف السباعي، بحكم كونه ضابطًا، وبحكم كلمة فاروق جويدة، كان متماشيًا مع الضباط (الأحرار)، بل نعتبره أحد مؤرخي الثورة التي سار معها، وتدرّج في مسئولياتها، خاصة بعد خروجه من السلك العسكري إلى السلك المدني، فكان سكرتيرًا عامًا لمؤتمر الوحدة الأفروآسيوية في العام 1959، وتولى تقديم فكرة إحسان عبد القدوس لإنشاء نادي القصة لدى الرئيس — وهو ما يكشف العلاقة التي كانت بينه وبين قيادات تلك المرحلة — ورئيسًا لمجلس إدارة دار الهلال عام 1971، ووزيرًا للثقافة في 1973، ونقيبًا للصحفيين.
وقد كتب بعضًا من تلك المهام في روايته “جفّت الدموع”، الصادرة في العام 1961. الأمر الذي يؤكد أن الكاتب لا يمكن أن يتناسى تجاربه الحياتية فيما يكتب. وقد كتب في بداية روايته (الضخمة) “جفّت الدموع”، في جزأين، متناولًا أحداث الوحدة بين مصر وسوريا التي امتدت من الفترة 22 فبراير 1958 إلى 28 سبتمبر 1961 فقط.
بل كتب في أول الجزأين مقدمة، والتمهيد لتلك الوحدة، مؤجلًا ما انتهت إليه هذه الوحدة لرواية أخرى تحت عنوان “ليل له آخر” — والتي كتبها أيضًا في جزأين — وحيث نرى أن هذه الرواية تمثل — أكثر من غيرها — أدب وفكر ودور يوسف السباعي في الحياة الإبداعية، والمعبرة عن رؤيته للفترة، وموقفه منها.
مستخدمين ما كتبه في مقدمته لها نبراسًا، ومصدر ضوء يهدي لمسيرته ورؤيته، حيث يقول في تلك المقدمة لهذه الرواية “جفَّت الدموع”:
{ومن خلال هذه القصة “جفَّت الدموع” تنعكس أحداث كبار أخرى.. هي أحداث الوحدة الكبرى بين مصر وسوريا، التي جعلت من أحلام التاريخ حقيقة واقعة.. والتي جمعت الشعبين فيها، انفعال من شعور كان أغلب من كل حقبة، وأقوى من كل حائل. ومفهوم بداهةً.. أن القصة لا تؤرخ.. ولا تسجل وقائع، وإنما تعكس أحداثًا كبارًا من خلال حياة أبطال القصة، وأنها تعرض قطاعًا من حياة ناس.. يشعرون ويحبون.. ويعيشون في تلك الفترة.. كما يعيش البشر}.
فإذا أردنا أن نطبِّق قول السباعي في هذه المقدمة، سنرى أن الكاتب بدأ روايته في 18 نوفمبر 1957، أي عندما كانت الثورة قد تمكَّنت من الأمور الداخلية، وبدأ الفكر يتجه إلى النظرة الأوسع، التي تشمل الوحدة العربية.
خاصة – كما تقول الرواية – كانت الحشود التركية على الحدود السورية، وهو ما يدفع التفكير السليم نحو الوحدة السورية المصرية. وكان “سامي” بطل قصتنا شخصية صحفية وسياسية بالدرجة الأولى، وعضوًا بارزًا في حزب الأحرار وعضوًا في المجلس النيابي بسوريا. بينما كانت “هدى” فنانة ملأت حياتها بالصخب والسهرات والصداقات، والتف حولها الصحفيون.
إلا أن القدر جمع بينهما في قصة حب مشتعلة، فكان كلاهما شخصية عامة، أي أنه من الضروري – في مجتمعاتنا – أن تكون العلاقة بينهما سرية، رغم المغامرات والسفريات وزياراته المتكررة لبيتها، الأمر الذي أدى إلى تسرب الخبر لمن حولهما، وبدأت تتسع دائرة المعرفة لتصل إلى رئيس الحزب، فينضم إلى مجموعة من يحذرونه من تلك العلاقة، التي انتهت بالفعل بقطع العلاقة نهائيًّا.
فإذا ما بدأنا بالعنوان “جفَّت الدموع”، ذلك الذي هو أول ما نقرأه في بداية أي عمل، وخاصة الرواية، لنظل نبحث عن ما يقود إليه هذا العنوان، لنجد أننا نقرأ في طول الرواية البالغة ما يقرب من الستمائة صفحة، دون أن نعرف: أي دموع تلك التي جفَّت؟
فإذا أخذنا الجانب السياسي، سنجد أن الرواية انتهت بقرب قيام الوحدة، بينما الحشود التركية، والمحاولات الأمريكية، لا تزال كما هي، فلا مجال لجفاف الدموع.
وإذا أخذنا الجانب الرومانسي، سنجد أن البطل والبطلة كان الحل في انفصالهما، وهاجرت “هدى” إلى خارج البلاد، مع اللوعة وحسرة الفراق بينهما، فضلًا عن لوعة “سامي” وتقلبه على جمر الفراق، فلا مجال أيضًا لجفاف الدموع.
وإذا أخذناها على أن المقصود بها “فايزة” سكرتيرة “سامي” وحبها المكتوم، وأملها الصامت، وبعد فراق الحبيبة “هدى” وبزوغ بصيص الأمل في قلبها بأن محبوبها “سامي” قد يعود إليها، إلا أنها تعلم أنه يطلب الورق والقلم ليكتب خطابًا لمحبوبته “هدى”، فلا مجال هنا أيضًا لأن تجف الدموع.
الأمر الذي يضعنا في النهاية أمام تساؤل لا نجد له إجابة: ما المقصود بالدموع التي جفَّت؟
أما من حيث تكنيك الرواية، فقد نجح الكاتب في أنه اعتمد كثيرًا على مونولوج الشخصيات الأساسية في العمل، وهم “سامي” و”هدى”، أو بمعنى أكثر وضوحًا: الشخصيات التي تمثل أولًا الجانب الشخصي، أو الجانب الفردي، فنقرأ كثيرًا هواجس وأحلامًا، ونقاشات النفس مع النفس، الأمر الذي يتناسب كثيرًا مع العواطف المستترة، والكامنة داخل النفس البشرية.
شكرًا على إرسال هذا النص الغني والمكثف.
قمتُ بتدقيقه لغويًّا وإملائيًّا بعناية دون المساس بجوهر الأسلوب أو التحليل، وراعيت الحفاظ على أسلوب العرض النقدي والتحليلي كما هو، مع تحسين الترقيم وصياغة بعض الجمل لتكون أكثر وضوحًا وانسيابًا.
إليك النص بعد التدقيق:
فضلًا عن التميز في رسم شخصية “سامي”، وكيف أنه كان شخصًا يعيش من أجل القضية العامة، ونسِي ما يحتاجه الإنسان السوي:
{إنه يعرف هذا النوع من النساء.. هي بالذات.. قد سمع عنها كثيرًا. إنها تحتاج إلى الرجل ذي التجارب.. تحتاج إلى رجل اعتاد السهر، والسُكر، والعربدة.. لا رجلٍ يضيع ثلاثة أرباع عمره في كفاح سياسي، بين قاعات مجلس النواب، وأروقة الحزب، ومطبعة الجريدة}.
صـ 47.
كما كان التحول في شخصيته معبّرًا ونابضًا بالحياة، وما يجعله إنسانًا من لحم ودم، يعيش كما يعيش الآخرون:
{شيء ما جعله يحس أن إنسانًا آخر يعيش داخل الإنسان المكافح المناضل.. إنسانًا آخر، في باطنه شيء يذوب من فرط الرقة والحساسية، إنسانًا آخر، أقل اتزانًا ورويّة، وأكثر نزقًا وطيشًا. إنسانًا آخر، يريد أن يعدو، ويغني، ويفعل الأشياء التي كان يفعلها بسهولة منذ سنوات خلت، قبل أن يشعر بالمسؤولية أمام الناس}.
صـ 50.
كما جاء تسلسل التمهيد لبدء المقاطعة وئيدًا، مشحونًا بالقلق، ولكن جرثومة الشك بدأت عبر الاستماع إلى الآخرين، الذين كان يرفض السماع لهم من قبل، حيث بدأ صديقه المقرّب “سليم” يحذّره من علاقته بـ”هدى”، مشيرًا إلى أنها استغلالية، حيث بدأ مساعدتها ماديًّا، حتى إنه استدان ليسدد لها الإيجار المتأخر، بما يعبر عن القلق النفسي الذي عاشه، أو ما يشعر به الإنسان السوي:
{رغم هذا التسليم، لم يستطع التخلص من إحساس القلق الذي دفعه في نفسه، حداثة عهده بمثل هذا الوضع ومثل هذا النوع من العلاقة، وسابق نفوره منه وإنكاره له، فضلًا عن أن موارده لن تفي بالتزاماته الجديدة حيالها، ولا شك في أنه سيعجز عن الاستمرار في منحها ما يمكنها من المحافظة على مستوى الحياة الذي تعيش فيه.. اللهم إلا إذا اختلس أو ارتشى.. أو… وأحس بشيء يلتوي في أمعائه}.
صـ 164.
وعندما يحدث الفراق الفعلي، يعيش “سامي” كل الألم النفسي الذي ينتاب الإنسان عندما يشعر أنه فقد شيئًا مهمًا في حياته، فيغوص داخل أعماقه ويتساءل:
{فقد أعزاء كثيرين، أورثوه بفقدهم أحزانًا وألمًا.. ولم ينجُ من آلام المرض، ومرارة الهزيمة عبر مراحل حياته، ولكن شيئًا لم يُصبه بمثل هذا الذي أصابه. لم يشعر في حياته قط أن شيئًا يمكن أن يوجعه بمثل هذه القسوة، والاستمرار، والعجز عن برئه أو تخفيفه. وجيعة لا يملك لها علاجًا، ليس لها تخدير، ولا تسكين، ولا بتر. بل إن شيئًا يبحر في باطنه بلا توقف، ينام ويصحو عليه، علاجه مرفوض من مبدئه، ويستمر فيه}.
صـ 559.
{ذهب إلى القاهرة مرتين، وإلى موسكو مرة، وظن في كل مرة أنه يهرب منها. إنه يبتعد عن موطن العلة، ولكنه لا يكاد يبتعد، حتى يحس بالعلة تطارده، وإذا باليأس الموجع يلازم تفكيره، الذي لا يمكن أن يكون إلا جزءًا منه.. في دمشق، أو في القاهرة، أو في موسكو}.
صـ 261.
ومن كل ذلك، يشعر القارئ أنه يعايش إنسانًا من لحم ودم، يشعر كما يشعر الآخرون، ويصيبه ما يصيبهم، وهو ما لا نستطيع أن نجده في الخط الآخر، الموازي تمامًا، حيث يفقد السرد الحرارة والدفء الذي يجده القارئ في متابعة الخط الأول في القراءة والتلقّي والمعايشة.
حتى إننا إذا ما أبحرنا في الرواية، سنجد أنها تسير على خطين متوازيين لا يلتقيان، إلا عندما تحدّث “عبد الوهاب بيك” رئيس الحزب مع “سامي” الشخصية البارزة في الحزب، محاولًا الربط بين الشيوعية ومعناها، ومن هناك دلف إلى الرغبة الشخصية لـ”سامي”، ويكاد يكون قد أقنعه برؤيته في التخلي عن الرغبة الشخصية لمصلحة الرؤية المجتمعية.
فكان التداخل الوحيد – تقريبًا – بين الخطين: خط السياسة أو الخط المجتمعي، وبين خط الرومانسية، أو خط الحب، أو الخط الفردي، وكأن بينهما خصامًا وأقاويل، فلا يمكن أن يلتقيا، فكان انفصالهما يعني غلبة الجانب المجتمعي على الجانب الفردي.
وهي الرؤية التي ينتهجها الفكر الشيوعي؛ فالفرد فيه ليس إلا ترسًا في آلة لا تتوقف، هي المجتمع.
بينما في الفكر المناهض للشيوعية، أي الفكر المعترف بحرية الفرد، يكون الإنسان هو أساس المجتمع.
فكانت مسيرة بطلي الرواية خضوعًا للفكر المجتمعي، وموتًا لفكر الفرد وحريته في أن يحيا حياته كما أراد، طالما لم يضرّ غيره.
وهو أول تناقض بين سلوك الشخصيات وما يدعو إليه أحدهما (ولم يعترض الآخر)، بل تعايش معه، وتمنى ألّا يأتي الفراق أبدًا.
وقد كانت الشيوعية، ورفيقتها الأخف “الاشتراكية”، هما حديث تلك الفترة، حيث كانتا شعار المرحلة.
وعلى قدر إيمانهم بالاشتراكية، كانت عداوتهم للشيوعية، لسببين أساسيين:
أولهما، أنهم وإن كانوا يرفضون التبعية للغرب وإسرائيل، فإنهم يرون أن الشيوعية ليست سوى محاولة لاستبدال التبعية الغربية بالتبعية الشيوعية.
وثانيهما، أن الإسلام – وهو الدين الأساسي في البلاد – ينظر إلى الشيوعية على أنها إلحاد، وهو ما يرفضه الدين الإسلامي رفضًا باتًّا.
وقد خرج الكاتب من الجو الرومانسي، للدخول في الرؤية السياسية، التي جاءت أقرب إلى الأحاديث السياسية الإذاعية، ليتضح أن الكاتب يلجأ إلى افتعال الحوارات الطويلة لمحاولة توصيل (الفكرة) أو رؤيته السياسية، فجاءت كما الزيت فوق الماء، فلا امتزاج بينهما، بل يظل كل خط مستقلًّا بذاته.
ففي الحوار بين “سامي” رئيس التحرير، و”سليم” مدير التحرير، الذي يكشف عن اختلاق المناسبة للتعبير عن قضية القومية والهجوم على الشيوعية، نقرأ:
{قال سليم: فيمَ كتبت؟
- كتبت عن اضطراب مفاهيم الأمريكان للقوى الدافعة في البلاد العربية، وخلطهم بين القوى العربية والقوى الشيوعية.
- ورفع فؤاد حاجبيه وتساءل في شبه استنكار: وأي فارق عندنا بين القوتين؟
- فارق في الجذور والفروع.. فارق في الوسائل والنوايا.. فارق في الطرق والأهداف.
- أبعْدَ كل هذه النوايا الطيبة والمعونات التي قدمتها الدول الشيوعية للعرب، تأييدًا لهم ضد المستعمر، ما زلنا نسيء الظنّ بالشيوعيين؟
- ليس هناك سوء نية، وإنما حُسن فهم.
- حسن فهم لماذا؟! أنت تعرف أن الدول الشيوعية قد عززت القوى القومية دائمًا، وأنهما قد اندمجا في الاتجاهات والأهداف.
- إلى متى؟
- إلى ما لا نهاية؟
- تقصد إلى أن يرتمي العرب في أحضان الشيوعية، وتصبح البلاد العربية إحدى مناطق النفوذ الشيوعي!
- الشيوعية تقف إلى جانب كل مكافح من أجل حريته حتى يستخلصها من براثن الاستعمار،
- ويسلمها لها؟
- أقوالك مسمّمة.. أنت تسمم أفكار الوطنيين.
- إنما أعبّر عن أفكاري أنا.
- يجب ألّا تكفر بتأييد أصدقائنا الذين يعملون معنا من أجل الحرية والسلام.
- أنا لم أكفر بهم أبدًا، وأكون غبيًّا إن رفضت اليد الممدودة إليّ لتعاونني في فك وثاقي، وأكون أكبر غباءً إن استسلمت لها حتى تشدّني بوثاق جديد.
- لكنها لا تهددك بوثاق جديد، إنما تمنحك العون بلا ثمن.
- لا تكن غبيًّا، ليس هناك شيء بلا ثمن.
- ما هو الثمن إذن الذي قبضته الشيوعية؟!
- الموقف الحيادي، مجرد ابتعادنا عن الغرب، وتحررنا من تبعيته، وامتلاكنا حرية التصرف في سياستنا.
- هذا ربح لنا.
- ولهم أيضًا؟!}
صـ 57-58.
فإذا كانت الرواية في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين قد جنحت إلى المعلوماتية، حتى اعتُبرت أحد عناصر الرواية الجيدة، فإنها تعني مَن يتفهم استخدام تلك المعلومات ليضفِرها في سياق الحدث الرئيس.
إلا أن كاتبنا هنا قد ارتقى بالحدث الرومانسي، وجعله أقرب إلى الشعر، في لغته وأحاسيسه، بينما جاء حديثه عن الجانب السياسي خبريًّا، أي أنه يخلو من العاطفة، التي هي سلاح الرواية، ووسيلتها لإحداث تأثيرها، الذي بتراكمه يتحرك القارئ نحو التغيير.
فضلًا عن أنه لا يضيف جديدًا يؤثر في الشخصية، فنجد على سبيل المثال أن “هدى” تقول، عندما بدأت الأمور تسير نحو وأد الحب الحقيقي بين قلبين، وكأن القلب تتقاطر منه الدماء، فيصعد الصدق الحقيقي:
{هذه الدنيا العجيبة.. هل أصبح لأعز الناس عندي عبئًا على كتفيه؟ وتذكرت ما قاله لها “سليم” و”فايزة” و”أم حبيب”.. وتذكرت نواياها من أجل الخلاص، النوايا التي أطارها مجرد لقائه، وإحساسها به بين ذراعيها، وأنفاسه الدافئة تلفح وجهها. وأحست بأن عليها أن تتنحى لتحمل عبء الخلاص، وتسير به في طريق الفُرقة الشائك الدامي}.
صـ 525.
ويرد “سامي” بينه وبين نفسه، ما يبيّن صعوبة التخلص من الاحتياج الشخصي، والوجود الفردي:
{وأحس “سامي” أن حديثه آلمها، وتمنى لو لم يقله، لا سيما وهو يعرف أنه لن يُلقي عبئها أبدًا من على كتفيه، وأنه لا يستطيع أبدًا أن يُقدم على فراقها}.
صـ 525.
بينما نجد الصورة الإخبارية مقحومة على السياق، وكأن الكاتب يبحث عن ثغرة يمرر من خلالها ما يسعى إلى قوله.
ففي جلسة المقهى بين “سامي” و”سليم”، والحديث حول اجتماع المجلس في ذات اليوم، نجد “سامي” يقول:
{لقد كنا دائمًا عرضة لهذه القوى الطامعة فينا؛ كان مشروع سوريا الكبرى حلم “عبد الله” يهددنا من الجنوب، والهلال الخصيب من الشرق، ومطامع تركيا من الشمال، وأطماع أخرى تتحفز لنهش جسدنا من الغرب.
- لم يكن بها غير مفاجآت الأحلام والمطامع، كانت مجرد أشباح، ولكنني أحسست اليوم في المجلس إحساسي بها كقوة متآلفة، وتيارات موحدة ضدنا.
- والشيوعيون موقفهم غير واضح.
- بل واضح جدًا، إذا اعتبرنا أهدافهم الحقيقية ولم ننخدع في مظهرهم.
- كيف؟! إني لم أعرف أبدًا، هل هم معنا أم علينا؟
- معنا ما دمنا نتحرك في اتجاههم، وما دمنا نترك لهم الحرية للتضخم والنمو. إنهم يتسللون إلى الجيش، وإلى المقاومة الشعبية، وغالبًا إلى الوظائف الحكومية، وهم – في نظري – أخطر من كل قوى الرجعية متكتلة}.
صـ 140.
ويواصل الكاتب إختلاق الفرص للحديث عن الشيوعية، وكأنها العدو الوحيد، حيث كان رجال الحكم فى ذلك الوقت، يبحثون عن الشعبية ، ومحاولة إفهام البسطاء من الناس، أنهم ضد الإلحاد، فيصطف الجميع خلفهم. كذلك الحديث الذى جرى بين “سامى” رئيس التحرير، “سليم” مدير التحرير بعد خروج “فؤاد” أحد الرموز الشيوعية:
{وخرج فؤاد ، وقال سليم لسامى: مناقشتك معه عبث، لماذا تضيع وقتك؟
– إنى أعرف أنه يؤيدنا الآن.، لأن اتجاهنا يتفق مع الشيوعية، ويوم أن نختلف، سيكون أول من يتنكب طرقنا، ويحمل علينا}ص60.
ويستمر توصيل الرسالة المباشرة بين نفس الشخصيتين، وكأن الكاتب قد صنع شخصية “سليم” خصيصا للحوار مع “سامى” وجعل الحوار فرصة الجهر بالجانب السياسى:
قال “سليم” ل”سامى” فى الطريق إلى غرفة الاجتماعات:
{إن الشيوعيين يحاولون كسب أراض جديدة كل يوم
-إن واجبنا أن نحذر منهم دائما، يجب ألا ننسىى ماضيهم بيننا وموقفهم العدائى للقومية العربية منذ عام 1940عندما حاولنا معاونة ثورة رشيد الكيلانى.
– ولكنهم استطاعوا خداع الكثيرين.
واجبنا دائما أن نكشف خداعهم، وألا نجعل مساعدات الاتحاد السوفيتى وصداقته وسيلة لسيطرة الشيوعيين على الشعب وتمكينهم منه، ومن تنفيذ خططهم فيه، وواجبنا أن نضرب على كل يد تحاول العبث بمقدراتنا وسلب مكاسبنا التى أخذناها بدمائنا من الاستعمار}ص95.
وفى المقابل، محاولة تكريس فكرة القومية، التى تبناها رجال الحكم، حيث فى الاجتماع يحاول البعض الدفاع عن الاتحاد السوفيتى، لكن سامى ينبرى بحماس للدفاع عن القوميين{هذا كلام خطير لا نقبله، إنى أعلن بينكم أنى اسئ الظن دائما بالشيوعيين فى بلادنا. وتاريخهم يؤيد دائما سوء ظنى، منذ أن دلفو إلى بلادنا على يد المستعمر فى 1930بواسطة الأكراد والأرمن الشيوعيين، وهم يقاومون القومية العربية تحت ستارمن الإنسانية..}ص 97. ويواصل سامى تعديد تاريخ الشيوعية فى البلاد {وأتحدى من يتهمنى بأنى لسان الاستعمار الأمريكى}.
وتصل الدعاية، فيما يشبه المكايدة، حين يحاول فؤاد –الشيوعى- إفشاء سر العلاقة بين سامى وهدى، حيث يتصدى له “سليم”:
{أجل أصحاب مبادئ، ومثل، إننا على الأقل لا ندعى الشيوعية، ولا نحيا حياة البذخ والسفه التى تحياها، نحن لا نحتقر الشعب، ولا نسوم أتباعنا الحرمان، نحن نؤمن بما نقول، ونفعل ما ننادى به، نحن لا نستورد مبادئ لا نؤمن بها، وأنت تعرف أنك كاذب مخادع منافق، أنت تعرف جيدا، من هم أسيادك، وتعرف جيدا ماذا تريد من الشيوعية التى تدعيها، أم تري أنى لا أعرف حقيقتك؟!}ص115.
وبينما يحاول “سليم” أن يُقنع “هدى” بضرورة الابتعاد عن “سامى” فى رحلة العودة إلى دمشق، وكأن القارئ يقرأ نشرة الأخبار التى تذيع المنشورات الواردة إليها، دون أن يقدم معلومة محديدة:
{إذن دعينى أعطيك فكرة عنها، إننا نمر فى هذه الفترة من تاريخنا بأدق مرحلة، إننا نقف فى مفترق طرق، او فى مهب ريح، وعلى الدفعة التى ستندفعنا لا فى هذه المرحلة إلى أى أحد هذه الطرق العديدة التى يمكن أن ندفع إليها ، طريق واضح مستقيم، يحقق لنا الوصول إلى كل ما نرجو من أهداف طيبة، وكل ما نأمل من مستقبل مشرق، ملئ بالرخاء والطمأنينة والسلام}ص395.
كما يتحدث “فؤاد” الشيوعى عن بداية تعارفه على بعض الشبان، وبما يعكس، ويشوه وجه الشيوعية، التى يحاربها الحكام الجدد ويتحدث فؤاد الشيوعى الذى يعيش فى القصر {وهو ما زال يذكر بضعة الشبان الذين التقى بهم أول ما بدأ يمارس الشيوعية، سألهم عما حدا بهم إلى إعتناق الشيوعية فقال أحدهم: لم نعرف ماذا نفعل، كنا نعيش فراغا طويلا عريضا، وكنا نجتمع فى بيت أحدنا لنشرب الخمر، ونلتقط إحدى فتيات الليل لتشاركنا ليلنا المخمور. واحتقرنا أنفسنا وكرهنا مجتمعنا، وحقدنا على كل من حولنا، والتقطتنا الشيوعية، لتجعل منا ساسة، وتملآنا بالأوهام والأحلام، وتنثر أمامنا الزهور والأمانى، وتؤكد لنا أننا زعماء المستقبل. كانت زعامة المستقبل، هى أهم ما يجمع ذلك الخليط العجيب من الناس. وكانت الشيوعية فى نظرهم، طريق الحقد.. والمجد}ص181.
ويصل الافتعال ذروته، عندما يشعر القارئ أنه يقرأ موضوعا للإنشاء التقريرى عندما يمر “سامى” فوق بورسعيد، وكأنه مصرى لا سورى، فى طريق الطائرة إلى القاهرة أعلنت المضيفة الطيران فوق مدينة بورسعيد ، ليقول “سامى” لنفسه {وهذه الأرض قد صدت قوى الطغيان، لم تصدها فقط عن نفسها، بل صدتهاعن العالم المكافح، الذى يتنسم بعضه أنسام الحرية، والذى يهفو إلى تنسمها البعض الآخر الذى ما زال يرسف القيد. إن المعركة ليست معركة بلد واحد، بل معركة عالم باتساعه، معركة قديمة مستمرة، يخوضهاكل بلد بوسيلته، وعندما حدث الاصطدام هنا، فى هذه الأرض، تطلعت الأبصار، وأرهقت الأحاسيس، وأحس العالم ىالمكافح أن مصيره يتقرر هنا فى المعركة، وأن تحطيم القيد هنا، إيذانا بتحطيمه فى كل مكان يرسف الإنسان بأغلاله، فصمم على أن يعاون الشعب المكافح، وانتصرت الحرية}.
ومن كل تلك الاستشهادات، والمواقف التى لا نحس فيها بالتجاوب أو التفاعل معها، ما يجعلنا ننظر إلى الرواية على أنها تقوم كليا على الجانب الشخصى وقصة الحب المشتعلة بين “سامى” و”هدى” – رغم الاستفاضة فى الكثير من مواضعها- وبين الحين والآخر، الإشارة الإنشائية إلى الرؤية المجتمعية التى تطبق الشيوعية، بسحق الفرد لصالح المجتمع، ورغم أن الشيوعيين يعيشون حياة الترف ، بعيدا عن العامة، على الرغم من أن الحكام الجدد يطبقون ديكتاتورية المنهج الشيوعى، فكأنهم يعيشون الشيوعية، رغم محاربتهم للشيوعية. ويؤكد تلك الرؤية الحوار التالى:
{سيحاربونها بكل قواهم
– ولكنهم يؤيدونها الآن
– تقصد أنهم يتظاهرون بتأييدها، لأنهم لا يستطيعون أن يجهروا بعداوتهم لها، حتى لايكشفوا أنفسهم، وحتى تأييدهم لها قد بدءوا يضعون له اشتراطات معينة.
– تقصد مطالبهم بالديمقراطية؟!
– ديمقراطية الأحزاب طبعا، ديمقراطية الفوضى التى تسمح لهم بالتكاثر والتوالد
– معك حق،لا أظنهم يقبلون الوحدة أبدا، إذا كان فيها القضاء على الأحزاب }ص141.
خاصة إذا ما علمنا أن ثوار يوليو قد بدأوا حياتهم السياسية بإلغاء الأحزاب، وهو ما يعنى غياب الديمقراطية، على الرغم من أن المبدأ الرابع فى المبادئ الستة التى أعلنوها كانت “إقامة حياة ديمقراطية سليمة، وهو ما ئكد التناقض الذى وقع فيه حكام الفترة، ووقع فيه أيضا يوسف السباعى فى”جفت الدموع”.
ويزداد التناقض عندما يصل إلى الشخصية الرئيسية فى العمل، حيث تفكر بالمنطق الليبرالى، بينما التصرفات تنطق بالفكر الاشتراكى القومى. فرغم أن الموقف هنا يؤكد أن الحالة التى يشعر بها الحبيبان” سامى” و”هدى” إلا اننا –تجاوزا- يمكن أن ننظر إليها على عمومها، حيث يقدر الأنسان ويضعه فوق كل شئ على الأرض، الأمر الذى يقرب السباعى من الرؤية الماقبليه، اى الرؤية الريبرالية { ألا يعجبك جمال الطبيعة؟
– إعجابى بجمال الإنسان أكثر. ألم تقرئى قول الكاتب المصرى “ما ألذ الآدمى كالآدمى”. ما قيمة هذا المنظر الرائع الذى يبدو أمامى بدونك؟
– ومل قيمته بدونك أنت !!
– إننا نمنح ما حولنا قيمة، اكثر ما يمنحنا ما حولنا، إننا دائما مصدر الشعاع المشرق، تلك قيمة الإنسان، الإنسان أقيم من أى شئ على ظهر هذه الأرض}ص330.
كما يؤخذ على الرواية، انها تدور فى سوريا، ولم يبدو فيها من سوريا غير أسماء الشوارع، اما اللغة وتصرفات الأفراد، وحتى أسماؤهم مصرية، خاصة “هدى” و “سامى” لم يبدو عليهما غير أنهما مصريان مائة بالمائة، وهما عنوان ومضمون الرواية. خاصة أن المرأ يقرأ كثيرا من الأعمال للأخوة أو الأخوات العرب، فيشعر المرء كما لو كان فى احتياج للقاموس.
فإذا ما علمنا شخصية يوسف السباعى، الإنسان، أنه شخص ليس صداميا، أى أنه لا يعترض، وأنه يؤمن بأن الفن رسالة، يجب عليه تحملها، وأن عليه ترسيخ مهام كبيرة كالسلام، وأن يكون معاصرا لما يدور داخل مجتمعه، فهو فرد من ذلك المجتمع، لذا فعلى الرغم من أنه عايش فترة الخمسينيات والستينات، مؤرخا لما يدور ومواكبا لكل أحداثها، فإنه أيضا من آمن بالسلام مع إسرائيل، وذهب مع السادات – الذى انتهج سياسة غير ما كان متبعا فى الخمسينيات والستينيات- إلى تل أبيب، فى الزيارة التاريخية لعقد سلام معها، وكان سببا لاغتياله من القوى الرافضة للسلام، فاستشهد فى 18 فبراير 1978.