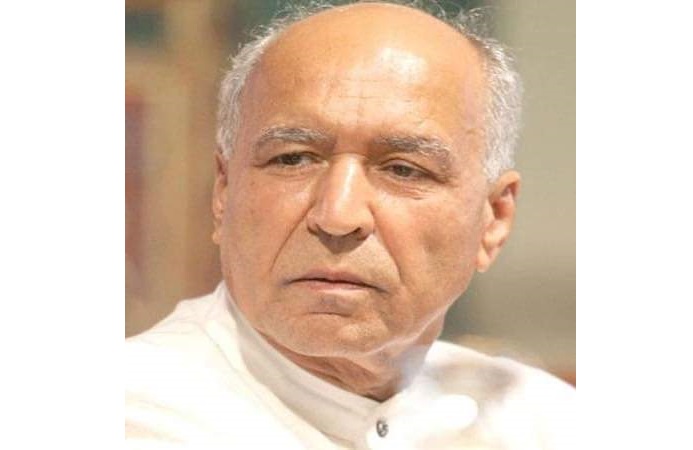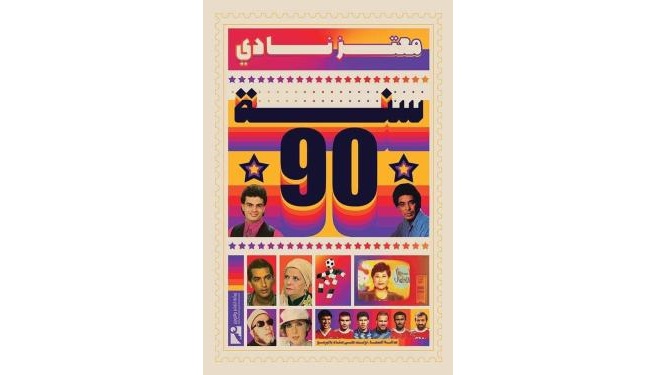ماجد ع محمد
“إيَّاك أن تزدهي بمناقب سواك”
إبكتيتوس
قبل أيام كنتُ بصدد تدبيج مقالة عن دمامة التزيي بما قاله الآخرون أو بما صنعه الغير، خصوصاً بعد تفشي ذلك الداء السلوكي على نطاقٍ واسع في مجتمعات الشرق الأوسط عقب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على اختلاف المنصات، حيث أن تلك المنصات التي تتعامل مع الأشخاص سواسية، تتيح المجال للمتطاولين على منتجات الغير وممتلكاتهم الإبداعية بأن يمارسوا هواياتهم على حساب الآخرين من دون أيِّ رادعٍ خارجي أو تأنيبٍ داخلي، وبالتالي نشر ما يريدون مما ينسبونه إلى أنفسهم من مقالات وقصص ومقتطفات وأقوال دون حسيبٍ أو رقيب، وقد جمعتُ النقاط الرئيسية لمقالتي تلك، لكني توقفت عن الكتابة فورَ اطلاعي على الدرة اليتيمة لابن المقفَّع، لأني وجدتُ بأن الرجل تحدث في دُرَّته عن نفس المرض الذي على ما يبدو كان منتشراً في زمانه أيضاً، أي منذ حوالي 1300 سنة، لذا لم أتردَّد في رمي ما جمعته وما سكبته من فقرات ونقاط ذلك المكتوب بعدما رأيتُ بأن ابن المقفَّع كفى ووفى، حيث جاء في الدرة اليتيمة: ” إن سمعْت من صاحبِك كلامًا أو رأيًا يعجبُك فلا تنتحلْه تزيُّنًا به عند الناس، واكتفِ من التزيُّن بأن تجتنيَ الصوابَ إذا سمعته وتنسبه إلى صاحبه، واعلم أن انتحالك ذاك سخطة لصاحبك، وأن فيه مع ذلك عارًا، فإن بلغ ذلك بك أن تشير برأي الرجل وتتكلم بكلامه، وهو يسمع، جمعت مع الظلم قلة الحياء، وهذا من سوء الأدب الفاشي في الناس”.
ومع أني بحكم العادة لستُ من معشر الصارمين في الحكم مع من يرتكبون الموبقات الاختلاسية عن جهلٍ أو قصور أو غايات سطحية لا تستدعي التشهير بهم، وبالرغم من عدم تشددُّي مع من رأيتهم بأم العين وهم يلبسون ما لم يشترونه أو يصنعونه وليس لهم جهدُ يدٍ أو إشغالُ عقلٍ في إيجاد المُنتشل بغير إذن، وبعد أن أمسكت بهم بالجرم المشهود وهم يأخذون ثمار الآخرين ليس من أجل سد الجوع الذاتي عبر ذلك المنتج الذي يُخال إليهم أنه يُساهم معنوياً في إعلاء شأن الذات، إنما كانت الإغارة بغرض التسويق الشخصي، التجارة المعنوية أو المباهاة به، ولخشيتي من أن يستسيغوا الأمرَ ومن ثم تصبح عملية الاقتناص اللامشروع عادةً لديهم فيزاولونها من دون حرج، ومن ثم مع دوام العملية لا يستطيعون الفِكاك من لِذَّة الممارسة بسهولة، فأجبرتُ نفسي وقتئذٍ على توجيه أصابع التشكيك إليهم حيال ما يُقدمون عليه سواء عن عمد أو عن عدم الدراية بأصول الأخذ والاستعارة، وبما أن الكثير من الناس لا يودون سماع صوت الحقيقة المتعارض مع ما يرغبون به، لذا فبدلاً من ألقى الإحسان منهم على المبادرة، أو كسب كلمة الشكر على الإشارة الموجَّهة لأصحاب العلاقة حظيتُ بمجافاتهم أجمعين.
عموماً، فبالرغم من استغرابي ممن يتناولون ثلاث أو أربع وجبات في اليوم ويقضون ساعات طوال في المحادثات الجانبية حول المواضيع العادية جداً ولا يخصصون ولو نصف ساعة لنهل العلوم والمعارف، إلاَّ أن اِندهاشي يبلغ ذروته عندما أرى لدى بعضهم هوس التكلم من دون أيّ رغبة بسماع صوت الغير، ويستبد بهم هوس الكتابة من دون صرف أيَّ جهدٍ في ميدان البحث الميداني أو القراءة، كما أني مازلتُ قيد التصور بأن من بعض أهم فوائد القراءة لقارئ المكتوب وللكاتب نفسه هو أن الكاتب عندما يكون كقارئاً جيِّداً فبفضل معرفته بكتابات العصور الغابرة وإلمامه بأثرهم المطبوع فهو يخدم القارئ من خلال تقريب المسافات واختصار الزمن، ويعمل على تلخيص التجارب ويوفِّر الوقت ويقلِّل الجهد، حيث أن الكاتب المطلع على منتجات السلف لا يعيد ما قاله السابقون بحذافيره إنما يعالج الموضوع أو الحدث أو الإشكالية الجديدة بلغةٍ موجزة فلا يسرف في الشرح والتفسير، وعوضاً عن الإسهاب يستدل بمقتطفٍ من بمكتوبات الراحلين، أو يستشهد بفقرةٍ من لدنهم، طالما أن جملةً واحدة من قصص السابقين المماثلة لما يجري الآن تختصر المسافة والزمن، فلا يهدر القارئ وقته في تتبع سرد عشرات الأسطر طالما كانت الجملة المستلة من خزائن الأولين تفي بالغرض، وهي تفيد الكاتب في أنه لا يُعيد إنتاج العجلة الخشبية ويسهب في شرح آلية عملها وصعوبة استعمالها طالما أن العجلات المطاطية موجودة أمامه وهي أمتن وأفضل استخداماً وأكثر فعاليةً وسرعةً، وأكثر راحة وقليلة التكاليف والأعطال، وحتى إن رأى الكاتب بأنه قادر على محاكاة النصوص السابقة فهو كما يحاول إقناعنا بقدرته على إنتاج العجلات المطاطية، هذا بالرغم من مرور أكثر من 130 سنة على اختراع الإطارات البلاستيكية من قِبل الطبيب البيطري الإيرلندي جورج بويد دانلوب سنة 1888.
على كل حال، حتى إن حاول إعادة الإبتكار فما الذي يؤكد بأن منتجه سيكون في مستوى المنتجات الموجودة، وأقل كلفة منها، وأفضل استعمالاً من النماذج المجربة من قبل ملايين الناس، بينما الصانع المقتحم الساحة من جديد لا ضمان قط لجودة منتجه، باعتبار أنه أولاً هو غير مجرَّب أصلاً ولا شهدت بضاعته حقل الاستخدام، وثانياً ما يزال المخترع الجديد قيد التفكير بصنعه، لذا لعله من الأفضل له الإلتفات إلى صناعة شيءٍ جديدٍ بدلاً من إبتداع شيءٍ موجودٍ منذ عشرات السنين ومحتفى به في كل أنحاء العالم، وذلك تجنباً لهدر الجهد والوقت والنقود.
فهذا هو الحال نفسه مع الذي لمجرد أن تعلَّم القراءة والكتابة ورأى غيره من نجوم الكتابة، فشعر بينه وبين نفسه بأنه ليس أقل شأناً منهم حتى لا يكون نجماً لامعاً مثلهم، ناسياً أو متناسياً المضائق والوديان والجبال وحقول الألغام التي قطعها أولئك الكتاب حتى استطاعوا إيصال أصواتهم للناس بعد جهدٍ جهيد من أعلى القمة أو من قعر الوادي السحيق.
ومن الأمثلة الحية الجميلة في هذا المجال وخاصةً عندما يعرف الممسك بالقلم أو الكيبورد تخوم معرفته بالفن الذي يزاوله، والزاوية أو الجبهة التي يود اقتحامها، هو ما تمثله واقعياً الكاتب المغربي ربيع السملالي في فرعٍ من فروع الكتابة الإبداعية، الذي كان ينوي يوماً تأليف روايةٍ ولكنه عندما قرأ رواية “زوربا” توقف عن التفكير بكتابة الرواية، ربما لأنه توصل بينه وبين نفسه إلى الاستنتاج بأنه مهما حاول ووضع كل جهده في إطار الرواية التي سيكتبها فلن تكون بمستوى رواية الكاتب اليوناني نيكوس كازانتزاكيس، لذا تخلى تماماً عن فكرة كتابة الرواية، حيث يقول السملالي بهذا الخصوص: ” من الطريف أنني كنت مسكوناً بكتابة رواية قبل قراءتي لـ:(زوربا)، ولكن بعد أن قرأتها وكررتُ قراءتها، أحجمتُ عن كتابة الرواية وماتت هذه الرغبة في داخلي”، فكم يستحق الإشادة بما أقدم عليه “السملالي” في هذا الإطار، وكم الفكرةُ جديرة بالاقتداء خصوصاً بالنسبة للناشئة ممن لا تجارب تذكر لديهم، ولم ينهلوا في كل حياتهم عشرُ كتب ومع ذلك أغرتهم رؤية أسمائهم على أغلفة الكتب، أو أولئك الذين تعلَّموا القراءة والكتابة في الكبر وأرادوا صك أسمائهم ورؤية مؤلفاتهم في واجهة المكتبات عبر كتابات باهتة، واهنة، ممجوجة، مواضيعها مطروقة وأساليبها دون العادية ولا جديد فيها.
أخيراً وليس آخراً، فبالإضافة إلى أهمية البُعد عن ظاهرة الاستنساخ والتكرار والتحلف بأردية الغير من دون وجه حق، فكم سيكون جميلاً بأن يعرف الغرُّ أو الكهلُ المقتحم عالم التدوين عنوةً أو بالوساطة أو تطفلاً قدراته ويُدرك جيداً حدود إمكانياته، ويعي نقاط ضعفه ويكون أقدر الناس على معرفة مكامن قوته ليحشد طاقته في موضعها المناسب، فيكون حينئذٍ قارئاً جيداً لمنتجات الغابرين والمعاصرين، ليس لكي يعيد إنتاج ما قاله الآخرون، ولا لأجل استنساخ تجربتهم في التدوين والمعالجة، وليس من أجل اقتناص الأفكار منهم ومن ثم تلحيفها وزركشتها بكلماتٍ عصرية حتى يوهم القارئ بأنه يقرأ شيئاً حديثاً خالياً من آثار الماضي، إنما يقرأ لكي لا يُعيد ما برع به الآخرون من قبلُ بطريقةٍ وأسلوبٍ وصيغةٍ أفضل منه بكثير، وعوضاً عن المسارعة في التدبيج أن يكتفي بقراءة ما كتبوه في ذلك المضمار، ولا جناح عليه إن تراجع عما كان ينوي القيام به بما أنه غير فالحٍ فيه، وأن يختار أقرب أريكةٍ ويتمتع مع المتلقي بمكتوبات السابقين، مقتفياً بذلك أثر الكاتب الأرجنتيني خورخيه لويس بورخس القائل: “إن ما قرأه كان أهم لديه بكثير مما كتبه”، هذا بالرغم من أن بورخيس من أشهر كتاب العالم في هذا العصر، وبالتالي يفيد صاحبنا المؤِلف القرّاء بثقافته القراءاتية فيوفر جهده ووقته ووقت المتلقي ومن ثم يُصرف طاقته الشخصية في موضوعٍ آخرٍ لم يسبقه إليه غيره.