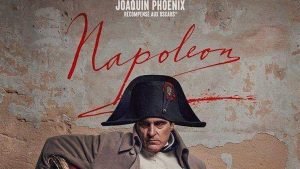أحـمد عبد الرحـيم
لى تعبير أردّده بخصوص أى مخرج يقدم عملًا لا ينتمى لتميّزه؛ وهو أن الكائنات الفضائية اختطفته، واستبدلته بشخص آخر يشبهه، ولكن ليس فى موهبته، ليقدِّم هذا الفيلم أو ذاك، الأدنى من مستواه المعهود. وفقًا لذلك، فإن المخرج الأمريكى مارتن سكورسيزى تم “اختطافه” مرتين على الأقل خلال العقد الأخير.
سكورسيزى مخرج ذو ثقافة سينمائية عالية، وأسلوب مؤثر، وعلامات فى السينما الأمريكية نالت حفاوة نقدية وجماهيرية. تنبرى أقلام عديدة قائلة إنه جنح للتجارية مؤخرًا، ولكنهم مخطئون، فالرجل – على الرغم من أفلامه الذاتية أو الفنية – كان على صلة مستمرة، وإن متقطعة، مع الأفلام التجارية؛ والدليل New York, New York أو نيويورك، نيويورك (1977)، The Color of Money أو لون المال (1986)، Cape Fear أو خليج الخوف (1991). ما حدث مؤخرًا أن العلاقة طالت، وصرنا ننتظر منه عملًا متمردًا على السائد، محطمًا للقواعد، مثل Taxi Driver أو سائق التاكسى (1976)، وRaging Bull أو الثور الهائج (1980)، وAfter Hours أو بعد ساعات العمل (1985)، أو Goodfellas أو الرفاق الطيبون (1990).. لكن بلا جدوى.
لست بصدد أسباب هذا الإغواء الأخير لسكورسيزى، وإنما بصدد فيلمين من هذه المرحلة، أعتبرهما الأقل قيمة. أولهما The Aviator أو الطيّار (2004)، الذى – رغم مشاهدتى له 3 مرات إلى الآن – لم أجد به الشىء العظيم، أو المقنع، أو سكورسيزى!
الفيلم عن حياة البليونير الأمريكى هاورد هيوز. لكن لماذا يصنع سكورسيزى فيلمًا عنه؟! الإجابة، وفق الفيلم، أن هذا التايكون الرأسمالى لم يكن المدلّل أو المتحذلق، وإنما كان رجلًا له أحلام، يدمن العمل لتحقيقها، ويدافع عنها ضد التفكير التقليدى (إنتاجه لأفلام ضد المألوف، حربه مع الرقابة، صراعه مع الحكومة لإنتاج طائرات مختلفة.. إلخ). إنه يشبه مخرج قصته الذى لطالما سعى لكسر شوكة الإنتاج التقليدى، وتصارع مع الرقابة عند اعتراضهم على العنف فى أفلامه. لكنى إن كنت اقتنعت بذلك سببًا، فأنا لم أقتنع بالنتيجة: الفيلم نفسه!
لماذا لا توجد أى إشارة تفهمنا مرض هيوز (ستعرف – من خارج الفيلم – أنه الوسواس القهرى)، أو تطلعنا على ماضيه (مشهد واحد زهيد، يكاد يكون مفرغ المعنى، لأمه وهى تحممه)؟، فى مشهد يحتفظ ببوله فى زجاجات، وفى آخر يتنصت بهوس على مكالمات عشيقته آڤا جاردنر.. ما أزمته النفسية بالضبط؟! لماذا تعامل السيناريو مع علاقته بالسينما وكأنها الترويح الدرامى؟ ولماذا بدلًا من أن نشاهد رجلًا مجنونًا بأحلامه، مسكونًا بشياطينه، شاهدنا رجلًا يعشق الأفلام الكبيرة، والطائرات الكبيرة، والصدور النسائية الكبيرة! لم أطق ليوناردو دى كابريو فى دور البطولة. إنه بوجهه الصبيانى الأملس، وصوته الطفولى الرفيع، بدا كغلام فى ثياب وماكياچ رجل ناضج، ناهيك عن كونه لا يشبه هيوز الحقيقى شكلًا. الواقع أن حضور دى كابريو وموهبته أبعد من تقديم ثلاثة أرباع الشخصيات التى يمثّلها، ليصبح من أضعف العناصر فى أغلب أفلامه، وعمله مع مخرجين كبار فى كل مرة يزيد المفارقة سوءًا. اللقطات المولَّّّدة بالكومبيوتر كانت مكشوفة فى عدد من اللقطات, وإصرار سكورسيزى على تصوير كل مشهد بطريقة مقارِبة لونيًا للتصوير فى أفلام الفترة التى يدور فيها المشهد؛ لم يصل إلى شىء ملموس أو فعّال، وانتهى إلى مجرد تلذُّذ ذاتى.
ما أحببته لم يخرج عن لقطة يرى ويسمع فيها هيوز، مكتئبًا، مياه الصنبور وكأنها سيول من سكاكين، ومشهد يتناول فيه الغداء مع أقارب كاثرين هيبورن، الذين – على حد تعبيره – “غير مضطرين للعمل لثرائهم”، حيث يتكامل الحوار مع الأداء والمونتاچ لخلق حالة صدام بديعة بين حالم يكافح ونيام يثرثرون. مشهد سقوط طائرة هيوز كان مبهرًا، وإن كنت رأيت مثله، وأفضل، فى أفلام أخرى؛ لكن قد يكون هذا هو قصد سكورسيزى، أن يُظهِر – للاستديو أو لنفسه – أنه قادر على صنع مشاهد “هوليوودية” كما الآخرين.
على صعيد الإخراج، رأيت بوضوح أن سكورسيزى يعمل بلا شغف، ويُتم الأمور بدون رغبة فى التفرد، والحق أنى لم أره “لامبالى” لهذه الدرجة من قبل. ربما كان الفيلم صفقة ليس إلا؛ عملًا مبهرًا عن المليونير الأشهر، يعطى فيها الاستديو ما يريدون كما يريدون، كى يعطوه لاحقًا التصريح بفيلم يفعل فيه ما يريد كما يريد، وإلا قد يكون هذا هو أكثر فيلم بلا مذاق لسكورسيزى.
..يتنافس على هذا اللقب فيلمه التالى مباشرة The Departed أو الراحل (2006)، المقتبس عن الفيلم الهونج-كونجى Infernal Affairs أو علاقات جهنمية (2002)، والراحل فيلم تشويق يدور فى عالم العصابات، تخصُّص سكورسيزى السابق، لكن الأمريكية-الإيرلندية هذه المرة، وليست الأمريكية-الإيطالية كما رأينا فى Mean Streets أو شوارع حقيرة (1973)، وGoodfellas أو الرفاق الطيبون (1990)، وCasino أو الملهى (1995)، عن ضابط يعمل متخفيًا ضمن مجرمين، ومجرم يعمل متخفيًا وسط ضباط، ورحلة كلٍّا منهما لكشف الآخر. فى البداية، ظننت أنى على موعد مع فيلم مثير، قد يحمل معنى فكريًّا، لكن المحصلة كانت أقل قيمة، وتعانى من مشاكل عديدة.
تطوُّر الخط الزمنى كان غريبًا؛ ففجأة، وعبر مشهدين عاديين، تنقضى سنة كاملة. الطبيبة النفسية تقع فى حب البطلين، ولا أحد من أى فريق يدرى بالأمر. رئيس العصابة تارة يتاجر فى المخدرات، وتارة فى السلاح، وتارة يبيع أسرارًا صناعية للصين، وتارة يدور الشوارع جامعًا إتاوات (!)؛ أهو زعيم مجرمين، أم مجرم صغير، أم الجريمة ذاتها؟! شخصية الضابط الشريف دائم الإنفعال (أداء مارك والبرج) عجزت أن تكون ترويحية، أو منطقية، أو مُحتمَلة. كلمة السباب الرئيسية فى الإنجليزية، والبادئة بحرف F، منطلقة بمجانية وفيرة (237 مرة). عكس أفلام سكورسيزى السابقة عن العصابات، لم يصغ السباب مناخًا واقعيًا، وإنما أضاف – بالإفراط المخيف فيه – زيفًا، ومللًا، وعصبية. ثم كيف – بالله عليكم – عملية بوليسية خطيرة، كإرسال عميل فيدرالى مُتَخَفًّ لعصابة، لا يعلم بها إلا ضابطان فقط؟!
بذكر الضابط المتخفى كمجرم، قدّم دى كابريو، بتوتر مُبالَغ فيه طوال الوقت، أداء كوميديًا من الطراز الأول، لدرجة اعتقادى فى لحظات أنه سيعترف على نفسه، وينفجر صارخًا: “اقتلونى وخلِّصونى من بؤسى!”، مات ديمون، فى دور المجرم المتخفى كضابط، كان بوجهه المسطح، وتعبيراته الباردة، ضعيف الحضور والأداء. أنا لم أكره شخصيته، وإنما كرهت عجزه عن جعلى أكره شخصيته، أو أنفعل بها أصلًا. ڤيرا فارميجا، كحبيبة للبطلين، كانت بين متوسطة وضعيفة. لا يوجد حب فى عينيها، وإنما رعب أزلى، ولا يوجد كيمياء تجمعها وأيًّا من نجمى الفيلم، ولا يوجد شك أنها بدت أكبر منهما سنًا! مارتن شين، كالضابط المتابع للعملية، كان جليديًا كالمعتاد، ولكن هذه المرة أستطيع لوم السيناريو أيضًا، الذى لم يوفِّر له أى شخصية. إلا أن أحدًا لم يكن أسوأ من چاك نيكلسون كزعيم العصابة. ظن سكورسيزى أن التكلم ببذاءة وصخب، مع ترك الحبل على الغارب لنيكلسون وارتجالاته، سيصنع شخصية فريدة، ولكن كم كان مخطئًا، لأن ما شاهدته لم يزد على كونه خليطًا من الچوكر (شخصية شريرة أداها نيكلسون سابقًا فى فيلم Batman أو الرجل الوطواط 1989)، ونيكلسون نفسه فى حالة غرور. لذلك – مثلًا – تحوّل مشهده الرئيسى مع دى كابريو، عند شكه فى هوية الأخير، إلى اسكتش كوميدى غير مضحك، بدلًا من لحظة فائقة الجدية والسخونة.
عندما يتذمّر الذراع الأيمن لرئيس العصابة (أداء راى وينستون)، قائلًا بحكمة ومرارة: “يا لها من أمة فئران!”، قاصدًا كثرة الخونة، لابد أن تضحك بحزن. “تضحك” لأن هذه هى طريقة السيناريو لإدخال تعليق اجتماعى ما فى فيلم مشوّق، يخلو أساسًا من التشويق، و”بحزن” لأن هذا يأتى من مخرج تعوّدنا منه على ما هو أذكى. أعلن سكورسيزى أن فيلمه عن “غياب الثقة فى المجتمع الأمريكى بعد 11 سبتمبر 2001″، بينما أراه عملًا ساخرًا عن الموضوع، لاسيما مع المجرزة الهزلية التى تختم الأحداث.
إخراج سكورسيزى هنا لم يُدهِش، أو يؤثر. كأغلب أفلامه، الإيقاع سريع، لكن مع غياب لمسة الرصانة. السيناريو يفتقر إلى قوة الإقناع، وكأن لا وقت لديه، لذا يعطينا “عناوين الأخبار” فحسب، ومع المونتاچ المسعور استحال الفيلم لإعلان مهتاج طويل، فاقدًا أى بعد ثانٍ، أو جوهر متعقل، ليتبقى منه فيلم بوليسى متوسط القيمة، من النوعية التى تتأسى بعدها قائلًا: “كان له أن يكون أفضل..”. وإذا ما نبّهتنى لفوزه بأوسكار أحسن فيلم، فسأجيبك بأنه واحد من شهود النفى فى قضية اقتناعى بالأوسكار، وما أكثرهم!
ليست مشكلة أن يُخرِج سكورسيزى، أو أى مخرج، فيلمًا تجاريًا. المشكلة أن يكون فيلمًا غير ممتع، وغير مقنع، وليس فى تميز صاحبه. وعمومًا، دعنا نحمد الله أن الكائنات الفضائية لا تختطف سكورسيزى طويلًا. فى حالات أخرى، قد يختطفون مخرجًا لنصف مسيرته الفنية، أو يتركونه يُخرج فيلمًا واحدًا رائعًا ثم يستولون عليه للأبد!
…………………
نُشرت فى مجلة أبيض وأسود / العدد 30 / يونيو 2014.