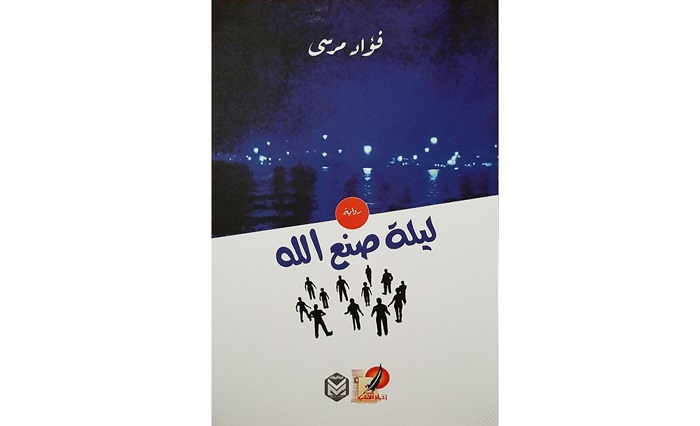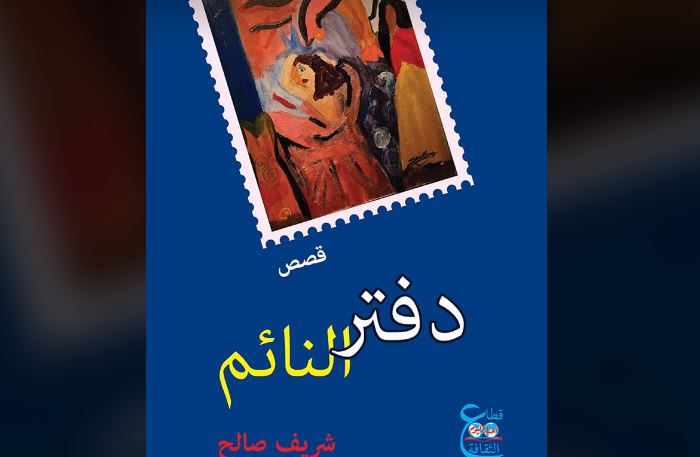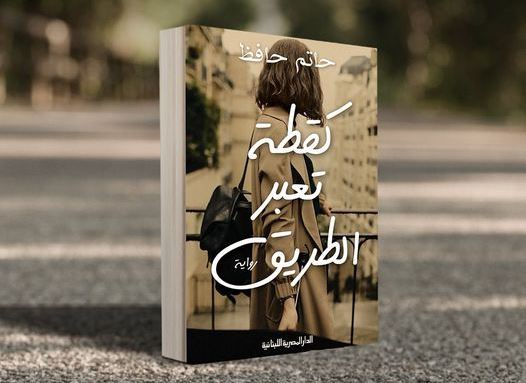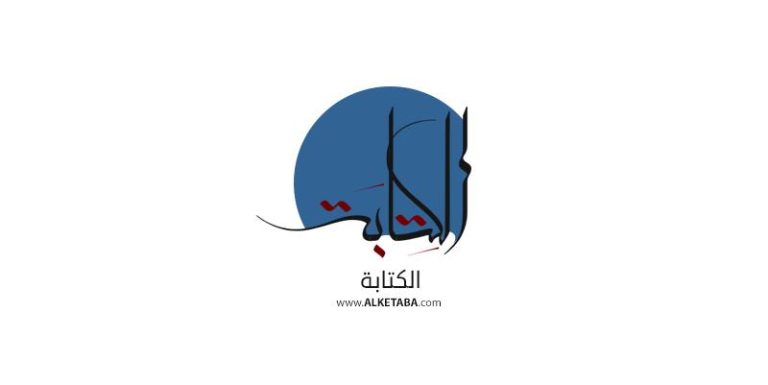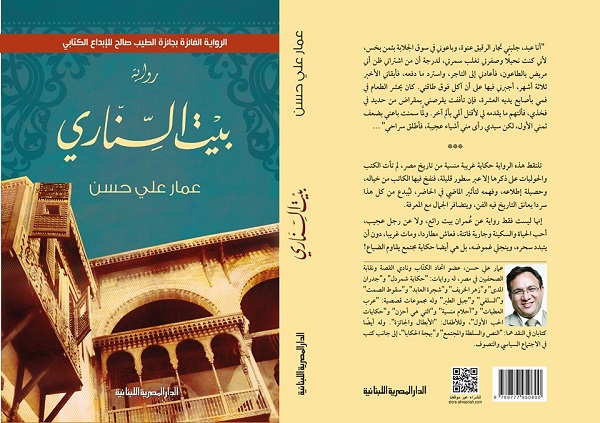بولص آدم
نصّ «عفوية» للأديبة المصرية ابتهال الشايب، يُعد تجربة سردية تتداخل فيها الأبعاد النفسية مع الرمزية الدقيقة، ليقدّم للقارئ رؤية مختلفة عن طبيعة الكتابة والوجود والمعنى. النص تجربة فكرية وحسّية تتناول الإنسان داخل ذاته، في عزلة من نوع خاص، يسعى لفهم العالم والكتابة، لكنه يواجه الحدود الداخلية والخارجية في آن واحد. الغرائبية في قصص إبتهال الشايب القصيرة تتولّد غالبًا حين يقتحم الاستثنائي مواقف الحياة اليومية، فينشأ من هذا التداخل منعطفٌ حادٌّ يواجه فيه البطل إدراكًا مفاجئًا أو سؤالًا مفتوحًا. وتتعمّق هذه الغرائبية بفضل السرد المكثّف واستخدام الرموز والإشارات الدقيقة، مما يدفع القارئ إلى استكشاف خلفية الأحداث بنفسه. تركز القصة على لحظات وجيزة ذات دلالة عميقة، وتترك مساحةً واسعة لتأويل القارئ وتقديره الشخصي لما يحدث. وغالبًا ما تفضي هذه الغرابة إلى منعطفٍ مفاجئ أو بصيرةٍ نافذة تمنح القارئ درسًا أو عبرة تتجاوز حدود الحكاية الظاهرة.
الرمزية في النص تظهر منذ البداية، حين تُذكَر الفراشات التي “كتبت ثلاث كلمات على حائط المستقبل”. هذه الفراشات لا تمثل الطبيعة وحدها، هي رمز للإلهام، للكتابة، ولوجود الآخر الذي يعطي معنى للذات. كلمات الفراشات الثلاث، رغم بساطتها، تحمل قيمة تجسيد للكتابة التي تأتي بلا تخطيط، للمعنى الذي يتشكل خارج إرادة الإنسان، ولقدرة العالم على فرض تواصله على الذات. يُعد تطور الفراشة من يرقة إلى شرنقة ثم إلى فراشة رمزًا قويًا للتحول والقدرة على بدء حياة جديدة، هذه الفراشات أحيانًا تكتب للذات الساردة، وأحيانًا لا تكتب، وهذا التذبذب يرمز إلى الطبيعة المتقلبة للإبداع والمعنى، وكأن النص يقول إن الكتابة لا تُمتلك، بل تُعاش وتُستقبل.
الجدران، التي تتكرر رمزيًا في النص، هي الأكثر قوة في تجسيد الذات البشرية: هناك “حائط المستقبل” الذي يمثل التطلعات والرغبات، و”حائط الماضي” الذي يمثل الذاكرة وما تم تجاوزه، و”حائط المختلط” الذي يضم الأحلام والآلام، و”حائط المشكلات” الذي يرمز إلى الاصطدام بالواقع اليومي. عندما يقول الراوي إن “الجلد كان يحيط بي من كل جانب”، يتحوّل الجلد إلى استعارة للحدود الذاتية، بينما الحوائط الرمزية تمثل محدودية الفعل والوعي. هذا الانغلاق الذاتي يعكس تجربة الإنسان المعاصر في مواجهة العالم واللغة: كل ما يأتي من الخارج — الفراشات، الحجر، الرصاصة، الورقة، الغبار — يترك أثرًا في الذات، لكنه لا يحررها بالكامل، بل يذكّرها بضعفها وعجزها عن السيطرة على معنى ما. التصوير في القصة يتجه نحو خلق صور لا يمكن تفسيرها منطقيًا، وتحفيز الخيال من خلال وضع رموز مألوفة في سياقات جديدة.
في «عفوية»، يدور الزمن في حلقةٍ مغلقة، كأنّ الذات الساردة محكومةٌ بتكرارٍ أبديّ لا فكاك منه. إنّ وجود بدايتين متتاليتين («بداية 1» و«بداية 1 مكرّر») يُمثّل إعلانًا رمزيًا بأنّ الوجود نفسه فقدَ خطَّ سيره، وأن الزمن لا يتقدّم نحو نهايةٍ، بل يعود دومًا إلى نقطة البدء: إلى العجز نفسه، والرغبة نفسها، والبحث نفسه. هذا الدوران يجد صداه في إحدى عشرة نهايةً مقطعيةً مرقّمةٍ تتوالى دون اكتمال؛ فكلّ نهايةٍ هي انطفاءُ محاولةٍ جديدةٍ للكتابة، وكلّ انطفاءٍ يفتح فراغًا جديدًا للانتظار. إنّ هذا التكرار اللامتناهي يُحاكي فلسفةَ العود الأبدي كما تخيّلها نيتشه، لكنه هنا مشبعٌ بحسٍّ إنسانيٍّ شفيف؛ إذ تكتب الشايب عن ذاتٍ تعيش الوجودَ كمتاهة، وعن الكتابة كفعلٍ يتجدّد رغم خيبته. وفي جوهر هذا البناء تتجلّى روحُ ما بعد الحداثة، حيث الزمنُ شبكةٌ من الاحتمالات، والنصُّ عفويةُ تجربةٍ مستمرّةٍ تُعاد صياغتُها مع كلّ محاولة، وكلّ قارئ، وكلّ خسارةٍ جديدةٍ للمعنى.
الرمزية هنا ليست سريالية بالمعنى التقليدي، لكنها تشترك مع السريالية الجديدة في كسر المنطق الظاهر وإظهار العمق المخفي للذات والمجتمع. الماء الذي يرنّم به النص، والذي عادةً يرمز للتطهير أو الحياة، يتحول إلى عنصر ثقيل بلا جدوى، وكأن الحوادث والعوالم الداخلية للذات تفقد من فعاليتها الطبيعية، ويصبح الإنسان عاجزًا أمامها، في “نبل العاجز” الذي يميز التجربة الوجودية للراوي. الحجر والرصاصة والورقة ليست مجرد أدوات، بل رموز للمقاومة، للصمت، وللحرمان: كل شيء في النص يتحول إلى حدث داخلي يعكس الصراع مع الذات أكثر مما يعكس العالم الخارجي.
التكرار والبدء من جديد، الذي يظهر في النص، يعكس فلسفة الإنسان الباحث عن معنى في عالم متغير، حيث كل محاولة للكتابة هي محاولة لتجاوز العجز، وكل كلمة مكتوبة أو مفقودة تُعيد رسم حدود الذات. النص يشبه المرآة المتصدعة التي تعكس الحلم والواقع معًا، حيث يُصبح الفشل جزءًا من جمال الكتابة نفسها. النص هنا لا يروي الحكاية التقليدية، بل يصوّر التجربة البشرية للانتظار والحرمان والبحث عن أثر.
في ضوء حساسية ما بعد الحداثة، يكشف نصّ «عفوية» لابتهال الشايب عن وعيٍ لا يملك مركزًا ثابتًا، بل يتحرك بين الداخل والخارج، الحلم والواقع، في فضاء تتبدّل فيه الرموز مع كل قراءة. نبل النص ينبع من عجزه الشريف؛ من الإصرار على الكتابة رغم إدراك استحالة الوصول إلى المعنى الكامل. وعندما نبلغ الجملة الختامية: «الفراشات بالتأكيد في مكانٍ آخر»، ندرك أن الشايب لا تغلق الدائرة، بل تفتحها على احتمالات الحلم. فذلك “المكان الآخر” قد يكون الكتابة ذاتها، أو العالم الذي لم يُكتب بعد، أو الذات التي ما زالت تنتظر فراشاتها لتكتبها من جديد. وهكذا يتحول النص إلى تأمل عميق في جوهر الإبداع والوجود، حيث يبقى السؤال معلّقًا في الهواء: هل نكتب لأننا نعرف، أم لأننا نحاول أن نعرف؟