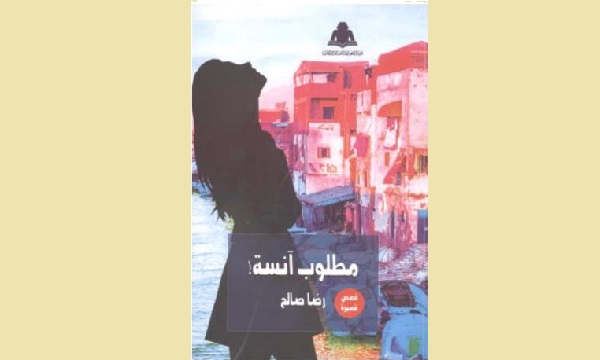عبد اللطيف النيلة
على امتداد مساءات عصيبة وأنا مشدودة، في توتر، إلى الطريق المتربة المحفوفة من جانبيها بالنخيل. تتسمر عيناي على كل عابر يلوح متسللا من فتحة السور القديم. في تثاقل تخطو القدمان مثيرتين غبارا خفيفا، فتنكتم أنفاسي، وتتسارع نبضات قلبي، وأكاد أتطاول برأسي إلى الأمام. يغادر العابر ظلال الشفق، يسقط الضوء على وجهه، فيما نظراتي ترنو إليه في تنبه أقصى. يَخيبُ تفرّسي، فأخفض أجفاني مبتلعة ريقي. أرفع كأس عصير التفاح إلى فمي، في محاولة لمداراة انفعالاتي، أرشف رشفتين دون أن أحس بطعمهما، إلا أن الرجفة التي تتخلل أصابعي تفضح ما يعتمل في أعماقي. وحين تصطدم قاعدة الكأس بزجاج الطاولة، يتنبه إليّ الأصحاب فيلقون علي نظرات قلقة. لكنهم لا يلبثون أن يغرقوا في الحديث، بل يحاول بعضهم إشراكي في الموضوع المثار، وتعلو ضحكاتهم من لحظة لأخرى. يستولي عليّ الصمت، ولا أشعر بأدنى رغبة في الكلام، بيد أني أرغم نفسي على إلقاء عبارات مقتضبة حين أفطن إلى شرودي. بمنديل أمسح العرق الناضح من جبيني، وأستشعر تعاطفهم معي. يصبح وقت انتظاري ثقيلا ولزجا، وأركّب رقم حميد مرارا، فلا يجيبني غير الرنين الطويل القاسي. أغرق في عالمي الداخلي، تتقاذفني الهواجس. إلا أن تعليقاتهم المازحة تنتزعني من عزلتي؛ يقول لي البهجة:
“لا عليك، سيأتي حميد عندما يضع اللمسات الأخيرة على ملحمته الغزلية الموسومة بعنوان: مجنون سعاد”.
تعقب لطيفة: “سَعْداتْكْ آختي! لقد أطاش هواكِ عقلَ الرجل حتى أضاع اتجاه القِبلة وما عاد يعبأ بمواعيدنا!”.
يتدخل ابراهيم: “الحقيقة أنه منشغل بالتفكير في أسرار هدم العوالم الفاسدة”…
بتلقائية يخلقون جوا من الفكاهة، فينشرح صدري قليلا، إلا أن عيني لا تفتآن تسرحان، من حين لآخر، في الطريق المتربة المحفوفة بالنخيل.
***
أشرد وأنتظر، وحميد لا يأتي.
تأتي اللحظات التي تقاسمناها معا، ويأتي حميد، في شريط ذكرياتي، شبيها بنفسه في كل لحظة، لكنه يبدو مختلفا في اليوم الأخير؛ جلسنا مثلما دأبنا حول الطاولة المربعة، وذهب النادل لتلبية طلباتنا، وأخذت أنتظر حميد. كان غالبا ما يقبل في اللحظة الأخيرة، إلا أنه لم يتخلف قط عن الموعد. ولما أهلّ رأيته متعبا شاحب الوجه تتصبب حبيبات العرق من جبهته وأرنبة أنفه. ألقى التحية ببرود، وجلس بجواري.
” الجو مختنق هذا المساء”، قلت له متطلعة إليه في قلق.
“والكلاب تخنقنا أيضا”، أجابني فيما هو يخرج علبة السجائر من جيب قميصه الرمادي.
“أنا أتحدث عن الجو”، قلت متبسمة في محاولة لتلطيف التوتر.
” وأنا أتحدث عن الكلاب”، رد وهو يشعل سيجارة “كازا” التي لم تكن مزودة بمصفاة.
“عن أي كلاب تتحدث؟”، قالت لطيفة كأنها اختطفت السؤال من بين شفتي.
قطب حميد وجهه في تذمر واضح، وبدا عاجزا عن التعبير؛ فتح فمه مصدرا همهمة وحرك أصابع يديه بعصبية. فتدخل ابراهيم مازحا:
“دعوا الرجل وشأنه، لعله يتحدث عن الكلاب التي في رأسه، فمن يشرب لفافة حشيش في هذا الجو الربيعي لا بد أن تتخايل له السباع والضباع، لا الكلاب فقط”.
ضحكنا جميعا إلا حميد الذي بان عليه الامتعاض. اكتفى بسحب أنفاس عميقة من السيجارة، ونفثها في الهواء لائذا بصمت قاس. في تلك اللحظة بالذات، حمل النادل العجوز إلينا الطلبات، وسأل حميد، في لطف، ماذا يريد أن يشرب. حدق حميد في وجه النادل طويلا، وعلى ملامحه تعبير من يعلن: ” من أين قطر السقف بهذا الأبله؟”. غرق النادل في الحرج، وبدا مرتبكا وهو يعيد سؤال حميد عن طلبه. “لا رغبة لي في شيء، اتركني وشأني”، رد يوسف بصوت خفيض. افتعل النادل ابتسامة: “طيب، سأعود إليك عندما تلتقط أنفاسك أَسّي حميد”. بنبرة حازمة كرر حميد عدم رغبته في شيء، فعاد النادل إلى الابتسام: “أعرف أنك تحب القهوة المهروسة، لا تهتم، سأحضر لك فنجانا على حسابي”. فانفجر حميد في وجهه: “خذ قهوتك للكلاب!”. مصدوما، راح النادل يكرر أنه لم يقصد الإساءة. فجأة انقض حميد على عنقه، فأخذ النادل يدفعه عنه صائحا: “الله يهديك أسي حميد!”، فيما بذلنا ما بوسعنا لجر حميد بعيدا.
غمرني يومها إحساس طاغ بأن حميد لا يشبه إطلاقا حميد الذي أعرف. كان يعامل النادل العجوز بلطف، يتجاذب معه أطراف الحديث حول أحواله، يترك علبة السجائر في متناوله، وينفحه بقشيشا كل مرة. ما الذي حدث إذن؟ عجزت عن تصديق ما رأت عيناي، كنت أمعن فيه النظر وأتساءل عن سبب التغير الذي طرأ عليه. حتى معي كان مختلفا ذلك المساء.
“دَخْلي سوقْ راسْكْ أَسُعاد!”، هكذا صرخ في وجهي، بصوت جاف بارد، عندما سحبته من ذراعه لأبعده عن النادل العجوز.
في الطريق، ونحن معا، هدأ قليلا. أصغى إلي وأنا ألومه على تصرفه الغريب مع الرجل المسكين، لكنه فاجأني: “عيناه لا تكفان عن الدوران!”. سألته إن كان يقصد أنه يتجسس على رواد المقهى، فأومأ بالإيجاب. رددت عليه: “حْشومة عْليك تظلم الرجل”. أحسست بيده تضغط قليلا على يدي، وقال إنه لم يعد يفهم ما يجري من حوله، وإن الأمور صارت تختلط عليه هذه الأيام. أرعبني كلامه، فسألته عما به، فأجابني بأنه سيخبرني فيما بعد. وحين مد يده يودعني، أسرّ إلي: “منذ أيام وأنا أخوض صراعا حاميا ضد الحشيش”.
***
يأتي حميد بجسمه النحيل ووجهه الأسمر وعينيه الجاحظتين، يلقي التحية على الأصحاب، ويصافحني بحرارة قبل أن يقتعد الكرسي الشاغر بجواري. أنظر إليه في بساطة ثيابه جالسا بهدوء، لكن حزنا دفينا يطل باحتشام من عينيه. رغم قلقي عليه، فإني كنت مفتونة بمسحة الحزن التي كانت ترين على صفحة محياه، وبذلك الصمت العميق الذي يسبغ عليه غلالة من النضج والكبرياء، إلا أني كنت أنزعج من شروده. يسافر بعيدا ويتركني وحدي، وحين أسأله: “إلى أين ذهب بك التفكير؟”، يبتسم ولا ينبس ببنت شفة. قلت له، ذات مرة، ونحن معا وحدنا، نفترش عشب الحديقة العمومية:
“هل ترانا أتينا إلى هذه الخضرة لنغرق في الصمت المتأمل؟”
“وماذا عساي أقول؟”.
“أصبح الآخرون يُنسونك حتى نفسك!”.
“وهل هناك فرق بيني وبين الآخرين؟ مصيرنا واحد كما لا يخفى عنك”.
“وأنا؟ ما موقعي من الإعراب؟”.
يضحك: “أنت؟.. أنت امرأتي”، ويغرق في عيني.
“لكن لماذا لا تفكر في نفسك قليلا؟ إلى متى هذا الركض من مكان إلى آخر؟ إلى متى ذلك السيل من الحلقات والنقاشات والتظاهرات وما لست أدري؟”.
“تلك أشياء لابد منها.. من أجلنا معا ومن أجل أبي ومن أجل الآخرين”.
أعقب مشيرة بسبابتي إلى فمي: “اخفض صوتك فنحن في مكان عمومي”.
يطبق علينا الصمت، وتُسمَع زقزقات عصافير وهسيس حشرات، ويهز النسيم أوراق الأشجار. أرى إلى قميص حميد، عند الصدر تماما، يعلو ويهبط بانتظام، وأسترق السمع إلى أنفاس حميد. يشعل سيجارة “كازا”، يسحب الدخان وينفثه، ثم تمسك يده يدي، ويشرع في الحديث عن حادثة أبيه الخَضّار.
***
بعد الفجر يعلق شكارته على كتفه ويرتدي جلبابه الصوفي، ثم يمضي إلى سوق الجملة. حركة وجلبة دائبين. تجار خضروات وفواكه، شاحنات وصنادق وعربات، وزبائن. يشتري قسطا من الخضر الأكثر استهلاكا؛ البصل والطماطم والبطاطس، ويعود صحبة سائق العربة المجرورة ببغل إلى السوق المنتشر خلف سور المدينة القديمة. فوق مساحة السوق العارية تبدأ حرب الأعصاب. بمجرد أن تلوح البزة الكاكية بجسمها العريض وحذائها المنتفخ الأسود، يطلق الباعة المتجولون سيقانهم للريح، ينقل بائعو النعناع دراجاتهم إلى أمكنة آمنة، أما أصحاب العربات الخشبية فمنهم من يلتمس مهلة، ومنهم من يتوارى في الأزقة المجاورة إلى حين، ومنهم من يدس ورقة مالية في جيب البزة الكاكية. لكن لا أحد يفلت حين تأتي سيارات “الهوندا”. تنتشر في أرجاء السوق بزات كاكية كثيرة، يعم الاضطراب السوق، وكل من ضبط متلبسا بالبيع تحجز بضاعته ويقذف بها داخل جوف “الهوندات”.
في تلك المرة، دفع أبوه عربته الخشبية بما وسعه من قوة وطفق يركض. ترك خلفه عدة صناديق ممتلئة خضرا وجوالات بصل، وأراد أن لا تمتد أيديهم إلى حمولة العربة والميزان. كان يدفع ويركض، ومن ورائه بزة كاكية تطارده. عجلات العربة الخشبية تتدحرج في سرعة على الإسفلت، وهو يركض متصببا عرقا ويلهث، والبزة الكاكية تلهث. ثم صارت الطريق شديدة الانحدار، فانطلقت العجلات تتدحرج بجنون، لم يعد يبذل أدنى جهد في دفع العربة، لكن البزة الكاكية لم تكف عن الركض وراءه. فجأة انحرفت العربة الخشبية، لم يكن بوسع أبيه أن يتحكم في توجيه دفتها، أصبح منساقا خلف العربة، لترتطم أخيرا بمقدمة شاحنة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.
“لا شك أن حسنة من حسناته قد دفعت عنه البلاء والبأس”، هكذا كانت أم حميد تعلق كلما أثير الحديث عن الحادثة المشؤومة.
لم يلق أبوه حتفه، لكن الشاحنة سحقت قدميه معا وهشمت عظام ساعده الأيمن. ظل لفترة طويلة تحت العلاج، ثم غادر المستشفى بقدمين مبتورتين وساعد معاق. أصبح حبيس كرسي الإعاقة، يتتبع ما يجري في البيت تحت أنظاره ويعقب على الكبيرة والصغيرة بصوت زاعق، وكان على ضجره أن يبلغ أقصاه قبل أن يتنازل عن رفضه الجلوس في الخارج بالقرب من باب البيت.
عبثا أحاول الانفلات من ضغط تفاصيل الحادث، تبتل عيناي بدمعتين ساخنتين، فتمسحهما أصابع حميد بامتنان تومض به عيناه الغائرتا الحزن. تستقر رأس سبابته فوق خالي الأسود، يتحسسه برفق، ويقول لي متبسما كأنما يسعى إلى تبديد سحائب المرارة التي خيمت علينا: “لا أدري لماذا لم يواصل هذا الخال تدحرجه من جدار أنفك حتى يصل إلى قلب خدك؟”. أضحك بعذوبة، فيما يؤوب حميد إلى الصمت المترع بأنفاس التبغ.
***
كنت أتلفت حولنا دائما، وأقول لحميد اخفض صوتك، وحتى في غرفة إبراهيم كنت أصغي إلى كلماته وأشير مازحة إلى الجدران: “إن لها آذانا!”.
يستلقي حميد فوق السرير، عيناه الجاحظتان تنغرسان في لون السقف الأزرق، وأصابعه تتشابك خلف رأسه. أجلس على حافة السرير، أتحسس شفتيه بأناملي: “ألا ترى كم احترقتا؟”، تطوق أصابعه السمراء يدي، ويطبع قبلة على أناملي. وعندما يشرع في إعداد لفافة الحشيش، أحدق فيه بنظرة غاضبة: “متى تنقطع عن هذا السم اللعين؟”. على ملامح وجهه يرتسم الإحساس بالضيق، ويقول إنه ببساطة يجد نفسه في لحظة النشوة، قبل أن يردف بأنه لم يعد يطيق أن يرى أباه يتدهور، يوما إثر يوم، وقد صارت أعصابه مستنفرة، وأمه تتحامل على نفسها لتفترش أرض السوق طوال ساعات تبيع الخبز، فيما أخته تسهر ليلا ولا تعود إلا مع أول أشعة الصباح…
لكني لا أتركه يستسلم لمراراته، أشعل موسيقى صاخبة تضرم الطرب في الدماء، وأشعل ضوء الأباجورة الأحمر الخافت، أختطف منه اللفافة وأفتتها، أضع يدا على ذراعه وأخرى على ساعده لأسحبه إلى قلب الغرفة. يرتخي بين يدي باستسلام، فنرقص على إيقاع الموسيقى، وأهمس له من فوق كتفه: “هذه هي النشوة حقا!”. يشد على خصري، ويضحك من أعماق قلبه كطفل كبير.
ويوم أخبرني بأنه انقطع عن تعاطي لفافة الحشيش، رقصت روحي جذلى. قال إنه نفذ رغبتي، لكني خشيت أن يكون الأمر مجرد نزوة عابرة.
***
بعد أيام الترقب والانتظار أخبرني البهجة، في تردد مترع بالحرج، بأنه ذهب صحبة إبراهيم لزيارة حميد، فأصيبا بالصدمة.
بينما هما في على بعد خطوات من مسكنه، تناهى إليهما صوت زاعق: “وا وْجوهْ الجوع! وا وْجوهْ الجوع!”. تلفتا بحثا عن مصدر الصوت، فاكتشفا حميد يطل من خلف جدار دار خربة ويكرر النداء. فوجئا لأنهما لم يعهداه مازحا بتلك الطريقة الغريبة. قفز خارجا من الدار الخربة، ببنطال بني وجاكت بلون حائل، وأشعل سيجارة من سجائره الرخيصة، وأخذ يحدق فيهما بعينين أصبحتا غائرتين بهالات زرقاء. سأله البهجة عن أحواله، فرد:
“أولاد الحرام قتلوني!”.
“ماذا وقع؟”
“رجاء دعوني وشأني!”.
“نحن أصحابك يا حميد، أخبرنا ما الذي يقلقك؟”.
“حتى لو بتُّ أشرح لكما إلى حدود الصباح لن تفهما شيئا!”.
يقترحان عليه الجلوس في مقهى ليتكلموا بحرية، فيرفض. وفيما هم يتمشون بعيدا عن الزقاق، يعرض عليه البهجة تدخين لفافة حشيش، فيرد:
“ألا تعلمان أني هجرتها؟ منذ أيام، بل منذ أسابيع. لم يكن الأمر سهلا، لقد قاومتها طويلا بضراوة، ابنة العاهرة لا تريد أن تفرط في، تتشبث بي باستماتة. تصورا أنها عاقبتني بالأرق والصداع، لأيام وأنا أضع رأسي على الوسادة دون جدوى، أرغب في النوم والنوم يستعصي، كل من في البيت ينام حتى أني أسمع شخير أبي، إلا أنا. ألف الإزار الأبيض حول جسدي العاري تقريبا، ويتناهى إلي هسيس الحشرات، الصهد والأرق والظلام ورأسي يدور ويؤلمني، شربت أنواعا مختلفة من الأدوية، لكن دون تأثير يذكر، وحين أخذت أتناول الحبوب المنومة أتاني النوم أخيرا، لكنه كان نوما رهيبا، كوابيس رهيبة حيث أرى كلابا تنهش أبي وأمي وأختي وتركض ورائي بسعار”.
توقف عن الكلام لحظة، قبل أن يردف بسحنة شابها خليط من الخوف والكراهية والغضب:
“لكني أعرف أنهم وراء كل ما يحدث لي؟ أولاد الحرام يستلذون تعذيبي”.
“من تقصد؟”.
“من غير الكلاب؟”.
جال بنظرات زائغة في ما حوله، وأشار بيده:
“انظروا! إنهم منبثون في كل مكان!”.
***
صارت غرفتي الصغيرة غارقة في الفوضى، حتى أصبحت أمي لا تكف عن مطاردتي بتعليقاتها اللاذعة، وتقول لأبي إنها لا تعرف ما الذي أصاب ابنتك، لم تعد تهتم بنفسها، ولم تعد تأخذ حذرها في غسل الأواني، ولم تعد تشاهد التلفاز، وأنا منطوية على نفسي، غارقة في الصمت لا أعلق بشيء. غياب حميد خلف فراغا هائلا في حياتي، وما وصلني من أخباره رج روحي رجة عظيمة. الأسوأ أني لم أعد أجد سبيلا للاتصال به؛ هاتفه مقفل على الدوام، ومحاولات البهجة وإبراهيم لحمله على المجيء إلى المقهى أو أي مكان آخر ألتقيه فيه، باءت بالفشل.
أخيرا قررت أن أذهب لزيارته، رغم أني أدرك أن وضعي غير الرسمي بالنسبة إليه سيخلق لي حرجا مع أسرته. إلا أني عولت على الاحتماء بالبهجة للتمويه على حقيقتي.
طرق البهجة الباب، ففتحت لنا أخت حميد. سألها عنه، فأخبرته بأنه خرج، وأردفت “مشية بلا رجعة”. وقبل أن يهم باستفسارها عن سبب سخطها عليه، أقبلت أمها ودعتنا إلى الدخول ساحبة البهجة من يده، كما لو أنها تريد أن تشهده على ما ارتكبه حميد. صحن الدار كان في حالة تدعو للرثاء؛ ثياب مبعثرة، حبل غسيل متدلٍّ على الأرض وجفنة غسيل، ماء موحل يغطي سطح الزليج المتآكل، ديك طليق يتنقل صائحا في مساحة تناثرت فوقها فضلات الطعام إلى جانب برازه المتيبس. قالت أم حميد:
“أرأيت يا ابني ماذا فعل صاحبك؟ ها أنتذا ترى بعينيك، حالتنا تْشفّي العْدا، لقد تشاجر مع أخته وقطع الحبل”.
“ولكن لماذا؟”
“لا أعرف ما الذي حل به، لم يعد يترك أي حبل سالما، هذا الولد سيُحَمِّقُني، في الليل لا يكف عن الهذيان، هات تلك الحبال! بكم تلك الحبال! جروا الكلاب إلى هناك! وكلام آخر لا معنى له، كأنما ضربه عفريت من العفاريت. أما في النهار فهو يقطب وجهه وينعزل في غرفته، اليوم فقط خرج على غير عادته، أحمل له الطعام فأجد المنفضة غاصة بأعقاب السجائر، الغرفة مختنقة برائحة الدخان والمذياع مفتوح بصوت عال، وهو إما منكب على أكوام من المجلات يفتش فيها عن صور أشخاص يقول عنهم: “هؤلاء هم الرجال فعلا!”، يقصها ويضعها في ملف خاص، وإما غارق في الكتب لا يرفع نظره عن صفحاتها. أقول له فليهدك الله يا ولدي، ما تفعله غير معقول، قم لتبحث لك عن شغل وكفى من هذه الكتب التي لا نفع من ورائها مثل حليب الحمارة، ماذا أفدنا من الشهادات؟ سنوات ونحن نكافح معك – تقبّلَ الله منا – وما من بريق أمل، أنا لا أكسب من بيع الخبز سوى القليل، وينبغي أن نتعاون على الزمان، لكنه لم يكن يلقي بالا لكلامي، ومن أراد أن يموت فليمت…”.
غصت عيناي بالدموع، وشعرت بالخواء يستولي على ركبتي. وإذ كنت أهم بمغادرة بيت حميد، تعالى صوت جهوري مشروخ من أحد الزوايا:
“ها أنتما تشهدان ما وقع لنا! حتى الولْد اللي كنتْ مْعوَّلْ عْليه مْشى خْلا!”.
التفتنا صوب الجهة التي انبعث منها الصوت، فرأيت عند عتبة إحدى الغرف رجلا ملتحيا متغضن الجبهة يقتعد كرسيا متحركا.
هرولت باتجاه الباب، وإحساس بالضياع يُدوِّم روحي.