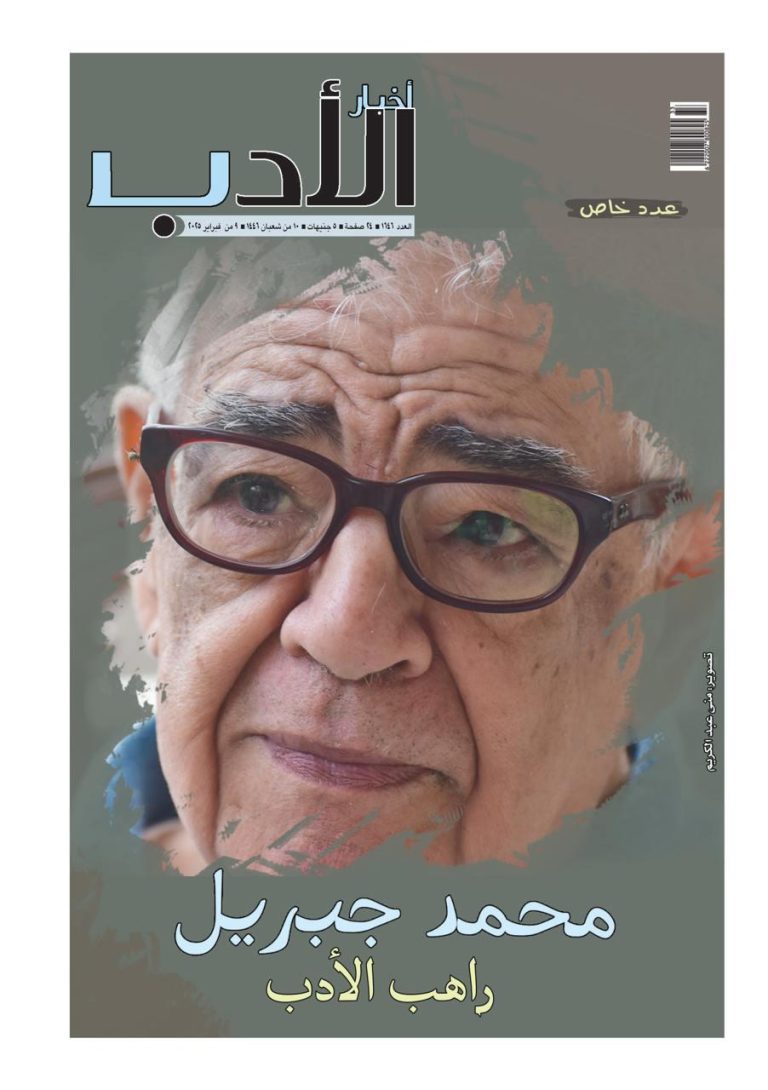محمود الورداني
برحيل عبده جبير انطوت صفحة من عمرى، بل مرحلة كاملة هى الأهم والأكثر تأثيرا، فلم يكن عبده مجرد صديق أو أحد أبناء جيلى. كان أكثر من ذلك، على الرغم من فترات الانقطاع الطويلة، من بينها مثلا عشر سنوات قضاها فى الكويت، وسنوات أخرى قضاها فى بيروت والفيوم، لكن ظل ما بيننا عصيا على الانفصام، ولطالما كانت لقاءاتنا الفعلية مجرد استمرار للقاءاتنا الافتراضية.
أريد أن أشير إلى أمر لم أفهمه حتى الآن. عبده كتب كثيرا، وهناك على سبيل المثال أعمال فاتنة وتجريبية مثل رواياته «تحريك القلب» وثلاثية «سبيل الشخص» و«عطلة رضوان»، ومجموعات قصصية مثل «فارس على حصان من الخشب» و«الوداع: تاج من العشب»، وكتابه «النغم الشارد» عن تجربة نجم والشيخ إمام.. هذه الأعمال وحدها كافية ليرضى عبده ويطمئن إلى أن عدم وجوده فى دائرة الضوء أو الشهرة بين قوسين طبعا، لا يرجع سببه أبدا إلى القيمة. أنا لا أعرف السبب، لكننى أعرف جيدا أن هذا ما يحدث: هناك كتّاب جيدون لا يحققون الوجود فى دائرة الضوء أو الشهرة. أعرف أن هذا كان سببا فى قلق عبده وإحساسه ربما بالغُبن، مثلما حدث مع كثيرين. وإذا أضيف إلى ذلك مأساة السنوات الخمس الأخيرة فى حياته، إثر نزيف فى المخ كان له تأثير شديد على الحركة والكلام، وبالتالى على عزلته الإجبارية، لأدركنا أن عبده كان يعانى بالفعل.
فى كتابى «الإمساك بالقمر» – دار الشروق – 2021 كتبت عنه السطور التالية بتصرف يسير جدا:
«.. البيوت التى سكنها عبده جبير تحملت الكثير من رذالاتنا أيضا، شأنها شأن بيت الرفيقة نعمات فى العمرانية أو الهرم، وبيت محمد سيف فى حارة درب البوارين، وسطح عمارة شارع عرابى، وبيت محمد الفيل فى حارة الزير المعلَّق فى عابدين.
عبده من أوائل من تعرَّفت عليهم على قهوة إيزافيتش، وكان تعليمه الأزهرى قاده للالتحاق بكلية اللغات والترجمة التابعة لجامعة الأزهر. أيامها كان يسكن فى شقة أم محمد بجوار حديقة المريلاند فى مصر الجديدة، ولم يكن ضروريا، كما أتذكر بمجرد أن تدخل الحجرة عبر باب الشقة، فإن هناك شرفة صغيرة فى الدور الأول، وبقفزة واحدة تصبح داخل الحجرة. عبده كريم جدا، وكثيرا ما شهدت تلك الحجرة أعدادا تفوق طاقتها على الاحتمال، وتتبرم أم محمد وربما توجه لنا كلمتين تعلن بهما سخطها، وهى رابضة فى برج المراقبة فى الصالة طوال الوقت.
أتذكر أننى أمضيت ليالى بصحبة يحيى الطاهر عبد الله وخليل فاضل وعلى كلفت وآخرين، وفى الصباح كان عبده أول من يستيقظ ليعد لك الحلبة باللبن وأحلى فايش صنعته أمه فى إسنا، ولا يمكن للواحد أن ينسى إلى أى حد كان شهيا.
ظلت بيوت عبده مفتوحة لأصدقائه على مدى عدة عقود، وهو واحد من أمهر الطباخين، وأكثرهم قدرة على إعداد الولائم بمفرده. على قهوة إيزافيتش قرأتُ قصصه الأولى مثل «أمواج» و«ضوء مصباح الغاز» و«دحرجة الأحجار فى الحديقة» وغيرها. هناك شيء ما خلاب فى حكيه الذى يبدو محايدا ورصينا، لكنه يمور بحركة داخلية تصل إلى حد العنف. لا أكتب نقدا هنا، لكننى أشير بسرعة إلى أنه كاتب تجربيى بامتياز، تنقّل بين عدد كبير من الأساليب والطرائق الفنية بحثا عن مرفأ، ويُحسب له أنه أدرك أنه لا مرفأ، وأن كل كتابة هى مرفأ جديد.
كنا ننشر معا فى جريدة المساء، سواء عند عبد الفتاح الجمل أو فاروق منيب، خلال الفترة التى غاب فيها الجمل أثناء إعداده لملحق أدبى لأخبار اليوم.
توثقت علاقتنا أكثر عندما سكنّا متجاورين تقريبا فى الهرم، وكان بيت عبده ملاذا للعشرات بلا أى مبالغة، سواء إقامة دائمة أو مؤقتة. والحقيقة أن تلك كانت ملامح أساسية لتلك المرحلة، ونحن لم نكن نتبادل الكتب وحدها، بل نتبادل القروش والزاد والنميمة.
لحُسن الطالع، أننا سكنّا متجاورين فى الهرم، تفصل بيننا مسافة نقطعها فى ربع ساعة سيرا على الأقدام، ولأنه كان أعزب، استراح كثيراً من الأصدقاء لتمضية الوقت لديه فى البيت. ولحُسن الطالع أيضا أن صديقنا المخرج الكبير سيد سعيد، كان يسكن فى منتصف المسافة بينى وبين عبده. آنذاك كان محمد السيد سعيد طالبا فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يقيم مع شقيقه سيد، ولك أن تتخيل الرغد الذى كنا غارقين فيه، وسيل الأصدقاء الذى كان لا ينقطع بين المقرات الثلاثة المتجاورة.
عبده صعيدى من إسنا ووالده أحد مشايخ الأزهر الكبار، ولكن الكتابة اختطفته مبكرا، وسرعان ما بدأ يتكاسل عن حضور محاضرات معهد اللغات الذى كان يدرس فيه. وفجأة قرر فى أوائل سبعينيات القرن الماضى السفر إلى اليونان ليلتقى بسامى السيوى هناك حسبما اتفقا، ويشتغلان فى جمع العنب، قبل أن يواصلا طريقهما إلى إيطاليا، حيث كان صديقنا الفنان البورسعيدى المحمود إبراهيم ينتظرهما، وكانت تلك هى الطريقة المعتادة لسفر الشباب آنذاك ومشاهدة أوروبا. كانت تذكرة الطائرة إلى بيروت هى الأرخص، ومنها يواصل إلى سوريا ثم تركيا برا.. وهكذا توقف فى بيروت، وذهب إلى د. غالى شكرى فى مقر عمله فى مجلة البلاغ، ليسلّمه رسالة من زوجته فى القاهرة. وهناك التقى ببلال الحسن أحد كبار أسطوات المهنة، وبسبب موضوع كان عبده قد كتبه عن انتحار صديقنا ثروت فخرى الفنان التشكيلى الذى كان فى بداية العشرينيات من عمره، عرف طريقه إلى الصحافة وتعلّم أصول المهنة على يد بلال الحسن.
عاد من بيروت بصحبة زوجته الأولى السيدة جين، التى شقّت لنفسها طريقا من الود والمحبة فى كل بيوت أصدقاء عبده التى دخلتها، كما فتحت بيتها لأصدقاء عبده لسنوات فى الطابق الأخير من بناية عتيقة فى شارع جريدة السياسة بالسيدة زينب.
عبده جورنالجى شاطر. أسطى «وديسكمان» لا يشق له غبار، وعمل لفترات متقطعة فى دار الهلال وكل الناس وكان مديرا لتحرير مجلة القاهرة عندما تولاها غالى شكرى.
عبده صديقى طبعا، لكننى لا أمتدحه هنا، بل أذكر وقائع محددة، من بينها مثلا أنه أمضى نحو عشر سنوات متواصلة كأحد مدراء تحرير جريدة القبس الكويتية، وكان يحرر وحده ملحقا يوميا من اثنتى عشرة صفحة.
أما شقته فى الطابق الأخير بشارع جريدة السياسة فى بيت السيدة زينب المتداعى، فقد استضاف فيها خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى العشرات من الكتاب والفنانين من أجيال مختلفة. وقبل اختراع الهواتف المحمولة، كان من النادر أن تتوجه إلى عبده ولا تجده. سوف تجده وتجد أصدقاءك، وتمضى الوقت الذى تشاء. ولو كنت جائعا ستجد طعاما وتشرب شايا. ربما وجدت الشيخ إمام أو نجم أو نجم وحده. ويستقبلك عبده وزوجته جين بكل ود ومحبة، وعند عبده هناك مكان لمبيتك وجلباب لنومك إذا تعذر عودتك.
وعلى الرغم من أن كلا منا اختار أن ينتمى إلى تنظيم يسارى مختلف، وإبان سنوات التطاحن الغبية البلهاء بين منظمات اليسار السرية، انضم كل منا إلى منظمة مختلفة إلا أن صداقتنا كانت أقوى، ولا أنسى أننى أرسلت له من محبسى فى سجن طرة عام 1980 أن يوفر لى نسخة من تاريخ الجبرتى وكتب أخرى ثمينة، فسارع بإرسالها.
ثم وقعت الطامة الكبرى عندما اهتزت البناية العتيقة فى السيدة زينب وتهدمت فى لحظات قليلة، بينما كان هو فى الفيوم، إلا أنه استطاع بمساعدة البعض إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مكتبته وأوراقه وأرشيفه، وإن كان قد فقد جانبا منها بالتأكيد.
وبعد عشر سنوات عاد من تغريبة الكويت.. أخيرا وقبل خمس سنوات فقط تعرَّض لنزيف فى المخ وظل يعانى حتى تركنا ومضى..».
وأخيراً.. مع السلامة ياصاحبى