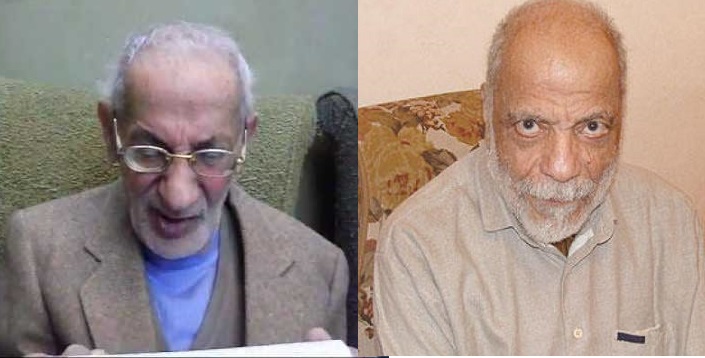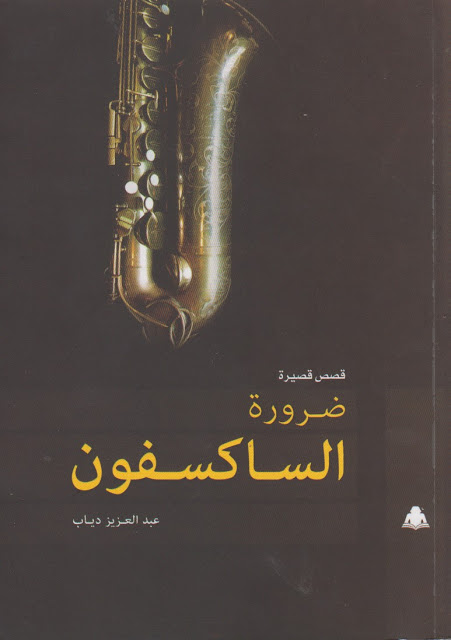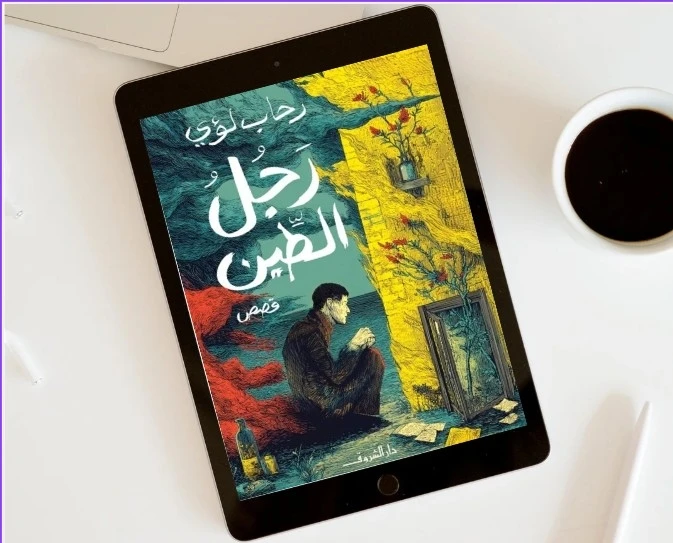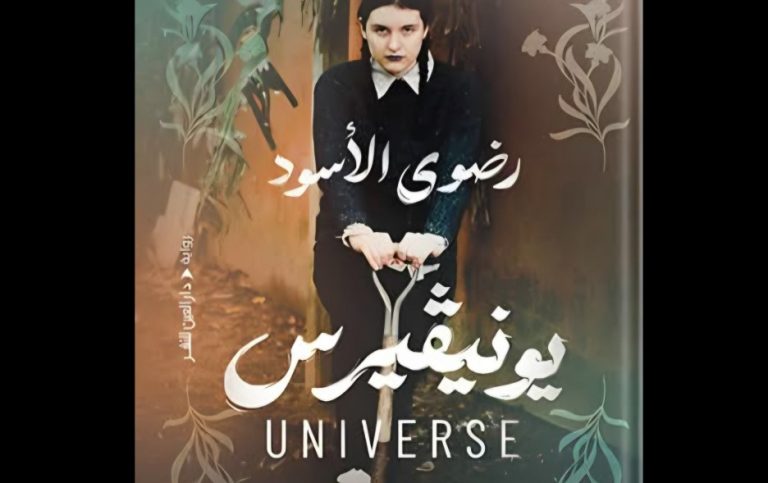جمال زكي مقار
(1)
يقول راينر ماريا ريلكه إن “الروائي كائن جمالي”، وإن شئت سحبت قول ريلكه على القاص والشاعر والمبدع على وجه العموم. والبحث عن الجمال هو بحث عن الكمال في جانب من جوانبه، لكن الجمال الفني يقع في منطقة تخالف الجمال الطبيعي، لأن جمال الطبيعة يأتي من ذاتها وهي تتابع إنتاج أنساق لا تكف عن تكرارها، بينما الجمال الفني يأتي من عقل مبدع أعاد ترتيب العالم عبر رؤية خاصة، وآية إبداعه أنه يقدمها لنا على نحو متغير من مرة لمرة في هيئة من هيئات الإبداع الفني: تمثال؛ لوحة؛ رواية؛ قصة قصيرة؛ قصيدة شعر؛ مقطوعة موسيقية، والمعيار هنا هو القدرة على إثارة أحاسيسنا بهذا الجمال.
يمتلك أشرف الصباغ في مجموعته “حبيبتي طبيبة العيون السريالية” قلما شديد الخصوصية يسبق عقله المبدع أفكاره ويجعلها تلهث خلفه مستخدما لغة خاصة سريعة الايقاع حتى إنك لا تشعر إلا والقصة قد انتهت إلى نهاية مدهشة وقوية لأن أكثر ما يبقى في النفس أثرا هو النهايات والخواتيم متى استدعى العقل عملا فنيا.
نظم الصباغ مجموعته هذه في خمس قصص تبتعد قليلا عن فن القصة القصيرة بمقدار ما تقترب من فن النوفيللا (القصة القصيرة الطويلة) التي تأخذ من معطيات القصة القصيرة بعضا وتأخذ من جينات الرواية بعضا لتخرج إلينا نصا يحتمل فضاءات أكثر اتساعا وطموحا على نحو ما سنرى. والرأي عندي أن نقسم مجموعة “حبيبتي طبيبة العيون السريالية” إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول منها يضم القصتين الأولى والثانية. والجزء الثاني يحتمل القصة الثالثة والرابعة. أما الجزء الثالث والأخير فيحمل القصة الخامسة، لأسباب تفصح عنها القراءة التالية لهذه القصص.
(2)
القصة الأولى والثانية هما قصتان تتجاوزان ما هو واقعي ويقدمان عالما يحوطه الرمز وتتعدد فيه مستويات الرؤية والقراءة، وإذا أُخذتا هكذا فقدتا كثيرا من الجمال الخاص بهما، كأنك به يريد من القارئ أن يشارك في رؤية العمل والتفاعل معه. وإذ يحسن بنا أن نقرأ القصص قصة قصة، نراه في قصة “حبيبتي طبيبة العيون السريالية”.
يضعنا من المفتتح أمام افتراض واحد يعدنا بقصة حب عجيبة بين امرأة تعيش الواقع على نحو سيريالي الطبائع مبنى ومعنى. فهي من الناحية الجسدية جميلة وجذابة (وفقا لمعايير الجمال الغربية الشرقية اللاتينية وكل ما فيها جميل ورائع وبديع وملائكي ومثير/ من واقع النص). هي إذن مزيج عجيب من ألوان الجمال الأنثوي الإنساني اجتمعت له ولها من القوة أسبابها جميعا؛ العائلة العريقة: فهي نورهان هانم أباظة؛ والعلم: طبيبة عيون؛ فضلا عن جمالها الخاص بما للجمال من شموخ وحظ من القوة والسطوة. وبالإجمال هي لوحة سيريالية حية، لماذا هي لوحة سيريالية حية؟ لأنه اجتمع لها وفيها كل ما هو راق رفيع وسام ممتزجا بميول سوقية تحررية تدفعها إليها روح متمردة جامحة، بل أن العلاقة بينها وبين ذلك حبيبها الفقير قلبا وقالبا الذي لم تعطه الحياة إلا القليل القليل: أصلا؛ وعملا؛ ما يثير في النفس دهشة وتعجبا، لأنه حين يضع نفسه موضع المقارنة معها نراه بائسا.. يعمل محررا في صحيفة عرجاء نصف ميتة وبالكاد راتبه من العمل يكفيه مر العوز، ثم تأخذنا القصة وتظهر “شفعات” المرأة الخمسينية الواقعية التي تمتلك سطوة من نوع آخر، ناتجة عن ممالأتها للسلطة الفكرية التي تنحو بالثقافة نحو تزييف الحقائق أملا في الحصول على نوع من التفوق التاريخي المزعوم. وهي في ص 14 “بصفتها ناقدة ما بعد حداثية؛ وأحيانا ناقدة نسوية سوسيولوجية ما بعد كولونالية.. صلب تخصصها عن تاريخ الهنود الحمر ودورهم في ارتقاء الأدب العربي إلى العالمية والمؤثرات العربية الإسلامية في الأدب الروسي الكلاسيكي..”. هكذا تبدأ شفعات في طرح نفسها بقوة لتشق العلاقة بين الحبيبين شقا بعد ان وضعت يدها على موضع ضعف وتهافت وانتهازية ودونية ونهم بطل القصة إلى الطعام والشراب حتى نزعت عنه كرامته. ففي ص 17 تراه يقول: “تضاعف حبي ومحبتي للدكتورة شفعات وابنها وجدي عندما زادت الدعوات على الغداء والعشاء..”. ولم تكتف شفعات بذلك بل حاولت ان تلعب نفس اللعبة مع نورهان هانم أباظة حين دعتها إلى رحلة بمنتجع دهب وهيأت الجو لابنها الدكتور وجدي ليبث نورهان لواعج حبه ورغبته في الاقتران بها.
ولما كان من غير الممكن أن نتصور نصا بكرا إلا إذا كان من الممكن أن نتصور العدم؛ فستقفز إلى الذهن صورة أدبية خالدة وتتجسد أمامنا شفعات كأنها (كلارا) أخرى قادمة من زيارة السيدة العجوز لفريدريش دورينمات، امرأة تشتري كل شيء بمال لها من مال وسطوة وقوة ونفوذ. وينقسم عالم القصة ويفصح عن ذروة الصراع فتطيح نورهان السريالية الجميلة بشفعات وابنها وتسلقهما بلسانها حتى إنها قالت لهما (من المنقي خيار/ النص)، ثم نرى ذلك الحبيب الدعي بعد أن أفصح عن ذاته الوضيعة أمامها وهو يطرح عليها مقايضة رخيصة تستبدل فيها ذاتها الجميلة المتسامية بولائم الطعام والشراب التي تفرد سماطها شفعات وابنها.
ومرة أخرى سينتج لنا ذلك المزج الجميل صورة تقفز إلى الذهن آتية من قصيدة جون كيتس “La Belle Dame sans Merci”، بما تحمله من رمزية، حيث تتجسد الحياة في صورة امرأة جميلة قاسية لا تعبأ بذلك الحبيب البائس الذي أفصح عن شهوانيته وضعته النفسية حتى استحق أن تركله نورهان بلا رحمة في موضع ذكورته وتطرده شر طردة.
(3)
أما القصة الثانية التي تنحو نحوا رمزيا فهي قصة “النملة”. ومن عبارة المفتتح يضعنا الكاتب أمام ذات متناهية الصغر (ص 29) “أنا نملة” لتتدفق القصة بعد هذه العبارة وتعمل تجسيدا لكائن حي ورؤيته لذاته بما هي عليه من صغر شأن، كائن يدرك أنه بلا حول ولا قوة، يمكن أن تدهسه قدم غاشمة أو تفعصه أصبع كائن إنساني عابث “فحياتنا لا تساوي خردلة”. ومع كل هذا الإدراك لحطة الشأن وضعف الحال لكونه نملة بائسة نراه لا يحب النمل ولا حياتها ولا نمط تفكيرها العبودي الملتزم المحافظ، ثم يعلو النص ليكشف عن كون هؤلاء النمل إن هم إلا بشر تم تدجينهم بالأوهام والخزعبلات التي تستخدم في إخضاعهم من قبل حكومات لعينة تستخدمهم وتزجرهم وتعاقبهم وتحتقرهم وتسرقهم وتمشي بالوقيعة بينهم لتظل تتسيدهم مقابل أن تفسح لهم ملليمتر واحدا يتسع لأجسادهم الصغيرة بينما سيتركون كل شيء لسادة الكوكب من البشر الأقوى ليتقاتلوا على الأراضي والأملاك والعقارات أو حتى ليصعدوا إلى الكواكب والمجرات الأخرى لكي يعيدوا إنتاج جشعهم الذي لا ينفد.
ويقدم النص من هؤلاء البشر الذين يعرفون كيف تتسلق هذه الكائنات وتصعد حتى تمسك بالخيوط اللازمة لاستعباد النمل، ذلك في هيئة نموذجين اجتمع فيهما الذكاء بالفهلوة وحطة الأصل بالوصولية والقدرة على المخادعة والتزييف، فيفرد صفحات للولد “شرشر” ص 33 “شرشر لم يكمل دراسته ولكنهم ينادونه ب “الدكتور”. نراه وسيما فارع الطول مبتسما على الدوام لسانه ينقط عسلا ويجيد لملمة الناس… موهوبا من صغره وكبرت معه موهبته حتى صارت أكبر من مؤخرته الكبيرة ” وقد اجتمعت فيه كل الأسباب التي دعا إليها السفاسطة القدماء لتكون سلما للصعود الاجتماعي تراه يلعب على كل الأحبال: فهو يدعي الثورية إذا ما غضب الناس وثاروا؛ وتبصره يجالس الأمن الوطني ويمشي بالوشاية والنميمة ويغازل الكتاب والكاتبات ويغوي النساء بلطفه على الرغم من كونه بخيل وأنتن من صرصار وأحط من فأر، وإذا كان شرشر هكذا فإن “دودو” جميلة رائعة وأكثر طموحا من “ماري انطوانيت، وكونداليزا رايس وهيلاري كلينتون”، حتى أن النملة حين رأتها أول مرة في المدرسة الابتدائية تنبأت لها بمستقبل باهر، دودو التي فشلت في كل أنواع الدراسة نجحت في بعض أشياء أخرى، صارت امرأة حلوة تجيد ثلاث لغات بالإضافة إلى القدرة على اجتذاب الرجال من كل المستويات: سائقو الميكروباص في السيدة عيشة، والعاملون في صالونات التجميل بالمهندسين والدقي وجاردن سيتي، وصار لديها حسابات في البنوك وسيارتان وشقتان وابنة صغيرة جميلة، وصار الجميع يذكر اسمها مسبوقا بألقاب كالمثقفة والكاتبة والصحفية المهتمة بحقوق المرأة، وبالطبع لا يخفى عنا ذلك الأسلوب الذي يستخدم السخرية المريرة من واقع الحياة الزائفة التي يعيشها البشر ومن الكيف الذي يصنعون به نجوما تماثل زيف الحياة التي يحيونها لكن ذلك لا يخفي عن النمل حقيقتهم ووقاحتهم وإصرارهم على أن يصبحوا صراصير وأوغادا في الوقت الذي يتخفون فيه خلف الثياب الفاخرة والبارفانات الغالية والابتسامات المغتصبة التي يتبادلونها، لتنتهي القصة بتصوير للمصير الإنساني الذي ينحو نحو الانقراض وانعدام القيمة ص 42 “لكنني في الفترات الأخيرة بدأت ألاحظ أن رؤوس البشر بدأت تصغر قليلا وتتضاءل أطرافهم، لاحظت عندما دققت النظر في رأس دودو وشرشر…. أما الفتاة الصغيرة التي ألبسوها مثل الدمية باربي… فكانت تتلاشى تدريجيا مثل ديناصور صغير يشبه ذلك الرجل وتلك المرأة اللذين يبدوان كأبويها”.
ومرة أخرى سيذكرنا كل هذا بقصتين عظيمتين إحداهما قصة “حلم رجل هزأة” لدوستويفسكي حيث تتم القصة من خلال حلم رجل هزأة نام فرأى المصير الإنساني بأكمله وهو يسير في مسارات الانحطاط. أما القصة الأخرى فهي “قصة المسخ أو التحول” التي تصور المصير الإنساني الفردي في مجتمع قائم على المنفعة الخالصة متى فقد الفرد فيه القيمة أُلقى به في القمامة “metamorphosis”.
(4)
لنترك الآن الرمزية وندخل عالمي القصتين التاليتين بواقعيتهما القحة الخالصة والمفجعة أيضا، أعني أولا: قصة “السيوفي” حيث يستهل الكاتب قصته بوصف المبنى الجسماني للشخصية الرئيسية التي ستكون مناط العمل، فتراه: شابا ممشوق القوام وسيما يشبه ممثل أدوار الشر الشهير (عادل أدهم) غير أنه أطول قامة، يزين وجهه ما يسميه المصريون بـ “البشلة”. تلك البشلة (الجرح القطعي) قطعت المسافة من تحت حلمة أذنه مارة بخده الأيسر ووسط أنفه لتصل إلى خده من الناحية الأخرى، يمتلك ذوقا رفيعا في اختيار ثيابه وتصفيف شعره. أما نفسيا فإنه كان في جانب منه شهما لا يسمح لأحد أن يتحرش بابنة من بنات حي الوايلي الكبير. وتمتد به الشهامة على الرغم من كونه زعيم عصابة ومسجل خطر بحيث لم يُسمع عنه يوما أنه ضرب أحدا من سكان المنطقة بل كان ينأى بلصوصه عن المنطقة بأكملها.
هكذا سيصبح السيوفي الشخصية المحورية التي تدور حولها الأحداث وتتجمع لتصعد به بعد أن جمع له الكاتب من النخوة والرجولة ما جعل منه بطلا شعبيا، ثم ترتفع الأحداث بالقصة وصولا إلى حالة من الكشف عن البؤس الاجتماعي وتردى حال الطبقات الشعبية في السنوات القليلة التي أعقبت حرب أكتوبر وتبني الدولة سياسة الانفتاح في ظل ظروف اقتصادية متردية لم تترك مجالا واحدا للناس البسطاء إلا وطالته يد التدمير: أزمات في كل شيء؛ الطعام والغذاء والمواصلات بل في الأدوات المدرسية والكراريس والناس صابرون على ما هم فيه، حتى جاءت قرارات المجموعة الاقتصادية يوم 17 يناير 1977 بمضاعفة أسعار السلع التموينية التي تمثل حائط الصد الأخير ، فيندفع الناس إلى الشارع في هبة شعبية كبرى كادت تتحول إلى ثورة. ويشارك السيوفي فيها مشاركة الأبطال الأسطوريين في ملحمة دامية ليحمي الناس ويدافع عن البسطاء ويقاتل قوات الأمن، وما بين كر وفر حتى أنزل السادات قواتَ فتحت نيران مدافع الجرونوف والكلاشينكوف وأعملت قتلا في البشر، ولم يعد أمام الجميع سوى التراجع حفاظا على أرواحهم ، بينما سرت الإشاعات والأراجيف بأن السيوفي نزح إلى الصعيد وأن قوات الأمن حاصرته هناك وقتلته. وتنتهي القصة لتترك لنا فيضا من الحكايا عما فعل السيوفي وعن حياته ومآثر ذلك البطل الشعبي القح الأصيل الذي كان يدفع الشر بعيدا عن حيه وبنات حيه.
(5)
ولنا عودة في بعض ملاحظات سريعة بعد أن نلقي إطلالة على القصة الرابعة وعنوانها “الورشة” التي تنتمي إلى القصة السابقة في كونهما يجسدان نموذجين من الأدب الواقعي الذي يتبنى نظرة تمزج الواقع بالفن لتعيد إنتاجه في صور زاهية جلية تتجلى فيها معطيات الحياة الشعبية وانتقال العمالة الريفية إلى المدينة لتنضم إلى جيش العمال البسطاء وبعضهم هؤلاء من أطفال الأسر الأكثر فقرا الذين طرحوا طفولتهم جانبا ليساعدوا أسرهم للبقاء على قيد الحياة، هكذا يمكن رؤية يوسف الطفل الصغير موفور الحماس والهمة وهو ينضم بعد قليل إلى جوقة العمل بالورشة، حيث: وحيد رئيس العمال، ومصطفى عامل المكبس والبنات ليلى وماجدة، ويشارك الجميع لعب دور في ملحمة لقمة العيش اليومية تلك الماكينات التي تبدأ بالزعيق والقرقعة من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء، وفي الخلفية يبرز الحاج صبحي صاحب الورشة التي تنتج الكاوتش وتعيد تشكيله ليصبح نعالا للأحذية الشعبية. وكما تدور الماكينات تدور الأحداث، وشيئا فشيئا يتحول يوسف مرمطون الورشة الذي يحضر الطعام والشاي للأسطوات إلى عامل على إحدى الماكينات، بينما تتشكل الحياة داخل تلك البوتقة ص 83 “عالم صغير مليء بالأسرار والدفء والوشايات والمرض”. وتعلو بنا الأحداث لتصبح قصص حب وصراع مع صاحب الورشة لزيادة الأجور، ثم يتصاعد الايقاع ويأخذ شكلا مأساويا حين تكاد ماكينة أن تلتهم أصابع يوسف، لكنه بحصافته ينجو من بترها في المستشفى العمومي على يد أطباء نصف جهلاء، وتعاود الماكينة الوحش التهام ساعد سعيد التهاما وعندما يعود إلى الورشة بعد شهور يصبح مجرد ساعيا يقضي طلبات العمال، ثم يأخذ منه اليأس كل مأخذ فيروح يذوي وينطفئ حتى وجدته زوجه ذات صباح ميتا، بينما يزداد صاحب الورشة جشعا ونهما وتموت في قلبه الرحمة، فتثور ثورة عمال الورشة ويعلنون إضرابهم عن العمل، وبعد عدة زيارات منزلية خفية من الحاج صبحي وأخيه سمير يبدأ العمال في العودة إلى العمل. وبينما تنحو بنا القصة نحو النهاية تأخذ اللغة طابعا شعريا ممزوجا بطعم مأساوي ص 96، 97 “بينما المعادلة أسهل بكثير رغم كل التحريف والانحراف؛ رغم الإمعان في إخفاء أصل المعادلة وتحولاتها الواضحة وضوح نظرة شبح صغير بعيون مغلقة يقف بين باب الشقة وباب البيت…”، بينما الطفل الصغير “لا يحتاج إلى شوكة وسكين ليأكل الخبز بالماء لكنه بحاجة إلى كلمة لا تستطيع الأم أن تقولها أو قالتها وبعثرتها الرياح”.
ويبدو أن هاتين القصتين كتبتا منذ زمن بعيد ولم يشأ لهما الحظ أن تنشرا، لأنهما تحملان منهجية كتابة تفارق القصتين الأولى والثانية وتنتميان إلى مدرسة الواقعية الاشتراكية التي انسحبت من الواقع الأدبي المصري منذ نهاية الثمانينيات. أما الملحوظة الثانية فتتعلق بقصة السيوفي حيث يختل التراتب الزمني للأحداث في صفحات 63؛ 64، لتعود الأحداث إلى تسلسلها الطبيعي بعد ذلك.
(6)
الآن ننتقل إلى درة هذه المجموعة أعني قصة “أول الأرض وأول البحر”؛ حيث تمسك حالة من التوهج بالقصة من مطلعها حتى نهايتها وإن اختلفت مستويات هذا التوهج إلا أن اللغة ستواكب هذه الحالة وسيضفي الحب المصفى الذي يوليه الكاتب لمدينة الإسكندرية عليها مذاقا محببا وهي تتراوح بين السرعة والبطء مما يجعلك أحيانا تجد في اللحاق بالكلمات والمعاني وأحيانا تغرق في تأمل الأحداث، وستلحظ أن الكاتب قسم مبنى هذه القصة التي تحتفي بالمكان كما تحتفي بالبشر تقسيما موسيقيا إلى أربعة أجزاء تذكرنا بتقسيم حركات “السوناتا” من حيث السرعة والتدفق حين يقف عند معالم الحياة والمدينة. وعندما يتناول بعض القصص الفرعية سيحمل إلينا عبر مونولوج داخلي طويل يجيء متأسيا على ما أصاب واقعها من تبدل أحوال الزمن منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي حيث شهدت حالة من النزوح الواسع من ريف بحري مصر وصعيدها بينما بدأت حالة من النزوح المعاكس للأرمن واليونانيين والايطاليين واليهود منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي. وسيظل النص يرصد تلك التغيرات التي لحقت بوجه المدينة الجميل حتى اختلط عليه الجغرافيا بالفوضى بالعنف والفقر والجهل والعشوائية ووقعت في أيدي بشر لهم سحنات غريبة مريبة يرتدون ملابس غير ملابسنا ولهم ألسنة غير ألسنتنا؛ ص 107 “إنه الفقد بكل معانيه وأبعاده المقيتة التي يصل فيها إلى حد فقدان الروح”، ثم تعاد العبارة على نحو أكثر حكمة وقسوة معا في ص 131 “كلما ابتعدت مصر عن البحر كلما ضعفت الإسكندرية وانهارت وكلما توغلت مصر في الصحراء كلما ماتت الإسكندرية وتلاشت”.
خصوصية المكان في هذه النوفيللا:
من غير الممكن تجاهل خصوصية المكان عند تناول عالم هذه النوفيللا التي تمثل مرثية أليمة ومؤلمة للإسكندرية المدينة العريقة التي كانت يوما مدينة كوزموبوليتانية تهوى إليها أفئدة شعوب الأرض ويمتزج فيها ما هو شعبي أصيل بشعوب وافدة من بقاع الدنيا ذلك قبل أن يتم دحر محتواها الإنساني الكوني العبقري الذي صهر كل تلك العناصر البشرية في بوتقتها وجعل منها مزيجا له مذاق إنساني خاص وروح عالمية الطابع تستطيع أن تجمع كل المتناقضات في صعيد واحد يموج بالحب والجمال والموسيقى وأحيانا بالدراما الدامية وقصص السفاحين العتاة من أمثال “ريا وسكينة” و”سعد إسكندر” والمقاومة الباسلة والخوف ولحظات الانتصار والانكسار. ولنقرأ من واقع النص ص 102 “منطقة القُصَعِي لا تقل في مركزيتها وأهميتها عن محطة الرمل فمن القصعي يمكننا أن نذهب إلى مناطق وأحياء لا حصر لها يمكننا أن نتوجه إلى فيكتوريا…… ومنها يمكن أن نصل إلى سان ستيفانو أو سيدي بشر… عبر تلك الحارات والشوارع المرصوفة بقوالب البازلت الأسود”. وعلى الجانب الآخر كانت هناك معالم أخرى لهذه المدينة ، ففي ص 107 “للإسكندرية وجه آخر يمكن أن تراه في بعض الأحياء والمناطق الفخمة بمبانيها الضخمة ذات الطرازات المعمارية المتوسطية، وإذا استثنينا المتاحف وخطوط التاريخ وخطواته وتضاريسه وخلوده وخلود أرواح من سكنوا فيه وسطروه، سنجد أمامنا فخامة راسخة واثقة وهادئة سكنت ذلك المستوى الإنساني الذي لم يذهب بعيدا أبدا عن رحاب الإسكندرية وروحها الحميمية وحضورها الطاغي التي صهرت جميع اعراق المتوسط ووحدت حتى ملامحها وردود أفعالها واستجاباتها الشرطية البسيطة في الحياة اليومية”.
(7)
مرة أخرى نعود إلى القصة نفسها لنرى كيف أنه عبر وعي إبداعي كثيف قُدم المكان ليس باعتباره ديكورا أو إطارا خارجيا من حواري وأزقة وشوارع وكباري يمكن أن تُحتوى من خلالها الأحداث بل إن المكان هنا يمثل العمود والأساس، أو قل إنه الترس المدير الذي كلما تحرك حركة واحدة تحركت بقية التروس الفرعية من شخوص وانفعالات ومشاعر حتى يعلو بالنشيج/ أو قل النشيد المتأسي في ص 112 “للجغرافيا المتوسطية مفعول السحر لأنها تؤكد أن لا شيئا بعيد ولا شيئا ثابت ولا شيئا ملموسا، ومع ذلك هناك حضور للأشياء وطغيان أبدي ثقيل لها ولوجودها المادي والروحي في آن معا يؤكد أن كل الطرق تؤدي إلى ما تريد، وأن البحر هو القبلة ومركز الكون وجوهر العقيدة، فمنه تنحدر الأماكن ويتفرع التاريخ وتنطلق الشوارع والحواري والأزقة”. وهو لا يغفل التفاعل بين البشر والمكان كأنه يريد أن يجعل منهما كائنا حيا واحدا، خذ مثلا لذلك تلك القصة الفرعية التي شملت الصفحات من 115 إلى 118 لتصور رحلة قصيرة لطفل صغير غر في شوارع الإسكندرية حين أرسلته أمه وأعطته خمسة تعريفة وزجاجة كبيرة ليذهب إلى أول “باكوس” لشراء لتر سبرتو، هكذا تتبعه طفل أكبر منه قليلا وراحا يقطعان معا الشوارع ثم سرق منه ملاليمه القليلة.
لقد استخدم الكاتب لإنجاز هذه المرثية كل الأساليب السردية التي تحكم السرد الروائي القائم على جعل المكان محورا له، هنا ستجد: الرحلة؛ الرسالة؛ الحلم؛ تداعي الأفكار والمعاني ص (112) وسير الأشخاص الشعبيين (الطفل زاهر، والطفل جابر؛ وعم حنفي وعبد العزيز) وهو في كل هذا الزخم يحافظ على قوة وتماسك بنيان العمل.
بانتهاء القراءة سيأتي من بعيد صوت نجيب محفوظ حاملا للروح مفتتح (ميرا مار) “الإسكندرية مهبط الشعاع وموطن الذكريات المبللة بالشهد والدموع ليثير في النفس شجنا على الشجن الذي حمله إلينا أشرف الصباغ عبر تلك المرثية. وذلك إيمانا بأن النص الأدبي الجميل يظل متعاليا عن أي شرح أو تناول أو تحليل أو حتى قراءة ولأن القاعدة الجمالية تخبرنا بأن “العمل الفني الجميل يظل يكشف لنا عن مواطن جمال جديدة في كل مرة نتناوله فيها سواء بالقراءة أو الاستماع أو المشاهدة”.