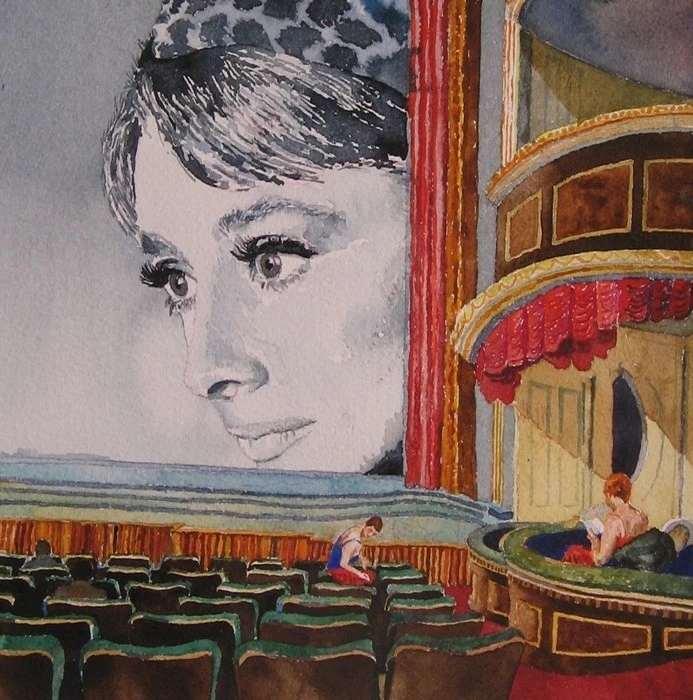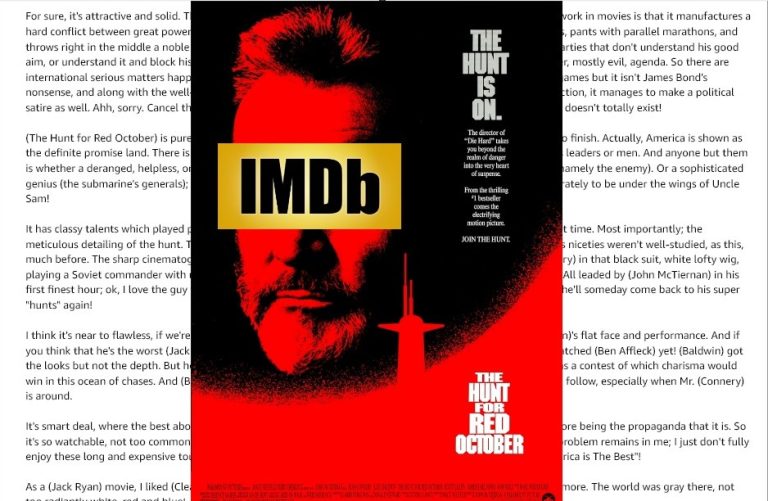أسامة كمال أبو زيد
لم يكن عادل إمام صدفة عابرة في دفتر الفن، مرّت ثم انطفأت، بل كان ـ ولا يزال ـ حالة متفردة، شديدة الالتباس، عصيّة على الاختزال، نجت من قوانين السوق، وخالفت نواميس العمر، وأربكت النقاد، وراوغت السلطة، واحتمت بالجماهير حتى النهاية.
وحين نكتب عنه، لا يجوز أن نلوّح بلقطة، أو نتمسّك بمشهد، أو نحاكمه بفيلم أو موقف؛ فمسيرة بهذا الطول لا تُقاس إلا بالرحلة كلها: بما تراكم، وبما ثبت، وبما صمد طويلًا في مواجهة الزمن.
لم يأتِ عادل إمام من كوكبٍ بعيد، ولم يهبط على السينما المصرية محمولًا على معجزة. خرج من الحارة المصرية بكل ما فيها من فهلوة وذكاء شعبي ومرارة وضحك. خرج من «الحلمية» محمّلًا بلغة الناس وإشاراتهم، بعينٍ تلتقط النوايا قبل الكلمات، وبحسّ إنساني لم يتعلّمه في الكتب، بل في الاحتكاك المباشر بالحياة: بالأزمات، بشظف العيش، وبالوجوه التي لا تقرأ الكتب، لكنها تعيش مآسي الواقع يوميًا.
منذ البدايات الأولى، بدا واضحًا أنه لا يريد أن يكون عابرًا. عام 1964، حين ظهر في دور «دسوقي أفندي»، ثم أعاد تجسيده على المسرح في العام نفسه، لم يكن مجرد كوميديان جديد، بل ملامح مشروع مختلف. ومع فطين عبد الوهاب، ثم نيازي مصطفى، ثم محمد عبد العزيز، فسمير سيف وشريف عرفة، تشكّلت أدواته، وتحددت ملامحه، لا بوصفه الأكثر وسامة أو موهبة، بل الأذكى في إدارة موهبته، والأشد إيمانًا بها.
في زمنٍ كان فيه الجميع ينحت طريقه نحو النجومية، ومع تراجع جيل رشدي أباظة وأحمد رمزي وصلاح ذو الفقار، وصعود أسماء مثل نور الشريف، عزت العلايلي، محمود ياسين، ثم لاحقًا محمود عبد العزيز، يحيى الفخراني، أحمد زكي، ومحمد صبحي، بدا المشهد كحلبة صراع مفتوحة. ومع ذلك، لم ينافسهم في ملعبهم، لأنه اختار ملعبًا آخر: الكوميديا، لا باعتبارها خفة ظل، بل صناعة، وسلطة، وسوقًا، ومعادلة دقيقة بين الضحك والبقاء.
وحين انفرط عقد كثيرين، وسافر بعضهم، ومرض آخرون، وبقي الصراع محتدمًا بين عادل إمام، سمير غانم، وسعيد صالح، حُسم الأمر في أوائل الثمانينيات لصالحه، لا بالصدفة، بل بالتخطيط. واقعة رفضه المبكر لدور في «الفوازير» مع أقرانه في أواخر الستينيات ـ كما يروي سمير خفاجي ـ لم تكن غرورًا، بل إعلان نية: هذا شاب يُعدّ نفسه ليكون نجمًا كبيرًا، لا يقبل أي شيء، ولا يمتهن نفسه، ولا يستهين بمكانته المقبلة.
كان يعرف أن الشعبية حورية لعوب خائنة، كما قال عنها العبقري تشارلي شابلن، وأن اللحاق بإيقاعها يحتاج جهدًا يوميًا. فاختار القراءة ملاذًا، والثقافة سلاحًا، والعمل الدائم قدرًا. لم يكن قارئًا استعراضيًا، بل قارئًا وظيفيًا، يؤمن بأن الاستيعاب أهم من القراءة، وبأن الثقافة لا قيمة لها إن لم تصل إلى الناس، كما تعلّم من كتب طه حسين، ومن أوراق الجرائد التي كان «عم جودة» يلفّ بها الجبنة في الحلمية.
ومع تصاعد شعبيته، طُرح السؤال الذي أطلقه الناقد الراحل سامي السلاموني في ثمانينيات القرن الماضي:
هل كان يستطيع عادل إمام أن يستغل هذا الاحتفاء الجماهيري ليُحدث انقلابًا فنيًا شاملًا؟
سؤال لا يقبل «نعم» أو «لا». لأن نجمًا يعيش على تصفيق الجماهير، ويحتكم إلى شباك التذاكر، لا يستطيع أن يغامر بكل شيء دفعة واحدة. عادل إمام كان واضحًا دائمًا: الفيصل بيني وبينكم هو الجمهور.
لذلك كان يكتب رقم إيرادات أفلامه أمام مرآة الماكياج في الكواليس، لا استعراضًا، بل اطمئنانًا: هل لا يزال الجمهور هنا؟
لم يكن ساذجًا في علاقته بالسلطة، ولا مشاكسًا مجانيًا. أدرك مبكرًا أن الفن لا يسمح بجمع السلطة والجماهير بسهولة، ومع ذلك حافظ على دفء العلاقة مع الاثنين، ومرّر صرخات البسطاء داخل أعماله، دون ادعاء بطولة زائفة. وحين اتُّهم بأنه «فنان السلطة»، رد ببساطة: شاهدوا «الزعيم».
«أنا ابن الشعب… الشعب هو من دفع ثمن كل ما أملكه».
هكذا أصبح ظاهرة نقدية فريدة: كتب تهاجمه، وكتب تمجّده، ومقالات تجمع المدح والقدح في السطر نفسه. انحاز البعض لأحمد زكي، وآخرون لنور الشريف، وغيرهم لمحمود عبد العزيز أو سعيد صالح، بينما اتخذ بعضهم موقفًا من عادل إمام لأنه «أشهر من اللازم». لكنه ظل ثابتًا، ثابتًا إلى درجة أن كل نجم جديد كان يُقاس عليه.
ومع كل ذلك، لم يكن معصومًا من التراجع. أعماله الدرامية الأخيرة لم تمتلك الهوس الجماهيري نفسه، لكن الرجل لم يتنازل، ولم يساوم، ولم يقبل تخفيض أجره، لأنه كان يعرف أن التنازل بداية الانكسار، وأن خطوة واحدة للخلف تعني السقوط في قاع لا رحمة فيه.
وهنا نعود إلى البداية…
إلى تلك القاعدة القاسية في الفن: من يتجاوز الستين يُحال إلى أدوار الآباء، أو الأدوار الشرفية الباهتة. عماد حمدي، زكي رستم، محمود المليجي، يوسف وهبي، وحتى فريد شوقي… أسماء عظيمة، طحنها العمر، أو تجاهلها السوق، أو أنقذها مخرج واحد بالمصادفة.
قليلون فقط نجوا من مقصلة الزمن، وقليلون امتلكوا رفاهية الرفض، لأن الرفض نفسه كان يحتاج قوة سوقية لا يملكها إلا نجم مطلوب.
الاستثناء التاريخي الوحيد كان عادل إمام.
لا حالة مشابهة.
لا سابقة.
ولا لاحقة حتى الآن.
لذلك، حين نكتب عنه، لا نكتبه بوصفه «الأكثر موهبة»، بل بوصفه الأكثر صمودًا، والأكثر وعيًا بلعبة الفن، والأقدر على البقاء في الضوء دون أن يسقط أو يُسقط غيره.
عادل إمام لم ينجُ من العمر فقط…
بل عقد صداقة معه.