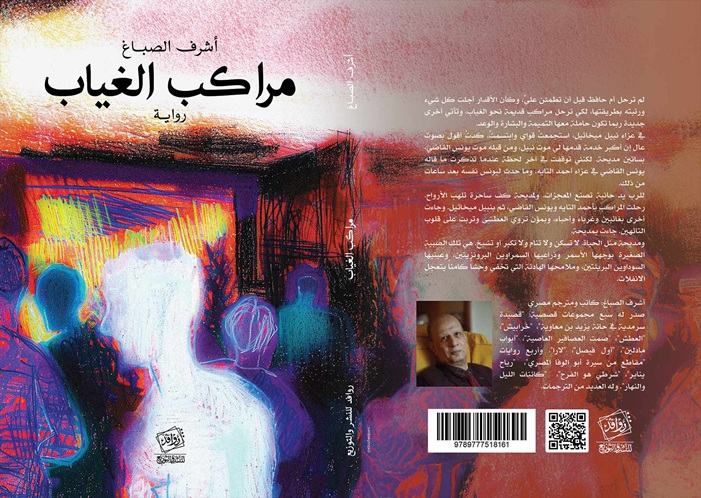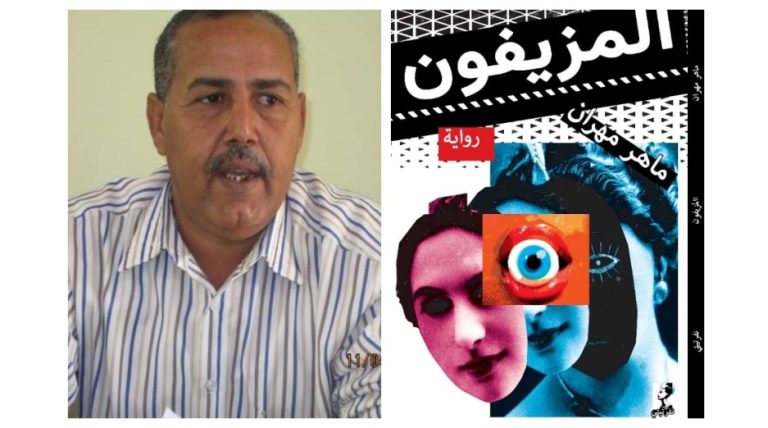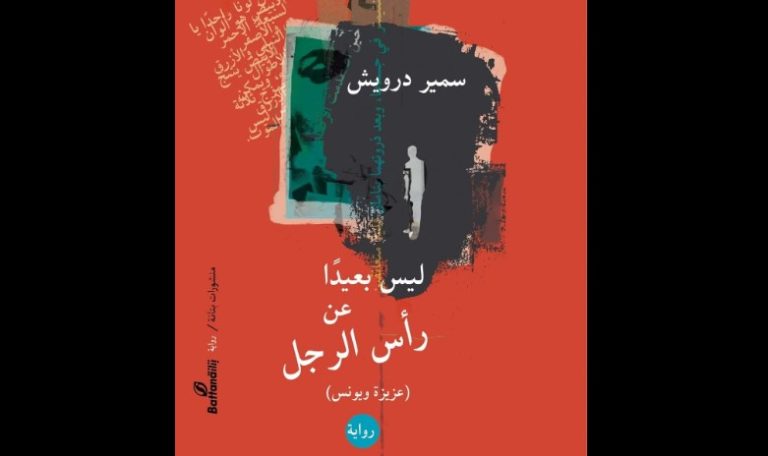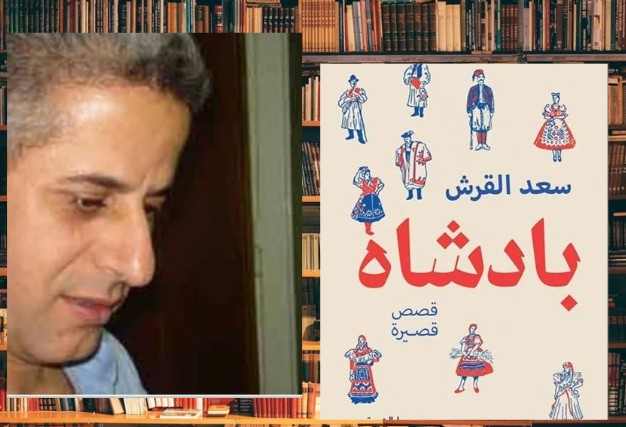عبير عبد العزيز
يبدو واضحاً لمن يقرأ رواية طاهر الشرقاوي الجديدة “عن الذي يربي حجراً في بيته” هذا الروائي الشاب أنه يتحرك في مساحة ليست بالشاسعة ولا المتنوعة من خلال الموضوع وشخصياته وأماكن حركته وسرده، وكان هذا هو التحدي الكبير لتلك الرواية حيث أنها طرحت مساحات فنية غنية ومدهشة وممتعة برغم ضيق المساحة التي تتحرك منها.
لم يحتج الروائي موضوعا غرائبياً ولا قضايا هامة تهم فئة من البشر ولا حقبة زمنية أو تاريخية لكنه قدم المهمل والطبيعي والبسيط ولكن بكنوزه الخاصة التي لا يتطرق لها الكثير. فقد اهتم هذا الكاتب بالفن الذي يكشف اللحظة ويثريها، بذلك التفصيل العشوائي الشخصي والعام من العالم ليكشفها مجتمعة حيث الإحساس هنا هو البطل والأفكار هم الشخصيات وليس البشر لتبرز بلاغة جديدة هى بلاغة تراكمية من الأفكار والمشاعر تصنع عالماً واقعياً خلاباً رغم بساطته وطبيعيته.
من أول لحظة في الرواية تجد حالة من الرصد والمراقبة للمحيط والانشغال الدائم بتفاصيل هادئة وعادية وبسيطة.
حياة هذا البطل الوحيد تماماً كيف تكون بهذا الثراء الذي لا يتوقعه أحد؟. تلك الحياة الباهتة في العلن الثرية جداً في الخفاء وليس خفاءاً سرياً ولكنه خفاء غير مدرك، خفاء جوهري. كان هذا البطل الذي يحيا بمفرده وعالمه الضيق تماماً كثقب إبرة كيف استطاع طاهر الشرقاوي أن يجعلنا ندرك من خلال هذا الثقب عوالم أكثر رحابة وفنية بالغة التأثير. حيث أنه جعل من الصوت منذ بدء الرواية حتى نهايتها وعلى امتدادها هو الحدث الأقوى والفاعل الرئيسي بها والرابط الذي يربط البطل بالحياة ومن أجله قد يحيا ويأمل. لقد بدأت الأحداث بصوت رنين الهاتف الذي اخترق الصمت، هذا الرنين العادي جداً الذي لايحمل في طياته أى أحداث غريبة أو مفاجئة جعله الكاتب هو الخيط السحري مثل الحبل السري الذي يربط الجنين بالأم. ما تنتظره عند طاهر الشرقاوي لاتجده فهو يباغتك بالطبيعي لا بالمدهش ولكنه في النهاية يمتعك ويريك مالا تتوقعه.
“كان الرنين مزعجاً ولحوحاً، وعالياً لدرجة لا تُحتمل، خدش السكون المحيط بي بلا مقدمات.. فقط رنين حاد يضغط على روحي..”
هذا الرنين الذي لم يصاحبه اسم أو رقم.. البطل في حالة من الانتظار والمراقبة والحذر من رفع سماعة الهاتف .. هو لا يعرف القادم كل ما يشغله قوة هذا الرنين. الذي لا يحمل ذكريات ولا هوية تثير حفيظة البطل فقط قوة غير مرغوب فيها في تلك اللحظة الثمينة من السكون وقت النهار.
كيف عبر الكاتب عن تلك اللحظات، وأكد على شخصية البطل وسماته من الترقب والحذر والقلق. ورغم ان هذا الرنين هو الوسيلة الوحيدة لتفاعل البطل مع الحياة وكل ما يأمل من خلال البنت سيلين المتكلمة معه دائما عبر الهاتف بطول الرواية.
أيضاً نجد عالما من الأصوات متنوعاً ومؤثراً يملأ الرواية فمن صوت قطرات الماء الذي يصدر من حنفية المطبخ طول الليل لأنه توقف فقط في الصباح وصوت الشارع بما يحتويه من ضجة وعربة مسرعة وصوت سيدتين تتجادلان وخطوات أقدام كثيفة ونباح كلب أتى من بعيد.. كل ذلك بدقة متناهية واهتمام مبالغ فيه بل الأقوى من ذلك في العاشرة صباحاً وقت النهوض والحركة والاستعداد للحياة وقبل مباغتة رنين الهاتف استطاع البطل، وكأنه يملك زراً كبس عليه ليجعل كل تلك الضجة صامتة إنه يتحكم في عالمه بالكامل حتى للحظات ولكن السيطرة هنا هامة، لكنه كان يعمل حساباً لكل ما هو معروف ومعتاد عليه إلاذلك الرنين المباغت:
“توقفت حنفية المطبخ عن التنقيط الذي تواصل طوال الليل، سكن الشارع من ضجة عيال المدارس، بينما تخلت ربات البيوت عن أعمال النظافة اليومية، حتى بائعو العيش وأنابيب البوتاجاز والخضروات ورجل الروبابيكيا- وباتفاق غير مسبق- لم يمروا اليوم كعادتهم..”
ربما تواطأ الجميع لتهيئة المكان للرنين. تتوالى الأصوات في الرواية لتأخذ مواقعها من حياة هذا البطل المراقب والكامن فهو يحيا مع هذه الأصوات المحيطة إن كانت واقعية أو متخيلة فنجد:
“موسيقى تنبعث بصوت خفيض من الكمبيوتر.. عندها سمعت الصوت: ( بس ..أنت ) بدا مآلوفاً لي، واصل الصوت: أنت.. هذه الموسيقى حلوة.. ارفع الصوت قليلاً.. كان الصوت يأتيني من أسفل، وكنت ابتسم وأنا أفرد يدي في الفراغ، بينما بهجة تسري في جسدي كالسحر، وموسيقى تحملني برفق وكأني أعيش في حلم.”
أصوات تأتيه أثناء سيره: “أمشي على مهل، بينما صوت تليفزيون ينساب عالياً من إحدى النوافذ، بأغنية تتر أحد المسلسلات”.
وعندما ظن أنه سمع صوت ذاك الحجر البني عند مدخل العمارة عندما صعد درجتين..” وعندما قال: “أنتظر شيئاً ما يحدث في حياتي.. أنتظر مجيء هذا الشيء”.
عندما صاحت ديكة الشرفات، ونبح كلب ثم سكت للأبد، عندا كح مار في الشارع بشدة قبل أن يبصق على الأرض،عندما انطلقت سارينة مصنع بعيد، عندما نزل عصفور على الأرض، ونقر بمنقاره مرتين ثم قفز ثلاث قفزات وطار بعدها الى الشجرة القريبة.. عندها صحوت من النوم، كل شيء كما تركته بالأمس.”
و يسمع صوت خبط من خارج النافذه ولايجيبه أحد.. وعندما تخبره أمه في زيارة له أن أحدا كان ينادي على اسمه بعد صلاة العشاء، كانوا يعتقدون أنه أحد أصدقائه، أو أحد الجيران لكنهم لايجدون أحدا بالباب وقد تكرر ذلك عدة مرات.. وعندما ينهي الرواية بمشهد تدريب أحباله الصوتية أمام المرآة فهى مجرد بروفة، هو يحاول التركيزفي الصوت الخارج من حنجرته في محاولة التعرف على حالته وفكر ان الغناء يعد حلا سريعا، لذلك بدأ الغناء بصوت منخفض، ثم تدرج في الصعود حتى وصل لدرجة الصياح..
كان غياب صوت البطل الحقيقي وأصوات من حوله من بشر وأحداث ووقائع تم استبدالها بأصوات أخرى تشاركه حياته وأفكاره ومشاعره فهو القائل :
” قررت وبلا سبب الصوم عن الكلام.. أنا بطبعي لا أتكلم كثيرا، ما أفعله هو أني أدخر طاقتي لأشياء أخرى مثل الحركة أو التفكير أو التأمل…. أحياناً أتوق إلى شهوة الكلام …. الكلمة سحر.. أين ذهبت أصوات الموتى؟! “
ونجد ان هناك ثنائية في عالم بطل الرواية إن كانت الأصوات أحد أركانها فالأحلام هى الذراع الآخر فعندما يقول :
“ماذا لو عشت في حلم دائم، أدخل حلماً ولا أخرج منه أبداً، أو يسلمنى حلم إلى آخر ثم آخر، وهكذا إلى ما لانهاية، تبدو لي الأحلام أكثر رحابة من الواقع، لامكان فيها للمنطق.. الحلم هو الحرية الكاملة، منقوش على بوابته بخط واضح: ( يافتى .. اترك عقلك، وسم الله، وادخل برجلك اليمين ) ففعلت ودخلت.”
لقد أتته سيرين في حلم كما زارها هو الآخر في حلم: ” الحلم الذي زارتني فيه كان ملوناً ” لقد كانت أحلامه قليلة وساعدته في ان يحلم كل يوم.. لقد اشترك هو وهى في عالم الأحلام والعشق والافتتان بهذا العالم: ” أنا خبيرة في الأحلام.. هكذا قالت سيرين “
” البنت التي عاشرت الأحلام.. هى الوحيدة التي ستفهم وتنصت بلاملل أو تذمر، أو حتى دون إعطاء تفسيرات لا معنى لها مثل الأخريات.. “
” تخيل كل شيء أفعله أو يحدث من حولى شفته من قبل في الحلم.”
البطل أيضاً عندما يصف لحظة واقعية مع سيرين تكون أشبه بحلم فعندما يتحدث عن لحظة الفراق: ” هل رافقتها إلى محطة المترو ؟
أم أوقفت لها سيارة أجرة ؟ “
لقد تم بناء الرواية على كم من عادات البطل الخاصة والثرية والمتراكمة التي لعبت واحتلت دور الصدارة وأغنتنا عن البحث عن حدث.. فمثلاً اتحاده مع العتمة فهو لا يسمع الموسيقى إلا مغمض العينين محلقاً في ظلام لطيف لا ينتهي، يفعل ذلك أيضاً عند الكلام في الهاتف ليستطيع الانصات والكلام بشكل أفضل:
” العتمة تمنحني القوة على الحوار..” بل يسارع إلى إغلاق الستارة
أو الضغط على زر النور اثناء المكالمة.. إنه يخشى المواجهة ولحظات الكشف، ولا يحب المراقبة والبحث عنه.وهو يؤكد ذلك في مقطع آخر عندما يتحدث عن تحركه مثل الأعمى في الظلام :
” مثل الأعمى كنت أتحرك بخفة في الظلام، انتقل ما بين الصالة والمطبخ والحمام وحجرة النوم.. أعد كوب الشاى دون الحاجة إلى إشعال نور المطبخ، فقط أضغط على زر الغلاية ، منتظرا سماع صوت غليان الماء. ” وعندما يقول : ” في الظلام تتحفزحواسي الأخرى للعمل وينشط عقلى.. اللمس والسمع هما عيناي للرؤية في ظلام يحوطني ..أجلس في صمت متوحداً بالكرسي. “
الظلام يساعده على اصطياد الأصوات والاستئناس بها.
وهو يتوق للظلام في النهار فيقول : ” أصنعه على الفور، أسحب الستائر الثقيلة على الشبابيك، فتحل العتمة في المكان، عتمة تتيح لي رؤية الموجودات، عكس ظلام الليلالغامق الذي يبتلع كل شيء بداخله، عتمة النهار تميل لأن تكون بروفة من ظلمة الليل. “
ومن عادته التي تخص ثنائية النور والظلام أيضا عشقه للحظات ما قبل الغروب، تحديدا ما بعد العصر.. هو أيضا لاينزل من بيته بعد الغروب إلا في الحالات الطارئة والضرورية.
هذا البطل المفعول به دائماً من الموجودات والأشياء المحيطة الغاية في الصغر والبساطة يحاول أن يكون أحياناً فاعلاً لكن مع الأفكار والتصورات فمن عادته اقتحام حديقة في وقت متأخر من الليل والتمدد على مقعدها الوحيد، ومن عادته عندما يحاول تسلية نفسه بمفرده ليس في حاجه لوجود شخص أوحدث أن يحصي بلاط الرصيف، ومن الممكن ايجاد قطعة نقود، بل صعَّد مع نفسه الفكرة بمراهنة نفسه على حدوث ذلك وأنها تحديدا ستكون من فئة النصف جنيه وأن تكون فوق الرصيف وليس في عرض الشارع، وأن تكون سليمة خالية من أى عيوب صالحة للصرف.. وضع الشروط في تلك اللحظات واجب وقانون لابد من اتباعه.. بل إنه في موضع آخر من الرواية يؤكد تلك العادة التي تخلق الحدث الأمثل ليومه بل لعدة أيام قادمة وهى عندما سيطرت عليه فكرة عدم ركوب المترو إلا إذا كان السائق بشارب، ورغم أن الأمر بدا صعباُ فكل السائقين للمترو بغير شارب فقال : ” وكأن الأمر مدبر من أجل تعذيبي، لكى أبقى هكذا بلا حراك على المقعد الحجري.. ” والسؤال هنا من يملك في تلك لحظة تعذيب من؟! ومن عادته اهتمامه بالقطط ومراقبتها ومراقبة الكثير من الكائنات التي تشترك معه في فعل الوحدة او الكمون أو الترقب مثل القمر والشمس والمقعد الوحيد بالحديقة..
ومن أغرب عادته توقه للأحجار والاحتفاظ بها على اختلاف احجامها واشكالها والاهتمام بها كأنها كائنات حية واحتفاظه بهذا الحجر البني الكبير وقد كتبت أحلى المقاطع عن هذا الحجر.. وكان له تأثير في عنوان الرواية.
من الجميل حالة السخرية في التعبير عن نوع خاص من البشر واطلاق مسمى مصاصى الدماء عليهم وتلك الكائنات التي تُجيد أن تنفرد وتتغذى على الأفراد الوحيدين ويتفننون بذلك وتلك المقاطع في الرواية بديعة الوصف والسرد.
ونجد أن اسماء الشخصيات والكائنات في الرواية قد أطلق عليها جميعها اسم (س ) فهناك صديقتي الأولى س، وصدبقتي الثانية س، وجاره س الذي قرر الانتقال لشقة أخرى، والشاعر س، وعاملة نظافة العمارة التي يسكن بها أم س، والقطة س لجارتي، وجاري س الذي لم يمنحني فرصة للنوم عندما خرج لمدخل العمار وبدأ يصيح.. كأن كل من حوله سؤال كبير عوالم لا يقترب منها ولايبزل مجهودا للتعرف عليها ولا يعطيها الفرصة إلا أن يكون هو الآخر س كبيرة بالنسبة لها..لذلك تكثر أسئلته في الرواية بمواضع متعددة هو من قال : ” انتظر شيئاً لا أعرفه.. ” هو الغامض للآخرين فعندما يسأله الجميع عن الحجر الذي في بيته يقول : ” ( إنه تحفة فنية) تلك هي الحجة التي كنت أقدمها لأصدقائي في المقهى عندما ألمح نظرة متسائلة على وجوههم..”
سيرين الشخصية الوحيدة التى أطلق اسمها وهى تبدأ ب”س” وكأنها من تحمل بعض الأجوبة التي فاز بها في حياته وجاءته على حين غرة.لقد أوضحت الرواية معظم ملامح الفرد الذي يعتنق الوحدة أسلوباً وقانوناً وغاية فهو من قال :
” أخذت أفكر في خفة الطائر، في وجوده معلقاً بين السماء والأرض، يبدو العالم من تحته مثل شيء ملقى بإهمال، يلفه الصخب والتراب وروائح راكدة، لو كنت مكانه لظللت في السماء الى الأبد، أبني عشى في الفراغ، أرافق البرق والرعد، وأنقر السحاب كلما قرصني الجوع.” ألم يقل: ” ما أفعله هو أنني أجمع حياتي كلها في مكان واحد.”
إنه الذي يجيب دائما بلا أعرف، فهو يحتاج لوقت للتفكير، أوعنده إجابة غير قاطعة، ليست نهائية.. هو السيد لا أعرف..
الذى كان دقيقاً جدا في كل ما يعرفه عن عالمه وما يخصة بتميز واضح واكتمال لا يحتاج لشيء بجانبه.. هو لا يعرف ما يعرفه الأخرون لكنه يعرف معرفة أخرى لاتخطر على بال أحد.. فهو المدهش لا المندهش، الذي يحيط بالأشياء لا أن تحيطه الأشياء وهو المُدرك المسيطر رغم عدم إعلانه عن ذلك.