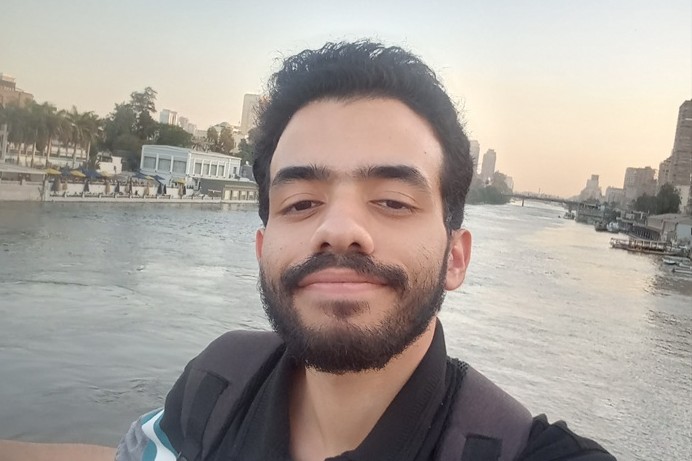حسن عبد الموجود
في عام 99 كنت لا أزال متأثراً بما أسمعه عن أساطير الكتابة رغم مرور عام كامل على حضوري إلى القاهرة. بالكاد تخلصت من فكرة حفظ قصصي كما كان يفعل يحيى الطاهر عبدالله. في الأتيليه أخبرت صديقي الدكتور محمد بدوي أنني كتبت قصة جديدة، فطلبها مني. كانت نفس القصة التي حملتْ عنوان مجموعتي الأولى “ساق وحيدة”، القصة التي اكتشف بطلُها -فور استيقاظه- أنه يسير على ساق وحيدة. في المقابلة التالية قال لي بدوي إن القصة أعجبته، مضيفاً أنني متأثر بكافكا. قلت له: “ولكنني لم أقرأ كافكا”، فقال: “كافكا من الكتَّاب العابرين، تأثيره ينتقل عبر مؤلفين آخرين”. وجَّه بدوي نظري إلى كافكا فبحثت عن أعماله فوراً.
كانت هذه القصة بداية اكتشافي لكتابة خاصة، حول أشخاص مصابين بنوع من البارانويا، ولديهم هواجسهم الخاصة تجاه كل شيء حولهم، تجاه البشر والحيوانات والطيور والجماد. كانت “ساق وحيدة” بداية تخلصي من إرث ثقيل، إرث يخص يحيى الطاهر عبدالله. كنت أقلده في كل شيء، في عالمه، وفي لغته، وحتى في طريقته التي انتقلت إليَّ شفاهة.
انتبهتُ فجأة أنه صارت لديَّ ملامح تخصني وأنني أتغير بالكامل، وبالتالي اتصلت بالروائي فؤاد قنديل رئيس تحرير سلسلة “إبداعات” وطلبت منه ألا يُصدر مجموعتي “أجيال جديدة من المدن الرمادية”. كان الرجل مندهشاً وقلقاً، وحاول أن يفهم سبب تراجعي المفاجئ قائلاً إن العمل في المطبعة، كان مهتماً -وهو الشخص المهذب جداً- ألا أكون متضايقاً منه لأي سبب من الأسباب، وأقنعته بأنني تجاوزت هذه المرحلة، وأنني لا أريد إصدار كتاب أندم عليه بعد ذلك، قلت له: “لا عليك.. ليس لك ذنب في أي شيء”، وهكذا كانت “ساق وحيدة” السلمة الأولى لي في عالم الأدب. لم أندم على إلغاء طباعة “أجيال جديدة من المدن الرمادية”، ولكنني حزنت بالطبع لأن غلافها الجميل الذي صممه الفنان الكبير محيي الدين اللباد لن يرى النور. لا تزال قصص هذه المجموعة تشكِّل مرجعيتي، إن جاز التعبير، مرجعيتي بتركيزها على منطقتي نقيض، العتمة في امتزاجها بالنور، وتفاصيل الحياة الكئيبة في امتزاجها ببهجة الخيال، أحد أبطال هذه المجموعة يشن حرباً على الجيران بالبندقية بسبب مؤامرات صغيرة لا تدور إلا في رأسه هو، بينما يعتني آخر بأشجار تطرح ثمرات الويسكي، ويعاني ثالث لأن الطرقات تتمدد به. هؤلاء أبطال يعيشون في متاهات تشبه المتاهات التي كنا نحلُّها في مجلات الأطفال، ولكن الفارق أنها متاهات لا أول ولا آخر لها، ولا يوجد حل لها في نهاية الصفحة. ثم جاء الدور على الرواية، كنت كمن يوفي خدمته الوطنية، كأن كتابة الرواية إلزام، أصدرت روايتين متتاليتين “عين القط” و”ناصية باتا”، الأولى كانت مهتمة برصد عالم القرية في الجنوب من خلال عين قط، أو عين راوٍ طفل، والثانية اهتمت أكثر بفكرة مؤسسة العقاب التي جاءت مزيجاً من كل مؤسسات العقاب في المجتمع.
ولأسباب كثيرة توقفت عن الكتابة لسنوات، وكان عليَّ، بعد ذلك الابتعاد الطويل، أن أعود إلى عالمي المفضل، عالم القصة القصيرة، فأنا كاتب قصة في الأساس، وحينما أذهب باتجاه الرواية أذهب زائراً، لكنني كنت كالضيف الثقيل الذي استمر عند جيرانه سنوات، عدت إلى القصة فكانت “السهو والخطأ” مجموعتي الثانية امتداداً لذلك العالم الذي ظهر في “ساق وحيدة”، العالم العبثي، الذي يرى فيه كل فرد في التلفزيون شيئاً يختلف عما رآه الآخرون رغم أنهم يشاهدون شيئاً واحداً، الذي يذهبون فيه إلى مطاعم تقدم خدمة عدم الاستجابة، إلخ. غير أن ما اختلف بين هذه المجموعة وسابقتها أن الخلفيات في القصص صارت أكثر وضوحاً، كما أن الأماكن ظهرت بمسمياتها، يمكن القول إن عالم الوحيدين الذي رسمتُه بالرصاص في “ساق وحيدة” أعدتُ رسمَه بالألوان الزاهية في “السهو والخطأ”، أما المجموعة الجديدة “حروب فاتنة” فالاتجاه كان أكثر ميلاً إلى رسم الشخصيات جيداً، وكنت في احتياج بالطبع إلى عدد أكبر من الكلمات لأحقق هذا، ولذلك فإن معظم القصص جاءت مكتنزة، كنت خائفاً من الأمر لكنني شعرت بسعادة حينما أخبرني أحد أصدقائي أنها ممتعة رغم ذلك الطول. كان هذا نوعاً من التحدي الجديد الذي فرضته على نفسي، فبخلاف أنني أردت أن أختار القصص العبثية من قلب الواقع، فإنني أردت أيضاً تقديم قصص ممتعة ومشبعة، وأن تكون متعتها مركزة مثل “حشو” الحلوى. كنت أثناء طفولتي آكل الحلوى قطعة قطعة محاذراً أن أذهب باتجاه القلب مباشرة، حيث الشيكولاتة الخام والمتعة الصافية. كنت أعتبر أنها مكافأتي في النهاية. هذه هي القصة القصيرة، القلب المُركَّز والممتع، وقد أردتُ وأنا أقدمه إلى الناس أن أكون أكثر كرماً من كل صانعي الحلوى في طفولتي، وأن أقول لهم إن قصة واحدة قادرة على مضاهاة رواية عظيمة، بكل لعبها وخيالها وأفكارها وشوارعها ومبانيها وأبطالها وتقاطعات مصائرهم.