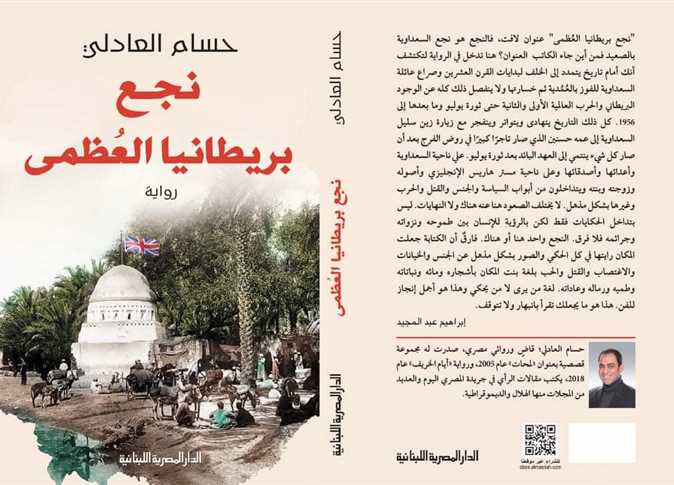ومثلما تغتني عتبة الرواية بأفعال الحياة ومعجزاتها تمنح المسوخ نصيباً في مراقبة عالم المدينة والتحكّم في تحولاته وقد خلقها هواء الموت عبر متوالية أحلام لا تقود، في كلِّ مرّةٍ، إلا لموت جديد، ” فور أن أقاموا فوقه القبة بدأ يحلم، ظلّ يحلم في كلّ مرّة بمدينة، يؤسس فيها بيتاً في منامه، ويكون له فيها ضريح عندما يستيقظ”، يبدأ الحلمُ لحظة الموت، ليكمل الموتُ الحلمَ، وتواصل الحكاية الاصغاء لصوت الغائب الذي ما إن يتجلّى حتى يبدو واحداً من أوهام الحياة التي تتوالد في كلِّ حين، إذ “إن اوهام الحياة أكثر بكثير من حقائقها”. الوهم الذي لا يقابل الحقيقة، ولا يتجسّد ندّاً شاخصاً من أندادها، إنما هو وجه من وجوهها، سافر وصريح مرّة، مغيّب ومجهول مرّة أخرى، إنه ليل العالم الذي تنشأ في عتمته المخاوف و تُحكى الحكايات وهي تمضي على طريق المعرفة الموغل في الألم، “إن عذاب الانسان يبدأ حين يسأل عمّا لا يجب أن يعرفه”، فهل ينبثق العذاب في (ضريح أبي) من سؤال المعرفة الممنوعة والمحرّمة، أو من رغبة الانسان وهي تستعين بالحكاية لمواجهة الفناء؟
تهئ الرواية مجالاً للإفادة من اللغة الصوفيّة وهي تمنح لغتها أفقاً مضافاً تختبر من خلاله فاعلية الصلة بين أدوات التعبير ومحمولاته، ظلاله وتلميحاته ومعانيه، مثلما تفيد من قدرات السرد الشعبي الذي ينمو متوالداً في كلِّ حكاية على نحو جديد. السرد الشعبي حاضر على نحو خصب عبر خصائص التوليد والتتابع والحركة الحرّة بين الحقيقة والخيال التي تقود، بالضرورة، لإنتاج سمة عجائبية تبدو واحدة من سمات حقل طارق إمام، بما يفتح أفقاً بين القص القصير والرواية، إن الحكاية التي انبثقت مستندة إلى ملمحها العجيب في قصته القصيرة ( العجوز الذي كلما حلم بمدينة مات فيها)، تجد متسعها في (ضريح أبي)، وهو المتسع الذي لا يحتفي بالثيمة وحدها، ولا يقف عند حدودها، بل يُنصت لتجلياتها وهي تعيش مغامرتها وتنتج أسئلتها في الكتابة والحياة، وهي ترصد تحوّلات المعجزة وتقف على رمادها، “عندما تفتقد المعجزةُ رعبها تتحوّل إلى شئ أكثر ألفة مما يراه الناسُ كلَّ يوم”، فمن خلال المعجزة تسعى الرواية لكسر الألفة وتجديد ما يعتمل في دواخل البلدة من رعب، وقد كانت “واحدة من أكثر البلدات قدرة على تحويل رعب وجود معجزة إلى ما يشبه أرقاً يومياً يكفي تجنّبه لكي يتبخّر”. لا تُميت المعجزةَ سوى معجزةٍ لاحقةٍ تنهض من رمادها لتوالي حكايتها وتجدّد أسئلتها مثلما تتجدّد ميتةُ الأب بين الصحو والمنام، فتقوده “كلُّ ميتة في المنام لميتة حقيقية في الواقع، لنهاية ينتهي فيها جسده كلَّ مرّة إلى التراب، ويُبعث بالاستيقاظ من نوم كجنين يرى الدنيا لأول مرّة“.
إنها المسافة الصعبة، السريّة والملغّزة، بين اليقظة والمنام، بين الموت بوجوهه التي لا تُعد، والحياة، وهي المسافة التي تقترحها الرواية أفقاً لحكاياتها التي تنشأ في ظل معجزة تخلخل الصلة مع الواقع وتفتح المجال أمام أسئلةٍ تتولّد من تراب الحكاية، من ذرات رمالها، فتقترح سبيلاً جديداً لدخول الضريح الذي يظل الكتابُ سبيله الأمثل فهو أبداً ” كتاب لا ينتهي، مثل حيوات صاحب الضريح، كلما امتلأت صفحاته ستولد صفحات بيضاء جديدة“.