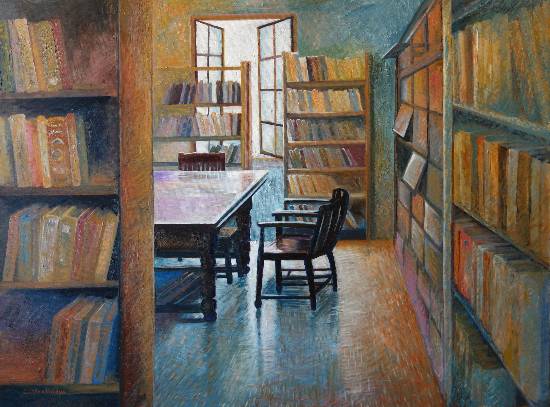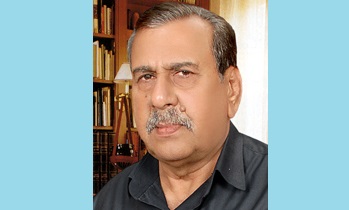د. إلياس زيدان
إطلالات تربويّة من شبابيك الوطن – 9
صَمَدْنا وتَمَرَّدْنا!
لم يرضخ جميع الطّلّاب المقهورين في كتاتيبهم ومدارسهم لقساوة معلّميهم وأساليب تعليمهم “القديمة العقيمة الجوفاء”.[1] والحديث يدور هنا عن أولئك الطّلّاب الّذين “صَمَدوا” ولم يتركوا، مُكْرَهين، تلك المؤسّسات البغيضة على قلوبهم والمهينة لكرامتهم الإنسانيّة إلى غير رجعة. تمرَّد هؤلاء الطّلّاب بشتّى الأشكال. استخدم بعضهم “تكتيكات” مختلفة للتّهرّب من السّاعات العصيبة التي قضوها في غرف كتاتيبهم ومدارسهم. بعضهم ضاق ذرعًا بعنف المعلّمين، فقام بأعمال تخريب وُجِّهت إلى ممتلكات الكتاتيب والمدارس، وبلغ الأمر ببعضهم الآخر حدّ الانتقام المباشر من المعلّمين المُعنِّفين. نعم، كان ابنُ الفرّان عليّ الخليلي (1943-2013) صاحب الصّندل المقطّع أحد هؤلاء.
روى لنا الطّالب الدّمشقيّ عليّ الطّنطاوي (1909-1999)، في “ذكريات”، عن ذلك المعلّم الشّيخ الّذي كان يحبسهم في غرفة الكتّاب، وينهكهم بكتابة ألف باء في ألواحهم الحجريّة “أربعاً وعشرين مرة، نكتبها ليراها ويمحوها، ثم نكتبها ليراها ويمحوها…”. [2] كان الطّلّاب يحاولون التهرّب من هذا العذاب، وكانوا يكتبون كما يقصّ عليّ: “إلّا أن يضطر أحدنا (أو يزعم أنه مضطر) للخروج إلى المرحاض فيسمح له بدقائق، إن زاد عليها، ازدادت عليه ضربات الخيزران”.[3] وهنا يوجّه الطّنطاوي أصابع الاتّهام إلى المسؤولين في الكَتاتيب مؤكّدًا: “كنا نكذب.. نعم! أفليسوا هم الذين دفعونا إلى الكذب؟”.[4] إذًا، لجأ الطّلّاب إلى الكذب، وفق الطّالب عليّ.
كان إدوارد سعيد (1935-2003)، طالب “إعداديّة الجزيرة” في القاهرة، يكذب أيضًا، وذكر في “خارج المكان” أنّه عانى الأمرّين من معاملة والديه القاسية له في البيت، ومن جوّ الطّاعة العمياء للمعلّمين والطّلّاب في المدرسة، والعنف المُمارس تجاهه.[5] ورغم أنّ المسافة بين بيته والمدرسة كانت قصيرة، لكنّه كان يتلكّأ في الوصول إليها وفي طريق عودته إلى البيت. وهو يكتب: “وكان الزمن الذي يستغرقني للذهاب إليها والعودة إلى البيت منها يثير دومًا إشكالًا مع أساتذتي وأهلي، وهو إشكالٌ ارتبط في ذهني ارتباطًا لا ينفصم بكلمتين هما: “التسكُّع” و”الكذب” وقد أدركتُ معناهما لارتباطهما باجتيازي المتعرج والمليء بالتخييل لتلك المسافة القصيرة”.[6] لكنّ الطّالب إدوارد، كما أكّدنا في الإطلالة السّابقة، يلوم نفسه لأنّه لم يقم بمعاقبة المِستر بولين حين “جذبني من قذالي ثم دفعني نحو الأسفل بحيث بتّ منحنيًا نصف انحناءة. ثم رفع الخيزرانة باليد الأخرى وهوى بها على مؤخرتي ثلاث مرات”.[7] لا بل وصل به الأمر حدّ اتّهام نفسه بالضّعف لعدم قيامه بذلك. فيتساءل بنبرة تأنيب للذّات: “وكيف أمكنني أن أكون بلا حَيل إلى هذا الحد و”ضعيفًا” كل هذا الضعف […] بحيث تركتُه يعتدي عليّ ويفلت من العقاب؟”.[8] حسب الطّالب إدوارد سعيد، فإنّ شعوره بالضعف وعدم قيامه بمعاقبة المعتدي كانت له تبعات سلبيّة هدّامة رافقتْه طوال حياته، نقرأها في قوله: “ظل بولين ساكنًا ذاكرتي، لا ينمو ولا يتحول، مثلَ الغُول في حكايات الأطفال”.[9]
ننطلق من دمشق والقاهرة إلى المدينة المنوَّرة، حيث كانت تجربة الطّالب عزيز ضياء (1914-1997) مع الكتّاب مشابهة لتجارب إخوانه في أقطار مختلفة من الوطن العربيّ. يؤكّد الطّالب عزيز في “حياتي مع الجوع والحب والحرب” أنّه ذاق “الفلكة”، وعانى هو وزملاؤه من تعنيف الشّيخ لهم. لكن، رغم عيشة الرّعب في الكتّاب إلّا أنّه استطاب الحياة فيه! وكيف يستطيب طفلٌ مكانًا كهذا تعرّض فيه لكلّ هذه القسوة؟! للطّفل عزيز تفسير مثير للاهتمام لهذا الأمر: “أما الأسباب التي جعلتني أستطيب الحياة في الكتّاب، وأتعشقها، فهي أولئك الزملاء الذين تعلمت منهم، كيف يرفعون أصواتهم متظاهرين بالقراءة، عندما يجلجل صوت الشيخ وفي يده الجريدة الخضراء الطويلة “جداً” بينما هم لا يقرأون، وإنما يرددون بعض الشائع من أغاني الحارة […]”.[10] لم ينتهِ الأمر عند هذا الحدّ، وكأنّ أطفال المدينة المنوّرة كانوا على تنسيق مع أطفال دمشق، إذ يحدّثنا عزيز عن “تلك الحيلة التي يلجأ إليها، للخروج من الكتّاب إلى “الميضة” وهي ما نسميه الآن “دورة المياه”.. ما على الزميل الذي يريد أن يخرج “ليتفسح” إلا أن يقف رافعاً يمناه مقبوضة الأصابع منفردة الخنصر، بينما يسراه تحت سرّته، وبحركة تململ تفسيرها أنه “محصور جدّاً”.[11] ويستمرّ في الوصف: “ولا يجهل الشيخ أنها حيلة للخروج فقط، فيتركه واقفاً هكذا لحظات، ثم يأذن له بالخروج، فلا يكاد، حتى يقف آخر… وثالث… وكلهم بنفس الحركة “محصورون جدّاً”، ولا يجد الشيخ بداً من الإذن لهم”.[12] لم تكن خطوات التّلاميذ هذه عفويّة، فيشدّد: “واتضح لي – بعد فترة – أن الاثنين أو الثلاثة يتصنعون هذه الحركة باتفاق مسبق… فلا يكادون يخرجون من الباب، حتى ينطلقوا إلى باب الحرم الواسع العريض.. وهناك يجدون الحاجّات التكرونيات يبعن “البليلة” وهي الحمص المغلي الناضج […]”.[13]
سنعود إلى الطّالب عزيز ثانيةً بعد أن نزور الطّالب محمّد عبد العزيز سلام (1935-2013)، وهو من تعز اليمنيّة. في السّنة الدّراسيّة 1946/1947 تمّ اختيار الطّالب محمّد ضمن بعثة طُلّابيّة للتّعلّم في لبنان، وذلك في ظلّ عدم تطوّر جهاز التّعليم اليمنيّ في حينه. كان محمّد ضمن المجموعة الّتي تعلّمت في كلّيّة المقاصد الإسلاميّة في طرابلس. يبدو أنّ حياة المدرسة الدّاخليّة احتوت على كثيرٍ من القيود والحرمان والقساوة. وما هي الطّريقة الفضلى للتّحرّر من أسوار المدرسة؟ يؤكّد محمّد: “كان الاستاذ علي الانسي يسمح للطلبة الذين من تعز والحديدة […] بالخروج من المدرسة ليلا بغرض الذهاب الى المسجد لتأدية صلاة التراويح”.[14] لكنّهم، وعلى ذمّة الطّالب محمّد: “كنا نذهب للتسكع في أسواق مدينة طرابلس الشام وندخل السينما […]”.[15] يبدو أنّ الكذبة قد مرّت على الأستاذ حتّى تلك الليلة الّتي يؤكّد محمّد في خصوصها: “وفي احدى الليالي تاخرنا كثيرا عن موعد المذاكره بسبب عرض فيلمين متتاليين في السينما”.[16] وجاء العقاب: “عندما عدنا وجدنا أن الاستاذ علي الانسي قد وقف لنا بالمرصاد ليس للتوبيخ فقط ولكن للضرب بالمسطرة على راحة الايدي”.[17] بعد الضرب سألهم الأستاذ عن سبب التّأخّر: “فأجبناه بأن إمام المسجد أطال في قراءة السور والركوع والسجود”.[18] لم ينتهِ كذب الطّلّاب عند هذا الحدّ. كان محمّد وأغلبيّة الطّلّاب المصلّين-المتسكّعين من “الشوافع” باستثناء الطّالب يحي جغمان، فيؤكّد محمّد: “كان معروفا بأن مذهب الأخ يحي (زيدي) أي انه لا يصلي التراويح”.[19] في تلك الليلة العصيبة سأل الأستاذ عليّ الطّالب يحي: “أين كنت يا يحي؟ فرد الأخ يحي، بكل حزم وصلافه، كنت اصلي التراويح مع الاخوان”.[20] اندهش الأستاذ من الإجابة “وقال له “انت !! بتصلي تراويح؟ من أي حين قدك شافعي”؟”.[21] وردّ يحي على الأستاذ قائلا: “منذ القدم”. وأضاف يحي: “احنا بيت جغمان أصلا نقيله من لواء تعز وابي وجدي كلهم شوافع”.[22] ويكتب محمّد: “ومن يومها كان الاخ يحي جغمان يخرج معنا لتأدية صلاة التراويح في شوارع ودور سينما طرابلس الشام”.[23]
لم يكن ما وصفناه أعلاه قمّة “العفرتة”، كما يسمّيها الطّالب عزيز ضياء: “كانت هناك أعمال تخريبية خطيرة تمارس في الميضة… وهي تكسير أباريق الوضوء المصنوعة من الفخار […] والغرض هو ادعاء عدم وجود هذه الأباريق للوضوء عند أذان الظهر.. ولا أدري كم من عشرات أباريق الفخار هذه كان يشتريها الكتّاب كل أسبوع”.[24] ويضيف عزيز: “تطورت تصرفات (الشقاوة) و(العفرتة) بيننا، ومنها الاستمرار في تكسير الأباريق.. وعندما اشترى الكتّاب أباريق من الصفيح… لم نتردد في قطع ما كنا نسميه (أخشامها – جمع خشم) […]”.[25] هذا ما كان يحدث خارج غرفة الكتّاب. وهل من عفرتة داخله؟ بالطبع. يواصل عزيز سرده: “هذا إلى جانب مسحوق كنا نشتريه من العطار ونحتال لنفثه عندما ترتفع أصواتنا بالقراءة… فإذا بنوبة من (العطس) تنتشر لتصل حتى إلى العريف”.[26] وكان لا بدّ للشّيخ من أن يردّ النّار بالمثل، فيكتب عزيز: “ولم يكن الشيخ الجليل يجهل هذا المسحوق، فيأمر العريف (محمد) بتفتيش كل واحد منا، فإذا وجد أثراً للمسحوق في جيب أحدنا، فإن نصيبه تلك (الفلكة) و(الفرش) بينما نوبة العطس مستمرة… ومعها الضحك المتواصل، على الذي وقع في الفلكة و(أكلها) والضمير عائد إلى (العلقة)”.[27] ويضيف الطّالب عزيز: “ومع أننا كنا نؤكد في كل مرة كلمة (توبة يا الشيخ) فإن التوبة هذه كانت مجرد كلام… إذ ما أكثر ما عدنا إلى هذه التصرفات”.[28] وكان الأولاد لا يكتفون بتخريب الأباريق، بل وصل بهم الأمر إلى “تفريغ الحنفية من الماء.. فالأبارق مقطوعة (الأخشام) والحنفية لا ماء فيها… ومع ذلك فقد كنا نسرع للصلاة في وقتَيْ الظهر والعصر..”.[29] وكيف يُصلّون ولا ماء في الحنفيّة؟! وماذا بخصوص الوضوء؟! حتمًا سيجد الطّلّاب حلًّا. وبالفعل، وجدوه عند ذلك الطّالب “المُفْتي”! ينوّرنا الطّالب عزيز: “وقد أفتانا أحد الكبار من الزملاء بأننا نستطيع أن نتيمم… وعلَّمنا التيمم.. وهذا ما شجّعنا أو أغرانا بأن نواصل تخريب الأباريق، وتفريغ الحنفية الجدارية من المياه”.[30]
يعترف حنّا ديب نقّارة (1912-1984) أنّه كان مشاغبًا، لا بل كوّن هو وبعض زملائه في مدرسة القسّيس خضر – “سان لوكس” في حيفا، “عصابة من الطلاب المشاغبين في الصف، وصرنا نتحرش بالطلاب ونقيم الضجة […]”.[31] كانت المدرسة تسجّل مخالفات الطّلّاب في سجلّ خاصّ، وعند وصول مخالفات الطّالب عددًا محدّدًا كان يُعاقَب بضربات بالخيزرانة من المدير. ويروي الطّالب حنّا بخصوص عصابته: “ولمّا اشتهرنا بالمشاغبة كانت العلامات السيئة تسجل في مقابل أسمائنا سواء أكنا نحن المذنبين أم غيرنا”.[32] غضب أفراد العصابة من هذا الوضع، وبناءً عليه كما يؤكّد حنّا: “قررت عصابتنا الاستيلاء على السجل وتمزيقه، وهكذا انتظرنا حتى خلت المدرسة من الطلاب والمعلمين، فأخذنا السجل إلى شارع الراهبات خارج سور المدرسة وهناك مزقناه إرباً إرباً”.[33] في اليوم التّالي حقّقت المدرسة في الأمر، وانهار أحد الطّلّاب “وسرد ما يعرفه فعوقبنا عقاباً مضاعفاً”.[34] وكيف يُبرّر الطّالب حنّا فعلتهم هذه؟! يقول في ذلك جازمًا: “لقد دفعنا إلى هذا العمل شعورنا بالاضطهاد، إذ كان كل إخلال بالنظام يُنسب إلينا بحق أو من دون حق، وكردة فعل على هذا الإجحاف مزقنا السجل”.[35] ويُجمِل قائلًا: “علمتني هذه الحادثة معنى أن يثور المرء على الظلم ولا يقبل الاستكانة إليه”.[36]
وصَلَ الأمر ببعض الطّلّاب حدّ التّمرّد. يصف جبرا إبراهيم جبرا (1919-1994) تمرّد جليل – أحد طلّاب صفّه الأكبر سنًّا في بيت لحم – على معلّمه. يروي جبرا أنّ المعلّم أمرَ الطّالب جليل بقراءة جملة من كتاب القراءة العربيّة، ويبدو أنّ جليل لم يكن متمكّنًا، ولذلك “قرأها متلعثماً، وبأخطاء كثيرة”.[37] في حالة كهذه لا بدّ من معاقبة جليل. أمرَ المعلّم الطّالب جليل “بأن يترك مكانه وينزل الى رأس أحد المقاعد “السفلى”، حيث “أولاد الألف باء”، ليراجع درسه”.[38] امتثل جليل لأمر المعلّم، ولكنّه ما إن جلس هناك حتّى بدأ يمازِح ويُضِحك الطّلّاب الصّغار. لم يتوقّف جليل عن إضحاك الطّلّاب الصّغار رغم تنبيهات وتقريعات المعلّم، وفي النهاية صاحَ المعلّم بجليل وأمره بأن يأتي إليه لينال قصاصه بأربع عصيّ. تمرّد جليل على أمر المعلّم وقال “متحدّياً، بصوت عالٍ: “والله مش جاي!” وأضحك صبية المدرسة كلهم”.[39] ثارت حفيظة المعلّم وهبّ في اتّجاه جليل حاملًا إحدى عصيّه الغليظة، فهرب جليل من المعلّم والمعلّم يطارده محاولًا الإمساك به، وضربه بالعصا ولكن هيهات. يؤكّد جبرا: “انطلق الطريد من باب المدرسة، واختفى”.[40] يقيِّم جبرا الأمر فيكتب: “تمرّد مثل ذلك كان نادراً، لأن آباء الطلبة كانوا في الأغلب مع المعلم على أبنائهم”.[41] بناءً على ذلك، كان الطّلّاب يعصون بأساليب أخرى، كما يشير جبرا: “والعُصاة بين الصبية كانوا حقاً كثيرين. فالعديدون منهم لا يأتون إلى المدرسة إلّا مكرهين، ويفضّلون اللعب بين أرجاء الخرابة، أو الانسراح بين الناس في سوق البلدية القريب”.[42]
قام بعض الطّلّاب المضطهدين بالانتقام من معلّميهم بشكلٍ مباشر. وفي العودة إلى الطّالب النّابلسيّ عليّ الخليلي (1943-2013)، فقد كره ذلك الأستاذ الّذي كان يأمره بالحبس الذّاتيّ داخل خزانة في حائط الصّفّ، ويسرق من علاماته ويعطيها لطالب آخر.[43] بدأ الطّفل عليّ يكوّن صورة سلبيّة عن أستاذه، فيصفه كما يلي: “كان معلماً بشعاً، مثل قرد، هو كذلك، في عيني على الأقل […]”.[44] لم يكتفِ عليّ بهذا العقاب “الذِهْنِيّ” لمعلّمه، بل انتقم منه بهذه الطريقة: “وقد حرصت مرة، على أن أصطاده بالشعبة، شددت المغّيطة بأقصى قوتي، وأطلقت الحصوة منها إِلى رأسه، أصابته، وهو ينحني إلى رباط حذائه، على عتبة باب المدرسة. تلوّى، ولم يعرف أنها مني”.[45]
في سيرته “قصة حياة” وصف لنا الطّالب القاهريّ إبراهيم المازني (1890-1949) معاناته في الكتّاب. في سنّ السادسة أخرجته أمّه من الكتّاب وبعثت به إلى المدرسة.[46] واستمرّ القهر هناك أيضًا. يروي الطّالب إبراهيم: “وكان مساعد المديرة رجلا فظًا […] إذا أخطأنا أو قصرنا يأمر الواحد منا أن يخلع الطربوش ثم يضربه على رأسه العاري بالخيزرانة”.[47] وذات يوم بلغ السّيل الزّبى، فقرّر الطّلّاب إعلان الثورة على أستاذهم. يكتب إبراهيم: “وكنا في الفصل سبعة أو ثمانية، فحدث يوما أن أوسعنا ضربًا على رءوسنا فثرنا به من فرط الألم، وتمردنا عليه وأشبعناه لكما وركلا، ومزقنا له سترته الطويلة – الاستانبولين – وخطفنا العصا من يده وأذقناه وقعها على أصابع يديه وعلى ركبتيه ولا أحتاج أن أذكر أننا طُردنا […]”.[48]
تعاضَدَ الطّلّاب المقهورون في جهات مختلفة من الوطن الكبير. ففي فجيج في المغرب، كما يذكر محمّد عابد الجابري (2010-1935): “لم يكن الأطفال المشاغبون يستسلمون لعصا الفقيه هكذا بدون رد الفعل، بل كانوا كثيراً ما “ينتقمون””.[49] وقد تنوّعت أساليب الانتقام، فمنها ما تمثّل “بوضع أشياء حادّة موخزة أو مزعجة بين تلابيب صوف “هيضورة” الفقيه: تارة شوكاً وتارة مسماراً وأحياناُ عقرباً…”.[50] لم تكُن هذه الأفعال كافية لكي تروي غليل الطّلّاب، فلا بدّ من أن يروا الفقيه وقد جنّ جنونه. يكتب الطّالب محمّد في هذا النّوع من الانتقام: “أما إذا أراد أحدهم أن يرى الفقيه وقد جن جنونه فإنه يطلق “مواء” كمواء القط عندما يكون الفقيه منهمكاً في تصحيح لوحة أو منساقاً مع غفوة نوم. إنه التحدي الذي يجعل الفقيه يفقد عقله، إذ لا يتبيّن في الغالب صاحب “المواء” ولا يجرؤ أو يقبل أحد من الأطفال الكشف عن اسمه، وهكذا يأخذ الفقيه بالضرب بعصاه، يميناً وشمالاً فتتمايل الصفوف وتتزاحم الأرجل والأجساد ويكثر الصياح”.[51]
وفي حلحول الفلسطينيّة “استحدث” الطّالب نبيل عَناني (1943-) وزملاؤه نوعًا جديدًا من الانتقام هو في غاية الخطورة. يكتب عَناني: “وشاعت أجواء إرهابية في المدرسة، الأمر الذي أوجد ردة فعل سلبية لديّ ولدى الطلاب، ونتيجة عكسية لما يؤمل به من التربية والتعليم”.[52] فقام الطّالب نبيل ومجموعة من أصدقائه بالانتقام، لكنّ الانتقام هذه المرّة لم يكن مباشرًا من أحد المسؤولين، وإنّما من أخٍ له! يبدو أنّ نائب مدير المدرسة كان من خارج حلحول، فاستأجر وأسرته بيتًا في حلحول، وقد كان يسكن معه أخوه الذي ارتاد المدرسة مع نبيل وكان في صفّه. رأى نبيل ومجموعة أصدقائه أنّ الانتقام من أخ نائب المدير أسهل من الانتقام من نائب المدير نفسه، على ما يبدو. ويذكر نبيل أنّه ذات ليلة، بعد أن خلد هذا الطّالب إلى النّوم في “شرفة غربيّة خارج البيت […] اتجهنا إليه بحذر، وحملناه مع فرشته، كل من طرف، ووضعناه وهو نائم عليها في منتصف الشارع وتركناه”.[53] وكاد هذا السّلوك يودي بحياة هذا الطّالب، ففي الصّباح أفاق “من نومه مذعوراً في إثر زعيق بوق سيارة كادت تصدمه”.[54]
وبعد،
أودّ، عزيزي/تي القارئ/ة، أن أسألك عن رأيك بِطَرْح جبرا إبراهيم جبرا عن كون: “الذات والمحيط كانا أحياناً موضوعين متبادلين، في الواحد انعكاس للآخر، بل وتجسيد رمزيّ له أحياناً […] ولكن الذات والمحيط كانا أحياناً على طرفي نقيض. وكان على الذات أن ترفض، بضرب من الجنون، أن تجد انعكاسها في المحيط، وأن تخلص من فعله المدمّر، إلى أن يأتي اليوم الذي تريد فيه أن تتحكّم به، وتغيّره”.[55]
في إطلالتنا القادمة سنتناول ظاهرة “شيطنة التّلاميذ” الّتي يرى عبّاس محمود العقّاد (1889-1964) أنّها ملازمة لحياتهم المدرسيّة مع معلّميهم، لا بل مُستحبَّة إذا كانت ضمن حدود معيّنة.[56] لم تقتصر “شيطنة التّلاميذ” على نوعيّة معيّنة منهم، فقد مارسها حتّى الطّلّاب الذين يتمتّعون بسمعة طيّبة وبسلوك حسن، من أمثال الطّالب ميخائيل نعيمة (1889-1988).
أدعوكم/نّ إلى رحلة شائقة مع بعض هذه “الشّيطنات” في إطلالتنا القادمة.
ألقاكم/نّ بخير.
……………….…………
[1] . التّليدي، أبي الفتوح عبد الله. ذكريات من حياتي. الطّبعة الأولى. دمشق: دار القلم. ص 27.
[2] . الطّنطاوي، علي. (1985). ذكريات (1). الطبعة الأولى. جدّة: دار المنارة للنشر. ص 31.
[3] . المصدر السابق. ص 31.
[4] . المصدر السابق. ص 31.
[5] . سعيد، إدوارد. (2000). خارج المكان: مذكرات. نقلها إلى العربيّة فوّاز طرابلسي. بيروت: دار الآداب للنشر والتوزيع.
[6] . المصدر السابق. ص 64.
[7] . المصدر السابق. ص 69.
[8] . المصدر السابق. ص 69.
[9] . المصدر السابق. ص 70.
[10] . ضياء، عزيز. (2012). حياتي مع الجوع والحب والحرب. الجزء الثاني. بيروت: التنوير للطباعة والنشر والتوزيع. ص 63-64.
[11] . المصدر السابق. ص 64.
[12] . المصدر السابق. ص 64.
[13] . المصدر السابق. ص 64.
[14] . سلام، محمد عبد العزيز. (2006). ذكريات وأحداث (يمنية): سيرة ذاتية. القاهرة: مكتبة مدبولي. ص 50.
[15] . المصدر السابق. ص 50.
[16] . المصدر السابق. ص 50.
[17] . المصدر السابق. ص 50.
[18] . المصدر السابق. ص 50.
[19] . المصدر السابق. ص 51.
[20] . المصدر السابق. ص 51.
[21] . المصدر السابق. ص 51.
[22] . المصدر السابق. ص 51.
[23] . المصدر السابق. ص 51.
[24] . ضياء، عزيز. (2012). حياتي مع الجوع والحب والحرب. الجزء الثاني. بيروت: التنوير للطباعة والنشر والتوزيع. ص 64.
[25] . المصدر السابق. ص 90.
[26] . المصدر السابق. ص 90.
[27] . المصدر السابق. ص 90.
[28] . المصدر السابق. ص 90.
[29] . المصدر السابق. ص 91.
[30] . المصدر السابق. ص 91.
[31] . نقارة، حنّا ديب. (2011). مذكّرات محام فلسطيني: حنّا ديب نقارة – محامي الأرض والشعب. تحرير عطا الله سعيد قبطي. الطبعة الثانية. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. ص 27.
[32] . المصدر السابق ص 27.
[33] . المصدر السابق ص 27.
[34] . المصدر السابق ص 27.
[35] . المصدر السابق ص 27.
[36] . المصدر السابق ص 27.
[37] . جبرا، جبرا إبراهيم. (2001). البئرُ الأولى: فصول من سيرة ذاتيّة. الطّبعة الثانية. بيروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر. ص 54.
[38] . المصدر السابق. ص 54.
[39] . المصدر السابق. ص 54.
[40] . المصدر السابق. ص 54.
[41] . المصدر السابق. ص 54.
[42] . المصدر السابق. ص 55.
[43] . الخليلي، علي. (1998). بيت النار: المكان الأول، القصيدة الأولى، سيرة ذاتيّة. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.
[44] . المصدر السابق. ص 159.
[45] . المصدر السابق. ص 159.
[46] . المازني، إبراهيم عبد القادر. (2010). قصة حياة. وندسور: مؤسسة هنداوي.
[47] . المصدر السابق. ص 21.
[48] . المصدر السابق. ص 21.
[49] . الجابري، محمد عابد. (1997). حفريات في الذاكرة من بعيد. الطبعة الأولى. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ص 48.
[50] . المصدر السابق. ص 48.
[51] . المصدر السابق. ص 48.
[52] . عَناني، نبيل. (2019). الخروج إلى النور. مراجعة النّصّ وتحريره رنا عناني. الطبعة الأولى. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. ص 10.
[53] . المصدر السابق. ص 15.
[54] . المصدر السابق. ص 15.
[55] . جبرا، جبرا إبراهيم. (2001). البئرُ الأولى: فصول من سيرة ذاتيّة. الطّبعة الثانية. بيروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر. ص 10.
[56] . العقّاد، عبّاس محمود. (2013). أنا. القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.