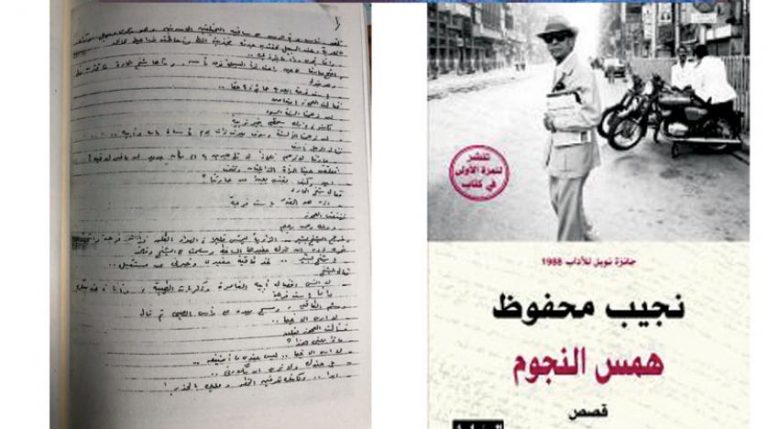تنقسم المجموعة إلى قسمين لا يتضح في البداية الرابط بينهما، القسم الأول (صولو الخليفة): نرى فيه الأبناء الذين يتقاتلون على مدخرات الأم البسيطة في (مسألة التوكتوك) حتى تقع مغشيًا عليها، وفي (عزف منفرد): نجد هذا العنوان يلخص رحلة حياة الشخصية ويدعو للتعاطف معها والإعجاب بها، الأستاذ كمال مغني الكورس الذي شارك في عدد من الأعمال الفنية المشهورة ولكنه لم يكن له حظ في الشهرة، حتى تجاوزه الزمن لصالح أنواع أخرى رديئة من “الفن” ونرى الحاضر يطرد الماضي بقسوة من أماكنه الأثيرة ويجردها من جمالها القديم: “افتتح في تسعينيات القرن الماضي بعد بلوغه سن المعاش أول وأشهر محل آلات موسيقية في شارع الخليفة، حيث يؤجر لفرق الأفراح والزفاف تلك الآلات، لكن تجارته بارت مع بدايات القرن الواحد والعشرين بعد ظهور فرق المهرجانات”، “بعد وفاة زوجته قلت مرات خروجه من البيت الذي يحوي كل ذكرياته، قلما تجده في الشارع، فقط يخرج ليقبض المعاش، ويشتري له الجيران متطلباته اليومية، يجلس من آن لآخر في مقهى السيدة سكينة القريب من بيته على فترات متباعدة، خاصة بعد موت صاحب المقهى وقيام أولاده بتركيب شاشات كبيرة يشاهد من خلالها الجمهور مباريات الدوريات الأوروبية”، حتى يموت وحيدًا منفردًا في طابور انتظار قبض المعاش، في (سماعي) شخصية النجار الذي يستغرق في هواية تربية الحمام حتى ينسى نفسه ويفوته الزواج وتكوين الأسرة وتنحصر حياته بين عمله وغية الحمام والمسجد الذي يؤذن فيه في لوحة جميلة احتشدت فيها مفردات جمالية رائعة حين يصف الكاتب يومه العادي مستمعًا لأم كلثوم في الراديو ومعدًا قهوته على السبرتاية وجلسته في مقهى حبايب الست وأداءه الأذان واسمه نفسه على رأس هذه المفردات (ربيع)، حتى يأتي يوم رحيله حين يتفقد جيرانه غية الحمام فيجدون جثته متدلية منها: “ونفذوا الجزء الأهم من الوصية، أن يخرجوا الحمام كله من الغية لو حدث له مكروه، فهولا يتحمل ذلك الذنب، وهو ما جعل كل أصحاب غيات الحمام في شارع الخليفة يطلقون سراح الحمام من غياتهم كوداع أخير للأسطى ربيع النجار” فالجمال يموت ولكنه يعزينا بانطلاقه إلى عالم آخر أكثر حرية، نرى ما يشبه تأريخًا شعبيًا للحي في (كريشندو سيد روسيا) البلطجي في صراعه مع الحاج صابر رجل الأعمال المرتبط بالحزب الوطني وسعيد ظاظا حفيد الفتوات القدامى الطامح لإعادة سطوته، ثم يعود الكاتب إلى ذكريات طفولته وأول شبابه في نصوص (سينما الهلال- سينما أوديون- سينما مترو- سينما الهلال) التي نلحظ في خلفيتها نغمة شجن تنعي جماليات الزمن المنقضي (أفلامه مثلًا) التي صارت مادة لسخرية الجيل الجديد، والتي يطاردها الواقع ويمحي أثرها لحساب القبح المستورد: “..وتتلفت حولك باحثًا عن سينما الهلال الصيفي لنجمها الشهير الأوحد طوال أيام طفولتك نجم الترسو فريد شوقي وغريمه الأبدي محمود المليجي، فلا تجد لها أثرًا سوى تلك الأرض المهجورة التي أجابك أحد العاملين بالمقهى أنها ستتحول لمول متخصص في الملابس المستوردة من الصين.”، نجد قصة (الوصية) التي تستحق حديثًا مستقلًا، (توك شو) حيث الأستاذ كمال الفنان المغمور يتوسط لفتاة من منطقته لتعمل في أحد برامج التوك شو كواحدة من جمهور يتم استئجاره للتصفيق في البرامج الحوارية على أمل أن تحقق شيئًا من الشهرة يومًا ما بدون أن تعلم أن لعالم التوك شو هذا قوانينه التي لا يمكن خرقها، فتطرد منه حين تحاول أن تطلب من الطبيب ضيف البرنامج على الهواء المساعدة في علاج والدتها، ويُقطع عليها الإرسال إلى فاصل إعلاني قبل أن ينتبه الجمهور إلى فعلتها وتُطرد من البرنامج في مفارقة تجبرنا على تأمل معنى كلمة (توك شو) لنجدها استعراضًا للكلام بلا حقيقة فيه ولا فعل ينبني عليه، “خرجت من الاستوديو وهي تبكي بينما المذيعة كانت تتكلم في حلقتها عن المنافسة الشديدة والغيرة والمؤامرات التي تتعرض لها كضريبة على نجاحها وعن قلبها الطيب الذي سيجعلها تبحث عن الفتاة المندسة على البرنامج لتحاول مساعدتها وسط تصفيق الجماهير المتحمسة.
جدل الماضي والحاضر
بعد الانتهاء من القسم الأول، والدخول إلى فضاء القسم الثاني (قبل وبعد)، يبدأ التصدير الذي استهل به الكاتب المجموعة في الإفصاح عن مكنونه، وربما يبدو المغزى من اختيار الكاتب الصيني لو شيون الذي يعد أبا للقصة الصينية الحديثة والذي اعتبره ماو تسي تونج نفسه أحد أساتذته لدوره الكبير في تحديث الثقافة واللغة الصينيتين، ويظهر التناقض المحتدم بين قسمي المجموعة، فالقسم الأول يحكي غالبًا عن شخصيات الحي، المغني المغمور، مربي الحمام، بائع الشاي الذي يريد أن يضحّي في العيد لأول مرة، البلطجي في صراعه مع أحد رجال النظام السابق، الكاتب نفسه في ذكريات صباه في نصوص السينما والعشرة جنيه، الموظف البائس في الأصوات، الفتاة التي تحلم بالشهرة ويقمع طموحها عالم التوك شو، وكل هؤلاء يسكنون ذلك المكان بما لاسمه من دلالة تاريخية يمثلون مرحلة من مراحل الماضي للمجتمع المصري، هذا الماضي المثقل يتناقض بعنف مع سيرة الحاضر في (قبل وبعد) حيث الحقائق المحجوبة وتكريس الجهل في قصة (الحريق) حيث تحترق القرية ولا أحد يعلم السبب وتفشل السلطات في حصار الحريق بينما ينصح المشايخ بالدعاء والصلاة وأهل القرية ينفقون كل ما يمتلكون على الدجالين أملًا في وقف الحريق الذي يتجدد ولا يوقفه شيء لتنتهي القصة بالسؤال الصارخ: ” يا خلق هوه ايه أصل الحريق ومصدر اللهب فين؟!” وفي قصة (الشيء الذي هوى) حين يسقط جسم غريب على القرية يفشل الكل في معرفة ماهيته حتى تأتي اللجنة التي تتعرف عليه ولكنها تعامل الجمهور كجماعة من الصغار غير الراشدين وتكتم الحقائق عنهم: “توصلت جهات البحث الجنائي في تقريرها إلى أن الجسم الغريب الذي وجد في القرية هو تانك بنزين خاص بطائرة تدريب حربية، كانت قد تخلصت من ذلك التانك أثناء عملية تدريبية سرية مع توصية بعد نشر نتيجة التقرير حتى لا تحدث بلبلة في مجتمع القرية الهادئ وعدم المساهمة في نشر مناخ تشاؤمي في البلاد”، ومع كل ذلك الاضطراب في واقع الحياة نجد المجتمع يعاني هوس المظاهر والكمالية Perfectionismفي (قبل وبعد)، هذه المظهرية تتبدى أيضًا في التكريم الشكلي الاحتفالي الذي تأخر كثيرًا على مستحقه حتى نسيه وصار لا يبالي به لو جاء في (الكاتب الكبير)، وتتبدى في فرض الأنماط في الكتابة وخنقها بالضغوط المادية في (كونشرتو الزوجين والراديو) التي نشرها سابقا كنص مسرحي عاد ليعدل فيه ويكسبه مستوى سردياً آخر يتوازى فيه حضور الكاتب نفسه الذي يكتب النص مع شخصية بطل النص فنجد معاناتهما تتلاقى تحت تأثير نفس السلطات الحاكمة من سلطة سياسية ومن شركات متعددة الجنسيات فرضت “النظام العالمي الجديد” الذي أصبح فيه العالم قرية صغيرة كما ينطق بذلك القاضي ووكيل النيابة في مشهد كافكوي لمحاكمة الشخصية على جريمة قتل لم يمت القتيل فيها، وفي تسليع الثقافة والتحيز لقضايا بعينها وأساليب معينة في الكتابة في (الفيلم الأفغاني)، ربما يمكن فهم هذا التناقض بالعودة إلى التصدير، فأهالي الخليفة بصراعاتهم وإخفاقاتهم ربما يمثلون الإنسان البدائي، وأهالي قبل وبعد يمثلون هذا الإنسان بعد أن ارتقى شكليًا فقط وتوقف عن أكل لحم البشر في العلن، ولكنه لازال يمارسه خفية ويذرف عليه دموع التماسيح أمام الكاميرات، مما يحيلنا إلى أزمة التحديث الشكلي الذي مر به المجتمع، فرغم امتلاك المجتمع لأدوات الحداثة واستهلاكه لأحدث منتجاتها، إلا أنه في تنظيمه الاجتماعي لا يزال فيه كل عدوانية البدائيين، فالتحديث الذي جرى كان على السطح فقط (تحديثًا برانيًا بتعبير د. علي مبروك مثلًا أو نهضة تلفيقية بتعبير د. نصر حامد أبو زيد رحمهما الله)، ويعادل هذا في نص (قبل وبعد) العملية التي تجريها الشخصية على أنفها، ولأن التحديث شكلي، سطحي، غير حقيقي، مفتقد إلى البنية الضرورية، فمصيره إلى الفشل وإلى التشوه، كما يرمز له الكاتب بإصابة أحد أعصاب الوجه لدى الشخصية أثناء إجراء العملية مما يجعلها غير قادرة على الابتسام مشلولة الوجه فاقدة للروح بمعنى أدق، رغم امتلاكها للأنف الجميل الذي أرادته أو أرادت لها الميديا أن تريده.
هذا العالم المتهالك الذي تغيب فيه الحقائق ويسوده الاستغلال والعنف الوقح أحياناً والمتأنق أحيانًا، لا يستغرب فيه حضور الموت مظللا عليه، كقدر معلق لا يخلو أحيانًا من الطرافة وفيه للمفارقة قدر من الجمال والحرية
الموت
في المجموعة يظهر حضور خاص للموت لم نجده كثيرًا في أعمال الكاتب السابقة، فيظهر ماديًا في بعض القصص، ويظهر معنويًا في قصص أخرى، ويظهر في أحد القصص بالذات “الوصية” بشكل يشبه المعارضة الأدبية لقصة العظيم يوسف إدريس (الرحلة) في مجموعة (بيت من لحم)، بطل (الرحلة) كان يحمل معه جثة أبيه في سيارته في رحلة على الطريق منكرًا موته الذي يلاحظه المارة ورجال المرور وعمال محطة البنزين، إلى أن يفاجأ هو نفسه بأنه يشم رائحة الجثة ويضطر لتركها ومغادرة السيارة كي تكون قبرا له كي يستنشق الهواء النقي، “الهواء الذي لا أشم فيه تلك الرائحة الملعونة الغالية؛ رائحتك” ، قصة إدريس كانت تدفع إلى نوع خاص من العلاقة مع الماضي تجعلنا رغم كل حبنا له وتقديرنا له نصر على تجاوزه كي نعيش، لأن الحياة لا تتوقف، ورغم أن إدريس كتبها ونشرها في يونيو عام 1970، إلا أنها تشير إلى الموقف الذي كان ينبغي اتخاذه من رحيل الزعيم جمال عبد الناصر بعد ذلك شهور قليلة، وعندما نقرأ وصية شريف عبد المجيد نرى العكس، فالبطلة سعاد تستمد حياتها كلها من ماضيها “الأم”، تصبر بها على هجر الإخوة الذين ربتهم وعلى الوحدة والعنوسة والاستغلال في مشغل أم نبوي: “هي اللي مصبراني على العيشة وبلاويها، هي البلسم اللي مخليني عايشة، طول ما أنا في الشغل بادعي ربنا ما يحصل لهاش حاجة ولما أروح طول الليل أدعي يارب احفظها لي لحد الصبح ” ، سعاد تتعامل مع جثة أمها تماما كما لو كانت لا تزال حية، تعد لها طعامها وتحقنها بالإنسولين وترد على التليفون بدلا منها وتعتذر عنها بنومها أو مرضها، وكما يفتضح موت الأب برائحة جثته في قصة إدريس، تفضح الرائحة سعاد حين تأتي أم نبوي إلى البيت وتلاحظ الرائحة وترى الجثة وتتهم سعاد بالقتل التي تعلن “أمي زي الفل بس أنا بأنفذ الوصية ما نسيبش بعض في الموت والحياة”، هنا الذكرى لا يمكن الاستغناء عنها حتى يبلغ التعلق بها حد الوثنية، والماضي لا يمكن تجاوزه، لأن المستقبل قد أغلقت دونه الأبواب، والآتي صار سوداويًا بما يتجاوز بكثير ما كان مرتقبًا أيام يوسف إدريس، وهنا نشير إلى أن الكاتب قد التقط الفكرة التي بنى عليها حبكة (الوصية) من حادثة حقيقية نشرتها أحدى صفحات الحوادث التي نعلم أنه يتابعها جيدا في كل الجرائد وفقا لرؤية أفصح عنها في حوار له مع الشاعرة سلوى عبد الحليم في جريدة الحياة اللندنية: “ككاتب من العالم الثالث أنت لا تبحث عن الفانتازيا، بل إن وجود هذه المجتمعات في القرن الواحد والعشرين كمجرد مجتمعات استهلاكية لا تنتج أو تشارك في منجزات العلم والتكنولوجيا، هو وجود فانتازي في الأساس ويمكن اعتبار ذلك زاوية للرؤية في التعامل مع الواقع“، وهكذا يغوص في الواقع ليخرج منه بما يلقيه في وجوهنا محملًا بالدلالات السوسيولوجية والغرائبية معًا، لاعبًا بالحدود المراوغة بين الواقع والمتخيل.
الموت يظهر كمفارقة ساخرة في (الموت ضاحكًا) مؤلمة السخرية في مقطعها الأول (ضيف على الهواء) حين يموت الضيف قبل الهواء والآلة الإعلامية بادرة الدم ممثلة في مخرج البرنامج تتجاهله وتنتقل إلى الضيف الاحتياطي بينما يتورط المُعد في الجثة لا يدري أين يذهب بها، وتكون السخرية أقل مأساوية في (الحانوتي) حين يموت الحانوتي ويسأل أهل الحي عن من سيدفنه، بينما يبدو الموت في (سماعي) كأنه لحظة انعتاق ينتقل بها هذا البطل الوديع إلى عالم آخر أكثر جمالًا ويترافق مع تحرره من هذا العالم عتق أسراب الحمام، ويبدو كمصير منتظر معلّق على رؤوس الشخصيات في مسألة التوكتوك وغيرها، هذا التنوع يجعل عالم المجموعة يصل إلى ثراء مبهر، نرى فيه شريف عبد المجيد بنفس قدرته المعروفة على إمتاع القارئ، ولكنه باقتحامه تلك المساحة من المجال الإنساني (الموت في أشكاله المتنوعة والنوستالجيا في عودته إلى الصبا والنشأة)، نراه يرتقي درجة أخرى في تطوره الفني، ربما لها علاقة بانتقاله من الشباب إلى الكهولة (ولعله لا يغضب حين نذكّره بأن الكهل هو الرجل من الأربعين إلى الستين، أو من جاوز الشباب ولم يصل بعد إلى الشيخوخة، على عكس ما هو شائع)، نراه الآن أكثر حكمة.
___________________
*قاص وكاتب مصري