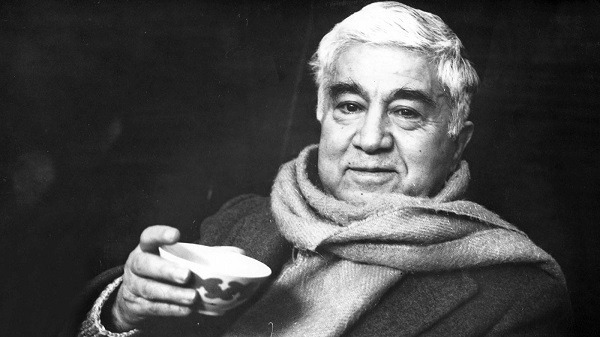في هذه الأماكن، بين جدرانها السميكة العالية، تتفتح حواسه كلها مرةً واحدة . تتفتح ، لتقرأ ، بالأساس ، ما ليس مكتوباً بأية لغة من لغات الحس .
يأخذه الهواء البليل مهما كان زمهرير الحر فى الشارع ، نعومة الحجارة والانحناءات الخفية فى الجدران . يذكر الآن أن النور كان يفضح تعاشيق الزجاج الملون فى نوافذ مسجد ( أبو حريبة ) بالدرب الأحمر ، كان فؤاد وحده ، تائهاً كالعادة ، تعثر يومها بخادم المسجد الذى راح يُحدثه عن تاريخ المكان وأهمية الأثر ، ثم حكايات وكرامات صاحب المقام ، فلعلّ الخادم ظن أن فؤاد سائح أو صحفي أو ما شابه، ففتح معه الكلام بابتسامة معسولة وترحاب بعد أن لاحظ اهتمامه ، طمعاً ـ ربما ـ فى حلوان أو مصلحة أو حتى لمجرد التسلية وقتل الوقت بالونس . جلسا تحت مروحة سقف تصدر هديراً مزعجاً و كان الرجل يتكلم ممدداً ساقيه أمامه و يتثاءب ويهرش دغل صدره كل دقيقتين تقريباً ، ثم يفرك عينيه اللوزيتين العسليتين. عند المصافحة الأخيرة والوعد المراوغ بتكرار الزيارة كادت كفة الضخمة أن تحتوي داخل قبضتها أصابع فؤاد تماماً .
ماذا لو مرت الآن من هُنا نسمة لا يشعر بها مخلوق ؟
فهل ستنهار لها حقاً حيطان الأثر التاريخى ، المكان المقدس ، تتهشم لها قطع الزجاج الملون ، أو ما تبقى منها بعد حوادث الأيام و السرقات ؟ أو ربما خرج عندها شيخ المقام من قبره صائحاً هائجاً بعد سُبات طويل . أبداً . ولا شىء من هذا . مجرد هبٌة هواء خفيفة وبلا معنى. و رغم هذا فقد حركتْ في طريقها ريشة يمامة على الأرض وكنست بعض الغبار ، فـلمَ لا …. ؟
فهل تبقى أغنية الشهوة الظامئة تحوّم بلا قرار ولا هدف ؟ أهكذا تعيش أطول ؟ أو هكذا لا تموت ؟
لا ، كلُ مكانٍ مقدس، بما هو بدنُ الأيام و الليالي الذي أحرق الشهوات وأشعل الكلمات فى صمت كله كبرياء .
يهبط ُ السلالم الحجرية فى مجمع الكنائس. فؤاد مع بعض الملاعين ، هادى المشٌاء و محمود و جورج و طارق . نزل السلالم المكنوسة بعناية ومحبة والناعمة من حك الخطوات فيها لعشرات السنين، ربما أراد أن يضىء شمعة لأم النور .
كان نهاراً شتوياً صافي البياض، والمنظر يغلفه حجابٌ شفاف، مما يستحق كاميرا سينمائية في فيلم ناعم الإيقاع. الأزقة ما بين البنايات الكنسية و منازل الناس كانت تضيقُ شيئاً فشيئاً ، بعضها لا يفضى إلى شىء ، مثل وخزة شهوة تومض للحظة فى الطريق ثم تنطفىء . بابٌ موارب يكشف عن نصف جسد امرأة تتكاسل فى نومتها على فراش رث يوحى بدفء خاص. يمر بمحاذاتهم رجل عجوز جدا فى ملابس ريفية وينظر اليهم بما يشبه الغضب ، ربما لأنهم كانوا يضحكون بصخب ، أو لأنهم شبان صغار وحسب .
الجريمة في دمائهم ، فى كنيسة ” أبو سرجة ” المنمنمة والمضيئة بنور جوانىّ غامض مثل فصٍ نادر في خاتم عتيق ، قاموا معاً باختراق التابو. سرقوا الهبات والصدقات التى يلقى بها المؤمنون في بئر مريم . نط جورج بخفة من فوق الحاجز الخشبى المنخفض ، ومن على الدرجات الأولانية للسلم الحجري الضيق ، يكاد يغمرها الماء ، لملم بلهوجة بعض النقود الورقية التى لم يطلها الماء بعد . دسوا فى جيوبهم بعد ذلك عدداً من الرسائل الصغيرة المطبقة جيدا والمحشورة على حواف الأيقونات ، وقرأوا فيها كل الأمنيات والأحلام الإنسانية المعتادة والموجعة مع هذا :
” صباح الخير مار جرجس . لازم أنجح بتقدير هذه السنة و إلا .. أنت تعرف ما سيحدث لى ” ـ ” أن أهاجر إلى كندا بقى خلاص زهقت ” ـ ” أن تنجح العملية ” ـ ” أن نتزوج ، نتزوج ، نتزوج يا عدرا يا أم الإله يا طيبة . “
أكان هذا هو المكتوب فعلاً؟ ألم نجد أيضاً ورقة مكتوبة بلغة أجنبية لم نستطع فك شفرتها؟ كيف نُخضع هذه الرسائل لأى سياقٍ من أي نوع ؟ ثم كيف نبرر كل جرائمنا الجميلة ؟
العيون الناعسة غطيسة السواد بجفونها الثقيلة والحواجب المقرونة بخط شعر خفيف يكاد لا يُرى. كأن الأمير سيلتفت الآن فيراها تنظر وتنتظر . الوجهُ الخمري الشاحب المسحوب بعظمة الوجنة البارزة والأنف المستقيم . و يلتفت فلا يرى أو يعرف أحداً هنا أو هناك . يلتقط إذاً شمعة من الشموع النائمة على الرملة الحمراء الداكنة السخنة أمام الصور ، يُدني فتيلتها من نور شمعة أخرى فتضىء ، يغرسها فى حبات الرمل الناعمة أمام أيقونة السيدة العذراء .
كأنما على نور الشموع فقط يمكن لهذا الجسد أن يضىء ، الجسد المرسوم بسذاجة الإيمان المطلق والتسليم النهائي ، وحرفة التشكيل الروتينى التى تسرق الأصابع من الواحد فتتحرك لوحدها تقريباً ، بمعزل عن وعيه أو همومه و كوابيسه .
وفى ليلٍ بعيد آتٍ سوف يمزق نصل صوت الست ظلمة غرفته وهو على مشارف النوم :
” يا ما ناديت فى وحدتى حبيبى
ما يردش إلا صدايا حبيبى حبيبى “
فهل يكفي الصدى ؟
يكفي الصدى ؟
الصدى ؟
ومع هذا يتجسد الحبيب ، من وراء حبسة الزجاج والخشب والمعدن . من داخل السطور القضبان المقدسة بلا سبب. يخرج الآن من خلف الجدارن الحجرية المزخرفة بأسماء الله الحسنى ، أو من بين ثنايا الستائر المخملية السوداء المشغولة بالصلبان المذهبة . يحطم كل أعمدة الرخام فى أركان العالم ليتجلى فى كل حى . يهشم الأيقونة التى طالما مزقتْ ضلوعه ويمد ذراعيه على شكل صليب ليحتضن الدنيا بما فيها .
يطلع علينا ، نور السموات والارض .
” لكن ، ألا تجد يا أمير صعوبة ، بل استحالة ، في أن يحيا الواحد فى عالم كل ما فيه مقدس ؟ “
لم يسأل أحد .
* * * *
من زمان وأنا أغطّي الهوامش البيضاء فى كتبى المدرسية بالتخطيطات والرسوم ، نساء عاريات أو يكدن ، رجال بشوارب غليظة وعيون بارزة ، أشجار تطرح بيوت عناكب وزهور كلها حدقات أعين و أسماك بأجنحة طويلة ، وكل الخرافات التى لا سبيل إلى أن توجد إلا بحركة الأقلام على الأوراق . ولكم عذبنى ثراء الخيال الفادح ذلك عندما تأكدت بنفسي أن تصوير أى كائن حي هو حرام شرعاً ، أيام الثانوية الأولى ، حين كان أي ولد عنده زغب خفيف على ذقنه يطلقه ليكون على السنة ، وكنت محاصراً ـ كما أنا الآن ـ بالنصوص .
حاولتُ أن أشرح للأخوة أيامها أنه ليس فى رسم الكائنات أي شرك بالله سبحانه وتعالى ، ولا مساس بخصوصية صنعته السامية ، والتى تُعجز كل ذي علم ، وهى نفخ الروح فى الطين لكن لعلّ التصوير هو نوع من التسبيح بحمد قدرته وعظيم جماله، فحاصروني بالنصوص لأجدني أمزق كل رسوماتى وأعلن توبتى عن اقتراف أي إثم يلوث ما بينى وبين ربى. وسرعان ما أعود للرسم ، لبعض الوقت ثم أعلن توبتى ، ثم من جديد أعود للخط و القد و الملمس . أىّ دراما ؟
ويسألنا مدرس الجغرافيا ، بلحيته العظيمة ، بعد أن يداهم الفصل فى غير حصته ، عن الذى رسم على السبورة . فأنهض هادئاً رغم أننى لستُ وحدي الذي تجاسر و رسم البنات الجميلات بملابس البحر، وأقول ” أنا ” ربما بفخر طفلي لبطلٍ في مأساة قديمة ، يعتز بسقطته جداً ، فقط لأنها منحة القدر له وحده ، مما يصنع أسطورته .
” عينى يا عينى على الفلسفة الجامدة جداً ” . هوى الأستاذ بعصا عريضة على يديّ المفرودتين أمامه عدة مرات دون أن أسحبهما مرة واحدة ، دون كلمة استرحام ، وبالطبع دون أى اعتراف بالخطأ. علّمت عصاه فى باطن كفي ثلاثة أيام. وكان الألم أيضاً حقاً خالصاً، أمرني بالعودة إلى مكاني بنبرة فيها شيء من استغراب أو إعجاب أو رفض . كأنني قررتُ ساعتها أن الخطأ جميل ، إذا كان ثمنه هذا العقاب اللذيذ. الذنب إذن ضروري بقدر ما هى المغفرة. و الخطيئة واجب الإنسان الأول على هذه الأرض فقط ليتوب، ويندم ويعود إلى بارئه مغسولاً بدموع العذاب .
“مراهق بقى ” ، ماذا تنتظرون مني ؟
أعرف الآن أننى أحاول أن أرسم كل الوجوه الحلوة التى ذهبتْ بعد التفاتة خاطفة ، أو أنها لم تظهر أساسا لتختفى ، كل الأجسام الغضة التى أضاءت طريقى للحظات . الخطوط التى لم أطمئن إليها ، الأماكن التي لم أسكن إليها ، الشفاه التى لم أستطعمها على مهل . أحاول بصبيانية الفن القديمة أن أسجن كل اللحظات المنفلتة فى أيقونتي الشخصية ، دون حرفة مصوري الزمن القديم ، أو حتى تقوى المؤمنين المُصدقين .
أما في الصف الأول الابتدائي ، فإن أستاذ حمدي لم يصدق أننى أنا ـ فؤاد ـ عُقلة الإصبع الذي رسمت بنفسي موضوع عيد الأم فى الكراسة العريضة بصفحاتها الجميلة النظيفة من أية سطور ، وعندما أؤكد حالفاً بالله يأمرنى أن أقوم وأرسم على السبورة الموضوع نفسه . وبالفعل رحتُ أشب على أطراف أصابع قدمى ، أنا الكتكوت الفصيح ، مخططاً بالطباشير الأبيض الخشن ، بحرقته في الأصابع ، صورة الأم الجالسة في ثوب كله زهور وحشية بجانبها الولد يحمل هدية على شكل قلب ملفوف بورق الهدايا المزركش . كان أستاذ حمدى واقفاً في فتحة الباب يدخن ويتابعنى ،غير مصدق تقريباً بطرف عينه العسلية الفاتحة ذات بؤبؤ لامع السواد ، ولم يكن يحلق ذقنه إلا نادراً ، لأنه كسول وله كرش . فهل قرصنى من خدى قائلاً :
“برافو عليك يا قرد .. سقفوا له يا بهايم .. ” ؟
دائما وأبداً ، الأيقونة نفسها تطاردني بلا هوادة : الأم و ابنها ، رضيعاً أو شاباً عاشقاً ، لافرق ، من أيام إيزيس وحورس وحتى على أكواب محلول معالجة الجفاف البلاستيكية المُوحية بالمرض .
وتصفقون لي فأفزع وأعرف أنكم بالفعل بهائم . فليعلُ إذن التصفيق هنا و هناك . من أجل فؤاد ، المعجزة ، في مسابقات الرسم وحفظ القرآن وإلقاء الشعر على السواء ، فى المدرسة أيام الابتدائي و الإعدادي وأوائل الثانوي ، ومراكز الشباب والنوادى الأهلية والتجمعات . تصفيق ، تصفيق حاد يصمّ الآذان، والكتكوت يتلقى الجوائز وشهادات التقدير. تقولون معجزة ثم تنسونه ورائكم وتذهبون للعب بدونه. أما أستاذ حمدى فقد حمله بين ذراعيه وطوحه عالياً فى الهواء بعد فوز المدرسة بالمركز الأول فى الرسم.
وعندما تُنجب زوجة أستاذ حمدى طفلهما الأول يدعو فؤاد إلى السبوع مع المدرسين والمدرسات وأبنائهم ، فيدور مع العيال حول الطفل المهروس الملامح والسمين : يارب يا ربنا ، يكبر ويبقى قدنا . والجسد الوليد مؤطراً بحافة المنخل الخشبية يحرك أطرافه فى الهواء ، كأنه يحاول السباحة أو الطيران ، يريد أن يفر هارباً ، يكبر ويصير مثلنا : بضاعة رخيصة معروضة ليلَ نهار في السوق الواسع، ليس هو الطفل الإلهي ذلك الذي يهتز ويصرخ يوم سبوعه ، فالأطفال الإلهيون يتكلمون فى المهد ، يقولون الحق بلا صراخ أو ضجيج ، لكنه العيّل المُشرد على أرض الهفوات والأخطاء ، ونداءات البيع و الشراء حتى عند حساب الإثم والغفران والمكسب والخسارة فى الدنيا والآخرة . فهل يكفى أن نردد ولو كل يوم حتى: الجسد جميل والحياة فرصة لا تُعوّض لنفهم أو نصدق ؟ ونرش الملح فى العيون الحاسدة وندق الهاون النحاس الضخم ، وحلقاتك برجالاتك ، إنشالله تعيش إنشالله تعيش، وتلسع فؤاد الشمعة الصغيرة التى يحملها، نقطة صغيرة ذوبتها النار تسقط على يده لكنها سرعان ما تتجمد على جلد الأصابع بعد حُرقة عابرة ولذيذة .
يا صائد الغزال من أجل المِسك والغزال حر تقيده السهام إلى جرح الصحارى المفتوح على الوقت ولا يفنيه الوقت يمر به خفيفاً كالغزال في صحارى المولى الكريم يا رمح السؤال يا سهم الله ثابت فى الوقت رغم سفره من صدري إلى صدري كل لحظة جديدة وغريبة ومنفلتة يا صائد الكلام بالهواء الحر يقيده الكلام إلى جرح السؤال كل لحظة تمر كما غزال الصحارى يا حر كما الهواء آخذك فى صدرى لأحسكَ في وأحبسك تمنحني لحظة حياة أبد أنا الميت يا صياد اليمام بالخوف والطير لا يخاف سوى الطيران على جناح خائف يا جسور بالحب وعاجز بالسؤال فكيف أستدفئ أنا العريان بصوف الريح باردة عليّ من دون أنفاس الطريدة تأتى مُسلمة نفسها دون جرح ولا طراد ولا سؤال ولا وقت يمر بى وديعاً كما صياد اليمام يجرحه اليمام لأن الصائد بلا جناح يشيله من على الأرض كاليمام .
* * * *
يا شمعة الوقت ، انطفئي لأضئ .
ــــــــــــــــــــــــ
*النص الثالث من متتالية: بعد أن يخرج الأمير للصيد