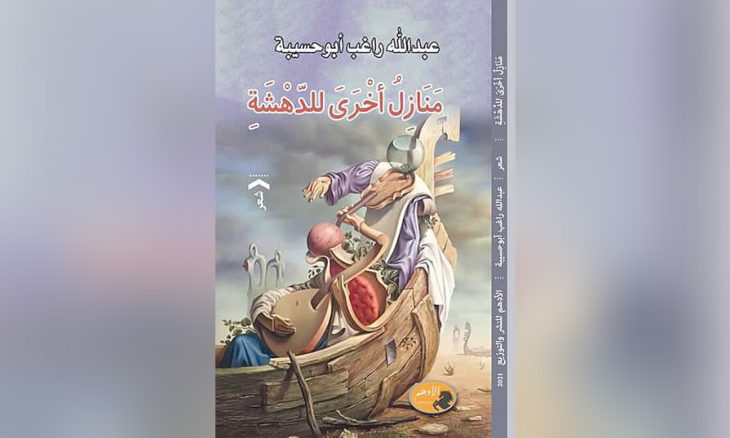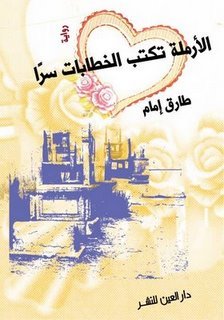د. عمار علي حسن
تبددت أحلام بطل رواية أشرف الصباغ الأخيرة “شرطي هو الفرح” في العدل والحرية والكفاية، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، فلم يجد أمامه خيارا سوى الهروب في خمسة مسارب: التمسك بالجذور، والنكوص إلى الطفولة، والغرق في الأساطير، والتحليق نحو عالم مثالي لم يولد، أو بالأحرى نحو العدم، ومعاقرة الخمر لاستجداء غياب مؤقت، معولا على أي منها أو بعضها أو جميعها في أن تمده بأسباب القدرة على مواصلة العيش، بعد أن ازدادت حياته قسوة في شبابه الغض، وكان يظن أنها ستمضي به سخية رخية.
إنها العودة المبتغاة التي عبر عنها الكاتب حين جعل بطله يناجي نفسه، بعد أن أرهقه العيش في المدينة: “في ليلة مقمرة، يشدك الحلم إلى العودة. أن تأتي تلك اللحظة التي تزهد فيها تلك الحياة الرتيبة، رغم عواصفها وهديرها وزوابعها. تتوالى عليك الأطياف والذكريات، تهجم بقوة، تزلزلك، فتقرر العودة. الطريق واحدة إلى تلك البلدة النائية، يمكنك أن تغادر القاهرة. تلك المدينة العجوز التي حكم عليها بالبؤس. والبؤس لا يتعلق أبدا بالثروة والجاه، ولا بالتاريخ أو التنوع الحضاري. إنه مرتبط بلعنة ما، أو بعمل من أعمال الشياطين”.
بطل الرواية “يوسف” شاب ثوري رأى تحطم حلمه أمام عينيه، بعد أن داست أقدام الطغاة والبغاة والجباة آثار كل ما هتفت به الحناجر وارتجت له الشوارع والميادين، ولم يبق مما صنعته الأيدي التي دقت الهواء، كي تتساقط الجدران السميكة للفساد والاستبداد، سوى أصابع مرتعشة، عاجزة عن هز قلوب الذين اطمئنوا إلى انحسار الناس من الشوارع، وتدني الصراخ ليصير همسا موجوعا مريرا، وإلى ارتفاع صوت الساخرين من دعاة التحرر والمساواة، والذين يواجههم بطل الرواية بسخرية مضادة، رغم أنه يدرك أنه صار واحدا من قلة ظلت قابضة على الجمر.
ليس هذا فحسب، بل يتبدد حلم البطل في حياة عاطفية دافئة رحبة، إذ يتكسر على نصال امرأة تقول له بوضوح: “شرطي هو الفرح” ما يعني أنها لا تريد أن تحتوي أحزانه الدفينة، ولا تهتم باستيعاب عيشه في الخيال، ولا رغبته في التحقق المبرأ من كل سوء، وهو الريفي البسيط الذي جاء إلى مدينة متوحشة، يتسع فيها التفاوت الطبقي إلى حد مخيف، وتركل بقدميها الكبيرتين القاسيتين أحلام شباب يأتون إليها من قاع الريف، باحثين عن الخلاص من الفقر والتهميش.
والهروب في زحام الأساطير، والذي يستغرق الجزء الأكبر من النص، تجسده تلك البقعة الساحرة المسحورة بقرية عزلاء منسية، حيث النهر الملعون، وشجرتا النبق والسنط الغريبتان، وفروعهما التي يتدلى منهما الخوف والرجاء، والهضبة الموحشة الغامضة التي تطل على النهر كحارس فاجر ليس بوسع أحد أن يتجاوزه، أو يروض الرعب الذي ينبعث من طلته المتجهمة، وتبدو كحد بين الوجود والعدم، وبين الرهبة والرغبة، وبين الخلاص والضياع. هنا يبحث الصغار في الماء المنساب على حكايات غريبة، تتناسل بلا هوادة، عن رجولة. وتبحث العاقرات عن سبب لملء أرحامهن بالغد. ويبحث الرجال عن فتوة، والأجداد عن كلمات جديدة يضيفونها إلى القصص التي لا يكفون عن تداولها في عقر البيوت، وفوق الجسور، ووسط الحقول اليانعة.
أما الهروب إلى الطفولة فلا يجني منه “يوسف” سوى مزيد من الوجع والغربة، إذ لا يكفيه أن يكون الجد القاسي المزواج يكن له حبا، ولا أن يجد في حضن امرأة غريبة الهيئة والطباع والأصل بعض الحنان الذي هو في جوع شديد إليه، رغم أن الدار يغص بالنسوة، أم وعمات وخالات وزوجات أعمام وأخوال، فكلهن مقهورات تحت عصا الجد الغليظة، وشتائمة البذيئة، واعتقاده في أن البشر والبهائم سواء، واحتقاره الشديد للنساء. ولم تكن طفولته في المدينة أحسن حالا، فهو مجرد صبي في ورشة، صاحبها بلا قلب، يمارس كل ألوان الظلم على العمال من أجل أن تتضخم ثروته، حتى لو أكلت الآلة القاسية إصبع “يوسف” ويد أمهر العمال، وجعلت بعضهم يمرض من آثار القهر حتى يموت، تاركا أهله يتكففون الناس.
والهروب إلى العالم المتخيل يظل مجرد أفكار طائرة لا تحط على الأرض، وأوهام تحلق أمام أبصار زائغة، وعالم يستحيل وجوده بين الناس، إنه عالم لم يخطر على البال، يتوق إليه البعض في ضمائرهم وسرائرهم، وفي جدلهم ونجواهم، حين يحل السأم، ويضيق الخناق، وتغلق الطرق أمام الأمل والراحة، لكن لا أحد منهم يجد طريقا هينا لينا إليه. إنه العدم، حيث يتساوى كل شيء. وقد عبر الكاتب عن هذا العالم المفارق والمتجاوز بقوله: “هنا لا نميمة ولا تلصص، لأن كل شيء واضح وشفاف ومرئي ,, لا خطأ، ولا عقاب، ولا ثواب، فلا رغبة ولا احتياج ولا صراع.. لا معرفة، فكل شيء معروف، ولا شيء معروف.. لا ضحك ولا بكاء، ولا مرض ولا شباب ولا شيخوخة.. لا حب ولا كراهية.. لا وهم ولا حقيقة.. كل شيء ولا شيء.. لا أمر ولا نهي، ولا قبول ولا رفض.. لا طاعة ولا معصية”.
إن بطل هذه الرواية، المكتوبة بلغة شاعرية، فاقد لليقين طيلة الوقت، ولا يكفيه ما بشرت به تصورات الفلاسفة وواضعي النظريات والأديولوجيات، ولا ما نطق به العارفون، لأن “الولي” في هذا النص خامل صامت محايد إلى حد بعيد، ولا ما حوته الكتب التي يقدسها الناس، لهذا لا يجد أنيسا إلا الغموض والأسئلة التي لا تكف عن غرس أشواكها المسنونة في رأسه، والمفارقات التي تجود بها قرائح الشعراء الحالمين، الذين لا صناعة لهم إلا منحنا الجمال والخيال والغربة، ومنهم كاتب هذه الرواية الذي سبق له أن أبدع الشعر.