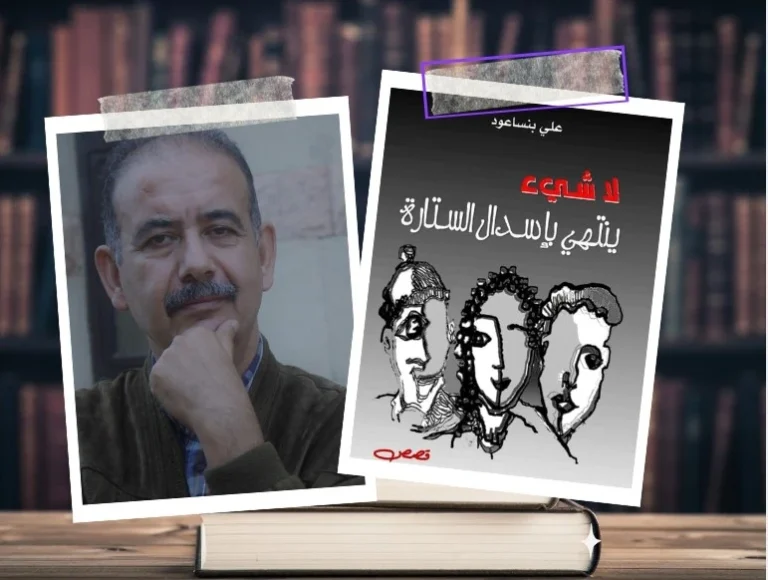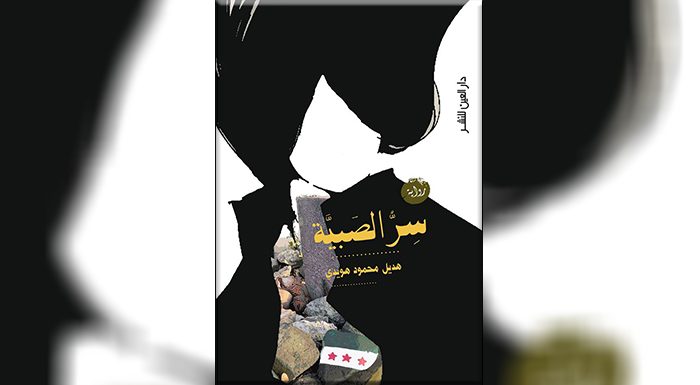دينا نبيل
لا يمكن لمصري فضلًا عن عربي أن ينسى ما حدث في نكسة 1967 وما أعقبها من انتكاسات أخرى وانكشافات كثيرة؛ فتلك الفترة المأزومة من تاريخ مصر لم يُحتل فيها جزءٌ عزيز من أرض الوطن – سيناء- فحسب، وإنما كانت فترة مكاشفة نفسية واجتماعية فضلًا عن السياسية، دفعت بكل مصري إلى مراجعة حساباته وتعديل سيره ومساره. ولا يمكن إغفال دور أدب النكسة في مضمار تلك المكاشفة وعلى رأسها رواية “ثرثرة فوق النيل” للكاتب الكبير نجيب محفوظ التي أشارت إلى أصابع الفساد التي تسببت في الهزيمة، أو استخدام الإسقاطات والإحالات الرمزية كما هو الحال في رواية “شيء من الخوف” للكاتب ثروت أباظة.
وقد تعرّضت كثير من الأعمال الإبداعية إلى قضايا موازية باعثة للأمل وبث روح التكاتف بين أفراد المجتمع المصري. ففيما يخصّ قضايا التهجير التي تعرضت لها “مدن القنال”: بورسعيد والإسماعيلية والسويس، جُسدت نماذج من القصص لأفراد عاديين قدّموا العون وفتحوا بيوتهم لاستقبال المهجرين، ولم يكن هذا بدافع التأريخ بقدر الرغبة في الخلاص من الجو الإحباطي، لذا جُسّدت حكاياتهم عبر صفحات الكتب أو على الشاشات. ورغم اقتراب تلك القصص من المثالية التي لا تنافي الواقع، إلّا أن بُعدًا آخر لم تجسر كثير من الروايات على الاقتراب منه، ألا وهو الأثر السلبي للتهجير على المهجرين أنفسهم. ورواية “شقي وسعيد” للكاتب حسين عبد الرحيم الصادرة عن دار ظلال وخطوط (2021) تخرج علينا بعد مضي ما يزيد عن نصف قرن من الزمن، لتُعلن عن هذا الجانب المسكوت عنه وتكشف ظلال التغريب والاستلاب التي تعرض إليها أهل القنال ولاسيما بورسعيد.
تأخذ الرواية شكل البينة الدائرية في بنيتها السردية، فتبدأ أحداثها وتنتهي بمشد مؤلم في ثلاجة الموتى، حيث يودّع (الحسين) – الشخصية الرئيسة بالرواية وراويها الأوحد – أمّه قبل لحدها. وما بين البداية والنهاية، يسترجع (الحسين) أحداث التهجير بمدينة بورسعيد بعد النكسة مباشرة وهو ابن ثلاثة عشر يومًا، والمعاناة التي يواجهها المهجرون في المعسكرات حتى وصولهم إلى البطراط ثم مستقرهم في طلخا بالدقهلية وتمضية عدة سنوات بها حتى قرار العودة إلى بورسعيد بعد الذكرى الأولى لنصر أكتوبر. وخلال تلك الأحداث، يظل الراوي صريعًا لكثير من الاسترجاعات التي تأخذه في كل اتجاه ويتخللها تيار الوعي وكثير من الأحلام والهلاوس. وهنا يتبدّى السؤال الآتي، هل حقًا مجرد الانتقال من بورسعيد إلى أية قرية مجاورة – داخل حدود الوطن – يُعدّ تهجيرًا قاسيًا يضع صاحب تجربته تحت رحمة مشاعر الاستلاب والاغتراب القوية كما هي مُبيّنة في الرواية؟ وهل يُدرك رضيع ابن ثلاثة عشر يومًا مثل تلك المعاني وهو يشهد طفولته وصباه تتفتح وتزهر في مدينة أخرى قبل العودة إلى بورسعيد؟ إن الإجابة على مثل هذه التساؤلات من الأهمية بمكان؛ إذ تضع المتلقي في مواجهة مع كثير من تقنيات السرد في الرواية ومقصدية الكاتب التي قد تتبدّى له من قراءة عمل يتناول النكسة بعد مضي أكثر من نصف قرن.
إن الأعمال التي تتناول نكسة 67 كمرتكز حدثي تعمد في مجملها إلى فعل المكاشفة وتجريد المجتمع من أوهامه وسلطاته المزيفة أو بمعنى أصح تهدف إلى تقويض السرديات الكبرى. يبدأ هذا التقويض بطرح موضوعة التهجير من زاوية مغايرة خاصة بالكاتب نفسه الذي عايش تجربة التهجير بنفسه؛ وهي زاوية مغايرة للسردية الكبرى التي طالما ركزّت على مركزية البطولة وتغافلت عن هامشية المعاناة. فليست الرواية هنا بصدد سرد بطولات شعبية وإن كان يحدث هذا بين الفينة والأخرى، ولكن تُركز بؤرة الأحداث على الأبعاد النفسية السلبية المسكوت عنها لعملية التهجير. ولا يرجع هذا لذمٍ في عملية التهجير نفسها ولكن هذا شأن الحرب وتلك ثيمة كثيرة التمظهر في أدب الحروب بشكل عام؛ ولكن إلقاء الضوء على هذه القضية من وجهة مسكوت عنها يمنح التجربة ظلالًا أكثر واقعية وإن كانت سلبية. فهذا الجيل هو جيل الصدمة الكبرى الآذنة بانهيار النظام القديم؛ يقول الراوي في بداية الرواية عندما سقط رضيعًا من حضن أمه في البحيرة وقت عملية التهجير، “وكانت صرختي الأولى التي هزّت الكون، سقطت الصديقة… تحوطني وتتعدد محاولات يائسة للقبض على الباقي من جسدي النحيل، مذعورًا كنت، ينتفخ قماطي ممتلئًا بهواء البحيرة والغبار”.
فيرى المتلقي هنا أحد المهجّرين الحقيقين من لحم ودم وليس كبطل ذي هالة أسطورية، يشار إليه دومًا في “18 حارة سعيد” حيث يقطن هو وأسرته باسم “حسين ابن المهجرين”، ويعاني من الوحدة وفقدان الأمان والاغتراب كونه يعرف – محض يعرف – أن المكان الذي نشأ به ليس أرضه أو مدينته الحقيقية وأنّ رحيله عنها شيء مؤكد مرهون بانتهاء الحرب. وهو ما يجيب عن التساؤل الأول الذي طرحناه سلفًا، ألا تقع بورسعيد والبصراط وطلخا داخل حدود وطن واحد؟ إن قضية الانتماء لا تتعلق بحدود وطن بقدر الشعور بالتجذر في أرض بعينها، وهنا تنتفي تلك الصفة عن (الحسين) في كل مكان تحط فيه قدماه؛ لذا لا يفتر يرى نفسه في أحلامه داخل شوارع غريبة، يقول: “في شارعي الطويل الممتد لآخر الزمان فاقدًا مكاني والعنوان”، وتعقيباته في صدره على تلاوة الشيخ محمد رفعت عندما يقرأ: “والتين والزيتون* وطور سينين* وهذا البلد…” فيقول “أي بلد!”. ومن ثمّ، يتبدى التشظي النفسي للشخصية الرئيسة كونه فاقدًا لبوصلة المكان وعليه، تضل منه أيضًا بوصلة الزمان فيرى نفسه رضيعًا تارة وبالغًا تارة أخرى، يتكلم بلسان الصبي المراهق ثم يعود إلى لسان الرضيع مجددًا. فيسيطر الزمن النفسي المشتت على الزمن السردي خالقًا نوع من التوتر والارتباك المقصود لدى المتلقي للوقوف على مدى التصدع النفسي الذي يعانيه مهجّرو الحرب.
ويمتد هذا التصدع النفسي إلى تقويض سردية كبرى أخرى وهي الذات الإنسانية نفسها؛ فالشخصية الرئيسة بالرواية ليست ذاتًا واحدة – كما هو المعهود – وإنما مشطورة إلى خمس ذوات. يقول الراوي: “أنظر في دهشة، أستطلع وجوه خمسة من الأشقياء، كانوا وحدهم يسيرون بخفة بلا صوت، تتدلّى رؤوسهم قريبة من الصدور، يرفعون أقدامهم بصعوبة. يشبهونني وقت الخطو والركض واستشعار الخطر”. يرى (الحسين) خمسة أشخاص يشبهونه يظهرون له من حين لآخر يخلقون لديه ولدى المتلقي نوعًا من المخاتلة تزداد حدتها كلما استشعر الوحدة والاغتراب. ففي المشهد الذي يسبق دخول (الحسين) – في السيارة وحيدًا – إلى حدود مدينة بورسعيد، وفي أحد هلاوسه، تحدث معركة بين (الحسين) نفسه وظلاله الأخرى، يستجوبهم فيردّون عليه “أنا ظلّك.. أنا عملك.. أنا الطفل المغولي… أنا الطفل القابع في روحك” ويحمل بلطة ويهمّ بتقطيعهم لولا ضربه بكفه بكل قوة على خلفية كابينة السائق. ومن ثمّ، يقف المتلقي على توصيف لنفسية أحد المهجّرين فانفصاله ليس عن الزمان والمكان فحسب وإنما عن الذات أيضًا. إلا أن هذا الانفصال يحمل داخل طيّاته تدميرًا للذات في لحظاتها الماضية بآلامها وأتراحها ويُعيد بناء الذات بشكل أكثر اتساقًا مع الحاضر بعد التخلص من تلك المخاتلة. لذا تنماز شخصية (الحسين) بتطور ديناميكي رغم صخب وتوتر الشخصية إلا أنّه يُصاغ على مهل وعلى مر الأحداث. لذا بدأت الرواية بمشهد موت الأم و”تسمّر” (الحسين) دون أن يدري أي رد فعل عليه أن يسلك، بل أخذ يفكر في كل لحظاتهما سويًا بين حب وكراهية. لتأتي سلسلة طويلة من الاسترجاعات على مدى ثمانية عشر فصلًا إلا أنّه وعند انتهاء الرواية وبعد الوصول إلى لحظة الكشف، ينفجر (الحسين) في البكاء ويناديها “خذيني معكِ” – وهو الرد الطبيعي من الابن في تلك اللحظة.
وتستمر سياسات التقويض بتوظيف الكاتب لوجهة نظر سردية فريدة من نوعها؛ فالراوي رجل في الخمسين من عمره منغمس في ذاكرة الطفولة إلى الحد الذي يُنسى فيه أمر ذلك الراوي البالغ برمته ويسيطر الصوت السردي للطفل على الأحداث بتذبذبه، وملاحظته لدقائق الأحداث دون فهم المغزى من ورائها، ومراقبته السلبية دون تدخّل فعّال من جهته إلى جانب صوته المشوّش وسطوة الحلم على أفكاره وواقعه، يقول مثلًا: “أجول ببصري في الفضاءات الخلفية عند الرفاس، أستطلع الطفل الأسمر وقد بدأ يرمي بطيارة ورقية تحمل ألوانًا زاهية… كنت أدقق النظر، أرقب الآفاق العالية”. ولا شك فإن لوجهة نظر الطفل الأثر البالغ في خلق مشهدية عالية ترصد صورًا مختلفة عبر جمل سردية قصيرة متلاحقة دون إسهاب، ودون تدخّل في رؤية المتلقي نفسه؛ فيترك تأويل ما يرى وقراءة المشهد للمتلقي في حيادٍ تام.
ويؤثر هذا الصوت السردي الفريد من نوعه في بنية الرواية بأكملها؛ فيتشظي الخط السردي بين كثير من الأحلام والهلاوس إلى حد قد يفقد فيه المتلقي إمساكه بزمام الخط السردي إن خانه التركيز. يسعى هذا الصوت إلى تفكيك سطوة البالغين ولاسيما الأب الذي يغيب عن المشهد الحدثي إلى قرابة منتصف الرواية؛ لذا يتكرر سؤال (الحسين) دومًا “أين أبي؟”، ثم سؤاله “أين أمي؟” في النصف الآخر من الرواية. ولعل لغياب البالغين مدلولًا واضحًا لا يخفى عن المتلقي ألّا وهو انهيار السلطة الأبوية لمجتمع الآباء بعد النكسة. فــ(الحسين) وأقرانه هم جيل ما بعد النكسة هم الجيل الذي عليه تشييد البنيان الذي هدمه جيل الكبار بسبب تعنتهم وعنجهيتهم وقسوتهم أحيانًا كما هو واضح في معاملة والد الحسين القاسية لأولاده. وعليه، تحتّم على الكاتب جعل راوي روايته طفلًا أو بالغًا بذاكرة طفل، يُعطّل صوت الكبار ويصير هو مركزًا للقوة السردية والمتحكّم فيها رغم صمته الدائم.
وعلى الرغم من موقف المشاحنة الذي يتجلى بين جيل الكبار وجيل الصغار، إلا أنّه لا يمكن إغفال توظيف الكاتب لبعضٍ من الإحالات الرمزية ولاسيما في أسماء بعض الشخوص. بدت والدة (الحسين) – (الصّدّيقة) – شخصية تحمل كثيرًا من التناقضات: القوة والجمال وفي أحيانٍ أخرى يخلق الكاتب تماسًا بينها وبين (فؤادة) – شادية، بعينيها الواسعتين – في فيلم “شيء من الخوف”، فيقول بعد مشهد محاولة اغتصاب أمه من أحد المهجرين في حمام معسكر البصراط، “أستعيد طلتها، ملامحها، جبروتها وقوة شكيمتها صلابتها عندما تكشّر عن أنيابها. دارت بي خيالاتي والفيلم لم يزل ينطق بالحوار في أرضية مغبّرة داهل شاشة سوداء: “باطل، باااااطل”. في ذلك المشهد الذي يرتبط فيه الوعي الجمعي بفكرة (فؤادة) التي ترمز لمصر نفسها، يبدأ المتلقي في رسم حدود تماس بين (الصّدّيقة) ومصر؛ إلا أنّ الراوي لا يلبث أن يقوّض ما رسمه المتلقي عبر إبراز علاقة (الحسين) المضطربة بأمه ونظراته الـــ (أوديبية) – نسبةً إلى أوديب الملك – لأمه، التي يمتزج فيها الوصف العاطفي بالحسي لجسدها.
ويتبدّى هذا التقويض الأشد إيلامًا في اسم شخصية (أم هاشم)، تلك الفتاة التي أحبها (الحسين) في صباه. لا يخفى على المتلقي مدلول اسم (أم هاشم) في الوعي الجمعي ، وارتباطه بالسيدة زينب أم المساكين التي يلجأ إليها كل مكروب. وفي الرواية تظهر تلك الفتاة التي تمثّل النبراس الوحيد للأملٍ والسعادة لدى (الحسين)، يلجأ إليها كلما شعر بالوحدة أو الحزن، وتأتيه في هواجسه، وتقول “تمسّك بالأمل يا حسين، غدًا ستعود لبلدك.. بورسعيد.. مكان الميلاد”. كما اتسمت تلك الفتاة بحبّها للمسجد وحفاظها على الصلاة؛ وعليه يبني المتلقي علاقات متشابكة بين دلالات اسم (أم هاشم) والطُّهر ومساعدة المكروب ودلالة اسم (الحسين) في هذا السياق، ثم يقوّض الكاتب تلك العلاقات جميعًا عندما تُغتصب (أم هاشم) فتشعل النار في جسدها وتموت. وتتحول إلى شبح يظل يلاحق (الحسين) في صحوه ومنامه وتأتيه في صور مرعبة عبر النافذة: “افتح، جئت إليك لتطفئني.. حسين، أنا أم هاشم.. أنا بموووت يا حسين”. ومن ثمّ، يوظّف الكاتب عددًا من الأسماء ذات دلالات في الوعي الجمعي ثمّ يقوّضها لبناء أجواء مصاحبة للتشتت والتصدع النفسي.
وأخيرًا، فإن رواية “شقي وسعيد” للكاتب حسين عبد الرحيم تتناول أحداث ما بعد نكسة 1967، وقد تناول الكاتب عددًا من السرديات الكبرى عبر إلقاء الضوء على قضية التهجير. وقد شرع في هدم الواحدة تلو الأخرى، وبناء سرديات أخرى جديدة لتجسيد معاناة المهجّرين في أعقاب النكسة. ولكن يبقى السؤال ما الجدوى من تقديم المزيد من أدب النكسة ولماذا يُكتب الآن في العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين؟ قد لا يكون الأمر بهدف التأريخ الاجتماعي بقدر تمثيل التشوهات النفسية والاجتماعية التي تنتج عن النكسة أيًا كان نوعها وزمنها ولفت نظر الأجيال الجديدة التي تفتقد الصلة بتاريخها وأصالتها إلى الأمانة الثقيلة على كاهلهم ألا وهي حفظ الأرض والوطن.