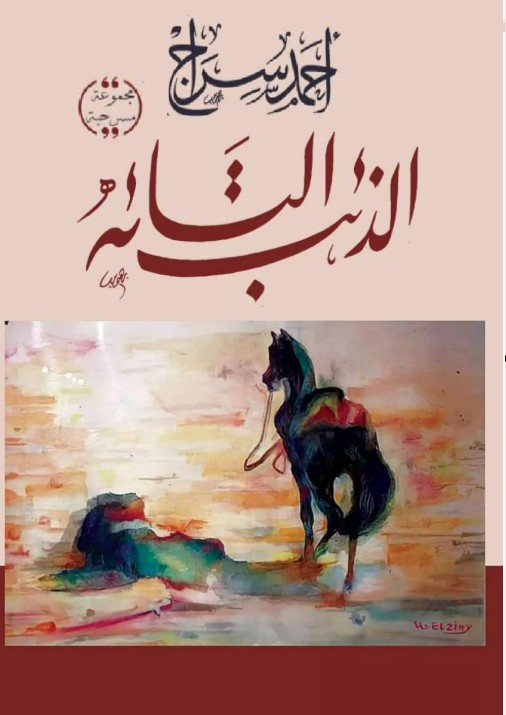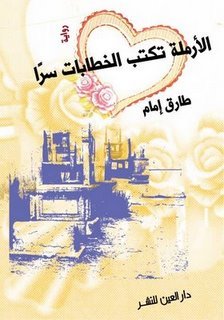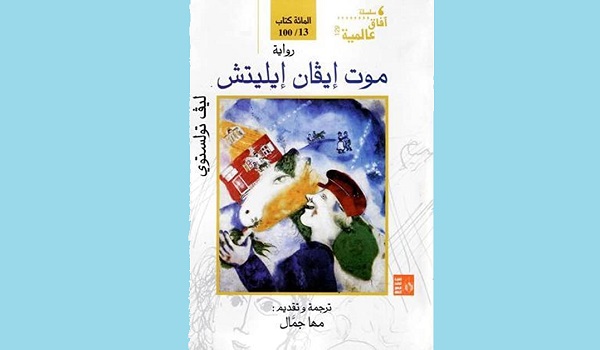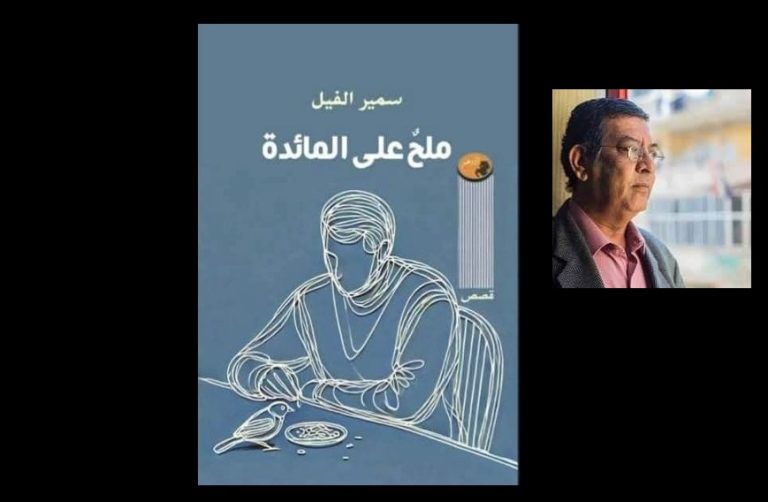وتضاء ملامح بعض الشخصيات الأخرى من خلال منظور البنت، مثلما نرى شخصية رجل الجنازات المولع بالموت والحكايات. وهكذا لا تتخلق الرواية عبر الحكاية والأحداث، بل عبر رسم الصور الشعرية ذات التفاصيل، أما الحكايات فتبقى في ذيل الرواية تحت عنوان “ملاحق”. وهكذا تحاول الرواية أن تحتفظ لنفسها بصفاء الصور، وتصنع ثنائية الصورة في مقابل الحكاية، والمشهد في مقابل التعاقب؛ إنها ببساطة تقيد الزمن في إطار مكانية الصورة، أما الحكايات التي يكون الزمن جوهريا فيها فإنها تُقصى إلى النهاية ملاحق يوهم بأنها توضيحية أو يمكن الاستغناء عنها. من هنا نبدأ السؤال عما يمنح هذا العمل شعريته السردية.
الحكاية والرواية
ولعل الانشغال بتشكيل الصور ذو أثر بالغ في بناء هذه الرواية؛ فكل فصل منها ينشغل بتشكيل صورة وينغلق على نحو يعطي للقارئ إحساسا باكتمال ما، فكأن الفصل قصة قصيرة، أو لنقل لوحة مكتملة يصح أن تنفرد عما سواها، ويصح أن تجتمع إلى غيرها فيتشكل مصير جديد. ويبدأ كل فصل بجملة تصلح مفتتحا لقصة قصيرة وتختتم بجملة تصلح لإغلاقها. لكن هذا الإغلاق ليس إغلاقا تاما، بل يكاد يكون تمهيدا لمفتتح جديد في متوالية من الصور تمنح للرواية بنيتها الخاصة.
تبدأ الرواية بفصل يركز على صورة القدم الصغيرة وينغلق على حلم الولد بامتلاكها، وإن كان ذلك على نحو قاس لا يخلو من سادية مفزعة. والفصل الثاني ينشغل بالصور نفسها، ثم ينغلق على مشهد فتيات كثيرات يقلدن البنت فيمشين حافيات. أما الفصل الثالث فتهيمن عليه صورة البنت النحيفة وحلم الولد بأن تكون حدباء، وينتهي الفصل بتحقق تلك الصورة.
يتشكل في الفصل الرابع حلم اليقظة – لدى البنت – بالموت في سن الثامنة والأربعين، وينتهي بيقينها من تحقق ذلك. وفي الفصل الخامس تظهر حيواناتها الأسطورية المتخيلة، وتنتهي بصورة أحدها، مؤكدا رسوخ حضوره. أما الفصل السادس فيرصد صورا متعددة لأحزان البنت، وينغلق على مشهد البنت إذ تبكي خيباتها وهي ملتحمة بـ”كنبتها” التي تمثل لها الرحم والملاذ. وبعد هذا يقدم الفصل السابع صورا لعلاقة البنت بأشيائها، وينتهي برغبتها في الموت.
تنتقل الرواية بعد هذا إلى الولد، حيث يصوره الفصل الثامن وهو يكتشف ذاته في مرآة الأنثى عبر حضور الفانيليا في الحلوى والجسد الأنثوي، وينتهي بالشعور بالتهديد إزاء السلطة الناعمة للحضور الأنثوي: “تفوح من جسمها رائحة الفانيليا، لكنها في نفس الوقت، كانت قادرة أن تحتوى في قبضتها، على قلب من الإسفنج، وتعصره بلا شفقة حتى آخر قطرة” (فانيليا، ص 42)
تتشكل في الفصل التاسع صورة يوم الأحد وطقوسه كاشفة عن ثنائية الزمن والفراق، وينتهي الفصل بتأكيد طقس تناول القهوة واللبن بوصفه أهم طقوس ذلك اليوم الذي منحه الله البنت. ثم يبدأ الفصل العاشر بصورة الطيور المحلقة مشيرة إلى حلم البنت بالسفر، وينغلق الفصل بترديدها جملة “أرغب في السفر إلى أي مكان في الدنيا .. أي مكان” (ص 49) ويرسم الفصل الحادي عشر صورة للشر بداخل البنت ويكشف عن رغبتها في القتل، وعن انهيار ذكريات طفولتها، وينتهي بمشهد يصور شفتي البنت – من منظور الولد – إذ تمزجان الشر بالاشتهاء.
الفصل الثاني عشر يصور فضاء الكافيتريا الأثير لدى البنت، حيث يسود الكلام والتفاعل الإنساني، ثم ينغلق الفصل بانسحاب الموسيقى وانغلاق الباب الزجاجي ببطء. أما الفصل الثالث عشر فيصور خشية البنت من فقد ثدييها، ويربط ذلك بالصراع ضد الزمن والخوف من ضياع الذاكرة، وبالتحديد فإن الحركة الدائرية ليد البنت حول الثديين لتأكيد الوجود الإنساني تقابل الحركة الدائرية في العالم بوصفها حركة تيه ناتج عن ضياع الذاكرة تمثله السيدة العجوز التي تتوه في شوارع المدينة وتجد بيتها بصعوبة. وينتهي الفصل باستعداد الفتاة لكتابة قصة عمن سمتها سيدة الغسيل. وهي نفسها إحدى قصص الملاحق. وتنتهي الرواية (بدون الملاحق) بصورة شكّلها وعي الولد، تُحول البنت إلى كيان أسطوري يرحل رأسيا إلى مستقره النهائي من غير انقطاع عن العالم؛ إذ تصبح سحابة تمنح العالم سكينة وقطرات من المطر مشبعة برائحة الفانيليا. وهكذا تصبح تجسيدا للأنوثة الكاملة، بوصفها وعدا أكثر من كونها تحققا أرضيا قابلا للزوال.
ليس ثم موضع للحكاية في ثنايا هذه الرواية، ومن ثم يكون مستقرها في نهاية الرواية على هيئة ملاحق لا تدعي لنفسها وجودا جوهريا، لكن تجاهلها محال أيضا. إن الملاحق محاولات لملء فجوات الرواية؛ فهل ثم من دلالة لتلك الفجوات الممتلئة أو الملاحق بعينها؟
الملحق الأول يركز على شخصية سيدة التيه؛ سيدة الذاكرة الضائعة، فكأنها أيقونة غياب الزمن واندحار الإنسان، وهي دلالة جوهرية في مجمل الرواية. بطلة هذا الملحق سيدة تعشق الحياة، لكن تلك الحياة لا تلبث أن تغادرها، وتترك لها أقل القليل من الذكريات الجميلة والكثير من الألم لما تفقده كل يوم. وهذا الملحق من ثم يتكامل مع الملحق التالي له الخاص برجل الجنازات عاشق الموت والحكايات، حيث تكون خاتمة حياته خالية من أي معنى، فكأن كلا من سيدة التيه ورجل الجنازات، يقدم نموذجا غير قادر على التفاعل المتوازن مع الزمن، في مقابل نموذج البنت.
صحيح أن رجل الجنازات أُعطى هذا اللقب على لسان الولد، لكن القصة ترشح أن ينال لقب رجل طقوس العبور: “لم يكن حضوره يقتصر على المناسبات الحزينة فقط، بل امتد أيضا إلى حفلات الزواج، وأعياد الميلاد، والسبوع والطهور، مما جعله يتبوأ ـ وبجدارة يستحقها ـ مقعد كبير العائلة بلا منازع، ممارسا دوره الناجح في حل مشاكلها، كإرجاع البنات الغاضبات، إلى بيوت أزواجهن، أو نصح الأولاد المتمردين على آبائهم، وكذلك تمثيل العائلة في المناسبات المختلفة. بدأت فكرة التدوين عنده، بعد أول مرة مارس فيها العادة السرية، كان الأمر بالنسبة له مفاجئا، وعلى غير توقع، في ذلك النهار الصيفي الحار، عندما أحس بتلك الجمرة المتقدة.” (ص ص 76- 77)
وتظل هذه الشخصية في الرواية واحدة من الشخصيات والعناصر التي لا يمكن فهمها إلا عبر استبطان القيم الجمالية للصورة، فهو يجمع بين ولعه بحضور الجنازات وكونه حكاء ماهراً، ومن ثم تتراسل شخصيته مع شخصية البنت، من حيث إن رجل الجنازات أكثر من سواه لصوقا بالتراب والرحم، فالجنازات تعبير عن لحظة الاحتفاء بالموت والحكاية معا؛ إذ تتشكل فيها الذكرى لتأخذ مظهر الصورة التي يسعى الإنسان المحتفي أو المحتفى به إلى تثبيتها في مواجهة الموت وتقلبات الزمن.
الملحق الثالث هو القصة التي كانت البنت تسعى إلى كتابتها عن سيدة الغسيل التي وهبت حياتها لهذا الطقس الذي يسمح لها بالتخلص من كل آثار الذاكرة حتى انتهى بها الأمر إلى أن جاراتها “وجدن عشرة من مشابك الغسيل الخشبية قد نبتت مكان أصابعها، وهي مزينة برغاوي الصابون.” (ص 81) إنها امرأة سباها حلم الماء وقضى على كيانها الروحي وعلى كل إمكانات تواصلها مع الذات ومع الآخر. إنها ببساطة النموذج الحلمي المضاد للبنت. إنها النفي الكامل لأنوثة الفانيليا.
شعرية الصور في الرواية
تبدأ الرواية بالتشبيه، كأنها تلفت النظر منذ السطر الأول إلى مركزية المجاز فيها. فالجملة الأولى في الرواية هي: “مثل قدم طفل”؛ وهي جملة تؤسس للجذر التصويري فيها، كما تكشف عن أهم الملامح التي ستوجه علاقة الشخصيتين المحوريتين، وتوضح أهم ملامح شخصية البنت وتوجهاتها التخيلية. على أن صورة القدم الصغيرة التي يتحدد جمالها – من دون أن يؤكد ذلك صراحة – من خلال صلابتها ولدونتها، ومن خلال ما تشغله من فراغ يؤكد طبيعتها المادية وانتماءها- من حيث هي صورة- إلى عنصر التراب؛ وتلك الصورة لا تكتمل إلا بوضع القدم في الهواء، وهكذا يتكامل عنصرا التراب والهواء ليشكلا المصدر الأساسي للصور المرتبطة بشخصية البنت في الرواية. الرواية تبدأ إذن على هذا النحو: “مثل قدم طفل. هذا أول خاطر مرّ في ذهن الولد، وهو يتأمل القدمين الممدودتين في الهواء. كانت البنت تريه الشراب الذي اشترته حديثا، عندما لَفَت نظره القدم الصغيرة، وفكر أن قدمها أيضا تصلح للفرجة، وأنه لو وضعها في راحة يده، بالكاد ستملؤها… كان مشدودا لهما، دائما تبهره الأشياء الصغيرة، كأجساد البنات النحيفة، أو الأثداء التي في حجم جوافة، واليوم لأول مرة، يشوف قدما في مثل هذا الحجم.” (ص 9) إننا إذن أمام إبداع سردي ينحو صوب الشعرية، ويتفاعل مع وظيفة الفن بطريقته الخاصة. فهل هذه هي الكتابة الشاعرية التي تحدث عنها باشلار ورآها تمتح صورها من عناصر الطبيعة على نحو يتراسل مع خيال الإنسان ورغباته في التعبير وطرائقه في تلقي صور العالم؟
هذا يدفع إلى الانطلاق في هذه القراءة من تصورات الظاهراتية والأبحاث النفسية والأنثروبولوجية التي تحلل المتخيل وتبحث في ماهيته ووظيفته مؤكدة تجذره في الفعل الإنساني ودوره الفاعل في كل نشاط، وهو ما يتبدى جليا لدى جيلبير دوران الذي “أبرز أن بنيات المتخيل وعلاقاته التركيبية والإيحائية ووظائفه الأنطولوجية تمثل الأساس الذي يحرك كل الأنشطة الذهنية والثقافية للإنسان، ويوجه طرائق اشتغالها وتشكلها. وإذا كان قد أوضح أيضا أن التخييل هو السلاح الذي ظل يواجه به الكائن البشري خوفه الأنطولوجي من المصير المظلم واقتراب ساعة الرحيل، فإن قيمة تصوراته وأهميتها النظرية لا تنحصر في هذا الإطار فحسب، بل تكمن أساسا في تأكيده أن المتخيل لا يهيمن فقط على الميثات والسحر والشعوذة، أو في البنيات الفنية للموسيقى والرسم والشعر وغيرها من الفنون الجميلة، وإنما يتحكم أيضا في الأنساق العقلانية والعلوم التجريدية؛ لأن كل هذه المعطيات الثقافية تنبني – بدرجات متفاوتة – على أوهام خاصة، وتطمح -بأساليب متباينة- إلى تجذير رموز الانتصار الأنطولوجي للإنسان في الحياة.” (الخيال والمتخيل في الفلسفة والنقد الحديثين، يوسف الإدريسي، الملتقى، المغرب، ط1، 2005، ص 171)
إن شعرية الصورة – على نحو ما تتخلق في الرواية – تند عن التأطير الدلالي، ولا نجد أنفسنا مطالبين بتقديم قائمة بدلالات نهائية لهذا المنجز الجمالي، وهو ما يجد الصدى النظري لدى جان بورجوس في كتابه “السبيل إلى شعرية المتخيل”، حيث يؤكد أنه “لا تُصنع الصورة الشعرية ولا ينحصر متخيلها ضمن معنى ثابت ومكتمل للدلالة، بل إنها تتحرر وتنفلت باستمرار من كل محاولة لضبط دلالتها وتصنيفها، ويظل عالمها التخييلي في حالة تكوُّن متواصل بالنسبة إلى مبدعها وقارئها على حد سواء، وكل شيء يحدث فيها كما لو كانت تقع دائما أمام ما تقول؛ لأنها تحمل أكثر من منطوقها، وتحيل على أبعد من موضوعها.” (الخيال والمتخيل، ص ص 182- 183)
الرواية لا تنشغل بأن تقدم دلالات نهائية أو حكايات دالة، بل إنها تنشغل بتأكيد البعد الأنطولوجي لفعل السرد بوصفه خلقا لعلاقة تواصل بين النص والقارئ في مواجهة الزمن والموت، عبر تفعيل طاقات التخييل.
الشخصية ورؤية العالم
في الرواية تندمج الذات بالعالم، ومن ثم لا ينفصل حلم اليقظة عن واقع شخصية البنت. وفي إطار هذه العلاقة تتشكل شعرية الحلم. إن وعي الشخصية يتفاعل مع العالم على نحو تنفتح معه آفاق الإبداع وطاقات التخييل، وهو ما يتسق مع طبيعة تلك الشخصية التي تحاول الهروب من طرائق التفاعل الذهني مع العالم، وهذه الثنائية تذكرنا بالتحليل الظاهراتي الذي قدمه باشلار، حيث “لا يفصل بين الذات والعالم؛ بين الوعي وموضوعه، ولا يتبنى الوصف التجريبي للظواهر؛ لأن من شأن ذلك أن يُبقي الذات في وضع استسلامي، ويعوقها عن إدراك المضامين الإيحائية والخصائص التخييلية للمواضيع الماثلة أمامها؛ بينما المطلوب أن يندمج الوعي في التأملات الشاردة للعالم والأشياء، ويكثف مشاركته في عملية التخيل الخلاق، فيداومها في انفصال تمام عن إجراءات التفكير العقلاني ومقتضيات التحليل التجريبي للظواهر. وباختصار، فما تدعونا إليه ظاهراتية التخيل الباشلارية أن نحاول الاتصال بالوعي المبدع للشاعر، ونعيش وثبات تخييلاته من جديد.” (الخيال والمتخيل ، ص ص 95- 96)
ولأن البنت تعيش الحلم واقعا فإنه يترك أثرا في جسدها، فتخلق الرواية واقعا سحريا لا سبيل إلى تأكيده أو نفيه: “وضعت البنت يدها أسفل ذقنها، وقالت: ـ كانت الحبال خشنة ومؤلمة… بُص. وسحبت يدها… كان هناك خط داكن، ممتزج بالجلد، يلتف بإحكام حول رقبتها.” (ص 63)
إن رواغ البنت إلى أحلام اليقظة ليس سوى موقف وجودي يكشف عنه الحضور الكثيف للصور الشعرية في الرواية، وهي صور لا تكتفي بأن تثير فينا جمالا فنيا؛ ذلك لأن “الإثارة الجمالية التي تولدها الصور الشعرية في النفس ليست ذات طابع فني صرف، ولا تنحصر غايتها في مجرد الإمتاع والمؤانسة، بل إنها لا تعدو أن تكون وسيلة لتحقيق غاية أخرى أبعد من ذلك وأكثر أهمية منه، ألا وهي تهدئة روع الإنسان ومواجهة قلقه الوجودي من التحولات المرعبة من الزمن، وخوفه من المصير المظلم والغامض الذي يتربص به؛ ومن ثم حين تغرق الصور الشعرية في الابتعاد عن الواقع الموضوعي، وتشيد عوالم فنية تثير في النفس خيالات التحرر من الواقع وتجاوزه، فإنها لا تهدف بذلك إلى الهروب من العالم المادي والتعويض عنه بآخر متخيل، وإنما تروم فهمه وإكماله وتجميله، وإرجاع ثقة الإنسان فيه، ولا توجد وسيلة لتحقيق ذلك – في تصور باشلار – غير الخيال.” (الخيال والمتخيل، ص 125)
وسواء أكانت الصور إيجابية تحتفي بالحياة أو سلبية سوداوية؛ فإنها تظل قادرة على إغناء مواقف الإنسان ومساندته في مواجهة الزمن وتحولات الحياة المرعبة، “وإذا كانت التخييلات التي تتغنى بالحياة وتتسك بها تعيد إلى الإنسان توازنه النفسي وتبعث فيه حب العالم، فإن الأمر ذاته يتحقق بالتخييلات السوداوية التي ترى في الوجود مجرد مصدر للشقاء؛ لأن الخيال الشعري يولِّد – بمنطقه الحركي المتسامي ومضامينه الإيحائية التي تجدد العزائم – الطاقة القمينة بتلطيف الرموز المنظمة التي تذكر بسلبية الحياة وعبثها، فيطهر بذلك النفس الإنسانية من مخاوفها وهواجس السقوط والانكسار التي تجثم على تفكيرها وتخيلاتها.” (الخيال والمتخيل، ص 125- 126)
إن رسم صورة البنت على هذا النحو في الرواية قد يبدو لنا محاولة لمغالبة الزمن في إطار مكاني، أو لنقل إنه محاولة لقهر الزمان عبر المكان، وهذا ما قد نفهمه في ضوء تأملات “جيلبير دوران” للمتخيل؛ إذ يرى أن ما يوجه تعبيره هو الاهتمام بتحويل الزمن بوساطة الشكل المكاني من ميدان القدر الحتمي إلى ميدان الانتصار الإيديولوجي؛ “فالغاية الجوهرية التي توجه اشتغال المتخيلات بكل أنواعها خاصيتها التلميحية التي تجعل منها مشروعا يستهدف تحسين وضع الإنسان في العالم، ويحولها إلى سلاح فعال تواجه به الذات فساد الموت وإفساده وعدمية الحياة وقسوتها وغموض المصير وظلاميته. إنها بعبارة أخرى وسيلة من وسائل التعزيم والتعوذ تستهدف – برموزها وترسيماتها وانتظام بنياتها الحركية والإيحائية – أن تهدئ قلق الإنسان ورعبه من التحولات المفاجئة للحياة ومن تعاقب الزمن واقتراب ساعة الرحيل الأبدي.” (الخيال والمتخيل، ص 161- 162) وهذا الوعي بقيمة المتخيل ووظيفته يدفعنا إلى تأمل ما يفعله النص أكثر من تأمُّل ما يعنيه.
ثنائية التعظيم والتقزيم
إذا كانت المبالغة خروجا من المألوف عبر التضخيم بحيث تبهر العين الرائية، وإذا كانت كذلك تعبيرا عن الخروج إلى العالم وعدم الاكتفاء بالانسجام معه بل تعبيرا عن التعالي عليه؛ فإن التقزيم يبدو خروجا آخر عن المألوف عبر الرجوع إلى الأصل ومحاولة الالتصاق الحميم بالرحم الخصبة المنجبة، ومن ثم فإن التصغير أو التقزيم لا يسعى إلى بهر العين الرائية، بل إلى بهر البصيرة بمغالبة الزمن، وذلك عبر المخالفة المعهودة لناموسه في تنامي الأشياء. إن الولع بالتصغير في هذه الرواية شكل آخر من أشكال مغالبة قهر الزمن.
وفي مقابل هذا التصغير نجد الولع بالحيوانات الضخمة حتى المنقرض منها (الديناصورات)؛ فكأن الشخصية تضخم قواها المساندة للقدرة على مغالبة الزمن والموت بأكثر من وسيلة، وهذا يماثل ما تفعله الأساطير والخرافات، حيث تتضخم القوى التدميرية، وفي مقابلها تتزايد قدرة الأسلحة المناوئة على الفتك وتخليص العناصر الخيرة.
الديناصور يبدو في الرواية رمزا للحضور الكثيف للزمن ولغيابه كذلك. فالديناصور هنا تشكل في أعياد شم النسيم، وأخذ لونه الأخضر من الطبيعة، وبدأ فكرةً في ذهن البنت، حتى صار حضورا، ومنحته اسم إبريل ليظل دالا على تقلب الزمن وعلى غياب الحقيقة أيضا. الصور المتشكلة للحيوانات والطيور تستعير ملامحها من عنصر الهواء على وجه الخصوص، لأنها ترتبط في الأساس بفعل الحركة في مواجهة الزمن.
وهذا النوع من التخييل يلتقي مع ما تقوم به الشخصية من فعل مقابل – على نحو من الأنحاء – للتضخيم، وهو تلطيف فعل مواجهة الموت، ويلتقي هذا مع ما رصده جيلبير دوران من أن “الخيال وسيلة يتعوذ بها الإنسان من رعب الزمن وإرهاب المصير المظلم الذي يتربص به؛ ذلك لأن كل المتخيلات تبدو مضادات ذهنية للخوف الوجودي الذي يسكن النفس البشرية ويجثم على تفكيرها في الذات والعالم والمستقبل، لكونها تحرر الإنسان وتطهر أفكاره ومشاعره من الآثار السلبية المترسبة فيها نتيجة المعاناة اليومية المريرة إزاء رموز المصير المرعب والغامض والزمان القاسي والمتناهي التي تقود بلا رحمة إلى الموت، فتعيد إليه بدل ذلك حبه للحياة وإقباله الحالم عليها والمتساكن عليها. ولتحقيق ذلك يعتمد الخيال على إحدى أبرز أدواته التي لفتت نظر علماء الإناسة ألا وهي التلطيف؛ إذ يلطف دلالات الرمز المشئومة فيحد من إيحاءاتها الرهيبة، وذلك بقلب رمزيتها وتغيير دلالاتها الموحشة.” (الخيال والمتخيل، ص ص 167- 168)
البنت تحلم بأن تموت في الثامنة والأربعين، لكنها تلطف هذا الحديث الوجودي الجلل: “لم تعرف البنت تحديدا، لماذا اختارت أن تموت عندما تبلغ هذا العمر.. أيضا وللمرة الثانية، لم تكن تخطط لأن تذكر هذا الرقم بالذات، لكنه جاء على لسانها عفوا، حيث وجدت نفسها تنطقه بكل سلاسة ويسر، كل ما كانت تود قوله، إنها تريد أن تموت في سن مبكرة، وبطريقة سريعة جداً، كأن تنام فتستيقظ لتجد نفسها ميتة، أو بواسطة سيارة مسرعة ذات هيكل صلب، قادر على إنهاء المسألة في جزء من الثانية، وسيكون آخر ما تحمله من ذكريات معها، وهى تسبح في ظلام مفاجئ، صوت فرملة حاد، وارتطام شيء ما.” (ص 22) إنها حتى في حلمها بالموت تنهل من عنصري التراب والهواء، فتريد أن تموت ملتصقة بالأرض راحلة عبر الفراغ أو الظلام المفاجئ.
ويحرص النص – إذ يقدم أحلام البنت حول المشط المنقوش شعرا – على أن يقرن العشق بالموت، فيختار بيت جرير:
إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا
وبعد ذلك مباشرة تمشط البنت شعرها، وتستعيد ذكرياتها حول ثنائية الصور الحية والصور الميتة، إذ استبدلت بصور العائلة أوراق النباتات والأشجار وملأت بها الألبوم، ثم لم تلبث أن امتلأت روحها بحلم يقظة يقترن بحركة النور، فأعلنت رضاءها بحضور الموت في تلك اللحظة: “واصلت تمشيط شعرها على مهل، وهى تتذكر في ابتسام، العلقة التي أخذتها من أمها، عندما اكتشفت اختفاء كل صور العائلة، التي تؤرخ للأحداث السعيدة، من ألبوم الصور، وحل مكانها العشرات، من أوراق النباتات والأشجار. تحرك مستطيل النور، من على قدميها وطرف السرير، منتقلا إلى بلاط الحجرة. كانت هناك فرحة بداخل البنت، تلك الفرحة التي تدفعها إلى ارتكاب أفعال، ربما تبدو للآخرين مجنونة، كأن تصيح بصوت عال، أو تكلم نفسها، وتؤنب الكتب، والأقلام، والشبشب. فكرت البنت، وهى تتأمل خط النور، الذي بدأ يتحرك ببطء شديد، صاعدا الكرسي: أنها لو ماتت الآن، ستكون مبسوطة” (ص 37) فكأن الشخصية تعلن أن تحقق تناغم الذات مع الداخل والخارج هو السبيل الوحيد إلى تقبل حقيقة الموت برضى واطمئنان. حقيقة الموت ليست مرعبة تماما، لكن الاختيار المناسب للحظة مواجهتها هو ما يجعل الأمر ثقيل الوطء أو لطيفا كنسمة عابرة قد تدعوك إلى الابتسام.
يقترن العشق بالموت جليا في حلم يقظة للبنت تبدى فيه رغبتها في القتل بحثا عن حقيقة الموت والوجود الإنساني الهش؛ إنها محاولة للدخول إلى الأعماق مع حضور تجليات الملمس والبزوغ والتخفي، إضافة إلى تجلى الصوت المنطلق في الفضاء معبرا عن الألم إذ يقترب بالإنسان من لحظة الفناء: “دائما أفكر في ذلك الشيء، أن أجربه ولو لمرة واحدة في حياتي، وأموت بعدها، أجرب القتل، تتملكني رغبة ملحة في رؤية الفزع، المرتسم على الوجه، جحوظ العينين، وتقلص الجلد، ظهور الحقيقة المختفية بالداخل، الضعف الذي سيبزغ كاملا، منتصبا وهشا، متجسدا في صيحات الألم والتوسل، لا أود قتل أي أحد، أرغب في قتل شخص أحبه، قريب منى، لدرجة تجعلني أفعلها بإتقان وحرفية عالية، وأتخلص من حبه لي إلى الأبد.” (ص 50)
مصادر التخييل في الرواية
لا تقتصر الكتابة الشاعرية عند باشلار على الشاعر وحده، بل هي بالأحرى – وبحسب استشهاداته الكثيرة – تتجلى سافرة في الكتابات السردية المحتفية بالخيال، وهو ما نراه فيما نحن بصدده من سرد في هذا العمل. وهنا نتساءل: أي عنصر من العناصر الأربعة يمثل البئر الثرّة للصور الشعرية في رواية “فانيليا”؟ أهو الماء أم النار أم الهواء أم التراب؟ أم أن هناك عناصر متعددة تتزاوج لتخلق الخيال الشاعري للرواية؟
تحاول الرواية أن ترتقي ببعض العناصر المادية الصغيرة إلى مستوى فعل التأثير الشعري، بحيث تجعلها مماثلة للعناصر الأربعة الكبرى، أي أن تكون أصيلة وأصلية، وأن تكون ذات طاقة روحية وإيحائية مزدوجة تجمع بين الرغبة والرهبة؛ بين الخير والشر، وبمعنى آخر فإنه “يجب على العنصر المادي – لكي يرقى إلى مستوى الانشغال الشاعري- أن يتضمن من الخصائص المادية والحركية ما يلهب الحواس ويثير النفس، ولن يتحقق ذلك إلا إذا كان منفتحا على كل القيم وقابلا لتشكيل كل الصور والمعاني والإيحاء بها، مهما تباعدت وتباينت.” (الخيال والمتخيل، ص ص 100- 101)
رؤية العالم ومصادر التخييل في شخصية البنت
تستمد الرواية شعريتها غالبا من عنصر الهواء والتراب حين يتعلق الأمر بالبنت على وجه التحديد، وهذان العنصران يتزاوجان ليخلقا الخيال الشاعري لتلك الرواية. والتراب هو الأكثر حضورا، بدءا من ارتباطها الحميم بالأرض ورغبتها في السير حافية، ومرورا بعلاقتها بالأجسام في لدونتها وصلابتها. وهنا يستحق عنصر التراب وقفة؛ إذ “يمثل التراب العنصر الشاعري الرابع والأخير في تصور باشلار، ويتميز هذا العنصر بطابع خاص؛ إذ يظل خاضعا في تمظهره المادي والحركي للواقع والبداهة، خلافا للعناصر الأخرى التي يشتغل خيالها الحركي والمادي بحرية أكبر، ولا ترتهن ضرورة بالمعطى الأرضي. ولا ينحصر مجال اشتغال هذا العنصر ضمن المعنى الضيق لكلمة تراب، بل يشمل مختلف المعطيات والأشياء ذات الجوهر الترابي، والتي تتحدد علاقتها بالإنسان على أساس الحلم والتخييل. ولذلك فهو يضم من ناحية عوالم المعدن والحجر والصمغ وغيرها من العناصر ذات الأصل الترابي التي يحيل مظهرها المادي على القوة الإرادة على الإنسان ومجهوده العضلي، والتي تتجاذب صورها الإيحائية جدلية الصلابة واللين، كما يضم من ناحية أخرى عوالم البيت والبطن والكهف وكل فضاءات الدفء المماثلة لها التي تشي بعلاقة الإنسان الحميمية معها والمتساكنة معها، وترمز باستمرار إلى الرغبة الغريزية في العودة إلى الأم.”( (الخيال والمتخيل، ص ص 108- 109)
وإذا صح أن نقسم الخيال الترابي إلى خيال منفتح وخيال منطو، فلعل الأخير هو الأكثر هيمنة على شخصية البنت، إذ نجد لديها الكثير مما يرتبط بالخيال المنطوي الذي لا ينفصل عما أشار إليه باشلار من “الصور الشعرية للراحة والملجأ والتجذر التي توظف -بالرغم من تنوع أشكالها واختلاف بنياتها وفضاءاتها- رموز الحميمية (المنزل والبطن والكهف) والتي توحي بالرغبة الغريزية الكونية المتمثلة في الحنين الحالم بالرجوع الحميمي إلى الأم والاستمتاع بحنانها ودفء رحمها؛ مما يعني أن حركة الخيال الانطوائي تتجه باستمرار بحو عوالم الدفء العميق والمستتر التي تولد في النفس الإحساس بالراحة المفتقدة وتثير أحلامها الجميلة المهدئة لروعها.” (الخيال والمتخيل ص 110)
تنهل أحلام يقظة البنت وأحلام نومها وكذلك تصورها عن ذاتها من عنصر التراب على وجه الخصوص، وهو ما يتجلى في الاقتراب الحميم من الأشياء ذات القدرة الخاصة على الاحتواء: “هناك شيء آخر تعشقه البنت: كنبتها التي تحوّلها بالليل إلى سرير، تلك الكنبة الزرقاء التي كانت حريصة دائما، على أن تأخذها معها إلى كل البيوتات التي سكنتها، لدرجة أن النوم لم يكن يستطيع التعرف عليها، في أي مكان آخر. الكنبة التي كانت تلفها جيدا، خلال فترات انتقالها من بيت لآخر، بورق أو مشمع، فتصير مومياء ضخمة، تليق بكل هذا العشق، وكانت قطعة الأثاث الوحيدة، التي تتابع فيها الحمالين أثناء نقلها، من العربة حتى مكانها الجديد، خوفا عليها من الخدش، هذا الغرام الذي جعلها تمارس فوقها كل أنشطتها الحياتية، بدءا من القراءة، وكتابة مذكراتها في كشاكيل مدرسية، إلى تأمل نقط وهمية في السقف، أو إغماض عينيها وتخيل أحلام شبقية. متخللة كل ذلك، بتحريك مؤشر الراديو، بحثا عن الموسيقى. أخيرا، توصل الولد إلى قناعة أراحته كثيرا: البنت لا تحب الحياة، أو حتى تعيشها. إنها ببساطة شديدة: تُعَارك الحياة.” (ص 32) ولنلاحظ هنا كيف أن الموت يحضر في صورة المومياء، وفي حمل “الكنبة” من العربة حتى مكانها الجديد، فكأن تلك “الكنبة” هي فائض الذات، وليست قطعة منفصلة عنها. وتستمر الصورة في التشكل من عنصر التراب: “واصل الولد تفكيره، وهو يتأمل القدم التي بدأت تتأرجح بخفة في الفراغ، مبديا إعجابه في نفس الوقت، ببياض الساق الملفوفة، والذي يبدأ من فوق الشراب القصير حتى حافة البنطلون الأسود، وزغب أصفر خفيف ينتشر فوق البياض.” (ص9) وتظل أحلام اليقظة لدى البنت مرتبط ةبالتراب، فهي تحب أن تمشي حافية. “طبعا لم تكن البنت، تمشى حافية طول الوقت، فقط شارعا أو شارعين، ثم ترتدي الصندل. قالت مرة للولد الذي لا يتكلم كثيرا: إنها رغبة، تأتى فأنفذها على الفور وبدون تفكير، وعندما ظل في صمته، واصلت وهى تشرح موقفها: مثل حنينك إلي تدخين سيجارة، أو رغبتك في جسد بنت مارة.” (ص 13)
الماء والنار يغيبان إذن. وهكذا نتوقع إذا ما استمر الأمر على هذا النحو أن يميل المتخيل إلى أحلام الطيران والهروب، وكذلك إلى الانطواء والرجوع إلى الرحم والدخول إلى الأعماق والملاذات.
يتكامل تشكيل الصورة عبر عنصر التراب مع الإحساس العميق بالجسد والرغبة الحميمة في الفضاء القادر على الاحتواء، وهكذا يرسم الراوي الصور التي تكشف عن الأبعاد الثقافية والنفسية والروحية حين تتكامل عناصر تلك الصور: “كانت تنتحي جانبا بجوار باب عمارة، أو فاترينة محل، ثم تنحني لأسفل، وفى حركه تلقائية تخلع الصندل، تمسكه في يدها، وتواصل سيرها بشكل عادى تماما، منتشية بإحساس ملمس الرصيف لباطن قدميها. لم تكن تسمع شيئا من تعليقات المارة، الذين لاحظوا أنها تمشى حافية، أو تلقى بالاً للعيون التي تتابعها في صمت، فقط منتبهة لصوت دبيب خفيف، يسرى في عروقها، ويدغدغ برقة، صاعدا ببطء من أسفل القدم إلى الساق، ثم مابين الفخذين، مواصلا رحلة الصعود مارا بالبطن، والصدر، والرقبة، والخدين، والأذنين، حتى فروة الدماغ، التي تنكمش بسرعة، محدثة دغدغة يقف لها شعر الرأس. أحست البنت بارتياح، عندما وجدت مكانها المفضل في المقهى خاليا.” (ص 14)
وتنهل كوابيس البنت كذلك من عنصر التراب، لتقترن بالانسحاق والسقوط إلى عمق الهاوية والشعور المذلّ بالثقل. إن الكوابيس لديها تتجلى حين تغيب عنصر الهواء عن المشهد. صحيح أن المدن تتشابه لأن تماثيلها تجمع بين شاعرية التراب والهواء معا، لكن هذا التشابه يذكر البنت بتشابه عشاقها، فتلتئم عناصر الذكرى في قلبها ثقيلة الوطء لا تجد من عنصر الهواء مُعينا أو مَعينا: “قالت إن المدن واحدة، تتشابه في كل شيء، أحست البنت في تلك اللحظة، بثقل الصناديق الصغيرة، المعبأة بأحلامها الموءودة، وخيباتها المتعددة، والدموع التي سفحتها في السر، وكذلك عشاقها السريين، سواء الخائنين أو الهاربين، وأيضا رماد القتلى منهم، تلك الصناديق المختومة بأقفال نحاسية زاهية، والمرصوصة بدقة حول قلبها، والتي كان عددها يزداد بمرور الأيام، لدرجة جعلت البنت تعتقد أن جسدها مكون من مجموع تلك الصناديق، وأنها فقط مجرد روح، مهمتها الوحيدة منح الحياة لتمثال الصناديق.” (ص 33)
كانت البنت قد قررت أن تحتفل بعيد ميلادها الخامس والعشرين، وعدّته مؤشرا على اقترابها من موعد موتها الذي حددته بالعام الثامن والأربعين، لكنها تعدِل عن رأيها في لحظة تقترن فيها الكناية بالعناصر التصويرية ذات الحمولة النفسية العميقة: ” كانت تتابع راكب دراجة، يحمل فوق رأسه خبزا، وهو ينطلق بسرعة نحو البعيد، عندما قالت للولد بصوت خفيض، وابتسامة تظهر وتختفي، وعينين تتحركان في كل اتجاه: لا شيء.. فقدت الرغبة في الاحتفال بعيد ميلادي” (ص 31)
إن الصورة في هذه اللحظة تشير من طرف خفي إلى الطيران صوب البعيد من غير خوف، ولعل حضور الخبز كان كناية عن توحد الحياة بالموت معا، أو لنقل – إذا استعرنا بعض رمزيات الثقافة الفرعونية – إنه يشير إلى الخلود. ويحرص النص على أن يجعل الخبز هنا تعبيرا عن اكتمال عناصر الكون، فهو يجمع في طبيعته الذاتية بين المائية والترابية والنارية ويبقى عنصر الهواء الذي يحضر بدخول الخبز في علاقة مع الإنسان الذي يتحرك به صوب البعيد.
أحلام يقظة البنت هي التي تشكل رؤيتها لنفسها وللعالم، لذا لا نعجب حين نجدها قادرة على الانتقال من بيت إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى؛ ذلك لأنها تجد ملمح تشابه أساسيا بين المدن المختلفة يتكئ على عنصري التراب والهواء، ألا وهو ذلك الثقل في المنتصف الباحث عن التجذر في الأرض من غير أن يحلم بالانطلاق بعيدا جامعا بين الانتماء والطموح؛ بين الرسوخ والحركة؛ بين الثقة في الأنا والتفاعل مع الآخر: “سكنت البنت عشرات البيوت، في مختلف أحياء المدينة. لم يكن الأمر يمثل لها مشكلة، أو يجعلها تشعر بعدم الاستقرار، الطبيعي عندها هو الانتقال الدائم، وكل ما تفعله، هو أن تحمل كنبتها وتذهب. فكر الولد أنها محاربة ماهرة، وتجيد المراوغة. حكت له البنت، أن كل المدن تمتلك ميادين، تتوسطها تماثيل، لأشخاص يمتطون خيولا مسرجة، أو يقفون على أقدامهم، ويشيرون بأيديهم التي تحمل سيوفا، أو بأناملهم فقط، ناحية الفراغ. قالت: إن المدن واحدة، تتشابه في كل شيء.” (ص 33)
أما حلم حياتها المتحولة فإنه يرتبط بالتراب والهواء أيضا، فهي تحلم بأن تكون زهرة تتجذر في الأرض وتصعد في الفراغ متطاولة ناثرة عطرها عبر الأثير. (انظر ص 26) كل فصل في الرواية يصلح لأن يكون مفتتحا للرواية، كما أن ترتيب الفصول على الإجمال لا يبدو ملزما، فكله مجموعة من الصور المتجاورة المتكاملة يحق لك أن تبدأ منها بما شئت وتتلوه بما شئت. كأن الرواية إجمالا تحاول هزيمة تقلبات الزمن عبر تأطيره مكانيا باستغلال إمكانات الصورة الفنية. الرواية إذن في مجملها وعبر تشكلها الجمالي ليست سوى تحد صارم للزمن والموت.
حلم الليل نفسه لدى البنت يمتح من عنصري التراب والهواء، إذ تجمع فيه بين الانتماء إلى الأنوثة بتأكيد وجود الرحم مع الرغبة في القطيعة مع الآخر الخارج عن الذات بتأكيد انمحاء الثدي. الحلم يؤكد اختلافها عن البشر الأرضيين الذي يتواصلون عبر الجسد، ويؤكد انتماءها إلى عالم الطير، ومن ثم يكون حلم الطيران مركزيا في رؤيتها، وهو ما يهدد وجودها ذاته حين تتواصل مع أولئك البشر، فهي تحيا حالة تمزق وجودي نظرا لتميزها الروحي عن المحيطين بها، في حين أنها تنتمي فيزيقيا إليهم، وهكذا يكون اختلاف مصدر الخيال لديها عن أولئك البشر سببا في انقطاع التواصل وتحقق التهديد لوجودها ذاته: “كنت قد وصلت إلى الميدان، تحت تمثال الرجل الواقف المشير بإصبعه نحو السماء، وكأنهم اكتشفوا وجودي فجأة، اقتربوا منى في رعب وفزع، أخذوا يصيحون بأصوات ودمدمات غير واضحة، ثم بدءوا ينتفون الريش الذي نبت على يدي وساقي، كان ناعما وناصع البياض، أحببته بشدة، وكنت أصرخ وأنا أحاول منعهم من نتف الريش، وأجاهد للصعود ـ دون فائدة ـ إلى الأعلى، إلى السماء التي كانت تبدو لي زرقتها من بين أجسادهم الكثيفة، ثم صحوت وأنا أحس بالوجع، وكانت أطرافي ناعمة وملساء تماما، حتى أنه لم يكن هناك أثر، لأي زغب على ذراعيّ وساقيّ.” (ص ص 48- 49)
رؤية العالم ومصادر التخييل في شخصية الولد
يبدو أن الصور المرتبطة بالولد تنهل من عنصري الماء والهواء، حتى إن صورة قدم البنت كما يتخيلها الولد تظل لصيقة بالفراغ والهواء، “واعتاد الولد أن يشوفها في يقظته أيضا، لثوان معدودة قبل أن تختفي، كأن يفتح الدولاب، فتبرز مربوطة بخيط، وهى تتأرجح ببطء، أو تداعب خده بأصابعها الرقيقة، أثناء انشغاله في المطبخ، بعمل الشاي بالقرنفل. لم يكن يجزع منها، أو يشهق في رعب عندما تلمسه على حين غفلة، بالعكس، كان مبسوطا من شقاوتها، ومن لعبة الظهور والاختفاء، التي تمارسها معه”. (ص11) كذلك فإنه – في الفصل الثالث – حين يحلم بالكتابة يهاجمه هاجس أو كابوس يقظة يدعوه إلى “خبط دماغه في جدار صلد حتى يسيل الدم.” (ص 17) فهو لا يستطيع أن يكتب، لكنه يجد الحل في الأحلام المرتبطة بالهواء، “فقط عليه التحلي بخصائص الصياد: المراقبة، والصبر، واقتناص اللحظة المناسبة. أراحه قليلا ما توصل إليه، فأخذ يكرر لنفسه: نعم أنا صياد.. صياد.. صياد.. ابتسم الولد ساخرا، وهو يتخيل نفسه يحمل مقطفا ممتلئا بصيده، ويقعد به على ناصية شارع، وهو ينادى بصوت عال: سمك صاحى.. الحق نصيبك.. سمك طازة.” (ص 17)
نجاة الولد تكون بالالتحام بعنصر الهواء، وهو العنصر المشترك مع البنت، والصيد يرتبط بالهواء والفضاء. إن الصيد يعني كسر الفراغ والالتحام بالفريسة عبر احتواء الفضاء باستخدام الآلات المناسبة التي تحبط سعي الفريسة وتكسر قدرتها على الهروب من لحظة الانسحاق. إن الأحلام التي تنهل من عنصر الهواء تحقق ذلك الأمل في السيطرة وقهر الزمن، لكن الولد لا يلبث أن يسقط في براثن الماء مرة أخرى باستخدام التداعي المعجمي الذي يسمح بالحركة عبر جذر (ص ي د) بين الهواء والماء، أو بين صيد البر وصيد البحر، وبينهما بون شاسع على مستوى تشكيل الصور والكشف عن الأبعاد الرمزية للشخصية.
ولنلاحظ أن أحلام يقظة الولد التي ترتبط بالبنت تنهل من عنصر الهواء أيضا، حيث يريد أن يكتب عنها فيحاول أن يغير أبعادها في الفراغ لذا يحلم: “سأجعلها حدباء… نعم تمتلك قتبا على ظهرها، وسأطلق عليها اسم أزميرالدا.. ثم يقع في حبها أمير، أو فارس، أو أحد النبلاء، عندما يكتشف قلبها الكبير… لن أجعلها دميمة بشكل بشع، ستكون مليحة الوجه واللسان، فقط هذا القتب الذي تنوء بحمله.. وسيكون مناسبا أن تعمل عازفة بيانو، أو مُدرسة رسم لأبناء الأثرياء.. توقف الولد عن أحلام يقظته، عندما وجد عيون البنت في عينيه.” (ص 18)
وعلى الرغم من أن البنت تلوم الولد على صمته – والصمت ضد الكلام الذي يرتبط بالجريان والانسياب والتدفق إلى غير ذلك من ملامح عنصر الماء – فإنها لا تلتفت إلى أن الكلام عنده لا يكون نطقا بل يكون كتابة، لذا ترتبط أحلامه بالكتابة، ولنلاحظ أنه يمارس ذلك الفعل أو الحلم في الفضاءات المفتوحة.
ولنقارن تلك الصور بالصور المرتبطة بالبنت التي يرتبط الشعر لديها بالطيران والكتابة، لكن الكتابة هنا لا تمتح من عنصر الماء، بل من عنصر التراب، فهي نقوش محفورة تغوص في الأعماق ولا تكاد ترى عبر السنوات، وتنكشف شفراتها حين تتفاعل البنت مع ذاتها، إذ تستبطن طلوع الشمس وانسراب الموسيقى في الأثير حولها، وحين تحلم البنت بالطيران كانت طلعة الشمس بالخارج باهرة: “بعد يومين من احتجابها وراء غيوم سوداء خيمت على المدينة، وأسقطت أمطارا غزيرة، من خلال باب الشرفة المفتوح، كان يدخل نور ودفء، وأصوات تلاميذ عائدين من المدرسة. كانت البنت تشعر بأنها منتعشة، وخفيفة جدا، لذلك أخذت تردد من حين لآخر، مقاطع من الأغنية مع صوت محمد منير المنبعث من الكاسيت، وفكرت أنها بعد أن تنتهي من تمشيط شعرها، ستصنع فنجانا من القهوة، وتتناوله في الشرفة وهى تبص على الشارع، وربما تعزم زميلتها في الحجرة المجاورة، ثم قالت لروحها: هل هل من الممكن أن أصرح الآن بأنني سعيدة ؟ كانت تبص على المشط الخشبي، وتحديدا على يده المنقوشة بزخارف متداخلة مع بعضها، حتى هذه اللحظة، كانت تعتقد أنها مجرد أوراق نباتات، وحروف متفرقة، حُفرت على اليد الخشبية بغرض الزينة، لكن تحت الضوء الساطع للشمس، والموسيقى التي ملأت المكان حولها، وإحساسها الذي وصل لدرجة الإيمان، أنها تستطيع التحليق في فراغ الحجرة لو أرادت، من خلال ذلك، شافت المكتوب على يد المشط بشكل واضح، في الأول برزت كلمة عيون من وسط الزخارف، ولما دققت قليلا، استطاعت أن تفك الحروف المتعانقة، قالت البنت وهى تقرأ: إن العيون التي في طرفها حَوَر قتلننا ثم لم يُحيين قتلانا.” (ص ص 34- 35)
ولعل التحولات التي تطرأ على الولد في الفصل الثامن تكشف عن تخلق جديد لأحلام يقظته، لترتبط بالتراب والهواء؛ بالملمس المتثبت وبالتحليق الحالم: “أخذ يروح كثيرا إلى محل الحلويات، يلقى نظرة سريعة على الأرضية النظيفة، والسقف العالي، والصور الفوتوغرافية القديمة، المعلقة في كل مكان، والتي كان مهووسا بتأملها، مستمتعا بروائح الحلويات السابحة في الفراغ، والتي تجعله دائخا لبرهة، ثم ينظر إلى البنات الهادئات، المرتديات الزي الأبيض، قبل أن يتقدم إلى إحداهن، ويطلب بسبوسة أو كنافة، لم يكن يعرف إن كان ذلك تعويضا، عن إهمال الأربع سنوات الفائتة، أم لأنه يحب الحلويات فعلا.” (ص ص 41- 42)
ونستطيع أن نلاحظ أن نقطة الضعف لدى الولد هي انتماؤه جماليا وخياليا إلى عنصر الماء: “قالت: ارم بياضك. قالت: أحب العملة البيضاء لا الصفراء. قالت: قلبك رخو.. بُص.. قطعة من الإسفنج، ستعصرها حبيباتك بقسوة.” فانيليا، ص 40 ولعل التفاوت في عناصر الرؤية الحلمية لدى الولد والبنت هو ما جعل تلاقيهما وتكافؤهما أمرا بعيد المنال: “كانت تمتلك شعرا أسود، وعينين ساحرتين، وشفتين يقطر منهما العسل، وصدرا يفوح برائحة الجوافة، وأقداما غضة مثل الأطفال. أما يدها فكانت نحيفة، وصغيرة بدرجة مدهشة، والله العظيم نحيفة، وأصابعها رقيقة جدا، تشبه يد البنت التي تشتغل في محل الحلويات، وتفوح من جسمها رائحة الفانيليا، لكنها في نفس الوقت، كانت قادرة لأن تحتوى في قبضتها، على قلب من الإسفنج، وتعصره بلا شفقة حتى آخر قطرة.” (ص 42)
وإذا رجعنا إلى الكابوس الذي يهاجم البنت باستمرار لوجدناه يصور بشرا يليق بها أن تكون من بينهم، فهم حفاة يتأرجحون في الهواء على وجوههم الرضا والسكينة والارتياح. إنهم أناس تنتمي إليهم وينتمون إليها من خلال المشاركة في عناصر بناء المتخيل: “تجد نفسها تمشى في شوارع خالية تماما، فقط أوراق صحف قديمة، وأكياس، وقطط عرجاء، وأعقاب سجائر، تعبر الإسفلت في تكاسل. وعلى ناصية كل شارع جثة معلقة في حبل من ليف، تتأرجح في الهواء ببطء، كانت لرجال ونساء وأطفال، بيض وسمر وشقر.. أثداؤهن وأعضاؤهم الذكورية تتدلى لأسفل، كانت جثثا طازجة.. يبدو وكأنها مشنوقة منذ قليل، بعضها كان عاريا تماما، والبعض يرتدى ملابسه الكاملة، إلا أنهم جميعا كانوا حفاة… وعلى وجوههم ترتسم السكينة ويبدو الرضا والارتياح.” (ص ص 61- 62)
لكن هذا الحلم نفسه يتحول إلى صورة مختلفة حين يمس خيال الولد؛ إذ يجعله أكثر اقترانا بالماء: “بالتأكيد سيفكر الولد كثيرا، وهو يشرب قهوة ما بعد العصر في تلك اللوحة، متناولا بين كل رشفة وأخرى حبة تمر.. قلب ضخم، سحابة عملاقة تغطى سماء المدينة، ذات الشوارع المتربة، والأدخنة السائرة في الفراغ، وبشر لهم جلود لزجة، وعيونهم متعلقة بالسحابة الراسية فوقهم.. نتفة القطن الحبلى بالماء.. كان يود أن يرسمها، يعرف تماما أين يضع ضربة الفرشاة، وكثافة اللون.. متذكرا هذا الحلم الذي حكته له أكثر من مرة، ويطاردها من سنوات، حيث تجد نفسها تمشى في شوارع خالية تماما، فقط أوراق صحف قديمة….” (ص 61)
ليس غريبا إذن أن يفتتح أحد فصول الرواية (العاشر) بصورة الطيور التي تحلق فوق البنت والولد، وفي الوقت الذي تنشغل البنت فيه كثيرا بحلم السفر قرين الطير، تبدو عينا الولد متعلقة بلوحة ثابتة تبعث بأضوائها التي لا تلبث أن تقترن بالماء على هيئة الدم: “كان هناك الكثير من الطيور التي تشكل سربا، وهى تعبر في السماء من فوقهما، وعلى فترات متقاربة تطلق صيحات عالية، خمنت البنت أنه ربما يكون إوزا مهاجرا. الطيور كانت مرتفعة جدا ومتقاربة من بعضها، لدرجة خُيل لهما، وكأنها طائر واحد عملاق، أخذ يلف بانسيابية وخفة في دوائر، بشكل بدا غير مفهوم، قبل أن يبتعد مختفيا تماما.
كانت البنت تبص من شباك بيتها المطل على الشارع، بينما وقف الولد بجوارها، يرقب لوحة إعلانات ضخمة، فوق سطح العمارة المقابلة، ظلت البنت واقفة بجوار حافة الشباك، وهى تتأمل الظلام الخفيف، الذي بدأ يحل بشكل سريع في الخارج، وفى نفس الوقت الذي أضاءت فيه لوحة الإعلانات، مرسلة نورا متقطعا، متعدد الألوان، قالت: أفكر بجدية في السفر، لا أعرف إلى أين ؟ كانت قد اتصلت بالولد، وقالت إنها مخنوقة، وتحس بوحشة شديدة، وترغب في الكلام مع أي شخص.” (ص 47)
لكن حلم التواصل ينقطع إذ يتكشف للقارئ أن الشخصيتين تنهلان من منهلين مختلفين: “كانت لوحة الإعلانات بالخارج، ترسل من خلال الشباك المفتوح، دوائر من النور الأحمر، تومض على جدران وأرضية الحجرة المظلمة، وأيضا على وجه البنت المتربعة على الكنبة، والذي يصبح لحظتها في لون الدم، قالت بعد صمت قصير: أرغب في السفر إلى أي مكان في الدنيا.. أي مكان.” (ص 49)
وحين يحلم الولد بالتواصل مع البنت نراه يسعى إلى الانتماء إلى الرحم والاندغام في الآخر، وهو ما يعوقه وعي البنت بحضور الموت وهشاشة العلاقات الإنسانية الزائلة. تنفصم عرى العلاقة بين الولد والبنت إذن بسبب الهوة الفاصلة بينهما على مستوى الوعي بالزمن والموت، وعلى مستوى عناصر التخييل: “يفكر منذ فترة في الالتصاق بها، بجلدها الذي يدوخ من رائحته، يلتصق أكثر.. وأكثر.. حتى تخترق جذوره مسامها، وتصل إلى الأوردة والشرايين، آخذا في التحور، مكونا ثديا ثالثا صغيرا، أو يدا زائدة، أو “خالا” فوق بطنها تحت السرة تماما، أو جنينا قابعا في رحمها. ضحكت البنت عندما أخبرها الولد برغبته تلك، قالت: لكن جلدي مالح، احذر.. سوف تموت.. عندها رفت فراشة في الفراغ الفاصل بين وجهيهما، حطت قليلا على راحة يدها النائمة على المنضدة، ثم حركت جناحيها، وواصلت الطيران، تابعتها بعينيها في اندهاش حتى ابتعدت، ثم بصت على رؤوس العمارات العالية، المحيطة بهما، قالت في حيرة: من أين أتت؟.. مسكينة.. هى أيضا سوف تموت بعد قليل.. كل الأشياء تموت.” (ص ص 62- 63)
وهكذا تكون القطيعة في التواصل بين الولد والبنت التي تعلنها نهاية الرواية تجد التعبير عنها في صورة المدينة التي تأكل ساكنيها، لأنها تخلو من الميادين الحاملة لأحلام البنت وخيالاتها، فهي تمثل متاهة، إذ إنها شوارع تفضي إلى شوارع، ومن ثم حُقّ للبنت أن تقول له “مدينتك تأكلني”. فكأن اختلاف الوعي بالفضاءات يمثل أحد الأسباب الجوهرية لانقطاع التواصل بينهما؛ فهو وعي بفضاءات الوجود ذاته لا بالفضاء المكاني المتعين في الواقع المادي.
الأسماء ومصادر التخييل
إن التحليل الظاهراتي وحده قادر على كشف قيمة كلمة “فانيليا”. إنها الحضور الرهيف والغياب الفذ معا. وهي لا تحتاج إلى تبرير لتكون عنوان العمل، إذ يكفي أنها لدى الكاتب رمز مباشر للأنثى، وهذا ما يصرح به في شهاداته. وهو أمر لا يحتاج منه إلى برهنة على جوهريته وصدقيته. كلمة “فانيليا” تخلق لدى المتلقي شعورا بالجسد والروح معا، ولا يخلو حضورها من سحرية. من أين تأتي الفانيليا؟ وكيف تصير على ضآلتها صاحبة الصوت الأعلى في كل حضور مادي مهما كانت كثافته. لكنها تحتاج فحسب إلى حضور الماء أو الهواء، ومن ثم تتسلل بخفاء ليصبح لها الجلاء الكامل والحضور الأتم. إنها الأنثى تحضر في غيابها، وتغيب عند الحضور، لأن لها البهاء الأكمل والترفع البهي.
يغضب الولد لأنه اكتشف أنه لم يسبق له الالتفات إلى وجود محل حلويات في الشارع، إلى أن جاءت لحظة كاشفة. تظهر كلمة فانيليا للمرة الأولى مقترنة بهذا البزوغ المباغت لمحل الحلويات أمام وعي الولد. إنها بالضبط لحظة الاكتشاف الحميم للأنثى، وهنا ينتبه الولد إلى شعرية الهواء والتراب؛ إلى جمالية الوجود الأنثوي: “توقف الولد على الرصيف، بالضبط قدام المحل ذي الواجهة الزجاجية الصغيرة، وهو ينظر إليه، في البدء وصلته الرائحة، رائحة الفانيليا، والبسبوسة الساخنة، والمكسرات، ثم رأى علب الشيكولاتة التي على شكل قلوب ودوائر، معروضة خلف الزجاج. قال في سره: محل حلويات! ثم مشى.” (ص 39)
ولعل العنصر الذي يجمع بين الولد والبنت يتجلى في الحضور الكثيف للفانيليا، سواء أكان حضورها في الحلوى ليشحذ وعي الولد فينتبه إلى جدلية الحضور والغياب، أم كان حضورها في الجسد الأنثوي بوصفها المعادل الموضوعي له، أو بوصفها كناية عن الأنوثة أو تحقق الحضور والغياب معا.
تبقى الإشارة إلى أن الرواية تبدأ بملمح جسدي في الشخصية المحورية، لكن خيوط السرد يجذب بعضها بعضا لتتشكل ملامح الشخصية ونتعرف طبيعتها وطبيعة الشخصيات الأخرى التي تتفاعل معها، لكن ذلك كله يبدو محتفيا بالتفاصيل الصغيرة من غير أن نتمكن بالإمساك بكثير من الأحداث التي تصنع حكاية تملأ الأذن؛ فهي بالأحرى رواية تشكل صورا لتخاطب العين نافذة إلى عمق المخيلة. وفي أثناء ذلك كله نجد شخصيات منمذجة، لا بمعنى أنها نمطية معتادة بل بمعنى أنها نماذج إنسانية قد تنطبق على أفراد عديدين أو قليلين، من غير أن تنشغل الرواية بإيهامنا بواقعية تلك الشخصيات. إنها شخصيات احتمالية يصنعها الشعر، وقد يحاكيها الواقع، وهكذا نجد البنت والولد ورجل الجنازات … إلى آخر تلك الشخصيات، من غير أسماء يعرفون بها.
إن تجريد الشخصيات من أسمائها تزكية للخيال؛ إذ تبدو البنت على وجه الخصوص نمطا للتواصل مع العالم وفهم حقيقته وتمثل أسراره المادية والحركية عبر الخيال. وإذا كانت الرواية تقدم البنت بوصفها تجليا على سطح المرآة الصقيلة للولد، فإن هيمنة خيالات الأنثى والحضور الطاغي لها يؤكدان أن الرواية في عمقها تقدم الولد بوصفه مظهرا عابرا لجوهر الأنوثة، وأنه مرآة لتلقي حقائقها إذ تتنزل عليه، فإنما الولد مجلى لصفات الأنثى وبه تتكشف حقائقها.
ــــــــــــــــــ
شاعر وأكاديمى مصري