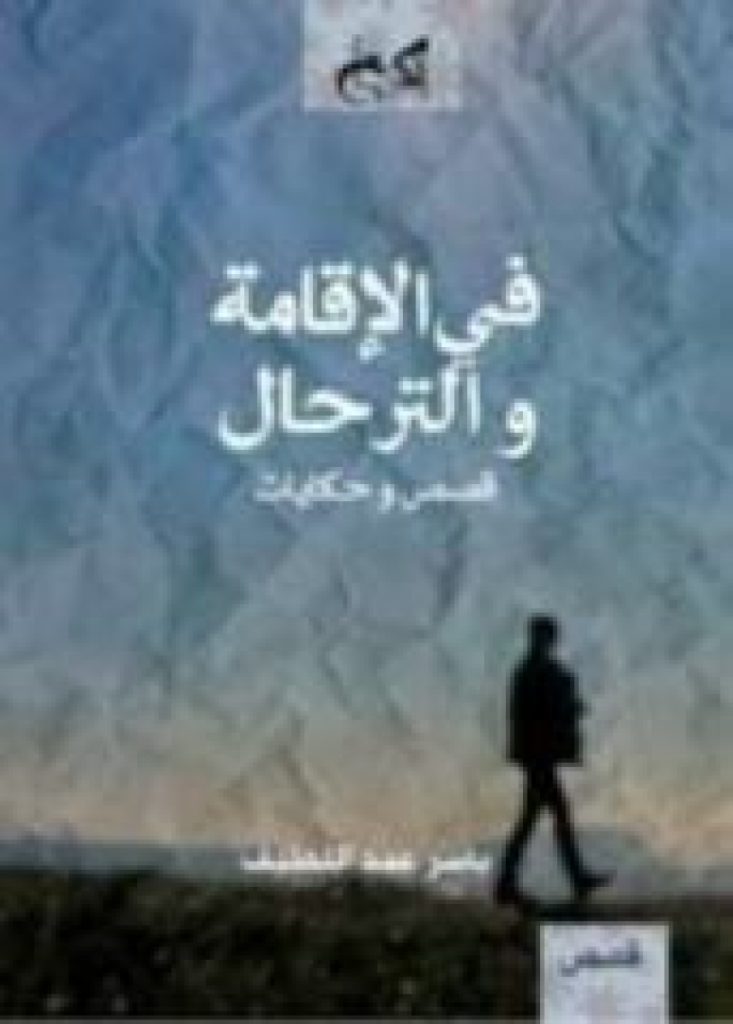“وكان أملي في يوم أسلاك، وأفضّي م الهوا كاسي..وأفضي م الهوا كاسي”.
“إذاعة أم كلثوم” كانت فيما مضى محطةً للأغاني، تبدأ بثّها في الخامسة مساءً على الموجات المتوسطة بأغنية طويلة لأم كلثوم، ثم تليها أغنية لعبد الوهاب ثم تتنوّع الفقرات، حتى تُختَتَم بأغنية أخرى لأم كلثوم تبدأ في التاسعة وتستمر لنحو العاشرة. لسنوات ظلّ الغموض يلفّ هذه الإذاعة. وكانت الأسطورة تقول إنها محطةٌ احتياطية أنشأها رجال نظام يوليو من باب “التأمين الإذاعي” حتى إذا استولى أي انقلابيين مفترضين على مبنى الإذاعة ـكما فعلوا هم عام 1952ـ تكون تلك المحطة جاهزةً لحرب المواقع. وتزيد الأسطورة فتقول إن مكان بثّها هو قصر عابدين!
للصمت صوت في المعادي. في ذكرى تعود لعام 1993، لبداية العام تحديدًا، كنت قد عدت لتوّي من الإسكندرية مصابًا بإنفلونزا حادة. قضيت الأيام الأولى من ذلك العام في السرير بين حمّى وهذيان وسعال عنيف. في غياب شبه تام عن العالم. صحيح كان أهلي موجودين بالمنزل، وصحيح عادني الطبيب خلال هذه الأيام. لكن المرض كان قد صنع فقاعته حولي. في فجر اليوم الرابع استيقظتُ غارقًا في عرقي. ذهبت الحمّى وشعرت بنوع من الإفاقة الواهنة. كان المطر يهطل بغزارة ليلتها، ومع إحساسي بما يمكن أن نسميه النقاهة، توقّف عن الهطول. سمعت تساقط القطرات الثقيلة العالقة بشجر الفيكس الكثيف خارج نافذتي وقد غسلته الأمطار من أتربته المقيمة. وسمعت صوت دراجة تسير، خشخشات وطئها للأوراق الميّتة، والصرير البطيء لعجلاتها وتروسها من حركة راكب يُبدِل في تثاقل. خلته رجلاً مسنًا عائدًا في الفجر. من أين وإلى أين؟ كان ذلك الصوت هو أول إشارة آدمية تصل حواسي منذ أيام. كأنّه شفرةٌ صوتية تلاقت مع دبيب الحياة في جسدي بعد غيبوبة المرض.
ويطلق المترو جرسًا قصيرًا يعلنعن إغلاق الأبواب أتوماتيكيًا، ثم صافرةً تعلن مغادرة المحطة الحالية. أربع دقائق في المتوسّط بين المحطة والأخرى × ثماني محطات بين الضاحية والمركز، بالطقطقات الشهيرة للعجلات على القضبان، بحساب الفلنكات، والذهن شارد من النافذة يعبر جسرًا صوتيًا من مجال لآخر.
ستظل لي رحلة شبه يومية، من المعادي لوسط المدينة. أعود لـ “مواطن الصبا” كما يقولون. أسكن في المعادي بجسدي وبعض روحي، ومعظم روحي في وسط المدينة. قبل احتراف الكتابة وارتياد مقاهي المثقفين. كنت أنتبذ وصديق لي من الحي القديم مقهى صغيرا بباب اللوق، عمارة أنور وجدي، يُعرف بمقهى “فتحي”. هناك سأتعلّم من بعض الرجال المسنّين الإنصات لصوت أم كلثوم في الوصلة الليلية، وسأتعلم الربط بين احتساء القهوة وتدخين السيجارة، ارتباطًا شرطيًا. باختصار، سأتعلّم فنون “المَزَاج” البريء على الطريقة المصرية التقليدية: قهوة، وسيجارة، والاستغراق في صوت أم كلثوم حتى الانتشاء طربًا. سيستمر برنامجي الدراسي بمقهى فتحي طيلة أربع سنوات، وسينخرط صديقي في دائرة لعب الورق “على المشاريب” مع الزبائن الكبار. ولما لم أكن من المستمتعين بلعب الورق أو أيّ من ألعاب الطاولة، فقد تُرِكتُ للإذاعة والتأمّل. ومع تسرّب وحش الملل، ستنقطع علاقتي بالمقهى، وتخفت تدريجيًا علاقتي بصديق الحي القديم. لا شكّ أن لعب الورق مع الزبائن وانهماكي في “السماع” كان يعطيني وصديقي شعورًا وهميًا بالنضج، كنا في نحو الرابعة عشرة. وعندما زرت مقهى فتحي، بعدها بأعوام، في منتصف التسعينيات، في العشرينات من عمري كان معظم زبائنه من العجائز قد رحلوا.
في طبقة أخرى من الزمن، سترتبط ضاحية المعادي عندي باكتشاف موسيقى “الروك آند رول”.
كنا مراهقين في حالة غضب على القيود المدرسية الصارمة، نُعبِّر عن ذلك بالتدخين عند أطراف ملعب الكرة، ولدى الباب لحظة الانصراف. ثم سيتطوّر الأمر لمعاقرة المخدّرات كرد فعل جذري على سلطة أبوية وأمومية كنا نبالغ في حجمها. وينتهي الأمر بنا إلى تعميق العزلة النفسيةفي إطار المجموعة المغلقة من الأصدقاء، لتأخذ تلك العزلة طابعًا جغرافيًا مرتبطًا بانعزال الضاحية عن جسد المدينة واكتفائها بنفسها. وربما هنا تحديدًا كففت عن الذهاب لمقهى فتحي، وانقطعت نسبيًا علاقتي بـ”وسط البلد” وصحبته. وتحضرني هنا الأزمنة في تعاقبها، عندما أحاول أن أُفَصِل حساب السنين.
ما يجذب في الروك آند رول هو الإيقاع بمعنى Beat وليس بمعنى Rhythm. الدق القوي والواثق والعنيف أحيانًا للطبول يلاقي ما هو جوهري في روح المراهق. لاسيّما وقد وضع في الإطار المناسب: ضاحية ذات ثقافة تحاول أن تكون غربية ومنعزلة جغرافيًا. لو عدت بالزمن لأعوام 1985 و86 و87 لسمعت تلك الموسيقى تتردّد في زوايا الشوارع الهادئة، وتنساب من نوافذ غرف نوم الشباب المعلّقة على حوائطهابوسترات لبوب مارلي يلف سيجارةً ضخمة من الماريجوانا، ومن السيارات المتوقفة بميادين خاوية، بداخلها شباب يدخّنون وقد استغرقوا في الإنصات.
ذلك العنف الكامن، والتمرّد العشوائي ستصاحبه ممارسات شديدة الحماقة، كاقتحام المدرسة ليلا، وإضرام النيران في معمل الكيمياء، أو سرقة علم الدولة بعد قطع حبله وترك الصاري عاريًا في قلب الفناء.ثم يأتي بعد ذلك طورٌ عنيف من الاغتراب الوجودي، كالخواء الذي يعقب ارتكاب الجريمة. الوحدة وفقدان القدرة على التواصل مع العالم، خاصة الحياة اليومية بشكلها المبتذل، كأننا بصدد مُثُل عليا لا تجد مخرجًا، أو لا تستطيع التعبير عن نفسها سوى بالسلب.
Kicking around on a piece of ground in your hometown
Waiting for someone or something to show you the way.
تلك الجملة من أغنية “تايم” لـ “بينك فلويد” ستصاحبني في سنوات التجوال بلا هدف في المعادي، وقطعها من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. تتردّد تلك الأغنية بمقدّمتها الموسيقية الشهيرة في أذني عبر سماعات “الووكمان”. أسير حتى يهدّني التعب، أمرُّ على جسور المشاة التي تعبر شريط السكة الحديدية، أشاهدُ كتابات نقشت ببخّاخات الطلاء على حديد الجسور: “هذا كوبري سِمَري” أو “المعادي كلها مؤخرتها حمراء” أو “مخدّرات مخدّرات إحنا بتوع المخدّرات” أو “زمن الصلايب” في إشارة لحبوب الريهايبينول المخدّرة التي كانت تعرف بأبي صليبة، وتعليق طريف يستلهم أغنية مغناجة لصباح يقول “ذنبك إيه.. ذنبك بحبك”. كان الحبُ قد صار أمرًا خرافيًّا. والذات تبحث عن التشكّل في هذا السديم الثقافي لنهاية الثمانينيات. في العتبة التالية مباشرة، دخلتُ الجامعة، وتم افتتاح مترو الأنفاق، بعد أن كان اسمه قطار حلوان، تحديدًا في أكتوبر 1987 سأتم عامي الثامن عشر.
رحلة إلى حديقة الحيوان في الطفولة المبكرة… بركٌ وبحيرات لأفراس النهر وسباع البحر والتماسيح، ماؤها أخضر يميل إلى البنّي تحسّ قوامه ثقيلا كالزيت. ورائحة قوية تسيطر على المكان… من مكان بعيد يترامى إلى أذنك الصغيرة قرعٌ متوالٍ لطبول. يتردّد كل بضعة دقائق. ستجوبُ الحديقةَ كلها بحثًا عن مصدر الطبول: هل هو بائع يعلن عن بضاعته، أم هي جماعة من الشباب يعبّرون عن سعادتهم بأخلاقيات مختلفة للنزهة؟
تبدو لي أم كلثوم أكثر من مجرد مغنّية، هي طريقة موسيقيّة بالمعنى الصوفي للكلمة، مدرسة بالمعنى الفني، سأتعلّم من خلالها التنقيب في التُراث الغنائي المصري، بعدها وقبلها وفي أثنائها. وستتفرّع اهتماماتي في مرحلة لاحقة لتطال ما تم تهميشه من هذا التراث عبر مؤسّسات تشكيل الذوق. ما يجمع موسيقى أم كلثوم في ذائقتي بــ “الروك آند رول” هو عمق الإيقاع المعزوف بالوتريات. الكونتر باص لدى الأولى والبيز جيتار في الأخير. طنين يتوازى مع نبض القلب، سأحاول طوال الوقت أن أقارب وأقارن بين خطّه وخط اللحن الأساسي. كأنه تجريد له، هيكل عظمي لقوام الميلودي. وسأظل في ذلك الجدل بين المعادي ووسط البلد حتى أغادر القاهرة دون علم متى أعود.
الأفق شاهقُ البياض من الثلوج، والبيوت رماديةٌ بأسقفٍ بنّية مائلة، لا من قرميد وإنما من مادة صناعية أخف وزنًا وأرخص ثمنًا. يمتد المشهد هكذا لأميال في هذه الضاحية التي أقطنها بأكبر مدن الغرب الأوسط الكندي. أقف في النافذة أرقب نجيمات الثلج تتكسّر على الزجاج. لا أحد يمر سوى أرنب أبيض ضخم. الأرانب هنا هي قطط الشوارع. الهدوء التام في هذا الخواء السيبيري مسكونٌ بأصوات باطنية: طنين جهاز التدفئة المركزي تنساه، ولا تكاد تشعر به. وتتوهم أنك بصدد صمت مطبق، لكنك لن تتبيّن الضجيج الذي يقطن رأسك إلا عندما يصمت الجهاز عند تشبّع الغرف بدرجة الحرارة المطلوبة، ليعاود طنينه بعدها بدقائق فتعاود نسيانه ولا تتذكره إلا عندما يصمت في استراحته التالية. في ذلك الصمت المشحون. أستعيد حوارات قديمة لم تنته، أُنهيها على النحو الذي كان يجب أن تقفلَ عنده. وتتداعى صور وأطياف لمناطق من الماضي ظننتها قد بادت. تمرق كانقلابة مفاجئة في الذهن، ثنية أو عقدة في مسار التفكير ما تلبث أن تخبو، وتعود من حيث أتت، ليعود الذهن لمساره، ويعود للحياة اليومية مذاقها الواقعي.
أطهو في المساء الفول المصري بدَقّة الثوم والكمون، وأنتقي من على جهاز الكمبيوتر أغنية مناسبة لطقس الحنين: “هجرتك يمكن أنسى هواك”. عندما سافرتُ، كان يصعُب عليَّ الارتحال بأشرطتي وأسطواناتي المفضّلة، فشحنت جهاز الكمبيوتر المحمول بـ 16 جيجا بايت من خلاصة تربيتي الموسيقية. وفي مكالمة تليفونية من قارة أخرى سيخبرني صديقي نقلا عن أصدقائه الموسيقيين، أن صيغةmp3 المستخدمة في حفظ ملفات الموسيقى على أجهزة الكومبيوتر إن هي إلا موت محقّق للموسيقى في نهاية رحلة تطوّر الوسائط، إذ أنها تُقلص حجم الملف إلى أقصى درجة حتى لا يشغل حيزًا كبيرًا في الذاكرة الرقمية، فتضيع بذلك آلاف الذبذبات الدقيقة التي من دونها تفقد الموسيقى عمقها الصوتي.
قلت له: لكني لا أشعر بأدنى فرق عند السماع.
قال لي: أنت تستمع إلى شبح الأغنية وليس إلى الأغنية نفسها!
قلت له: هل تقصد أن أرشيفي…
قال: نعم، أرشيفك ميّت!
كان الوصف بالغَ القسوة، لكني تعوّدت ألا أدع المجازات تلتهم مزاجي ولو استندت إلى أكثر الحقائق علميةً. رائحةُ تقلية الثوم تتصاعد في فضاء الغرفة الكندية، والسيدة تردّد “وأفضّي م الهوا كاسي.. لقيت روحي في عز جفاك.. بفكر فيك وأنا ناسي” ومن مكان قديم في الذاكرة شممت رائحة الخبز الفينو الساخن وحي عابدين.
ــــــــــــــــــــــــ
من كتاب “في الإقامة والترحال” يصدر قريباً عن دار الكتب خان