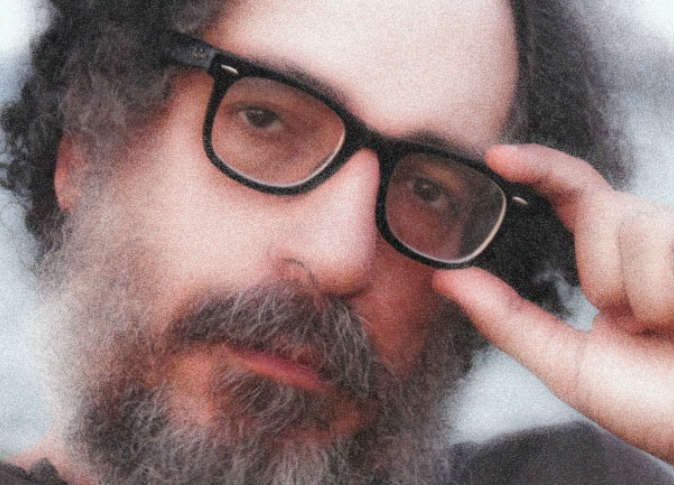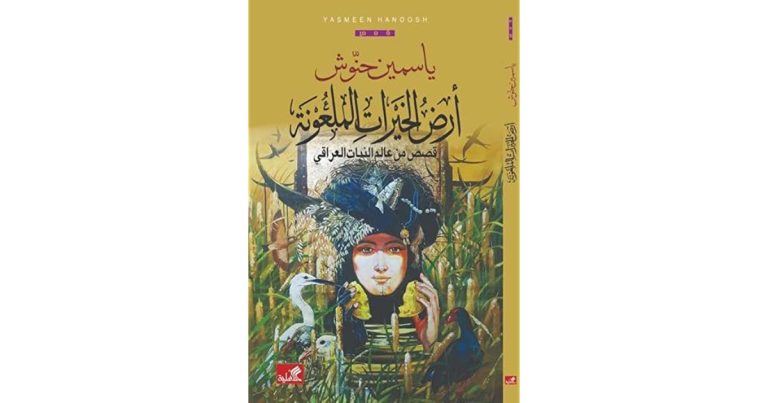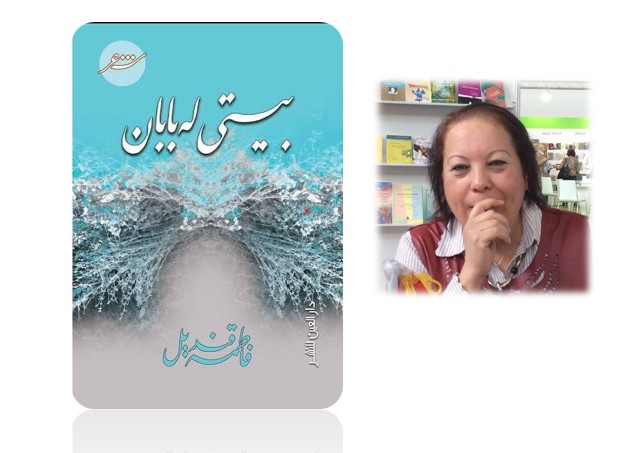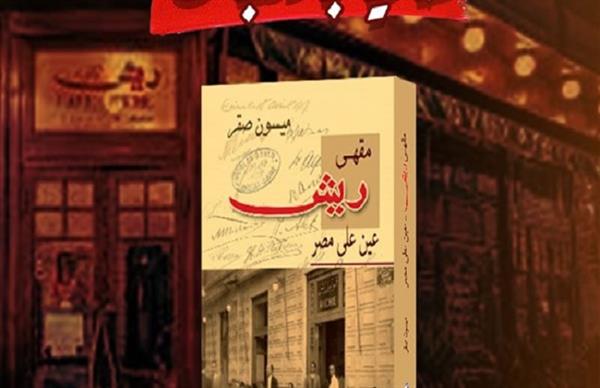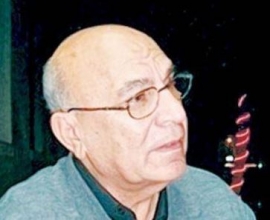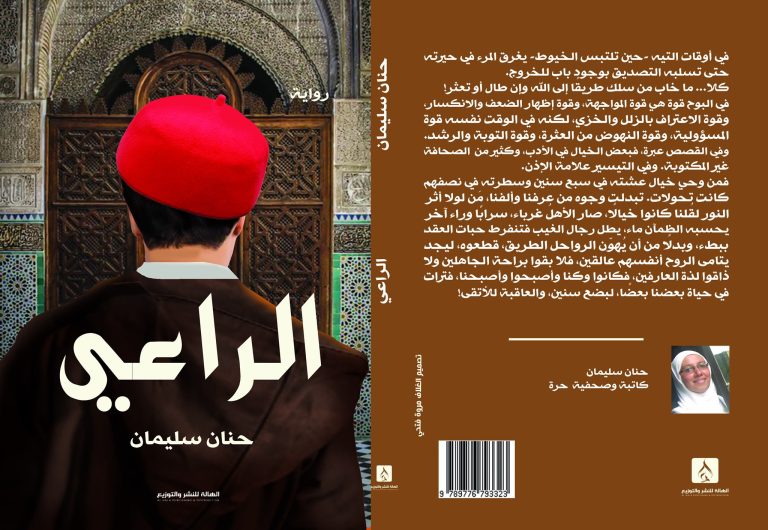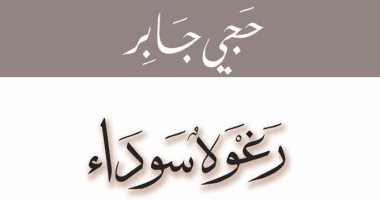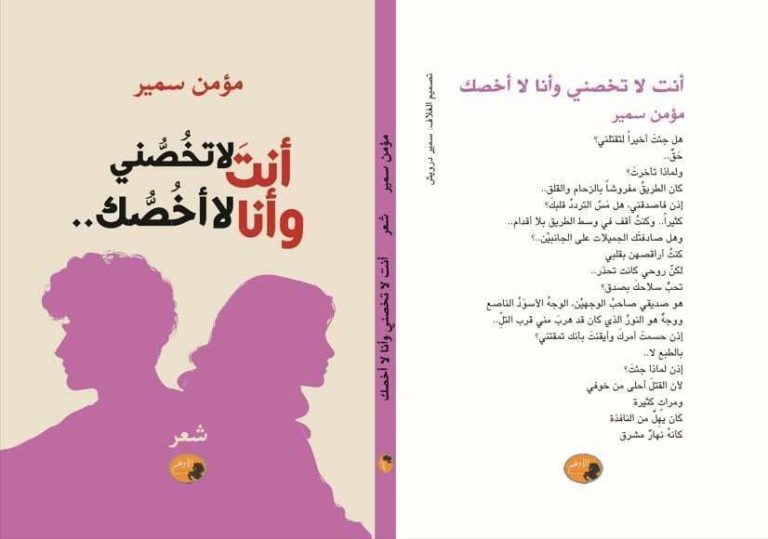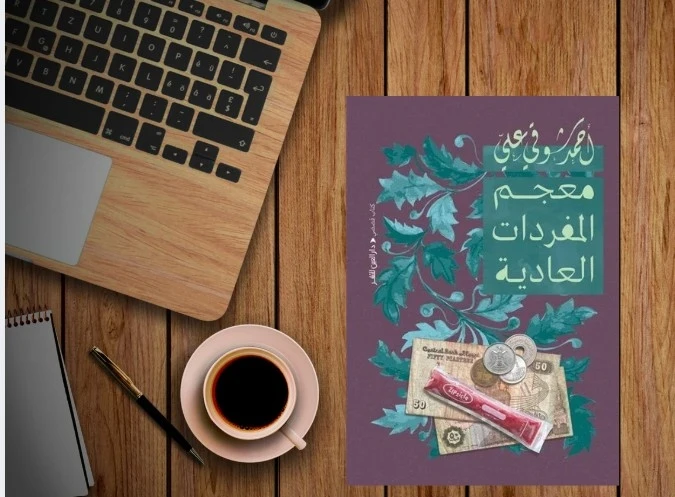نرمين يسر
بدون مقدمة تفصح ولو قليلا عن محتوى الرواية الذى بدا غامضا من خلال كلمة الناشر على ظهر الغلاف، والتي تكشف لك عن جزء ضئيل من فحوى الحكاية بين يوسف الصغير الباحث عن إعالة أسرته، وبين شخص يوسف الكبير الذي يبحث عن الخلود، نشرت دار الآداب أحدث مؤلفات الكاتب أشرف الصباغ تحت عنوان يرفع هامته بثقة “شرطي هو الفرح”.
يقتحمك صوت الراوي منذ الصفحات الأولى للرواية من خلال إلقاء الصدمات المتتالية والمكثفة التي تناقش- تقريبا- شتى الموضوعات التي تستحوذ على تفكير المصريين في الفترة ما بين ثورة يناير وحتى كتابة سطور الرواية التي تبدأ باحتضار أمه، حيث يلتف من حولها الأبناء والأحفاد، توصيهم بما يدور في نفسها قبيل مغادرتها عالمهم. وينتقل الكاتب في قفزة خلت من الارتباك إلى المستقبل حيث يظهر واحد من أحفاد الجدة “يوسف” في أحد حانات وسط القاهرة وتدور الحوارات المختلفة التي تتعرف من خلالها على آراء رواد الحانة من كتاب وصحفيين وموسيقيين وتجار أقمشة وحرفيين، إلى آخر الفئات المختلفة من زبائن الحانات. لم يغفل ضرورة تواجد شخص يبدو كما لو أنه من أصول أجنبية عاشق لمصر ويرفض مغادرتها. هنا يطرح الكاتب القضية الأرمنية من زاوية خاصة جدا، وبسيطة، عبر معاناة البطل التي لا تختلف كثيرا عن معاناة “عم أرمين سارويان” الذي لم يعد له سوى مصر. ومن خلال الحوار الذي يحمل قدرا من الكوميديا والسخرية والألم تتكشف الجوانب الإنسانية، سواء للشخصيتين– يوسف وأرمين – أو للعذاب الأرمني الذي لا يزال يدمي الضمائر.
أما عن المرأة، فينتقل الصباغ بين حكايات نسائية من القاهرة متمثلة في فتاته أو صديقته أو حبيبته، تلك المرأة القوية والجريئة، التي تقتحم عليه البار بعد أن غاب عنها كعادته. وتتعدد الحكايات والمواقف، ويتسع السرد عبر لقائهما ليدخل إلى مناطق أوسع وأكثر رحابة في أجواء من الرومانسية التي لا تخلو من طرح الاسئلة الوجودية من منطلق فلسفة المخمور الذي يثق بأنه يتحدث مع فتاته كما تحدث زرادشت، وبين ذكرياته عن صباه في القرية البعيدة وحبه واشتهائه. هنا تقفز محفوظة – حلم الصبا – ليس فقط إلى مخيلته بين الحين والآخر، بل وأيضا إلى المشهد الروائي. فهي أول من اتفق معه على تحدي الأساطير والمقدسات التي أرهقت الصغار وشتت رغبتهم الطبيعية في الحرية والعيش بعفوية. وبين تحدي الأساطير ومواجهتها، وبين أسطرة الواقع، يخلق الصباغ أسطورته الخاصة.
تجرى الاحداث على هذا المنوال السينمائي من المونتاج والتقطيع والربط بين الحاضر الذي يدور في المدينة والماضي الذي قضاه بطل الرواية في الريف بدون إرباك، حيث تتكشف العلاقات المتباينة والفروق بين نساء الريف والمدينة أو بالأحرى نساء عائلته الذي نشأ بينهن، واللائي يشعرن بالقهر والمهانة معظم الوقت عن طريق تعرضهن للضرب والإهانات أو الإجبار على الزواج. وعلى الرغم من كل ذلك، تكشف لنا الرواية عن عالم دائم الحركة، تمارس النساء فيه العمل كجزء من وجودهن وكينونتهن. عالم رغم واقعيته، يحمل غرائبية ويثير الدهشة والألم في آن واحد. عالم يعيش الأسطورة ويحول الواقع إلى ساحة من الخيال بشخصيات قد نراها أو نسمع عنها، وربما تعاملنا معها في يوم ما. ولكنها هنا تشكِّل عالما سحريا دائب الحركة.
لم يجد يوسف ابن السابعة مخرج من حالة الضغط النفسي وفقدان الهوية سوى الاتجاه إلى تحدى الأساطير التي تقدسها القرية والتي تنص على وجوب الابتعاد عن الفرع الملعون من النهر، وعن الحرش الذي نسجت عقول سكان القرية حكايات مرعبة عنه. يجد يوسف الراحة والأمان في مقام سيدي الخراشي الذي يعد المُخلص والولي لأهل القرية. فيقوم بزيارته بعد السباحة في النهر واللجوء إلى الاختباء في رحاب مقامه قليلا قبيل الفجر. وقبل أن يقوم بمغامرته الأخيرة.
بين وسط القاهرة والبارات وحالات السكر ومناقشة الثورة والسلطة والإخوان، وبين حالته الداخلية وحوارته التي تخضع لمنطق الخمر، فيخضع لها السرد نفسه، وبين وصوله إلى القرية، يحكي يوسف حكايات كثيرة. يسرد جوانب من حياته وحياة أفراد أسرته، وكأنه يستعرض حياة أجيال متتالية عاشت وماتت تحت وطأة القهر والذل والعشوائية والتدين والاستبداد الأبوي.
يسهب الكاتب في سرد تفاصيل يوميات العائلة الكبيرة ومشكلاتها التي لا تنتهي، والتي يوضح خلالها تفاصيل حياة الريف وعاداته وتقاليده ومعتقداته، ورد فعل الأقارب المتفقين ضمنا على تلك الحياة وبالنهج نفسه. وخلال رحلة البطل من المدينة إلى القرية، يحكي يوسف عن العمل في ورشة تصنيع الكاوتش وفقدانه أصابع يده التي قطعتها الماكينة في شرح تفصيلي واف قادر على إقناعك بأن الكاتب لم يراقب عمال الورشة فقط لمعرفة تفاصيل وأسرار حرفتهم، بل إنه عمل معهم يدا بيد! يبدو ذلك من خلال طرح دقيق لطريقة عمل الماكينات وأنواعها المختلفة مثل كسارة الكاوتش والمكبس الذي يعمل بالبخار، مقرونا بالمصطلحات الحرفية الخاصة بصناعة الكاوتش وأسماء قطع الحجارة نفسها المستخدمة في هذا العمل.
يتطرق الكاتب إلى الخوض في عالم العمال القاسي، حيث يعيشون عند خط “الستر” ويتلقون رواتبهم أسبوعيا ولا يحصلون على إجازات بأمر رب العمل الذي يشبه الغالبية العظمى من أصحاب الورش والمصانع الصغيرة، وربما الكبيرة أيضا، في قسوتهم الواضحة وتحميل العمال فوق طاقتهم بالإضافة إلى أنهم – ملاك الورش والمصانع الصغيرة- يخشون حوادث العمال وتلقي مخالفات مكتب العمل التي من شأنها إغلاق الورش ومطالبة المالك بتعويضات مالية كبيرة.
عودةٌ إلى القرية، وتحديدا في الفصل الأخير من رواية “شرطي هو الفرح” والذي يعد من أكثر فصول الرواية ثراءا لغويا وبلاغيا، حيث يسافر بك الكاتب إلى أرض أخرى وألم آخر موازٍ لم تشهده أحلامك.. دنيا من الطبيعة البكر وأشجار تكاد تروي قصص العشق التي مرت بها، جسد يخلع ثوب الدنيا استعدادا للغوص في المنتهى اللا متوقع من نهر ظل ملعونا طوال العمر وإذ به الخلاص والنجاة.
قد يكون أشرف الصباغ وصف حانات القاهرة وروادها وجميلاتها في حالة من السرد المرتبط بحالته البطل النفسية وفي ظل تشابكات اجتماعية في مرحلة صعبة. وقد يكون وصف بدقة عالم العمال وخبايا الورش، وانتقل في سرد “ممنتج” بين الحاضر والماضي إلى عادات القرية، وصولا إلى نزعة صوفية في تقديس أولياء الله الصالحين والخوف من الحرش الملعون الذي يؤدي بحياة السابحين في مياهه إلى التهلكة. قد يكون فعل كل ذلك كروائي أو سارد، ولكن هناك أيضا ذلك المستوى الذي قام فيه بوصف تخيُلي سريالي لم يشهده بعد ولم يشهده أحد منا…. إنه وصف الجنة!
وفي نهاية المطاف، يقف البطل المحمل بكل الأساطير والعذابات والتناقضات، والذي يحمل كل مقومات الضعف الإنساني، والقدرة الجسدية، أو بالأحرى، الإحساس بالجسد وبقدرته.. يقف البطل أمام الاختيار الوجودي والمصيري ليختار ليس بالضبط بين فرع النهر الصالح والفرع الآخر الملعون، وليس بالضبط بين الضفة التي يقف عليها مقام “سيدي الخراشي”، والضفة الأخرى التي يقف عليها الحرش بكل ما يحوي داخله من أسرار، بل ليختار بين الخلود هناك، والوجود هنا. في هذه اللحظة فقط يبدأ يوسف بصنع أسطورته الخاصة التي ستحكيها القرية في ما بعد في الحكايات والحواديت.. عن الضريح الطائر الذي حلَّق في يوم من الأيام بفارس فضَّل الوجود على الخلود، فامتطى الأسطورة نحو الشمس بكل معانيها ودلالاتها، وكأنه كان يضع أقدامه على أول طريق الفرح، لينفذ بذلك، وفي تلك اللحظة تحديدا، وصية حبيبته التي قالت له: “شرطي هو الفرح”..