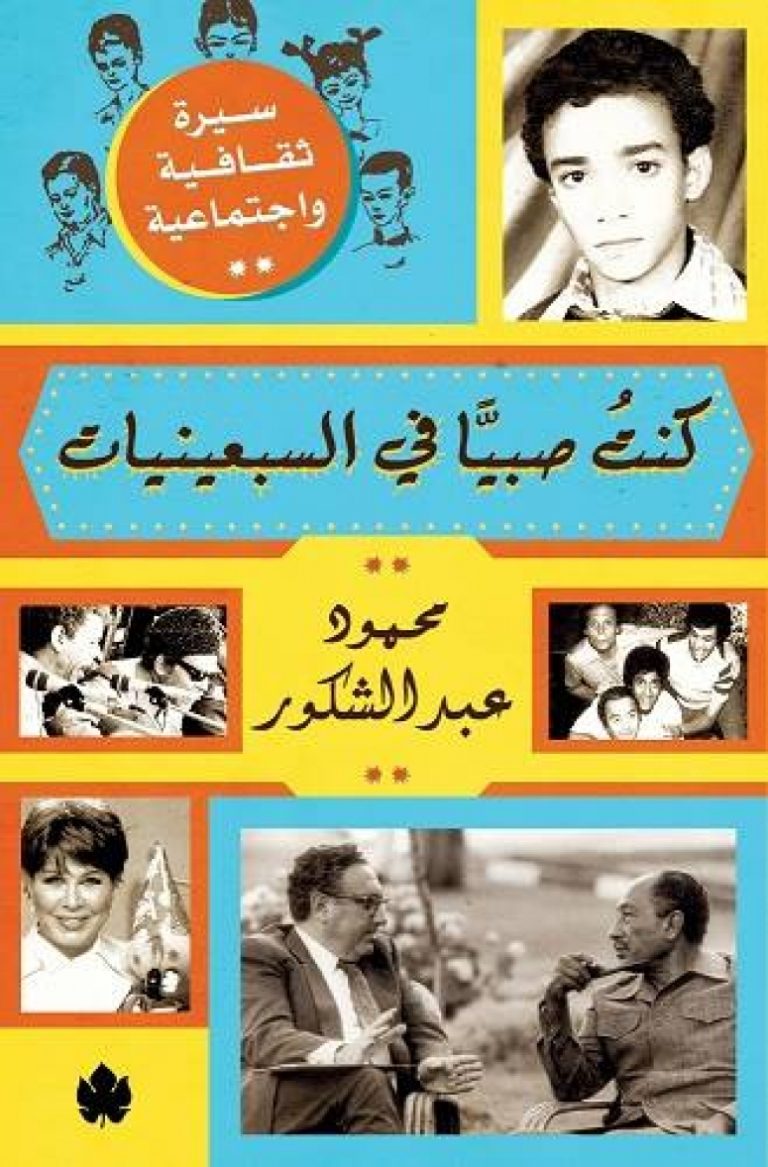ويبقى البحث عن الحب والعدل تيمة أساسية يدور في فلكها المشروع الإبداعي لعزة رشاد، ويمتد حبلا سُريا يربط بين رواياتيها “ذاكرة التيه” و”شجرة اللبخ”, رغم اتساع الفضاء الروائي وتعدد الشخوص المحورية في روايتها الثانية. تتمحور الرواية الأولى حول فتاة اختارت البحث عن أحلامها وتصدت لتقاليد لا ترى في المرأة سوى زوجة صالحة ووعاء للإنجاب، على خلفية أحداث سياسية امتدت من التهجير إثر نكسة 1967 وانتهت بسيطرة تيار الانفتاح الاقتصادي على حياة المصريين، وما أحدثه من تغيير في نسيجهم الاجتماعي وتكوينهم الفكري. يدور السرد من منظور الساردة بصيغة المتكلم، في تقنية استرجاعية تستعيد فيها أحداثا ماضية تمتزج بأصداء نفسية وفكرية، ليتحول قهر المجتمع للمرأة إلى مرآة لما يعانيه هذا المجتمع من غياب للحرية السياسية وسيطرة الصوت الواحد. تنتمي الساردة إلى أقرانها من “النجوم الشاردة” الباحثة عن التفرد وتحقيق الأحلام، إناثًا وذكورًا:
(ذلك هو سري معهم، ذلك هو شبهي بهم، أولئك الذين يجافيهم النوم ويبقون عالقين في سماوات الحلم البعيدة، لأنهم يمقتون أن يكونوا صورًا أو ظلالًا، لأن كلًا منهم يحاول أن يجد مساره الخاص، حتى لو ألقت به حقيقته الخاصة إلى أكثر الطرق وعورة… لأنهم حتى لو قيدت أطرافهم إلى الأرض تظل أرواحهم طليقة… لأنهم ينصتون جيدًا لأصوات أحلامهم، لأنهم رغم كل اعتزازهم بذواتهم وحيطتهم يتعثرون وينكفئون ثم ينهضون في الغالب، لذلك يراهم الآخرون سائرين على أذرعهم محلقين بسيقانهم في الهواء، ويظنهم البعض مجانين… لأنهم منذورون للحلم ومسكونون بالتساؤل يسمونهم النجوم الشاردة).
في روايتها الأحدث “شجرة اللبخ” تتعدد الشخوص، وتبقى “النجوم الشاردة” تهيم وراء البحث عن التحقق. تستخدم الكاتبة نفس تقنية السرد الاسترجاعية، ولكن يسيطر عليها صوت الراوي العليم المسيطرعلى دفة الحكي، وما له من قدرة خاصة على التفتيش في ضمائر الشخوص وقراءة أفكارهم، وذلك على مدى أربعة عشرة فصلا، يحمل كل منها اسم أحد شخوص الرواية، التي يتمحور حولها السرد في ذلك الفصل، كي تُحكى الحكاية من منظوره الخاص مختلطة بمشاعره وأفكاره. الشخوص جميعا تبحث عن الحب والعدل، ولكن تتعدد أساليب البحث وتتباين وعورة الطرق. يعود السرد إلى بداية القرن العشرين في مصر – عصر الاقطاع والاحتلال الإنجليزي والثورات الباحثة عن الحرية. تتوزع الحكاية متشظية على مدى الفصول الأربعة عشرة، فلا يستطيع القارئ فكاكًا من الرواية إلا مع نهاية السرد عند الصفحة 350.
يٌستهل السرد بمفتتح يصف فيه الراوي العليم قيظ يوم حار في قرية السوالمة – إحدى قرى بلبيس بمحافظة الشرقية – بينما يفاجأ المشيعون للجنازة بمن يخبرهم بطيران النعش، فيختلط الواقع بالتراث الحكائي الشعبي المتجذر في القرى المصرية:
(ظهيرة يوم حار، تقذف شمس “بؤونة” أشعتها الملتهبة عموديًا، فيتشقق سطح الأرض وينحني ظهر النهر الذي أوشك على الجفاف، وتتدلى أغصان الأشجار نحو الأرض مستسلمة لمصيرها، ويتفصد العرق فوق جباه أبناء “درب السوالمة”، فيما يمسح الولد “عتمان” وجهه بظهر كفه، ويلحق بهم محدقًا في الكتلة البشرية المتحركة بأبخرة العرق المختلط بروائح روث الدواب التي تثير الغثيان، في نفس اللحظة التي ينتبه فيها إلى هتاف الشيخ “دياب” إمام المسجد: “إنما الكرامة في الاستقامة”، ويلمح النعش وهو يسبق المشيعين، فيركض الولد ابن الاثنى عشر ربيعًا في جلبابه المشلوح بعد أن رأى ما جرى مرددًا: النعش طار. تتردد العبارة بسرعة فوق ألسنة النسوة في شوارع وأفنية وحواري القرية، ثم تنزلق الحكايات من بين رذاذ الشهنفة وخيوط المخاط عن نعوش الأسلاف التي طارت..)
وسرعان ما يدلف القارئ إلى فصول الرواية ليدرك أن صاحب النعش الطائر لم يكن سوى إقطاعيًا متسلطًا، أفسد حياة كل من حوله. تنساب فصول الرواية لتتشابك الحكايات وتجتمع حول “رضوان البلبيسي”، الذي امتدت يده لتفسد حياة الجميع، فمنهم من استسلم، مثل زوجته الثانية “سعاد”، ومنهم من استغل الوضع مثل الخولي “حسنين” الذي دفن البيه عند شجرة اللبخ، آملا أن تغطي رائحتها الذكية على رائحة الجثة العفنة، ويختلق حكاية النعش الطائر ليقنع الناس بأن يبني مقامًا في ذلك المكان للولي “رضوان البلبيسي”. ينضم “فارس” ابن “رضوان” إلى النجوم الشاردة الباحثة عن حلمها الخاص. يتعثر في الطريق أحيانًا ويمضي أحيانًا، فيشارك في الثورات الداعية لحرية الوطن، ورغم تعدد زيجاته يسعى إلى حبيبته الفقيرة “جميلة” التي تثور لكرامتها وتتمسك بحلمها الخاص على حساب حبها لابن البيه. ورغم حبه لابنة البيه، يرى “همام ابن مبارز”، الذي قتل البيه أباه، العدل في الانتقام من “رضوان” بقتله، ولكن يموت البيه بين أحضان عاهرة في منزل فقير، وينقله ابنه في الخفاء إلى منزله ليخرج منه في جنازة تليق به، ولكن تتعفن الجثة وتفوح الرائحة وتنتصر على أقوى العطور. تنتصر رائحة العفن على رائحة شجرة اللبخ – ذقن الباشا – الفواحة التي شُيد عندها المقام: (ما أن تعالت الزغاريد وترددت أصداؤها في الفضاء حتى بدأ الفوح.. الذي عجزت ذقن الباشا المزهرة ذات الشذى المميز عن إخفائه، حُفر بعد فترة مصرف هائل بجوار المقام… فراح رواد المقام يعزون الرائحة إليه…).
ومع سلاسة اللغة وكثافتها، لا يخلو النص من مفارقات ساخرة على مستوى اللغة والأحداث. ومن ذلك حين يكتشف “فارس” جثة أبيه في صومعة العاهرة وقد فاحت رائحته، لتبقى الرائحة العفنة لجثة البيه خيطًا رمزيًا يمتد في ثنايا السرد (…تفوح رائحة منفرة، يهبط الدرجات إلى حيث يرقد الرجل الذي لم يره الناس إلا في أبهى صورة، الرجل الذي كان يغرق نفسه بأثمن العطور ويهش بمنشته ذرة الغبار متأففًا). وفي خاتمة الرواية تلقي الكاتبة بغلالة رمزية على السرد كله، فتتحول حكاية “درب السوالمة” إلى حكاية تتكرر في كل زمان ومكان، يمتزج فيها الواقع والخيال، تحكي عن الحاكم المتسلط الذي يحوله المستسلمون والمنافقون والمنتفعون إلى واحد من أولياء الله الصالحين، وتروي عن كل مكان يظنه العابرون “جنة رضوان”، بينما تستعر في داخله نيران القهر والظلم، يستسلم لها البعض، وينتفع منها البعض، وتبقى قلة تتأجج في صدورها نيران الثورة وتبحث عن الحلم، فتتآلف أرواحها وتتجمع في سرب من النجوم الشاردة. تتحول الرواية كلها إلى حكاية تحكيها مسافرة إلى جارتها على المقعد المجاور بالسوبر جيت أثناء مروره بالمنطقة وانتشار الرائحة العفنة، مما يثير فضول المسافرة فتعود إلى الدرب بحثًا عن الحقيقية: (التقيت أناسًا ودخلت ديارًا، سمعت حكايات عجائزها عن الشجرة والسرايا والبيه وأبناء الدرب، حكايات وذكريات تداخلت بعضها ببعض وشاب أغلبها اختلاط الحقيقة بالخيال والممكن بالمستحيل، في منتصف إحدى الحكايات تبين لي أن البيه الذي تتحدث عنه إحداهن ليس هو نفس البيه الذي تحدثت عنه سابقتها على الرغم من تشابههما، وأن دروب اللبخ كثيرة في هذه المنطقة…)
“شجرة اللبخ” رواية بالغة الثراء، تتشابك فيها العلاقات الإنسانية والأحداث التاريخية. ورغم تعدد الشخوص استطاعت الكاتبة الغوص عميقا داخل نفس كل منها، فامتلكت دفة سرد متشابك متعدد الطبقات بموهبة كبيرة وقدرة فائقة.