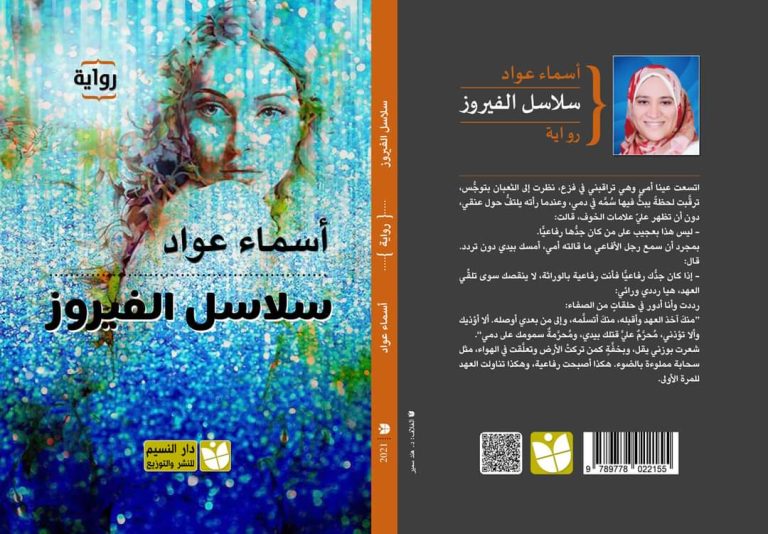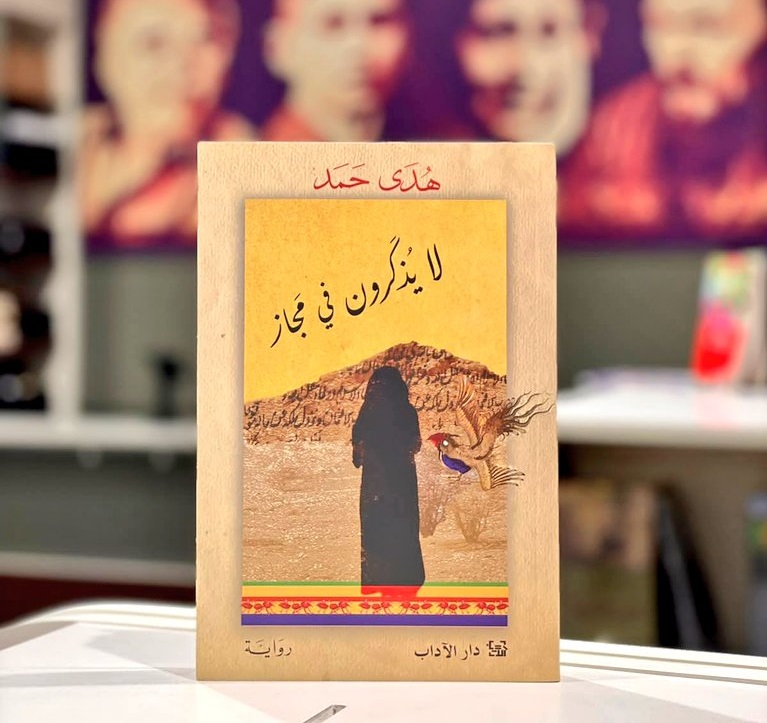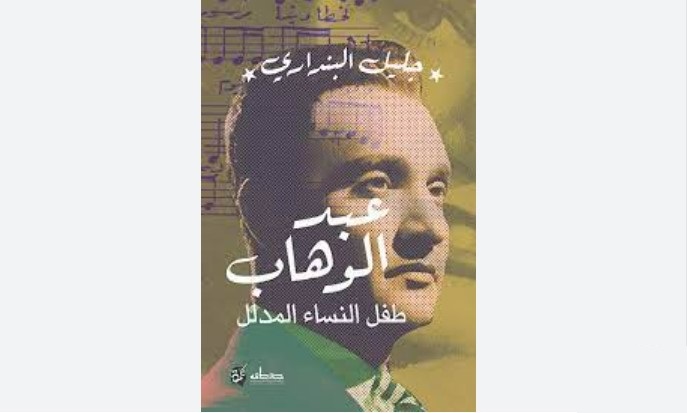د. محمد المسعودي
كان لقائي الأول مع الإبداع الروائي للكاتب والناقد شعيب حليفي خلال تسعينات القرن العشرين حينما قرأت روايته “رائحة الجنة” الصادرة عن منشورات الرابطة حينها، وهي رواية عن بادية الشاوية، وعن شخصيات مختلفة تخوض وقائع طريفة، وتسرد محكيات لا تخلو من غرابة تتمثل فيها أحداثا جرت بين المغرب والهند الصينية من خلال رصد مشاركة بعض شخصياتها في حروب فرنسا بالهند الصينية. لم تبرح ذاكرتي هذه الرواية وشخصياتها حتى الآن، وبعدها قرأت للكاتب أعماله الأخرى في السرد والنقد على السواء، خاصة بعدما توطدت أواصر الصداقة الصافية والمحبة العميقة بيني وبين شعيب حليفي، وصار يهديني كتبه كلما سنحت فرصة اللقاء بيننا، أو أحيانا تصلني من خلال أصدقاء مشتركين. وهكذا حينما تسلمت آخر رواية لشعيب منه -خلال لقاء ثقافي بمدينة طنجة- انكببت على قراءتها في أول فرصة مكنتني من الاختلاء بها، وأثناء القراءة لفتت نظري عدة جوانب فنية وقضايا جمالية يمكن أن تكون مدخلا إلى قراءة هذا النص الروائي، لكني آثرت أن أتناول لمحة فنية بارزة في الرواية-كما يتبين من عنوان هذه القراءة- وهي الشاعرية في سياق علاقتها بالفانتاستيك. فأين تتمثل شاعرية رواية “خط الزناتي”؟ وما دور الفانتاستيك في تشكيل شاعرية الرواية؟ وكيف يسهم البعدان معا في بناء المتخيل الروائي وتشييد الدلالة في النص؟
في ضوء هذه الأسئلة سنتناول بالدراسة بعض صيغ الكتابة الإبداعية في العمل الأخير للمبدع الروائي والناقد شعيب حليفي، وهو عمل ينضاف إلى ريبرتوار الكاتب الحافل بنصوص سردية كثيرة أمتعت القارئ المغربي وقدمت له صورة إبداعية دقيقة وغنية عن بادية “الشاوية” بالمغرب، وعن راهنها وماضيها عبر متخيل سردي فاتن منذ رواية “زمن الشوق”، ومرورا بأعمال كثيرة أخرى، ووصولا إلى “خط الزناتي” موضوع قراءتنا هذه.
يعود شعيب حليفي في رواية “خط الزناتي” إلى فضاء البادية المغربية الأثيرة لديه ليشكل عوالمه السردية وبناء متخيله. ومن يقرأ الرواية يلفت نظره اشتغالها الفني من أفق فانتاستيكي يسهم بقسط وافر في تحقيق شاعرية الرواية على مستوى المحكي وفي الصياغة الأسلوبية واللغوية، خاصة أن هذا البعد الفانتاستيكي يلتحم بسحر لحظة زمنية تلقي بظلالها على الشخصيات والأحداث والأمكنة وظواهر الوجود والحياة، مما يجعل هذا السحر فاعلا جوهريا وعنصرا هاما من عناصر تشكيل المتخيل وتشييد دلالات النص وأبعاده الترميزية.
فعلا إن أحداث الرواية جميعها تدور في يوم واحد من أيام القرية، غير أن الزمن بليله ونهاره، بسحره وغموضه والتباسه، ببهائه ورونقه وانطلاقه يلقي بثقله على المتخيل ويجعل منه لحظة فارقة من لحظات المحكي السردي في الرواية، ومن ثم، فإن الفانتاستيك يتصل بهذا الكائن الأبدي السرمدي الذي هو نسغ الحكاية ونسغ كل عجيب، ووراء كل تحول في الأحاسيس والمشاعر الإنسانية، ووراء كل تغير يجري في نواميس الأشياء والطبيعة. ومن هنا كانت الرواية تغوص في تصوير تحولات الزمن لتسبر تحولات الإنسان والطبيعة والحيوانات وكل الكائنات الفاعلة والمتفاعلة في النص.
يقول السارد في مقطع دال من الرواية:
“صمت الراعي، فيما بقي عيسى ينظر إليه مستمعا.. كأن هناك فارقا زمنيا بين المتكلم والمستمع، تلاه دوي صمت ملفوف في فراغ سقط من علو شاهق فارتطم بعقل عيسى. عيسى الذي شرب الكلام والمعنى وارتوى، وضرب طربوشه الأحمر على الأرض، وهمَّ يريد عكازة الزينة التي أثث بها صورته الليلية، وهو ينظر نحوي كما لو كان يستأذنني في ذاك الجزء من الثانية، لينزل بها على رأس الحيمر[الراعي] المندهش والساكن” (الرواية، ص. 90)
يكشف النص عن إحساس السارد “موسى الزناتي” بالزمن، عن وقوفه عند تفاصيل دقيقة لحركته من خلال التركيز على سلوكات الشخصيات الأخرى المحيطة به، وتصويره لأفعالها الغريبة، وردود أفعالها التي لا تخلو من إثارة الدهشة والغرابة لدى الراوي ذاته أو لدى المتلقي. ونلمس في المقطع ذلك الحس الفانتاستيكي الذي يرتقي بالمشهد إلى تصوير شاعري يقتنص سحر اللحظة وغموضها، وعمق أحاسيس الشخصيات وتوزع مشاعرها. وعبر هذا التصوير يتمكن السارد من الغوص في غور شخصياته ليكشف أثر فعل الزمن فيها وفي نفسيتها. وقد كانت الصياغة اللغوية شاعرية التركيب شاعرية المحتوى بحيث لا تخطئ عين القارئ هذا البعد في كل جمل المقطع.
وفي نص آخر يقول السارد ممعنا في تأثيث هذه اللحظة الليلية بتفاصيل أخرى، وبصور ترمي إلى تعميق البعد الفانتاستيكي وإسهامه في تشكيل شاعرية الرواية عبر الإمعان في تصوير تماهي كائنات الوجود وتلاقيها خلال هذه الفترة الزمنية:
“توقف.. ثم عاد يفكر في ما قاله عنه، ونحن نضحك من المشهد الذي انقلب على عيسى، وسمعت سوسو تضحك بدورها، بينما توقف الصرار عن عزفه المتكرر، مؤقتا ليرتوي بدوره.
قال منفعلا دون أن يستطيع تصنع الرد بشكل طبيعي:
-نعم، كلامك صحيح آ السويرح. فعلا ذهبت عند الشوافة بنت دويدة وصاحبها المهدي!!
لم يتأخر الحيمر في الرد فقال:
-لعلني نسيت إخبارك.. أنا هو المهدي المنتظر آسيدنا ولد مّي اهْنية!!
انتهى الحوار بالعودة سريعا إلى البسط والضحك، وتبين أن الراعي الحيمر أحس بمكر عويسا فشاء أن يكون خير الماكرين به، وعاد يصفر في مزماره القصبي بلحن يستعطف النهار القادم ألا يكون نسخة من سابقه” (الرواية، ص. 90-91)
نلمس في هذا المقطع ذلك التماهي السحري بين الإنسان والطبيعة عبر حضور الموسيقى (الناي) وتوقها إلى أن يكون النهار التالي غير اليوم في تفاصيله وثقله، كما لو أن الليل بخفته وروحانيته ينسي الكائنات همومها وآلامها، ويصبح مجالا للبوح والانعتاق من سطوة العمل ورقابة الآخرين. ونلمس في المشهد كيف تشارك الكلبة سوسو والصرار في الحدث من خلال ضحك الأولى من كلام الراعي، بدورها، ومن خلال صمت الثاني وتشربه لمعاني كلام الراعي الحيمر الذي يمكر بعيسى ويرد له الصاع من خلال معانيه المحلقة والمواربة. هكذا نشهد فنتاستيكية الوقائع، ونرى كيف تبني متخيل الرواية وهي تبئر اللحظة الزمنية (الليل) وتمنحه بعدا يضمخ النص بشاعرية ملحوظة، كما أن اللغة تختزن بعدا شعريا تصويريا جليا، وبالأخص في الجمل الأخيرة من المقطع.
وهكذا تصير اللغة الراقية بصورها المجازية وبلاغتها السردية العميقة أفقا لتشكيل شاعرية الرواية وبناء متخيلها على أساس فنتاستيكي جلي، ويمكن أن نضيف إليها المشاهد التي تضطلع فيها حيوانات الرواية (كلاب-قنافذ-صرار..) في منحها أدوارا لا تقل عن أدوار الشخصيات الإنسانية في التعبير عن حكمة الحياة، وحكمة الزمن وفعله في الحياة. لننظر إلى المقطع الآتي من الرواية:
“وصلتُ إلى الضيعة فاستقبلتني سوسو حزينة لأن الليل يُشعرها بالوحدة، وفيه تُدرك أن لصوص النهار عميٌ، بينما لصوص الليل مبصرون.
-هل تخشين، يا سوسو، أن يسرقوا ما نملك؟
-أخاف أن يسرقوا الليل مثلما سرقوا النهار.
-تخيلي يا سوسو.. هل يمكن أن نحيا في زمن لا ليل ولا نهار فيه؟
-آويلي!! عَوْوْوْوْوْوْ…
تردد من بعيد عواء متصل وحزين للكرطيط، فاقد الذيل، مستعطفا سوسو أن ترأف بحاله.. وبعد لحظات، بات متواترا يتقاطع وصوت صرار الليل العازف، طياب العنب.. الذي لا ينقطع.
رفعت رأسي فأحسست بلمعان نجم الشمال الثابت والسريع وهو ينطح، مثل جدي جذلان، الظلام الزاحف، فيضيء سماء واسعة ترتج بنجوم أخرى منتشرة” (الرواية، ص. 87)
تشترك في تشكيل متخيل هذا المقطع الروائي عناصر متعددة إنسان-حيوان-نجوم-حركة الزمن. وعبر هذه العناصر تنبني الأبعاد الرمزية للمشهد في دلالاته على الإحساس بالخوف والقلق من الآتي حتى لدى الحيوان: سوسو التي تخشى من سرقة الليل كما تمت سرقة النهار، وبهذه الحوارية الفانتاستيكية ترد الحكمة على لسان الحيوان لتدل على بعد تأملي واضح في كنه النص يكشف عن رفض لما يقوم به لصوص الليل والنهار من تدمير للحياة وسلب الناس حقهم في العيش بسلام.
ويتعمق البعد الشاعري لهذه الأبعاد الفنتاستيكية من خلال ملاحظة “موسى الزناتي” لحركة النجوم وتصوره الذهني لها، إذ شخص نجم الشمال كجذي ينطح زحف الظلام، وهي صورة شاعرية ترسخ البعد الرمزي الذي عبرت عنه حكمة سوسو المنبثقة من الفطرة السليمة وتأمل الوجود والحياة. وبهذه الشاكلة نجد الرواية تحفل بمثل هذه الروح الحكيمة المنبجسة من الارتباط بالطبيعة وبرصد تحولاتها، وتحول الزمن وفعله فيها وفي الكائنات جميعها، كما أن تماهي هذه العناصر ذات المنحنى الواقعي بالفانتاستيكي يجعل شاعرية الرواية أفقا جوهرا في تكوينها السردي. يقول السارد متحدثا عن “خيرة الكناوية” وفعلها الساحر في النفوس راويا على لسانه ما تستشعره حتى الذوات الأخرى الحاضرة في ذلك المجلس تلك الليلة:
“.. تنقر بتتال من ظهر السبابة والوسطى بإحكام الإبهام، فنشعر جميعا كأن النقر في قلوبنا، ثم تفتح فجأة عينيها في عينيَّ مباشرة فيسقط حجاب الليل وتتململ النجوم في السماء. رشاقتها من رشاقة أنثى النمر، ولونها من لون الفرس الأدهم شديد السواد. كل شيء فيها صغير من القدمين إلى الأنف والأذنين، إلى فمها المدور، إلا العينين فهما واسعتان، امتلأتا عسلا تليدا مصفى، زادهما الحاجبان الهلاليان عنفوانا، أما صدرها فمُزهر بالشموخ”. (ص.109)
بهذه الكيفية يتماهى السارد موسى الزناتي مع الآخرين، ويعبر بشكل موارب عن ميلاد بذرة العشق في دواخله عبر استدعاء عناصر متنوعة تتصل، أيضا، بالطبيعة وبحركة الزمن، ونرى الصيغ اللغوية والتعبيرية ترتبط بهذه الحركة. وهذا البعد المتمثل في ربط الكائنات جميعها بالزمن وحركته هو عنصر من عناصر سحر الإبداع، أو ارتقائه ليصير قادرا على جعل شاعرية التصوير وما تخلفه من أثر مكونا ديناميا في بناء المتخيل الروائي؛ خاصة أن الرواية، وانطلاقا من عنوانها، تستدعي طقوس “السحر” وعوالمه من خلال استحضار “خط الزناتي”، وعن طريق ربط بطل الرواية “موسى الزناتي” ببعض ممارساته كما يسردها وكما تؤثثها حكايته. يقول:
“.. أشعر بصفاء غريب يجعلني واثقا غير متردد في اقتفاء أثر الكلمات الجوهرية اللائقة بملامسة أهداب الغيب الذي هو ليس سوى ظلال ما نفعله أو نفكر فيه من رغبات وأحلام. لذة بمذاق قوة لا تُرى وأنت تلاعب ما يختفي خلف الحياة الصغيرة الشبيهة بحفنة رمل. سلاسة في إيجاد كلمات تصاحب الأبراج وتؤاخيها، وخفة في جري الحروف والخطوط بين أصابعي والتراب”. (ص. 140)
إن المقطع المستشهد به يستدعي عالم الأبراج والنجوم وما يتصل به من تنجيم وتخمين وارتباط بالغيب واستكناهه، وتأويل للرؤى واستشرافها، وهي مهنة موسى الزناتي خلال فترة من فترات حياته. وهذا البعد أيضا من بين عناصر أخرى تتصل بالزمن وفعله في “الحياة الصغيرة”، كما نعتها السارد، ولكن الشاسعة بسحرها ورونقها وبعوالمها اللامحدودة، وهي العوالم التي لا يمكن الإمساك بها إلا عبر بلاغة الفانتاساتيك وشاعرية البناء الفني، إضافة إلى شاعرية الكون التخييلي في النص الروائي برمته.
هكذا ومن خلال كل ما سبق نتبين أن الكاتب شعيب حليفي جعل من الأفق الفانتاستيكي منطلقا لتشكيل متخيله الروائي، وهو متخيل شاعري المحتوى شاعري الصياغة الفنية، وعبره استطاع أن ينتج نصا يتميز بالحيوية، والقدرة على الغوص في نفسية شخصياته، وخاصة بطله “موسى الزناتي” وهو يتفاعل مع الحياة، والطبيعة، والزمن، والإنسان، ومع عوالم الرموز والحروف، وكل ما يشكل سحر الحياة وغوامضها، وبذلك كانت الرواية إضافة نوعية إلى سردية الكاتب التي يؤسس معالمها الخاصة والمتفردة من عمل إلى آخر، وفي دأب وتفان إبداعي لافت للنظر.
*شعيب حليفي، خط الزناتي، منشورات السرديات، الدار البيضاء، 2023.