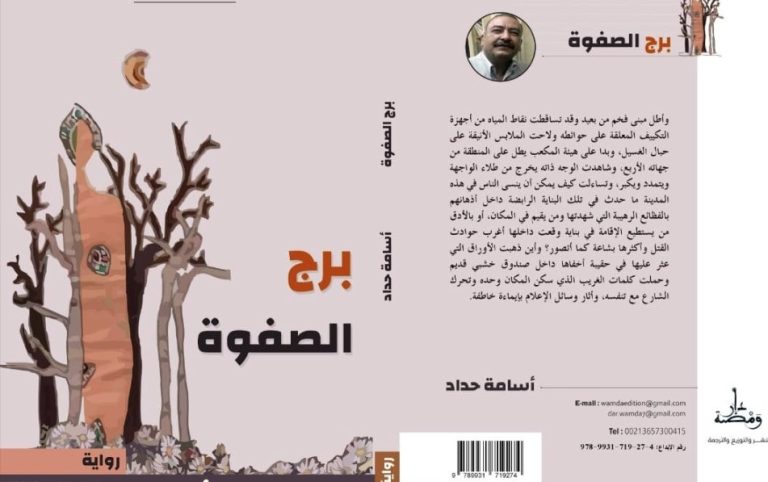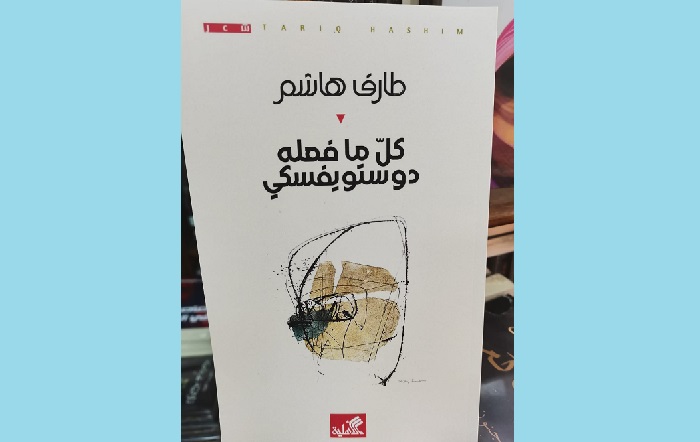شوقى عبد الحميد يحيى
تُصر “جيهان” على الذهاب للطبيب النفسى ب “هشام” بصحبة المؤلف(السارد). فيشير الطبيب لحالة هشام، ويوجه كلامه إلى المؤلف، وكأنه يعنيه هو بالحديث، ويصف بأنه يعانى من “اضطراب الهوية التفارقى”. على الرغم أن “هشام” يعانى المرض النفسى، أو (الإعاقة الذهنية) إلا أن الإشارة هنا تعنى القصدية، إلى “المؤلف” أو أحد الشخصيات الأساسية في رواية الروائى صبحى موسى الأحدث “كلاب تنبح خارج النافذة”[1]. لذا كانت الحالة المرضية تنطبق بالدرجة الأولى على السارد أو “المؤلف”. ويعضد ذلك وجود شبيه له، يتعثر الآخرون في التفريق بينهم، كما أن نشأته الأولى تؤكد إصابته بتلك الحالة المرضية، وهو الأمر الذى يجعلنا ننظر إلى الرواية باعتبارها رواية أصوات، من الدرجة الأولى، خاصة أن الرواية تقع في الفترة التي انقسم فيها المجتمع المصرى إلى وجهات نظر مختلفة، بل ومتعددة، وهى الفترة الواقع بين اعتلاء الإخوان لكرسى الحكم في مصر، بعد ثورة زرعت الأمل في النفوس، وكان الشعب فيها أقرب للنموذجية في سمو التصرفات الحضارية، والتعاون بين الجميع، بما فيهم المسلم والمسيحى، فالكل أصبح مصريا وفقط، بينما في تلك الفترة التي تناولتها الرواية، اصبح الانقسام هو السمة الغالبة، والظاهرة للعيان، والملموسة بالعين، فكان اختيار الكاتب صبحى موسى، لهذه الحالة المرضية، اختيارا موفقا إلى درجة كبيرة. حيث يبدأ ظهور التجسيد الحى للمجتمع من خلال الشخصية، وكأنها المفعول به، أو المتأثر بذلك المجتمع، وبكل ما يعيشه من نجاحات أو إحباطات، وليؤكد رؤيتنا بأن المبدع – وهو هنا مؤلف- ليس إلا مرآة تعكس ما يجرى على أرض المجتمع، فكانت العلاقة بين الإبداع والسياسة.
فإذا كان “اضطراب الهوية التفارقى” ليس من المصطلحات المشهورة في علم النفس، وهو يعنى انقسام الشخصية- وهو ما يعرف ب”الفصام”-إلا ان الكاتب هنا استدعى هذه المصلح غير الدارج –كما نتصور- لاحتوائه على كلمتى (الهوية والتفارقى)، وكلاهما يحققان رؤية الرواية. وكلاهما الفصام أو اضطراب الهوية التفارقى، يحدث بتأثير ظروف الطفولة، وهوما يرجعنا إلى نشأة “المؤلف” الذى تعانى والدته من عديد الأمراض، ولا يعلم أحد تحديد نوع المرض الذى تعانى منه، والذى يقال عنه “الذئبة الحمراء”. وفى تلك الأثناء، يهرب الوالد إلى دول الخليج ويكتفى بإرسال الشيكات، تاركا للابن “المؤلف” مهمة رعاية الأم المريضة، فكان نتيجة ذلك أن أسمته مُدَرِسة الفصل بالشاعر، لأنه كان خجولا ولا يحب العراك مع أحد، ولأن الجميع كانوا يضربونه و{دائما ما كان يجلس وحيدا ويبكى في صمت، ثم ينسحب الناس ليعيش في عوالم خياله الشرير، تلك التي يكون فيها بطلا يضرب كل من حوله، حتى تنام القرية على حسه، ولا يجرؤ أحد على الخروج من بيته دون إذن منه} ص236. أي أن هناك فاصل بين الواقع والحلم عنده، وقد ولدت هذه الحالة، الفارق بين المتاح من الإمكانيات، والرغبة في الخروج عنها، الحالة المرضية. وجراء تلك الحالة من الضعف والهوان، ما أن وجد “سامبو” بشكله المهيب هو ما يكمل النقص عنده، حين كان في الثالثة عشر من عمره. وإن تسامحت الأم مع الأب إلا أنه لم يتسامح مع والده. فكأن، “المؤلف” أو السارد، يبحث عن الوالد، أو القوة المكملة لنقصه، فوجده في “سامبو” والذى رغم عجزة، فإن شكله بالشارب المتميز بالغلظة، كان عوضا عما يعانيه من ضعف وخذلان لذا قال عنه جملته المعبرة {رجل كَسَرَ عِين الدنيا فاختصرت له جسده}.
ويهرب هذا الابن، هو الآخر للإقامة في ممر ضيق، وحيدا بحجة أنه “كاتب وصحفى” كى يستطيع ممارسة عمله فيها، وقد ولدت عنده الحالة المرضية، والتي لا يعترف هو بها وفق ما هو دارج في معظم الحالات المرضية النفسية، فكانت تلك الحالة تظهر للآخرين. فتقول عنه “جيهان { إننى أتحول، ففي الليل أكون شخصا مستهترا، وفى النهار، أكون خجولا مؤدبا. أضحك وأنا أفكر في كلامها، فقد سمعت مثله من قبل، كان لامبو يقول إننى مخاو، بينما يقول ياسين إننى بحالات، أما رزق الله فيرانى مجنونا… أشعر أننى في ورطة، ولا أعرف هل أنا مخاو أم مجنون} ص135. وهكذا كانت النشأة قد وضعت بصمتها على شخصية السارد. بينما ساقت الأقدار إليه شبيها له، “ثابت”، الذى قام عنه بكل ما كان يجب أن يقوم هو به تجاه الأم بعد سفر الوالد، حيث يمارس هو الآخر عملية التعويض ف {لم يشعر ثابت يوما أن له أما غيرها، ولايمكنه أن يتذكر غير ملامح وجهها… هى بدورها لم تكن تحب المؤلف، وكثيرا ما كانت تراه شخصا لا يصلح لتحمل المسؤولية} ص306. ورغم هذا التشابه إلا أن فارقا جوهريا كان بين الأثنين- المؤلف وثابت- فبينما كان الأول، مؤلفا، يعمل بالصحافة والتأليف، حيث يمثل العقل أو الحكمة، أو العاطفة، كان الآخر “ثابت، على النقيض من ذلك، فهو كما يقول عنه “سامبو” شمال، وكان يعيش على كل الموائد، وتعلم القنص والموت، وممارسة المحاماة، خاصة عن نساء الليل. فهو يمارس الحيلة، والممارسة، والقوة، فكان الجانب الفعال من المؤلف، الذى عُرف بالسلبية. ولهذا نرى الرواية “رواية أصوات” من الدرجة الأولى، حيث قسم الكاتب-صبحى موسى-روايته إلى قسمين، القسم الأولى – أنجريتا- كان بلسان المؤلف، ونفس المواقف والأفعال، نراها بلسان “ثابت” في القسم الثانى –فئران بدينة-. وهو الأمر الذى ولد، إلى جانب القراءة الأولى، أو القراءة الاجتماعية، كانت القراءة الثانية، أو القراءة السياسية، التى تكمن في الخلفية، لتشكل العنصر الفاعل، غير المباشر، لحركة المجتمع، وما يدور فيه من فوران، وتفاعل، في فترة تعتبر من أكثر فترات التاريخ المصرى حراكا، وتفاعلا. خاصة أن المجتمع انقسم بدوره إلا واقعين، “أنجريتا” بناسها، سامبو ورزق الله، وتاجر المخدرات، والقاتل بالأجر والمؤلف، في جانب، والمدينة الجديدة، او العاصمة الجديدة، وبناسها الذى انتقلوا إليها وفى مقدمتهم “ثابت” و”جيهان” في جانب آخر.
ففي الجانب الأول “أنجريتا” التي يمكن التعرف على معناها، انها “صرخة غضب” وقد سميت بذلك لأنه عندما {يخبر السارد زملاء البار الفقير أنه مكلف بالكتابة عن أحد من عندهم قصور ذهنى، فيرد عليه الزميل {طب ما تكتب عن اللى عنده قصور مالى. الفقر أكثر قسوة يا صاحبى من العاهة. أنا مثلا عندى استعداد حد يقطع رجلى ويدينى مليون جنيه.
أتعجب من قسوة منطقه، وأهدهد عليه قائلا: كلنا فقرا، لكن مش الحل إننا نبرر القسوة على غيرنا، ولا إننا نرمى نفسنا في البحر.
يضحك ثابت، ويقول إن العجز له أشكال كثيرة، فحين تتألم والدة المرء ولا يستطيع أن يخفف عنها ألمها فهو عاجز. وحين لا يتمكن من دفع أجرة التاكسى الذي يقلها إلى المستشفى فهذا عجز أكبر و.. و.. و…………………….} ص32. وأيضا، وفى أثناء الثورة، يخرج السارد من الميدان {أسلم نفسى للزحام، وأظل سائرا إلى منتهاه، حيث لا يبقى سوى الأماكن المحرومة من كل شيء. لا صرف صحى، لا مياه، لا كهرباء، لا شيء سوى عربات الكسح التي تجوب الشوارع الملتوية على نفسها، أكوام القمامة تفوح بروائح العطن وغاز الميثان، لا شيء بعدها إلا مستعمرات الصفيح} ص50.
بينما نجد أن الجانب الآخر، والذى يأتي هذه المرة على لسان “ثابت” الذى يوجه حديثه إلى المؤلف {ليس عليك، فأنا أريد أن أحدثك عن المدينة الجميلة التي أسكن فيها الآن، مدينة جديدة، شوارعها نظيفة واسعة، ليس بها زحام كأنجريتا، ولا بيوت متداخلة في بعضها، ليس بها صرف أشبه بالمستنقعات، ولا عربات كسح له، كل شيء هنا آدمى وهادئ، بها نور وشمس ومدارس، بها مول وناد وكهرباء لا تنقطع…} ص243.
ويقول ثابت عن “جيهان” {لكننى كنت أخشى على جيهان، ما عادت تحتمل كل هذا الضغط، كل يوم اجتماعات ورحلات وسفر. كل يوم مسؤوليات جديدة. تقطع الرحلة من هناك إلى العاصمة في ساعتين، تترك سيارتها أمام محطة المونوريل وتذهب، تقول إنها مدينة عملاقة، ربما ستكون الأكبر في العالم يوما ما.. وأنهم سيتسامحون مع رجل وديع مثلى!!!} ص243. وتحمل الجملة الأخيرة {وأنهم سيتسامحون مع رجل وديع} الكثير من الإيحاءات التي تلقى بظلالها على المشهد، الذى يتواكب مع الدنيا الجديدة، لتتضافر مع {لذا كانت الكبارى والطرق الجديدة التي قضت على تاريخنا القديم…. يبدو أننا وحدنا الذين تحملنا هذه الضريبة} ص244.
بل وتكاد تنطق بالواقع المعيش{في كل زيارة كنت أحدثك عن “جيهان”، أقول إنها تعيش في شقتنا الجديدة، وتذهب إلى عملها الجديد، في العاصمة الجديدة} ص291.
التقنية الروائية
استعرض صبحى موسى الوضع في فترة حكم مبارك، في روايته “نقطة نظام”[2]. كما استعرض ثورة يناير في روايته “نادى المحبين”[3]. فلم يكن غريبا أن يتناول ما بعد ثورة يناير فى”كلاب تنبح خارج النافذة”. وهو ما يمكن أن نقول معه أن صبحى موسى يسير على نهج نجيب محفوظ، في تولى مسئولية التأريخ لمصر الحديثة في العصر الحاضر، بعدما، أرخ لمصر القديمة في روايته “الموريسكى الأخير”[4]. وهو الأمر الذى معه لا يمكن التوقف عند الرؤية المباشرة للكلاب، والتوقف عند النظرة الاجتماعية، خاصة أنه يجعل دائما المشهد السياسي في الخلفية للمشهد الظاهر.
كما جاء استخدام تقنية الأصوات، مناسبة جدا للتعبير عن اختلاف وجهات النظر، التي حكمت المرحلة التي يتناولها هنا، وهى فترة حكم الإخوان، التي تعددت وجهات النظر فيها، فلكل منها رؤيته ودوافعه التي عليها بنى هذه الرؤية. بل جاء انقسام السارد، بين “المؤلف” وشبيهه “ثابت”، التي حالفها التوفيق، للتعبير عن الجسد الواحد للأمة، بين المسيحى والمسلم. فإذا كان”المؤلف، يترك حبيبته “جيهان” والرجل الكبير في الفندق، عندما شعر بأنها تستخدمه كغطاء لما-تصور-أنها تفعله، الأمر الذى يحدد شخصية المؤلف، الذى تجرحه الكرامة، عن مسها أحد، نرى شبيهه “ثابت” والذى فتدور حوله الشبهات أثناء الثورة، ثم يُصرح لامبو بأنه يعمل مع الإخوان {يأكل على كل الموائد. ينتقل من الحزب الوطنى إلى الإخوان، ومن الإخوان إلى السلفيين، ومن تجار المخدرات إلى الدعارة والآداب، ليس له أخلاق} ص108. فهكذا كان لكل منهما رؤيته للحياة. في الوقت الذى أرادت جماعة الإخوان فيها أن تلغى وجود المسيحيين، او أن تعتبرهم ملة أخرى، والتى تجلت في مشهد لقاء كل من “ثابت” المسلم، ورزق الله المسيحى، عندما ذهب الأول للاعتذار، عن ماذا؟ لا نفهم. ورغم كل ما يفعله (المسيحى) من خير، لم يفعل المسلم مثله ف {كنا إذا حدثنا رزق الله عن الخلود ضحك ساخرا، رغم أنه لم يترك يوما قداس الأحد، ولم يتوقف عن التبرع لفقراء الرب… وقررت فجأة الصعود إلى السطح، وقفت أمامه طالبا منه أن ينصت لى. سألنى عما أريد. قلت إننى أريد أن أعتذر، فقال الكذب ليس له عذر، فما بلك بالخيانة والإفساد في الأرض، شعرت أنه أصبح خطيبا على منبر، ولم أتمالك نفسى من الضحك. قال التفاحة تفسد من داخلها أولا، وأننى طيلة الوقت كنت فاسدا.. ثم طالبنى أن أرحل عن بيته، فأخذ غضبى يتصاعد كبركان ثائر.. ولم يكن أمامى سوى أن أضع يدى على ظهره وأدفعه للأمام لأراه يحلق في الهواء كطائر كبير، ثم هرولت على السلم لأختبئ في المخزن} ص322،321. إلا ان الاختلاف في الطباع بين “المؤلف” و “ثابت”، لم يكون حاجزا بين الإثنين، حيث أن طبيعة “المؤلف” الخجول، والمتجنب للآخرين، كان بداخله باستمرار يحمل الإعجاب لشبيهه “ثابت” وكان ثابت هو الصورة الأخرى من المؤلف، فكان يظهر له وقت لا يتوقع منه الظهور، كما أنه كان يفعل ما يود هو فعله ولا يستطيع، مثل الاعتداء على مدير العمل عندما اعتدى على “جيهان”. فهو كان أقرب شبها به و{لم يكن الكثيرون يفرقون بينهما من شدة التقارب والتشابه، لكن ثابت هو أكثر انتباها، اكثر قوة ورغبة في الحياة…..كان المؤلف معجبا بمنطقه وطريقة تفكيره، ويعتبره مفكرا وفيلسوفا. ورغم أنه لم يكن يذاكر ولا يعرف طريقا للكتب، إلا أنه ظل ينجح عاما بعد الآخر حتى وجد نفسه في كلية الحقوق} ص240. كذلك كانت نظرة “ثابت” إلى “المؤلف”. ففى اعترافات “ثابت” عن ذكرياته مع المؤلف، يقول {فليس في أوراقك متسع لذكر ما تكبده الآخرون من أجلك، لا يهم، فقد مضت سنوات طويلة كنا فيها أكثر من صديقين، ربما شخص واحد بروحين روح لى وروح لك، لم يعد أحد يفرق بيننا، كانوا يعتبروننا شخصا وظله.. هكذا ارتضيت لنفسى دور الشرير، وتركت لك دور الملاك المحبوب} ص242. وهو ما أدى إلى تناسى الكاتب لما يمكن أن يحدث للقارئ جراء ما يمكن تصوره تداخلا في {حيث رآه المؤلف فى ذلك اليوم بدا له كائنا فضائيا….. كان سامبو ممسكا بدراجته، وباحثا بعينيه عمن يساعده في رفع صندوقى بيرة إلى كرسيها الخلفى، لمح المؤلف واقفا، نادى عليه متوقعا سرعة الإجابة.. لا يعرف سامبو لم تعاطف معه….} ص137.
{لا يعرف سامبو لم تآلف سريعا مع ثابت،…. فمن اللحظة التي نادى عليه كى يساعده في وضع صتدوقى البيرة على الدراجة وقد انتابه شعور بأنه الخليفة المنتظر} ص245. حيث يجعل القارئ يتصور أن الأمور خرجت عن سيطرته، فلا يدرى -القارئ غير المتمرس- انه تعمد ذلك لتأكيد الشبه الكبير بين الإثنين.
ومن صور الشرير، الذى يستند على فتوى الشيوخ، يقتل “ثابت” العمة. فبناء على فتوى من ياسر، بانه يفعل خيرا إن هو قتل أمه”-عمة هشام-كى يريحها من السرطان الذى ينهش في جسدها، فنفذ {حين تسلل –ثابت-فى غياب البواب عبر مواسير الصرف إلى البلكونة الصغيرة في منور شقتها، وضع وسادة على وجهها وأخذ يضغط عليه حتى أسلمت الروح، ثم تسلل عائدا إلى المنور ومنه عبر المواسير إلى الحديقة الخلفية للفيلا} ص304. فالوضع هنا يؤكد اختلاف وجهات النظر، حيث لم يكن المؤلف ليفعل ذلك تحت أي ظرف، احتراما للكثير من الأمور، غير ان “ثابت” فعلها متصورا أن ذلك سيريحها من معاناتها مع المرض، أى تخليص المجتمع من أمراضه، خاصة أن الفتوى جاءت ممن تصوره أهل للفتوى. غير أن طبيعة الإخوان تجلت في تجاهل “الشيخ ياسر” للعملية ومن قام بها، حيث الكمون والفعل من وراء الظاهر.
وايضا نرى أن ثابت ذهب مع “جيهان” إلى المدينة الجديدة، مسايرة لمن يملك القوة، بينما رفض المؤلف، رفضا تاما، أن يغادر “أنجريتا” أو مصر القديمة، حتى لو هددوه بهدم البيت فوق رأسه. فهنا التزام، وهناك مسايرة للقوة.
وهذا ما يقودنا إلى تأمل البعد الرمزى لبعض الشخوص. فإن كانت أنجريتا” وناسها حيث {كان الشباب في أنجريتا يتسللون كل صباح إلى الميدان، ولا يعودون إلا في نهاية الليل، وبعضهم كان يلازم الخيام.. فقد أقسموا ألا يعودوا إلى بيوتهم إلا بسقوط النظام} ص299. وإن نجحوا في إسقاط النظام، إلا أن مصيرهم كان على خلاف لما تمنوه، الأمر الذى يؤكد الفشل الذى يلازمهم. كذلك كانت أنجريتا، والتى يعبر عنها “المؤلف”، بكل خيباتهم، فكان إخفاق “المؤلف” هو إخفاق لأنجريتا، والتي بدورها تمثل الإنسان المصرى، المذبذب، الفاشل، الذى لم ينجح في عمل أقدم عليه.
فإذا كان مشرع مراقبة “هشام” هو المشروع الأكبر في حياة المؤلف، حيث هو الذى انتشله من حلة الفقر، وهو ما قداده للعمل، وكان عاطلا عنه، ثم كان مشروع إقامة الفنان”هشام” واقتناعه به، رغم سخرية الآخرين، وكأنه يحاول تحويل المجتمع كله للجمال والفن فشل، وأفشله الإخوان الذين تمكنوا من السيطرة على السلطة، وحتى عندما عمل السارد مع الإخوان، بتسليم الأغذية لهم فى رابعة، فشل الإخوان وهو معهم. وهو ما يتفق وحالة السكر والخمارة التي يعيش فيها القاتل بالأجر، وتاجر الحشيش والسباك، وهم الطائفة التي يسهل قيادها، فهى تعيش في حالة التوهان. وما أصبحت معه المدينة القديمة كلها في حالة سكر، وكأن المدينة كلها تسعى للنسيان، أو البعد عما يجرى في الآن {يفاجأ لامبو بوقوفنا أمام شقته، نخبره بأننا وجدنا الخمارة مغلقة فأحضرنا حاجاتنا وجئنا إلى بيت صاحبها، يضحك قائلا إن أنجريتا كلها أصبحت خمارة} ص173.
بينما المدينة الجديد على الجانب الآخر، هي ما يرويه “ثابت” –أيضا-عن جيهان التي اختفت عن أنظار “المؤلف” {أستطيع الآن أن أخبرك أين تقيم جيهان، فهى لم تمت ولم تهرب، ولم يحدث لها مكروه، لكنها قررت أن نعود إلى شقتها القديمة، حيث يمكنها أن تقيم وسط الناس، فقد فشلت في جمع أي منا بالآخر} ص 327. وتشى الجملة الأخرى ببؤرة العمل {فقد فشلت في جمع أي منا بالآخرْ}، وهو ما يوضح ارتباط المؤلف بمصر القديمة، وارتبط “ثابت بمصر الجديدة. وهو ما يدعونا للنظر في بعض الشخصيات الأخرى مثل “هشام” الذى –كما قلنا-يملك القوة الجسمانية، غير أنه لا يملك القوة العقلية، وهو أحد الحالمين بالسمو والرقى، الذى تؤدى إليه الفنون التشكيلة، وحب الجمال الممثل في ليلى علوى، و “جيهان” إلا أنه لم ينجح في حياته، وساقته أحلامه، إلى إطاعة اللعبة التي أودت به إلى الموت استسلم هشام للعب على الآيباد الذى اشتراه له المؤلف، ووجد في اللعبة ما يحقق له القوة التي يُفرغ فيها طاقته، فوجد في الميدان ما يشير إلى القوة. غير أن الثورة –أيضا-لم تنجح و{امتلأ الميدان بالمتظاهرين، وقامت الثورة على الإخوان، واصيبت البلاد بذئبة حمراء كبيرة، فراح الكل يهاجم الكل، معتبرا نفسه على صواب، والآخرين على خطأ.. واختفى كل من ثابت والمؤلف في غليان الثورة ولم تعد تُعرف أرضا لأي منهما، فالذئبة الحمراء توحشت، والبلاد أصبحت على وشك حرب داخلية، وما من مكان فيها إلا وبه صراع على أشده، حتى بدت كقطار منطلق بأقصى سرعته نحو الجحيم} ص302.
إلا أن البحث عن الجانب الشخصى ل”هشام” يشير إلى { أنه ورث عنها –عمته-الفن، فلم يأخذه من والديه اللذين كانا منشغلين بأبحاثهما في الكيماء العضوية, فوالده كان أستاذا فى كلية العلوم، وامه كانت معيدة بها}ص140. و{هي لا تعرف كيف يمكنها أن تقلص الفجوة بين إمكانياته والأحلام التي يراها} ص141.
وهنا ننظر إلى حالتين، هما موت الأبوين اللذين كانا والده أستاذ بكلية العلوم، وأمه معيدة بذات الكلية، أي ان العنصر العلمى غاب عن تكوين “هشام”، فكان كالطائر الذى لا يستطيع الطيران، بجناح واحد. وهذا ما يقودنا إلى رؤية العنصر الثانى، وهو أن هناك فجوة بين الحلم والإمكانيات. فإذا كان “هشام” لا يملك إلا جناح واحد، فكان في الحقيقة يمثل العجز الذي لا يستطيع معه مسايرة الحياة، وكان منطقيا أن يموت.
وأما الشخصية المحورية في العمل، وهي “”جيهان” فقد أحبها الجميع، وطمع فيها الجميع، غير أنها أقامت علاقات –أيضا-مع الجميع، إلا أنها علاقات ملتبسة، حتى أنه في كثير من تلك العلاقات، لم نكن نعرف، هل أقامت بالفعل علاقات معهم، ام أنها أفكار الغير عنها… فكل الذين عرفتهم خذلوها، جميعهم كانوا أقل من رغبتها في الحياة فكبلوا حركتها وتركوها للذئاب…. حيث الإقامة على مقربة من الميدان الذى خذلناه جميعا، فلم تكن ثورة مكتملة ولا قوية.. فسرعان ما سقطت، وعاد الجميع إلى بيوتهم مصفقين للثورة المجهضة. وقد تفاعلت مع الثورة، غير أنها ذهبت مع “ثابت” إلى العاصمة الجديدة فلم تكن أقل ترحيبا بالثورة {وكـأنها كانت تغتسل فيها من أخطائها، موقنة أنها تعيد تصحيح مسارها….. ستسألك كلما اشتدت بكما الأحوال عما فعلته لكما الثورة، فقد خسرتما كل شيء: المنزل والعمل والأصدقاء وحتى المدينة ووسطها} {ستقول إن الثورة تجردت من قلبها وأكلت أولادها مثل القطط.. ربما ستنظر إلى الكلاب التي تنبح خارج النافذة، حيث الحديقة المنتظرة أقامتها منذ سنوات، والمدن السعيدة التي أجبروك على الانتقال إليها، فلم تعد أنجريتا لك، ولا العاصمة العريقة تستحوذ على اهتمام أحد، حتى الحكومة هجرتها وبحثت لنفسها عن مدينة جديدة} ص131. ف”جيهان” تحب الحياة، وتسعى لأن تعيشها، فسايرت الجميع، علها تجد في أيهم ما يمكنها من العيش، فرحبت بالمؤلف، لكنه كان يعيش بجناح واحد، و لم يحقق أملها، وتعلقت ب “هشام” ولكنه بجناح واحد –أيضا-ثم إنه مات، وتعلقت برئيس الحزب ومن يملك المؤسسة الصحفية، غير أنه لم يكن غير حصالة، وكان كبيرا في العمر، ولا يستطيع أن يحقق لها الحياة. فهى كانت تحب العقل، وتحب الفن والجمال، وتحب القوة، والقدرة، لكنها فشلت في الجميع بين كل هذا في شخص واحد، فكانت خيباتها كبيرة. وهو ما عبر عنه “ثابت” لسان الحال، والممثل للعهد الجديد {نحكى عن هزائمنا التي باتت تطل برؤوسها علينا من كل جانب، ونضحك على النحس الذى لازمنا في كل شيء، موقنين أننا جيل الهزائم والنحس.. وهممت أن أضحك، لكنها فاجأتني بأنهم قرروا هدم أنجريتا، وليس أمامنا سوى الخروج من البيت.. وكنت معنا يومها، لكنك رفضت أن تخرج، ظلت تطالبك بالخروج، وأنت تصرخ فينا بالخيانة، وأننا جبناء، ضيعنا بتخاذلنا كل شيء} ص292. فكان بالإمكان النظر إلي “جيهتن| كممثل لمصر البائسة. على أن لمحة تكاد تكون عابرة، وهى الإشارة إلى ان “جيهان” ابنت أخ غير شقيق ل” سامبو”. أي أنها من ذلك الوسط، من “أنجريتا” ولذلك هي في النهاية، عادت إلى موطنها، عادت إلى الجذور، وهجرت القشور. وكأن الكاتب يُضمر الدعوة إلى التلاحم بين العالمين، عالم العاصمة الجديدة والعاصمة القديمة، وكأنه يلفظ تلك الثنائية التي أدت إلى انتشار “اضطراب الهوية التفارقى”. وهو ما يصرح به “ثابت” لسان الرواية الحقيقى، وكأنه يقر الشكل الدائرى، الذي يعيشه المجتمع، لينتهى من حيث بدأ، وكان الثورات لم تكن، موجها حديثه إلى المؤلف، او إقرارا بالواقع {أعرف أنك لم تكن تسامحنى، لكنك تستسلم مغلوبا على أمرك، فما الذى يمكنك فعله، ربما فكرت في ضريبة ابتعادى عنك، وأن الصفعات ستعود إلى وجهك من جديد.. لابد أنك أيقنت أننى الشخص الوحيد الذى يحميك} ص243.
تميز صبحى موسى، بالذكاء الفني، فهو يسكت عن الكثير، ويتركه لفطنة القارئ، ومن ذلك تجنبه الحديث عن الوطن في الحاضر، ضاغما كلا المرحلتين، مرحلة محبوب الطعن فيها، وهى مرحلة الإخوان، ومرحلة يفضل الجميع الابتعاد عنها، وهى ما بعد الإخوان، وكأنهما نسيج واحد. إلا أنه ساق بعضا من الكلمات التي يمكن أن يُستشف منها ما وراء السطور، مثل تلك التي يتحدث بها لسان الرواية “ثابت” ويتوجه به إلى ذلك الحالم، العائش في دنيا الخيال، والرؤى المثالية {أعلم يا صديقى أنك لا تصدقنى، ولابد أنك تقول إننى أدعى أمورا لم تحدث، وربما تبحث في ذاكرتك عن سامبو أو رزف الله كى يعضد موقفك، لكنهما رحلا وتركاك وحيدا، ربما نجيا بأنفسهما مما تعيشه الآن، لم ينتظر أي منهما كى يرى أنجريتا وقد أخذ الجنود في دفع أبنائها أمامهم كما تدفع الماشية إلى الزرائب، ولا شيء يمنعهم عن تهجيرهم من بيوتهم، فقد سيطروا على كل شئ، ولا أحد يملك أن يرفض ما قرروه} ص318. وكأنها فصل الخطاب. والترجمة الفعلية لما عليه عنوان الرواية.
ومن تأمل تلك النماذج، التي صنعها الكاتب، و(حكى) عنها وكأنه يحكى عن عالم ليس موجودا على الأرض، بينما قدماه تغوص في طينها، نستطيع القول بأن الكاتب صبحى موسى، قد استطاع أن يشيد بنيانه الروائى، في روايته “كلاب تنبح خارج النافذة”، والتي قسم العالم المريء فيها إلى عالمين، عالم خارج النافذة، وآخر داخلها. أقامها على عمودين اثنين، هما الجانب الشخصى للأفراد المشكلين للمجتمع، وبالتالي النظر إليهم تلك النظرة الاجتماعية، والتى تؤكد فقر”إنجريتا” أو مصر القديمة، ولذلك استحقت الاسم الذى هو دعوة للغضب. والعمود الثانى هو النظر إلى نفس الشخصيات برؤيتها الرمزية، التي تقود إلى الرؤية السياسية، والتي أدت فيها الثورة إلى ما كانت عليه قبلها، وهى إقامة مجتمع يخص الطبقة العليا، وهدم البيوت على رؤوس الطبقة الأدنى، فوجود هذه البيوت، يشوه الصورة التي يريدها قادة الثورة. نجخ في تمثيل ذلك بين الأماكن المنقسمة، فقسمت المجتمع الواحد. والأشخاص، الذين أتوا جميعهم غير قادرين على تحقيق حلمهم، لأنهم –جميعا-يطيرون… بجناح واحد.
…………………………………………….
[1] – صبحى موسى-كلاب تنبح خارج النافذة – صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات – ط 1 2024.
[2] – صبحي موسي – نقطة نظام – رواية – الدار المصرية اللبنانية – ط1 – 2017.
[3] – صبحى موسى- نادى المحبين – سما للنشر والتوزيع – ط 1 2021.
[4] – صبحى موسى – الموريسكى الأخير – المصرية اللبنانية- ط1 2015.