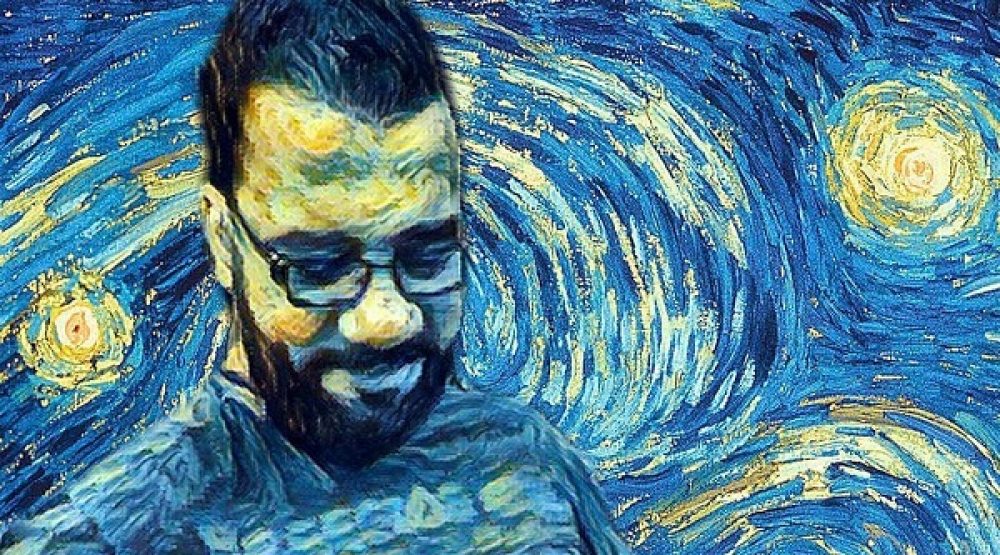ممدوح رزق
حينما أستعيد الآن تلك المرحلة التي مر عليها خمسة وعشرون عامًا تقريبًا وأعقبت انتهاء فترة عملي بجريدة “المساء”؛ يتملكني فورًا شعور جحيمي بالندم والحسرة على ما اعتبره بشكل عفوي إهدارًا لزمن طويل مبكر لا يمكن تعويضه، بل وكان ضياعه بمثابة تأسيس صارم لخسارات لم يتعطل تكاثرها وتوحشها طوال السنوات التالية بحيث أصبحت هوية دامغة لحياتي خصوصًا على المستوى المهني.. أتحدث عن الاضطرار للعمل في ما كان يسمى وقتئذ بـ “الصحافة الإقليمية”.. أن أشترك في تنفس الهواء ذاته مع العاملين في بالوعات “حديث المدينة”، و”أنباء وسط الدلتا”، و”أحرار الدقهلية” والذين وصفتهم في نوفيلا “جرثومة بو” بـ: “المحتالين، واللبوات، والمتاجرين بكرامتهم.. الذين كانوا مجرد قطع من الخراء، ترتدي البِدل والكرافتات، وتجلس وراء المكاتب، ولا تكره في حياتها أكثر من هذا الذي يعلم حقارتها تمامًا”.
لماذا الندم والحسرة؟.. لأنك ببساطة تكتشف في الأربعينيات ما كان يتحتم عليك فعله في العشرينيات.. الاكتشاف الذي يعادل التيقن فعليًا وعلى نحو يتجاوز أي وقت مضى بما يعنيه السقوط من السماء أو تناثر أشلائك في أعمق باطن من الأرض.. منذ خمسة أعوام تقريبًا وأنا أتعذّب كأنها لعنة النهاية البديهية باسترجاع كل الخطوات المناقضة التي كان ينبغي أن أقدم عليها في منتصف التسعينيات ولم أفكر ـ مجرد تفكير ـ في وجوبها وضرورتها.. مسارات عديدة للعمل تشترك جميعها في عدم قابليتها للاستدراك بعد انقضاء الزمن الملائم لوجودها وأيضًا في أنها كانت ستبقيني ـ مثلما أتصوّر ـ أكثر ابتعادًا عن الٱخرين.. أقل خضوعًا للتأثيرات القاتلة لـ “الظهور” وسط حصار العيون والأفواه.
هذا ما تكون عليه اللحظات الأولى من الاستعادة.. ما سيتبدّل تدريجيًا مع استمرارها ومواصلة التمعن في حقائق الواقع القديم الذي خلق الجذور الصلبة لهزائمك.. ستفكر في أنك كنت خلال ذلك العمر ما زلت راضخًا لما تركت ظلالك المرتعشة تغادر عزلتك نحو الحواف المائعة والعتبات الضبابية من أجله، أو مثلما كتبت في رواية “الفشل في النوم مع السيدة نون: “كأنه في طفولتي، وفي لحظة لا يمكنني تذكرها إطلاقاً استقر في داخلي يقين لا يمكن خدشه بأنه يمكن التحكم في العالم بواسطة الخضوع أولاً لديناصوراته، الذين سيقدّرون إخلاصك، ومسالمتك كقط أليف، قادر على حبس عنفه المتزايد؛ فيهبون أنفسهم في المقابل كتابعين لك”.. أنك كنت تطارد الجرائم التي لا يعاقب فيها القاتل ولا تُدفن جثة المقتول ولا تنتهي كما يقتضي قانون ما.. أنك كنت مسجونًا في تلك الغفلة القهرية التي رسخت وعدًا خبيثًا داخلك بإمكانية إخضاع الدنيا في آخر ذلك المطاف وشكّلها أشخاص وأحداث وأماكن كنت أنت الغنيمة المولودة تحت وصايتهم دون أدنى ثغرة للهروب.. أنك كنت مسكونًا بالمعجزات التي قد تحققها الأشباح اللامرئية للغة من أجلك وليس عبر الأجساد المتعيّنة التي تصوّر هذه اللغة.. لهذا لم تغلق على نفسك حينها باب ونافذة حجرتك لتبدأ رحلتك في كتابة “أدب الجريمة” مثلًا.. لهذا عملت في الصحافة بالمعنى الشامل لها، وقضيت خارج منزلك معظم الوقت برفقة الغرباء.. لهذا لم تكتب مسرحيات أو قصصًا مصورة أو سيناريوهات أفلام في تلك الفترة؛ أي ما سيُعرض ويُرسم ويُمثّل.
ذلك التمعن الذي سيتلاشى كذلك بالتدريج بعدما يبدو وكأنه أزاح الندم والحسرة عن قلبك، ومنحك ما يشبه مواساة الإدراك المتجدد للشروط الإجبارية الحاكمة لتاريخك الشخصي.. الإلزامات التي جعلت كل ما حدث كان لابد له أن يتم حقًا وفي مواعيده المناسبة، بالطريقة التي لم يكن هناك سبيل أو مجرد فرصة لتفاديها.. سيتلاشى كل هذا كأنه لم يوجد أبدًا ليعاود الشعور الجحيمي بأنك أهدرت زمنًا طويلًا مبكرًا لا يمكن تعويضه؛ يعاود افتراسك في لحظة لاحقة قبل أن تبدأ ثانية في تأمل حقائق الواقع القديم لاسترداد العزاء الغائب كأنه وداع خفي لا يتوقف احتدامه اليائس في روحي ويكشف عن نفسه في شكل نوبات احتضار روتينية صامتة.. العزاء الذي ربما يدفعك لتذكر “تشاك بولانيك” ثانية، كتشبث بخلاصة منقذة:
“Have your adventures, make your mistakes, and choose your friends poorly — all these make for great stories.”